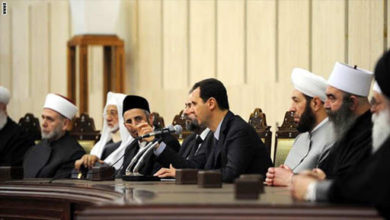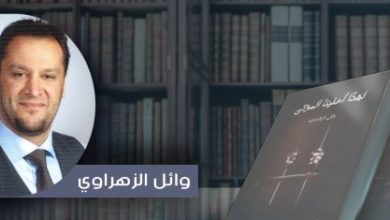قد يقول قائلٌ إن الحريةَ لم تأتِ بعدُ كي نكون قادرين على الكتابة تحت عنوان “الخوف من الحرية”، وأن التحرر غير الحرية. ومن أجل هؤلاء نؤكد قبل كلِّ شيء، أن العنوان هو “الخوف من الحرية”، وليس “الحرية”؛ ولو أن الحرية أتت، وذاق طعمَها الخائفون منها، لما كنا مضطرين لتناول مثل هكذا عنوان، لأن حضور الحرية، بطبيعة الحال، يُبدِّدُ الخوفَ منها.
الآن، الحرية تحتاج إلى تَحرُّرِ على مستويين اثنين، مُستوى السلطة، وهو بطبيعة الحال نقاشٌ حاضرٌ دائمًا هذه الأيام، وفيه الكثير من الوعود الإيجابية، وفيه بعض السلبيات والمنغصات؛ وهذا مستوى مُهم؛ ولكن ثمة مستوى آخر لا يقل أهميةً عنه، وهو التَحرُّر من أنفسنا الأمارة بالسوء، ومن عاداتنا السيئة المُتجذرة، وعصبياتنا التي تجعلنا تابعين لا نُفكِّر: يعني التُحرر من تكويننا الرَعوي.
بعد هذه المقدمة، واستنادًا إليها، نبدأ النقاش.
أخطر أنواع الخوف هو الخوف من الحرية، وكان لافتًا منذ سقوط النظام وجودُ نوعٍ من السوريين الذين يمتلكون نمطَ تفكيرٍ يمكن أن نقول، ونحن مرتاحو الضمير، إنَّه نتيجةُ خوفهم من الحرية التي صارت قريبةً وممكنةً بعد التحرير. وهذا الخوف يصنع حافزًا مدهشًا للتمسك بالهُوية، وهو في الأصل نتيجةٌ من نتائج التَهَوُّي: أي إحالة كل شيءٍ على الهُوية، وعلى الجماعة الموروثة السابقة على وجود الفرد، وخياراته الحرة المستقلة النابعة من تفكيره، وأفقه الإبداعي، مثل الدين، والطائفة، والإثنية.
الخوف من الحرية نتيجة منهج تفكيرٍ يبدأ أساسًا من العنوان الذي تختاره الجماعات للمشكلات التي تناقشها، وتُفكِّر في حلِّها، وهذا العنوان في الغالب يعكس طرائق فهم الأفراد، وطرائق اشتغال عقولهم، والذهنية التي تحدد مقارباتهم للحياة، أكثر مِمَّا يعكس طبيعة المشكلات نفسها، ونوعيتها.
مثلًا، إذا قلنا إن وصولَ مدرسة إسلامية إلى حكم سورية مشكلةً سياسيةً بالنسبة إلى كثيرٍ من السوريين، فإن طريقة نقاش هذه المشكلة انطلاقًا من تعزيز الطائفة، أو الدين، في مقابل ذلك، عنوانٌ يعكس تَملُّقَ الذات بوساطة نقد “الآخر”، (أو الذي تتم مقاربته بوصفه آخر)، ومن ثم تدبير هذا الإشكال بوصفه فرصةً لإعادة بناء القطيع الهووي والعودة إليه؛ فهذا لا يعني حلًا للمشكلة، ولا يعني عنوانًا صحيحًا لها، بل يعني إضافةَ مشكلةٍ جديدةٍ إلى القديمة. وبصورة أقرب إلى الواقع، نضرب أيضًا المثال الآتي: التطرف الدرزي ليس حلًا لمشكلة لتطرف السُني، بل مشكلة جديدة تضاف إليها؛ والقومية الكردية ليست حلًا لمشكلة القومية العربية، بل مشكلة جديدة تضاف إليها، وهكذا.
يمتلك الخوف من الحرية قدرةً مدهشةً على تحويل أي مشكلٍ وطني إلى فرصةٍ لإعادة التكور على الذات (الهُووية) الضيقة، لأنه ينطلق من إشكالٍ مع الآخر، ويفكِّر في حل هذا الإشكال، أو إيجاد صيغة تكون مخرجًا للحل؛ فيما المطلوب تغيير هذا الإشكال من أساسه، لأنه لا يفعل شيئًا إلا بناء القطعان الهُووية التي يُقَويها الخوفُ غيرُ العاقل.
في العمق، يخاف القطيعُ الهُوويُ الحريةَ لأنَّه يخشى الانفتاح، ويتوجَس من الآخر، ولأن نعرتَه العصبية تضطرب، وتقلق، وتشعر بالتهديد من إمكان توسيع دائرة الـ “نحن” توسيعًا مدنيًا لا يقيم وزنًا للقرابة، أو العائلة، أو الدين، أو الطائفة، أو العشيرة، أو العرق. مع هذا الخوف من الحرية يصير كلُّ حديثٍ مضطربٍ، وكل نقاشٍ قلق، ويصير كلُّ فعلٍ يهدف في جوهره إلى تسميك السياجات حول الجماعة، ومنع اندماجها مع الآخر، بل ومعاقبة الذين يحاولون عبور السياج إلى الخارج، أو الذين يفتحون النوافذ لبعض الهواء المنعش الجديد. والمدهش قدرة هذا التفكير الهووي على استعمال مصطلحاتٍ حيوية، مثل مصطلح “المدنية”، و “الديمقراطية”. هكذا صار مشهد شيخ عقل الطائفة الدرزية، وهو يحاول تَملُّقَ ذاتِه باستخدام “المدنية” و”العلمانية” و”الديمقراطية” مشهدًا طبيعيًا، في حين أن جلَّ ما يفعله الرجل بتملُّقِ ذاتِه، أنَّه يَسدُّ أفقَ المدنية، ويفتح أفقَ القبيلة، والطائفة، ويُسمِّكُ السياجات حولَ جماعته.
بالطبع، هذا لا يصادر حق الجماعات الطائفية الصغيرة بأن يشعروا بشيءٍ من الارتياب، وعدم الراحة، من تاريخ بعض أفراد السلطة الحالية المُتطرف، ومن حاضر بعضهم أيضًا. ولكن هذا حقٌ ليس حكرًا عليهم وحدهم، ولا يجوز أن يمتلكوه حصريًا لأنه حقٌ وطني وعمومي. وفي هذا السياق، ثمة ظاهراتٍ، لم تعد سرًا، تشي برغبة البعض في بناء سياجٍ حول الذات السُنيَّة السورية أيضًا، فيما يبدو في العمق خوفًا من الحرية، وتحصين الهوية السُنيَّة بالسلطة، مع أن هذا التحصين، لو فكَّرنا قليلًا، لن نجد له أيَّ حاجةٍ، إلا إذا ظل الخوفُ يحكم سُلوكَنا من “حافظ أسدٍ” جديدٍ لن يأتي أبدًا. لذلك، سأقول، مرتاح الضمير أيضًا، إن تطييف السنة يعني أن السنةَ، بأيديهم، يجعلون “حافظ الأسد” خالدًا بحق، لأن الخوفَ من عودة شيءٍ يشبه الإجرام الأسدي، وتضخيم احتمال حضوره، هو أصل القبول بمثل هذا التطييف؛ فلنكن حذرين من هذا الفعل الذي يتأسس على الخوف من الحرية، والذي يحكمه الخوف من شيءٍ ذهب ولن يعود.
يرتبط الخوف من الحرية بمسألةٍ أخرى مهمة، وهي اعتياد الرعاية، وسلوك الرعايا، ومواجهة صعوبة في كسر هذه العادة، وللأمانة هذا مُسوَّغٌ؛ فلقد عشنا كلَّ حياتنا رعيةً؛ ولكن حان الوقت لنخرج خارج دائرة الراحة هذه التي تمنع التفكير، لأن القبول بأننا مجرد رعايا قاصرون، وغيرُ قادرين على ابتكار معنى لحياتنا الاجتماعية والسياسية من دون وصاية شيخٍ، أو زعيم، أو أي وصي؛ يعني بالضرورة أننا قابلين لنتحول إلى أداةِ حربٍ، أو إرهاب، في أي وقت؛ وهذه كارثة حقيقية بالنظر إلى التجربة التي عايشناها على مدار سنواتنا السابقة في هذا البلد، والثمن العظيم الذي دفعناه لنكون أحرارًا.
الخوف من الحرية هو الذي يحوِّل المستقبل إلى مجرد ورشة إصلاحٍ هُووي للماضي، وهذا ما يخلق مصطلحاتٍ تشبه “الرسالة الخالدة”، وغياب التمييز بيننا وبين آبائنا، وأجدادنا، وأبنائنا؛ هكذا تصير الـ “نا” دالةً على الجماعة نفسها “إلى يوم القيامة”، وكأننا لا نولد ولادةً مثل باقي البشر، بل نتناسخ تناسخًا، ماضينا، مثل حاضرنا، مثل مستقبلنا.
باختصار، “نحن” الجماعات، اعتدنا أن نربي الأيديولوجيا؛ ومع أننا صرنا نعرف أن هذه الأخيرة عندما تكبر تقتلنا، ومع أننا عانينا منها كثيرًا، لكن نربيها من دون وعيٍ مرةً تلو المرة. والأيديولوجيا تبدأ من المساواة بين الذات والفضيلة: “نحن الأفضل”! إننا بهذه التربية، وبما تحتاج إليه من تفعيل عاداتنا الأثيرة في النبش في الماضي، لا نفعل شيئًا إلا أن نلوذَ بأقبيةٍ نأمَن فيها على عالمنا الهُووي الذي يسحبنا إلى الخلف ويقتلنا جوعًا، وحروبًا، ويبعدنا عن ديننا، ووجداننا، وإنسانيتنا، وضمائرنا.
أخيرًا قد يكون هذا النوع من الكتابة فعل ضميرٍ، أكثر مما هو فعلُ تفكير.
المصدر: تلفزيون سوريا