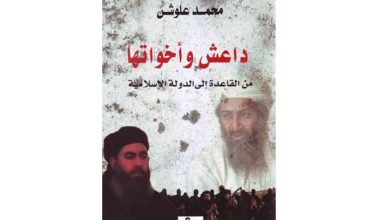منذ “هجمات نيويورك”، التي قادتها منظمة القاعدة السلفية بزعامة أسامة بن لادن في 11 أيلول/سبتمبر 2001، كان واضحاً أنّ التاريخ سيُسجّل هذا اليوم كمحطة فاصلة بين كل ما سبقها وما سيعقبها على صعيد الاستراتيجية الأميركية في العالم العربي، من منظور جديد يتمثل في “الحرب الاستباقية” و”الفوضى البنّاءة“.
وفي هذا السياق كانت بداية غزو العراق في 20 آذار/مارس 2003، وبداية إعادة هيكلة المنطقة العربية، من خلال تفكيك الوحدات الوطنية وإعادة تركيبها في إطار الشرق الأوسط الجديد. وهذا ما شهدناه كمحصلة لهذه السياسات في العراق وليبيا والسودان، وما نشهده هذه الأيام منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في فلسطين ولبنان وسوريا، مما يعني: تآكل مفاهيم السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وزوال التحصّن وراء مبادئ القانون الدولي، والتكيّف مع الضوابط الجديدة في العلاقات الدولية، وهي مقاومة الإرهاب وملاحقته، والتصدّي لمن يلجأ إليه ومعاقبة الدول المتراخية، وتقييد التحرك الدبلوماسي للدول المشكوك في ولائها، وطرد الدول “الـ مارقة” بالملاحقة والتهميش، بما ينسجم مع مخططات إسرائيل لإعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد.
في عالم الفكر والسياسة الدولية ليس هناك ما يُقبل كله أو يُرفض كله. فلو كان من السهل أن نرفض كل ما تقوله الولايات المتحدة، لما كانت حاضرة في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا.
وفي هذا السياق، سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى إجراء تغيّرات بنيوية في العالم العربي، وذلك عبر برنامج يرمي إلى “إصلاح المؤسسات الاقتصادية والتربوية والسياسية في الشرق الأوسط”. كما أعلن وزير الخارجية آنذاك، كولن باول، عن “مبادرة الشراكة الأميركية في الشرق الأوسط” في سياق عزم الولايات المتحدة على إعادة هيكلة برامج مساعداتها للدول العربية، لأنّ الكثيرين في العالم العربي، كما قال باول، يعانون اليوم “من انعدام الحريات السياسية والاقتصادية، والنقص في مجال حقوق المرأة، والتعليم الحديث الذي يحتاجون إليه للازدهار في القرن الحادي والعشرين”.
ومما لا شكَّ فيه أنّ المبادرة الأميركية كان يمكن أن يكون لها أثر في تسريع التحوّل السياسي في العالم العربي، لو كانت جادّة في رفع الغطاء عن الأنظمة التسلطية في المنطقة، بالطريقة نفسها التي رفع بها غورباتشوف الغطاء عن ديكتاتوريات أوروبا الشرقية بانتهاج سياسة الانفتاح والتقارب مع الغرب، وبناء أنظمة سياسية ديمقراطية.
وبالرغم من ذلك، ففي عالم الفكر والسياسة الدولية ليس هناك ما يُقبل كله أو يُرفض كله. فلو كان من السهل أن نرفض كل ما تقوله الولايات المتحدة، لما كانت حاضرة في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. ومن هذا المنطلق، لا مناص من الاعتراف بأنّ تطورنا السياسي ما زال بعيداً جداً عن الديمقراطية. وإذا كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة قد ركّزت على هذه القضية، فلأنها أضعف ما فينا، ونقطة الانكشاف القاتلة في تطورنا المعاصر، وهو ما لا ينفع فيه الإنكار، بل يجب أن نغلق نافذة انكشافنا في موضوع التقدم نحو الحداثة.
ولعلَّ من أهم الدراسات التي ظهرت بعد الهجمات، دراسة بعنوان “من أجل أن نسود” أصدرها مركز الدراسات الأمنية والدولية بواشنطن، إذ ورد فيها: “إنّ الدافع الرئيسي وراء غضب المسلمين هو فشل العديد من الدول الإسلامية في تشكيل حكومات عصرية تستجيب لاحتياجات شعوبها واحتياجات المجتمعات المدنية، التي لا يُسمح لها سوى بأقل مستوى من النقاش والديمقراطية”.
وبداية، يجب أن نعترف بأنّ الدول العربية بحاجة ماسّة إلى التطور في اتجاه ديمقراطي. لكن لا بدَّ من التأكيد على أنّ الديمقراطية لا يمكن أن تكون مجرد وصفة مستوردة من الخارج، بالرغم من وجود معايير كونية لها، وإنما هي – أساساً – فعل محلي داخلي وطني، وتفاعلات ونضالات شعبية. خاصة أنّ أميركا كانت وما زالت تتعامل بطريقة انتقائية مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. من هنا يبدو واضحاً أنّ المسألة الديمقراطية، في نظر الولايات المتحدة، ليست سوى “أداة” من أدوات السياسة الخارجية. فمثلما تُستخدم المعونات في دعم الأنظمة والدول من أجل خدمة مصالحها، كذلك يُستخدم هذا الشعار تبعاً لمدى قرب أو بعد النظام المعنيّ من السياسة والمصالح الأميركية. إذن نحن أمام حالة تتعلق بالمصالح والاستراتيجيات الأميركية.
إنّ أهم ما تنطوي عليه احتمالات ما بعد مرونة إدارة الرئيس الأميركي ترامب تجاه إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، هو ولادة النظام الشرق أوسطي، الذي سيكون الاقتصاد أحد أوجهه
وفي العالم العربي، لا يجوز الدفاع عن الأمر الواقع الراهن، الذي استنفد طاقة المجتمعات العربية وجعل منها بؤرة للطغيان والإرهاب والفساد. باختصار، يدور الأمر حول وحدة معركة الحرية، على حدّ تعبير ياسين الحاج صالح: استقلال الوطن وحرية المواطن والإنسان، والتحرر من السيطرة الخارجية لا كبديل عن الحرية السياسية والثقافية وحقوق الإنسان، بل كأفضل شرط لتحقيقها. فبكل بساطة، لا يمكن للشعوب أن تدافع عن سلطات تجوّعها وتحاصرها وتساومها حتى على حق المشاركة في رسم سياسات دولها.
إنّ أهم ما تنطوي عليه احتمالات ما بعد مرونة إدارة الرئيس الأميركي ترامب تجاه إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، هو ولادة النظام الشرق أوسطي، الذي سيكون الاقتصاد أحد أوجهه، لكنَّ الأولوية فيه سوف تكون للشقّ والمكوّن الأمني، تحت رقابة الثلاثي: إسرائيل وتركيا والسعودية.
وهكذا، لقد دخلنا مرحلة دقيقة جداً، مرحلة إعادة ترتيب الأنظمة والدول والحدود. فالحرب ضد الإرهاب ستغيّر كثيراً من المفاهيم السائدة بين الأمم، تماماً كما غيّرت نهاية الحرب العالمية الثانية مفاهيم العلاقات والتوازنات بين الدول.
وعلى الصعيد السوري، يبدو أنّ الإنجاز الداخلي فقط هو الذي يفتح الباب أمام تحقيق تطلعات شعبنا نحو ضمان حقوق الإنسان والديمقراطية والتقدم، مما يعني حلّ معضلات إعادة الإعمار والتنمية الشاملة والديمقراطية السياسية والازدهار الثقافي. وذلك من خلال تشاركية سياسية وصياغات عقلانية لمواردنا الاقتصادية والبشرية، والإقلاع عن الاعتماد على أهل الولاء من “إخوة المنهج السلفي” واستبعاد أهل الكفاءة. بما يفتح المجال لهيئة حكم انتقالي تشاركية، تُشرف على مجمل سياسات المرحلة الانتقالية، طبقاً لإعلان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، اللذين تم التأكيد عليهما في البيانين الأخيرين الصادرين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
المصدر: تلفزيون سوريا