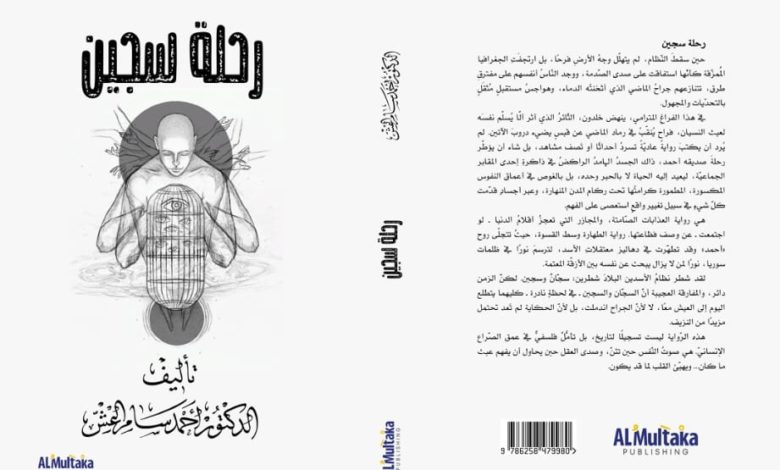
لعدة أيام بحث خلدون دون توقف عن ذاك الطبيب الذي تحدث عنه معتز، كان شيئاً ملحاً في داخله يدفعه للبحث عنه بجنون، وكأن هذا الطبيب يحمل خارطة الكنز المفقود، والعجيب أن الصدفة قررت أن يجتمع به بسرعة لم يتخيلها هو نفسه. فالبلد تعيش فوضى لا سابق لها، ويبدو التنقل داخلها فيه من المشقة الشيء الكثير، هذا ناهيك عن العبثية في البحث عن الأشخاص الذين خرجوا من المعتقل، وبالذات الذين كانوا داخل سجن صيدنايا الأحمر أو فرع فلسطين؛ لأن كلَّ مراسل ويوتيوبر على وجه الأرض صار يبحث عنهم، ليس تعاطفاً معهم، ولكن لزيادة المشاهدات والإعجابات؛ لأن هذه طبيعة النجوم، فهي تستغل كلَّ فرصة حزينة كانت أم جميلة لزيادة المتابعين، فقد تحول العالم بأسره بعد غزو التكنولوجيا إلى صفحات صفراء، تستثمر الآلام لجذب المشاهدين وزيادة عدد صور الإبهام المرفوع للأعلى، والمأساة السورية الوجبة الأدسم، بعد أن أصبح فضح جرائم النظام أمراً متاحاً ولا عواقب تقف خلفه؛ لذا ما أجمل المشاهدات الخالية من المُساءلة الفردية للمشاهير، التي تعجن المحتوى بالتعليقات والأسئلة والأجوبة التي تدغدغ الغرائز لاغير. وكعادة السوريين الذين يتفننون في تحويل المأساة إلى مواد للضحك في مشهد أقرب ما يكون للسريالية العبثية، أصبحت قصص المعتقلين تجذب ملايين المشاهدات، دون أن تجذب ملايين الدوافع لتغيير المسارات، فما أجمل عرض المأساة السورية على شكل مسرحية كوميدية أو حلقة من مسلسل مرايا أو مادة لطيفة للقطة في بقعة ضوء، فاختصار المأساة الإنسانية بالكوميديا ماركة مسجلة في البلدان العربية، وسوريا الأسد رائدة في هذا المجال. لكن أحياناً يظهر الخير من بين ركام الشرور. وبالفعل ظهر الطبيب في فيديو لأحد مشاهير اليوتيوب، بل حتى استضافته شاشة فضائية عربية تصطاد هذه اللقطات المثيرة، وكأن من ينقل الخبر قنوات لم تروج طويلاً لروايات النظام أو أن من يمولها لا يملك سجلاً موازياً من الهمجية على من يخالفه.
رأى خلدون أن تصيد الطبيب سعيد فرصةٌ لا تعوض لمتابعة رحلة صديقه ولفهم أعمق للمسارات النفسية للأزمة السورية ودراسة الأعاصير التي مازالت تعصف بكل من عبر فوق هذه الأرض. ربما أحسَّ خلدون أننا الآن بحق في عين العاصفة، فما مصطلح المكوعين، والناشطين المتأخرين جداً في إعلان ثورتهم إلا الهدوء الذي لا تعيشه إلا في عين العاصفة أو خارجها، وإحساس خلدون أنه هدوء عين العاصفة؛ لأن الجمر مازال يغلي تحت الرماد في سوريا ما بعد سقوط النظام. والعدالة الانتقالية مؤجلة إلى أجل غير مسمى!
الوصول إلى سعيد لم يستغرق الكثير، لكن موافقته على لقاء خلدون فشلت بعد عدد هائل من المحاولات، فماذا يريد شخص مجهولُ الهويةِ والنوايا من شاهد ملك على جرائم النظام؟ حقيقة عندما تنظر للمسألة من تلك الزوايا تجد أن هذا الطبيب محق، فهو بعد اللقاءات على الشاشات أصبح يتلقى الآلاف من الرسائل من أشخاص بدوافع ومشاعر مختلفة: تهديد، إعجاب، مواساة، رغبة بسرد المزيد من الوقائع، استفسارات من أمهات مكلومات يواسين أنفسهن بسماع خبر يمدهن بآخر طيف سعادة عابر مع ذكرى فقيدهن، بل حتى إنه عُرِضَ عليه المال من بعض أقرباء الضحايا فقط ليشتروا منه معلومة ولو صغيرة عن فقيدهم، أو حتى عن مصير جماعي لهم بين أشخاص كانوا يضمون مأساة الأهل (فقيدهم) التي لم ولن تنطفئ يوماً؛ وسط كلِّ هذا لعن الطبيب اللحظة التي وافق بها على الخروج مع هذا اليوتيوبر الذي كان عدد متابعيه يدل على سخافة محتواه، فكلما زاد عدد المتابعين علمت نوعية المحتوى.
لكن كل شيء تغير عندما أوصل خلدون للطبيب رسالة عن طريق صديق لهما، مفادها أنه رفيق درب الشخص الذي يدعى أحمد. عندها همَّ الطبيب للقاء خلدون في أسرع وقت، وكأن الآية قد انقلبت، وصار الطبيب هو من يبحث عنه.
اللقاء حدث في بيت صديق مشترك ودون أسئلة ودون مقدمات، بدأ الطبيب سعيد في رواية قصته، لم يتحدث عن شيء قبل الاعتقال؛ فهذا الموضوع لا يمت بأي صلة إلى سبب لقائه مع خلدون، بل بدأ حديثة لحظة دخوله المعتقل.
بدأ سعيد يصف لحظة وصوله إلى فرع فلسطين والإدراك المرعب لحجم القهر ووحشية المكان. يقول: تم تجريدنا على الفور من هوياتنا ليست تلك المغلفة بالبلاستيك؛ ولكن من هوياتنا الإنسانية كبشر من نفس فصيلة من يسوقوننا كالخراف! إلى جانب سجناء جدد آخرين تم إجبارنا جميعاً –ومنذ لقائنا في ذاك الجحيم المستعر-على تجربة مروعة من الارتباك والخوف لا يتوقف على حفلات التعذيب الجنونية ( دولاب، تعليق، أصوات…) أو التحقيق معنا ونحن معصوبو العينين نقطر خوفاً في ذاك الفراغ الأسود، ولكنها تمتد إلى تجربة إغراق أنوفنا برائحة الدم الممزوجةِ بعرق السجانين، أو تعطيرنا برائحة العفونة اللعينة تلك المعشعشة في مكتب المحقق -التي تزداد حدةً ووخزاً مع كلِّ مأساة إنسانية يضيفها إلى سجله الإجرامي، أو حتى صم أسماعنا بصرخات المعذبين نساء وأطفالاً ورجالاً.
فجأة تصبح حواسنا الخمسُ أسيرة سجانين وجلادين يتلاعبون بها كما يتلاعبون بأوراق الشدة أو ربما بوحشية أكثر فأوراق اللعب يحافظون عليها بغية استخدامها مرة أخرى، أما حواسك الخمسُ، فطمسها وإغراقها بالألم والمعاناة مهمة مقدسة؛ أقسموا بالولاء على أدائها بأفضل طريقة ممكنة. يصبح الرعب الشديد لما ينتظرنا واضحاً عندما تشهد الفوضى في عملية الاختيار للسوق إلى الألم الصرف، ناهيك عما هو أعظم بكثير وهو وحشية ضبابية المصير. تتمنى نزول المعجزات من السماء أو أن تلعب الصدفة لصالحك دون غيرك، كنا مستعدين للتضحية والفداء بأي شيء، ربما بأمهاتنا وآبائنا وزوجاتنا وأبنائنا، وكأننا في بروفة مصغرة ليوم العذاب الأكبر!
هذه اللحظة كانت صادمة بشكل صارخ للطبيب سعيد؛ لأنها تجسد الرعب المربك الذي شعر به السجناء الجدد عند سوقهم إلى مكان خارج هذا الكوكب يسمى –ويا للسخرية- فرع فلسطين التي لطالما تغنى النظام وحلفاؤه بتحريرها. تصوير فقدان الهوية والشعور الساحق بالعجز الذي واجهه السجناء الجدد بشكل واضح، يمهد الطريق للسقوط الحر للسجان والسجين الأول بعذاباته والثاني بآثامه.
كان الطبيب سعيد ممن استدعوا للمساعدة في عمليات التعذيب الطبي! هنا نطق خلدون بأول جملة: تعذيب طبي؟! أجابه سعيد: نعم هذا ما لم أذكره للعامة على الشاشات بغرض إمتاع ذاك الجمهور في كولوسيوم المأساة السورية وزيادة مستوى الإثارة لدى عشاق الدراما؛ لأني لا أستطيع –مهما حاولت- أن أدرك ما اقترفته يداي، ولماذا وكيف فعلته؟ عندما تأخذ قراراً وأنت عاجز عن إدراك أبعاده، أو يضعك القدر في خيارات كلِّها قاتمة فلا تدرك أيها أكثر قتامة إلا بأثر رجعي عندها تصبح تلك الحالة عورتك الأبدية التي لا تستطيع أن تغطيَها كلُّ أوراق التين في العالم، والآن معكم أكشفُها لأول مرة؛ لأن أحمد فقط من أعطاني تلك اللحظة من الاختيار دون أن ينطق بكلمة واحدة.
كثير من السجناء أجبروا على المساعدة في عمليات الإبادة والتصفية الجسدية من خلال العمل في محارق الجثث أو المكابس البشرية أو حتى بعمليات التخلص من الجثث. بدأ سعيد يصف روتين القتل الجماعي المرعب، حيث قُتل تحت التعذيب المئات من الناس كلَّ يوم ثم أحرقوا أو وثقوا ورحلوا إلى الجهات المجهولة. يروي سعيد رعبه عندما شهد القتل المنهجي، وأدرك الثمن العاطفي الذي تحمله أولئك الذين أجبروا على المشاركة فيه وهو واحد منهم.
يقول سعيد: ربما لم يكن لدي خيار؛ لأني إما أن أكون في الموقع القبيح الذي فيه الألم النفسي، أو على الطرف الآخر حيث هناك الألم الجسدي أشد بكثير. لا أعرف السبب الذي دفعني للوقوف حيث كنت، كنت أسوق بدايةً مبررات سخيفة أنني ربما أساعد أحداً أو أخفف الأذى عن أحد، لكن لم أدرك سخافة تلك التبريرات إلا عندما قابلت أحمد.
إن تصوير الدور المأساوي والمعقد أخلاقياً الذي لعبه سعيدٌ في السجن هو أحدُ أكثر أجزاء القصة إيلاماً. فقد سرد الكثير عن غرف الأسيد، والمحارق، والمكابس، كان يذكرها دون أن يبكي أو تدمع عيناه، لكن خلدون كان يشعر بأن وراء قسمات وجه “سعيد” التي لا يظهر خلالها أيُّ تعبير، يكمن فيها ألمٌ عميق دفنه سعيد تحت سابع أرض. يعكس دور سعيد كطبيب ومراقب لعمليات القتل الجماعي أهوال التواطؤ القسري، ويظهر العواقب النفسية والأخلاقية المدمرة المترتبة على إجبار المرء على القيام بمثل هذه المهام اللاإنسانية.
بصفته سجيناً طبيباً، تم إجبار سعيد على العمل مع الدكتور مضر، ذلك الطبيب الطائفي الحاقد سيئ السمعة المعروف بإجراء تجارب طبية وحشية على السجناء وبيع الأعضاء، وممارسة السادية المفرطة بأدوات أنبل مهنة عرفتها البشرية، حتى إن سعيداً كان شاهداً حياً على أول بثٍّ حي لحفلات التعذيب السادي الجنونية التي كانت تبث عبر دوائر مغلقة لتجوب العالم، ليستمتع بها من يمكن وصفهم بالشياطين البشرية من مختلف الأعراق والجنسيات، أولئك الذين يدفعون المبالغ الطائلة لإشباع ساديتهم. يصف سعيد التجارب المروعة التي أجريت على الأطفال والشيوخ، بما في ذلك العمليات الجراحية التي أجريت دون تخدير والحقن بمواد غريبة منها بول الرجل ذاته التي أدت إلى نتائج مروعة ومميتة في كثير من الأحيان. كما يصف سلوك مضر البارد والهادئ أثناء قيامه بهذه الفظائع دون أن تهتز له شعرة، بل شعر سعيد بالطبيب مضر منتشياً مخموراً بالطعم المر للانتقام من اللا-شيء. كان يروي الدكتور مضر بسعادة كيف بدأ مسيرته الحافلة بالتعذيب حتى الموت لطبيب كان ينافسه على قلب فتاة في كلية الطب، تلك الزميلة الجميلة اختارت ذاك الطبيب السني ابن المدينة وتزوجته، وعندما سمع أنه اعتقل في الثمانينات من القرن الفائت طار فرحاً وطلب نقله إلى سجن تدمر حيث يوجد منافسه السابق وضحيته العاجز في ذاك الوقت، كان يروي لسعيد المتعة التي لا توصف وهو يستمع لصرخاته ويشاهد الألم يعبر جسده المثخن بضربات المشرط الجراحي، والعجز يحاصر ذاك الطبيب الذي جُلُّ ذنبه أن قلب زوجته فضله على زميله.
قدم سعيد رواية مباشرة للجرائم الطبية التي ارتكبت تحت ستار المهنة السامية التي عادة لا تمارس إلا بعد قَسَم يحدد الإطار ويرسم الحدود الحرجة بين الصواب والخطأ. ويكشف سعيد التناقض الصارخ بين التبرير السخيف الذي استخدمه مضر والمعاناة التي لا يمكن وصفها للضحايا، لقد حفر حديث الدكتور سعيد خارطة الألم في ذهن خلدون عن عقلية مرتكبي الجرائم اللاإنسانية وعبثية التجاهل التام للحياة البشرية لدى هذه الوحوش التي تلبس أجساداً بشرية!
حاول الدكتور سعيد تعرية الواقع المروع للإبداع في إيذاء الذي يقف على النقيض منك، حيث صُفِّيَ الآلاف من الناس يوميًا في محيط مشبع باللا-رحمة. يصف سعيد عملية قيادة السجناء إلى حفلات التعذيب السادية، والجهود المحمومة التي بذلها الضحايا للمقاومة، والسعادة الصادمة لأولئك الذين أدركوا أنهم على وشك الموت. يقدم سعيد رواية مفصلة عن الضريبة النفسية والعاطفية التي فرضتها هذه العملية على كل من الضحايا وأولئك الذين شاركوا في العمليات دون أن يملكوا الخيار.
يبرز هذا القسم كشهادة على وحشية وطبيعة النظام المنهجية. إن وصف سعيد لعمليات التعذيب مثير للانفعال ومزعج، ويذكرنا بشكل صارخ بحجم القسوة البشرية إذا تجردنا من إنسانيتنا. إن موقفه كطبيب محاصر بين واجبه تجاه زملائه السجناء ومشاركته القسرية في هذه العمليات يضيف إلى الثقل العاطفي لروايته.
غالباً ما كان سعيد يتصارع مع معضلاته الأخلاقية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بدوره كسجين طبيب في سجن لا مكان فيه لتخفيف الألم، بل لزيادته، معادلة لم تخطر على باله أنها موجودة على سطح الكوكب عندما تخرج من كلية الطب! يصف الصراع الداخلي العميق الذي شعر به بشأن استخدام معرفته الطبية لإنقاذ بعض السجناء، بينما كان أيضاً متواطئاً في آلية الإبادة الأكبر دون أن يملك الخيار. يناقش الخيارات المعقدة التي كان عليه اتخاذها من أجل البقاء والتنازلات الأخلاقية التي كان عليه قبولها للبقاء على قيد الحياة.
لقد سلط سعيد الضوء على التكلفة النفسية للبقاء على قيد الحياة في مثل هذه البيئة غير الإنسانية. إن تأملات سعيد حول تواطئه في أهوال صيدنايا مؤلمة للغاية وتثير أسئلة صعبة حول البقاء، والأخلاق، وحدود القدرة البشرية على التحمل.
كان سعيد يُجبر على التأكد من مفارقة الضحايا للحياة قبل وضع كرتونة صغيرة كتب عليها رقم السجين وتاريخ وفاته، بعدها يُقاد الجسد إلى جهة يجهلها، لكن لا يخفى على المراقب أنه كان يُساق إلى المقابر الجماعية.
لأكثر من مرة قرر سعيد أن ينتقل من جانب التعذيب النفسي إلى جانب التعذيب الجسدي، فقدرته على الاحتمال استنفذت، وأحسَّ أنه لا يختلف عن ضحية مضر الأولى، وكأن الطبيب مضر يريد أن يعذبه ويقتله، لكن بطريقة أكثر إبداعاً مما فعله بضحيته الاولى. لقد تطور إجرام مضر حتى وصل إلى حدود يعجز عنها الشيطان الأكبر ذاتُه. في كل مرة يقرر فيها سعيد الانسحاب والقفز من دور المراقب المعذب نفسياً إلى دور الضحية التي تُسلخ وسط ضحكات السجانين وسادية الضباط، كان يتراجع في آخر ثانية.
قال سعيد: وكأن الدكتور مضر أحسَّ أنني أقاوم، فأراد أن يزيد الجرعة فقرر أن ينقلني إلى المكبس البشري، الذي كان آخر إبداعات رئيس السجن، فقد أراد أن يزيد سعة الحاويات التي تنقل الجثث، وبعد التشاور مع مضر على ما يبدو، أبدعا هذا القسم. إلى تلك اللحظة التي دخلت بها غرفة المكبس، كنت قد قمت بدور المساعد للدكتور مضر في عمليات سرقة الأعضاء، وكتابة تقارير الوفاة، والتأكد من توقف الحياة للأجساد التي وقفت طوابير، وكأننا في مصنع تجميع سيارات، لكن كنا بحقيقة الأمر مصنع تفكيك للروح الإنسانية في داخلنا جميعاً. كان أحمد أول من أُدخل إلى المكبس، كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، جلس مضر يراقبني في زاوية الغرفة بالقرب من مفتاح التشغيل مستمتعاً برؤية تفاصيل وجهي وردود أفعالي، ألقى السجانون وهم يضحكون بشكل هستيري ويرمون بالنكات السخيفة جثة أحمد على الطاولة الحديدية تحت المكبس، ثم التفت أحدهم إلى أحمد وقال له: “وحق علي هيك أحسلك تصير ورقة بدل ما تعبنا بحملك، هيك منلفك مثل السيجارة” ثم قهقه وقهقه معه الجمع، نظرت باتجاه مضر الذي لم يزح وجهه عني، وكأنه ينتظر أن أعلن استسلامي حتى يضعني مكان أحمد، لا أدري ما الذي دفعني لأن أشيح بناظري عنه، واستنفد أخر قطرة صبر يحملها دماغي المنهك. أحسَّ مضر ربما أنه فشل، فضغط زر التشغيل للمكبس، كانت عيناي لا تستطيعان أن تبتعدا عن ذاك الجسد النحيل الذي جلس صامتاً، وهو ينظر إلى المكبس ينزل ببطء ليسحق جسده، كان هناك بريق عجيب في عينيه، كأنهما كانتا تسبحان في عالم آخر، مع اقتراب المكبس منه ارتسمت على وجهه ابتسامة جميلة لم أشاهد في حياتي أجمل منها، كانت تحمل كلَّ السكينة في هذا الكوكب، وكأن دعَةَ أهل الأرض جميعاً انصبت دفعة واحدة عليه، وارتسمت على وجهه، كان لا شيء يشغلني عن النظر في هذا الوجه الجميل الذي لو جمعت له رضا أهل الأرض جميعاً، لزادهم بسهولة، شعور مختلط بشدة لا أدركه إلى الآن، اختلط في عقلي: خوف، استغراب، صدمة، إحساس بالجمال… أقسم لكم لا أدري، كلُّ ما أنا متأكد منه أن يد أحمد امتدت فجأة وأمسكت يدي، فأحسست بأجمل شعور لمسته في حياتي، كانت يده ناعمة أكثر من الحرير، وقبضته أحن من يد الأم وهي تمسك يد وليدها وهي تشاهده للمرة الأولى… بعدها لا أدري ما حدث لي، قال لي زملائي في السجن: إنهم شاهدوا السجانين يحملونني إلى زنزانتي وأنا غائب عن الوعي، وبقيت كذلك ليومين متتالين، حتى ظنوا أني أصارع سكرات الموت، كان السجانون يضحكون مع بعضهم، كيف أنني بحسب تعبيرهم “خروء وقلبو رقيق ما تحمل”، لكن في الحقيقة لم أشعر بشيء بعد أن أمسك أحمد بيدي، كل ما هنالك أني أردت أن اتشبث بهذا الشعور بأي ثمن، وبقي معي هذا الشعور إلى اللحظة التي وجدت فيها زملائي في الزنزانة يحملونني خارج السجن وهم لا يصدقون، ويقولون سعيد استيقظ لقد تحررنا، لقد سقط النظام.







