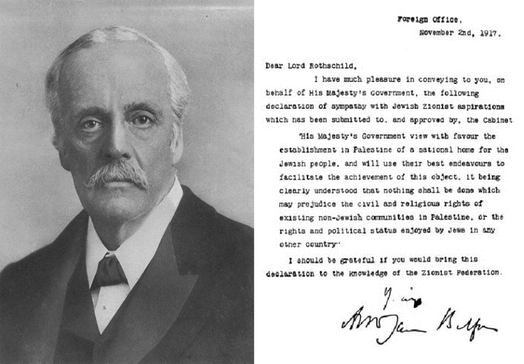
مقدمة: قضية قرن من الزمن
“إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة)، ليست دولة لكل مواطنيها؛ بل الدولة القومية للشعب اليهودي وله وحده”. بهذه اللهجة العنصرية، صرّح (رئيس حكومة كيان الإرهاب الصهيوني) بنيامين نتنياهو، عام 2019، في سياق رده على فنانة ومقدمة برامج “إسرائيلية”. وأوضح أنه لا توجد مشكلة مع المواطنين العرب في “إسرائيل”. وقال عن حزبه اليميني: “إنهم – أي العرب – يتمتعون بحقوق متساوية مثلنا جميعًا، وقد استثمرت حكومة “الليكود” في القطاع العربي أكثر من أي حكومة أخرى” .
هذا التصريح الملتبس بحدّ ذاته هو ترجمة للذهنية الصهيونية التي ما تزال تنمو وتتوالد في كل استحقاق، منذ “مؤتمر هرتزل” في مدينة بازل السويسرية عام 1897. هذه الذهنية التي تحولت يومها الى خطة استراتيجية بعيدة المدى، على يد ما يقارب 200 شخصية يهودية، انتخبت فلسطين من قائمة أهدافها، ووضعت الخطوات لإقامة وطن قومي لليهود فيها، يضمنه القانون العام .
ولعل أبرز الوثائق التاريخية التي تعكس كالمرآة ما عملت عليه هذه الذهنية، بعد عشرين سنة، هي وثيقة وعد بلفور عام 1917؛ أتى الوعد الملتبس على هيئة رسالة من مكتب وزارة الخارجية للمملكة البريطانية الى رئيس الجالية اليهودية في اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، ورد فيها من دون الخوض في السياق التاريخي والتأويل: “إنّ حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين…”.
ومن حماسة هرتزل وأمثاله، ينبثق هذا الخطاب وينطلق كمشروع متعاطف معه دوليًا، ليتماسك مع قانون الدولة القومية لليهود في “إسرائيل” بعد قرن من الزمن. إنه القانون الأساس من سلسلة قوانين تعويضية عن دستور مفقود، أتى بعد مخاض بين اليمين واليسار، وبين الوسطية والتطرف ليُعرِّف “إسرائيل” على أنها بالقانون العام دولة قومية للشعب اليهودي. أقر الكنيست “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) هذا القانون الحاسم للجدل “الإسرائيلي” الداخلي، في 19 يوليو/ تموز 2018، بأغلبية 62، ومعارضة 55، وبامتناع نائبين عن التصويت.
وفي المسار التاريخي؛ يقع قانون القومية، وهو القانون الأساسي الرابع عشر، في سلسلة القوانين المتتالية التي بدأ بسنّها الكنيست منذ إنشائه يونيو /حزيران 1950. هذه القوانين، كانت التعويض القانوني، بعد أن عجز المجتمع “الإسرائيلي” والسلطات السياسية والتشريعية المنبثقة عنه، عن صوغ توافقي لدستور متكامل للدولة الجديدة. وأهم سمات قانون القومية؛ إعلانه أن حق تقرير المصير في دولة “إسرائيل”، يقتصر على الشعب اليهودي، ويتجاهل حقوق الفلسطينيّين في الدولة، وهو يتميّز عما سبقه من وثائق جوهرية بإغفاله مبادئ جامعة مثل الديموقراطية والمساواة.
هل يعتبر هذا القانون بمثابة صدمة لمتابعي نشأة “إسرائيل”؛ ككيان، يسعى إلى أن يصبح الدولة الوحيدة على الأرض الفلسطينية، ضاربًا بعرض حائط المبكى، حضور الشعب الفلسطيني التاريخي، على هذه الأرض، بل وكلّ حقوقه؟ ربما لا، لو عدنا الى ذلك الحضور الفلسطيني الشرعي، الذي تآكله الانتداب البريطاني، في فترة ما بين الحربين الأولى والثانية، ليجهز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لدى قدومه فلسطين منتدبًا، ثم مغادرته لها كالحمل الوديع!
في الواقع، في القرارات الدولية، تنطلق قضية فلسطين مع القرار 181، حين أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، قرارًا يقضي بتقسيم فلسطين إلى “دولتين”، عربية ويهودية، وذلك بموافقة 23 دولة ورفض 13، وامتناع عشر دول عن التصويت. وقضى بإنهاء الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألّا يتأخر في أيّ حال عن 1 أغسطس/ آب 1948، وتجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب قبل التاريخ المحدد. تنشأ في فلسطين، الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس.
كما نصّ القرار على أن تكفل الدولة – أيّ كلتا الدولتين العربية واليهودية – لكل شخص وبغير تمييز حقوقا متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم؛ وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات كذلك، لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
ولكن الواقع الفعلي، نسف مشروع الدولتين قبل تطبيقه. إذ استمرت شرارة الحرب الأهلية بين العصابات الصهيونية، والقوات العربية، حتى غادر البريطانيون فلسطين كليًّا أواخر تشرين الأول/ نوفمبر 1947، تاركين فلسطين، نهبًا للمشروع الصهيوني الذي تنامي في ظل الانتداب على حساب الدولة الفلسطينية، التي كان من واجب البريطانيين تأمين مؤسسات لها، ودستور، وقوة عسكرية تحفظ أمنها، وبنية اقتصادية، وتنظيم إداري يرتقي بها الى مرتبة الدولة الحديثة.
على عكس الفرنسيين في بلاد الشام، تسلل البريطانيون من فلسطين، من دون أن يتركوا أثرًا لدولة تمثّل أصحاب الأرض، مخالفين المواثيق والعهود الدولية التي صدرت عن عصبة الأمم، بعد الحرب الأولى، طاعنين في ندوب المجتمع والسلطة المتهالكة أسافين العرقلة أمام صياغة هوية الدولة وسيادتها؛ بل تركوها نهبًا للآداء الصهيوني، السياسي والعسكري، ليرتع في جهاتها الأربع، معلنًا قيام دولة عام 1948؛ إعلان احتفالي لدولة بلا دستور، وقّعته شخصيات صهيونية يترأسها بن غوريون مدير الوكالة اليهودية، والرئيس التنفيذ للمنظمة الصهيونية العالمية، بعد أن سرقت من شعب كامل، خريطة وجوده وهويته، وأسماء مدنه وبلداته وقراه. ليس هذا فحسب، بل سمحت بطريقة أو بأخرى، بتشويه بنية فلسطين عبر العبث بالديموغرافية التاريخية، من خلال التخويف والاغتيال واغتصاب الحقوق والتهجير.
لقد كان ميسرًا فعلاً لـ”الوكالة اليهودية” العتيقة بمشروعها تحقيق مبتغاها بخطاها الوئيدة، بفعل سياسة الكيل بمكيالين، والتي دهست بها بريطانيا، ومن ثم هذه الدولة الساقطة تاريخ شعب، وكل المعايير الأخلاقية والإنسانية من خلال ممارساتها العنصرية بحق أصحاب الأرض. فهل اكتملت لهذه الدولة الهجينة مقومات وجودها؟ وكيف تترجمت ملامح هويتها الهجينة القومية القهرية والدينية المتعصبة؟ بدءًا من إعلان دولة على أنقاض قرى مهجرة، وأراضٍ مصادرة، وشعب مشتت بفعل المجازر والتخويف والطرد والابعاد؟ وهل أخذ هذا الكيان بعين الاعتبار المواثيق الدولية في احترام حقوق الانسان؟ أم مارس قوة القهر المبنية على الدين والتاريخ، واستبد بأهل الأرض، بغية تحقيق مشروعه ببناء الوطن القومي لليهود؟!
مكافحة العنصرية واحترام حقوق الانسان في المواثيق الدولية
تقودنا العودة العميقة في التاريخ بحثًا عن وقائع التمييز العنصرية، وعدم قبول الآخر؛ بل واستعباده واضطهاد انسانيته بأبشع المظاهر، الى طفرات التحضر بعيدًا عن الحياة المتوحشة الأولى. هذه الطفرة من التمييز والاستغلال والاستعباد تقودنا بدايةً الى قارات العالم القديم، حيث تلازمت مع موجات الحروب والغزو. وفيما انتشرت ظاهرة التمييز العنصري في زمن الامبراطوريات القديمة الكبرى من خلال تقسيم طبقات المجتمع؛ مثل اليونان على قاعدة يوناني عاقل وبربري متوحش، ومن خلال جلب الرقيق من الأصقاع البعيدة، كان من الملفت أنها استمرت بقوة في زمن الامبراطوريات في العصور الوسيطة، مترافقة مع الازدهار والعمران البشري، وما يسمى باستقرار الانسان “المتحضر” .
وعلى الرغم من حثّ بعض الأديان السماوية والفلسفات الأخلاقية في شتى زوايا المعمورة، الانسان على عدم استغلال أخيه الانسان، وتشجيعه على نبذ التمييز العنصري على أسس عصبية أو دينية أو اجتماعية، إلا أن هذه النزعة البشرية استمرت قائمة الى العصور الحديثة. من الملفت أنه من بين الديانات السماوية، كانت الديانة اليهودية تلتقي مع المذهب الأفلاطوني حول تفوق اليونان، في التمييز بين اليهودي والغريب؛ ففي العهد القديم، جاء في سفر التثنية: “لأنك شعب مقدس للربّ إلهك، وقد اختارك الربّ لكي تكون شعبًا خاصًا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض. بهذه القراءة، يعتبر اليهودي نفسه فوق باقي البشر، وتعتبر الأغيار، مسخرين لخدمته.
وإذا كان الرقّ؛ اضمحل مع الثورات وحركات التنوير، إلا أن العنصرية، بقيت ظلاً له على الرغم من نشوء الدولة الحديثة، ومفاهيم الديموقراطية وحقوق الانسان. وبعد مرور العالم الحديث بحربين عالميّتين، الأولى والثانية، وتوافق قادته على ضبط النزاعات بين الدول، وعلى إحلال السلام من خلال منظمة الأمم المتحدة، تتالت القرارات الدولة الراعية لكرامة الانسان. ومن بين هذه القرارات، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، كوثيقة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، في 10 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، بموجب قرار الجمعية العامة كمعيار مشترك للإنجازات لكافة الشعوب والأمم. ويحدد، لأول مرة، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا، ليكون الملهم لدساتير العديد من الدول المستقلة حديثًا؛ والعديد من الديموقراطيات الجديدة.
كما تم توسيع هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945. ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة متعَدّدة الأطراف اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بتاريخِ 16 ديسمبر/كانون الثاني 1966، الذي دخَل حيّزَ النّفاذِ في 23 مارس/آذار 1976.
ومن أهم ما ورد في هذا السياق؛ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 (د-20)؛ المؤرخ في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1965، وكان تاريخ النفاذ المقرر في 4 يناير/ كانون الثاني 1969: “… وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)؛ قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة، من دون قيد أو شرط، وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)، يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها” .
ليس هذا فحسب، بل أنشأت الأمم المتحدة تحت هيكليتها، مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد . حتى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2022، خدمت 123 دول أعضاء في الأمم المتحدة كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والملفت أن “إسرائيل” لم تكن من بينها.
في عام 1997، قررت الجمعية العامة عقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وعُقد المؤتمر بعد أربع سنوات في المدة من 31 أغسطس/ آب إلى 7 سبتمبر/ أيلول 2001 في ديربان بجنوب أفريقيا. وشملت الوثيقة الصادرة عنه تدابير بعيدة المدى لمكافحة العنصرية بجميع مظاهرها، وأعرب المشاركون في المؤتمر في المقدمة، عن القلق إزاء المحنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأجنبي، واعترف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولة مستقلة. كما سلّموا بأن الفصل العنصري والإبادة الجماعية يشكلان جريمة ضد الإنسانية في نظر القانون الدولي.
جدلية حقوق الانسان والتمييز العنصري في قوانين “إسرائيل”
لم يكن عام 1991، عامًا عاديًا بالنسبة لسلطة “الاحتلال الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية). إذ كان أمامها استحقاق “مؤتمر السلام” في مدريد، برعاية كل من أميركا والاتحاد السوفياتي. ومن الشروط التي كانت موضوعة لإتمام مشاركتها، التوقيع على بعض المواثيق الدولية التي كانت قد تغاضت عنها لعقود. فوقعت “إسرائيل” على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 19 ديسمبر/كانون الأول 1966، وصدقت عليه محليًا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1991، بالتوازي مع مؤتمر مدريد، أي بعد مرور ما يقارب 25 سنة على الميثاق الدولي.
عملت “إسرائيل” مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تحسين صورتها أمام النظام الدولي الجديد. فسعت جاهدة داخل أروقة النظام الدولي، الى إلغاء قرارات الشرعية الدولية السابقة حول فلسطين أو إضعاف قيمتها القانونية. وبالفعل، فقد تمكنت بدعم من أميركا عام 1991، وبتواطؤ أطراف أخرى من إسقاط قرار مساواة الصهيونية بالتمييز العنصري. وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379، قد حدّد: “أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”. وطالب جميع دول العالم بمقاومة “الأيديولوجية” الصهيونية التي تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين.
هذه المصادقة على المواثيق الدولية العتيقة بالنسبة للمبادرة الصهيونية المستجدة، تدفع الى السؤال: حول كيفية الالتزام بهذه المواثيق لا سيما احترام حقوق الانسان في القوانين “الإسرائيلية”، أو بالأحرى في الدستور؟! فهل كان لـ”إسرائيل” دستور ترتكز عليه، وتجري فيه التعديلات القانونية اللازمة؛ كي تتوافق مع هذه المصادقة أمام المجتمع الدولي؟
في الواقع، “إسرائيل”؛ هي مشروع دولة ينتظر تبلور الدستور. إذ أثارت صياغة الدستور للدولة؛ الجدل بين التيارات الدينية والعلمانية، وبخاصة؛ بشأن اعتماد التوراة للتشريع في الدولة، أو الاكتفاء بالكنيست كمصدر للتشريعات. واشتد الخلاف أيضًا؛ المتقاطع مع التوجهات المختلفة حول ماهية هذه الدولة، ديموقراطية أم دينية، والتي ارتجل القادة الصهاينة إعلانها أمام القانون العام عام 1948!
وأمام هذه العقبة، بشأن صياغة الدستور، تبلورت فكرة قوانين الأساس، حيث شرّع الكنيست 14 قانونًا أساسيًا بدلاً من الدستور الرسمي. ولكل قانون أساس صيغ في فترة زمنية ما، موضوع معيّن يتعامل مع الترتيبات الحكومية، وغيرها، ومع بعض القضايا ومن ضمنها حقوق الإنسان. وأتت فكرة قوانين الأساس؛ وفقا لقرار لجنة برلمانية صادر في 13 يونيو/ حزيران يونيو 1950، وتبنته الجمعية التأسيسية “الإسرائيلية” للدستور، بحسب توجيهات رئيس الوزراء في حينه دافيد بن غوريون. لكن الترتيبات الحكومية لتنظيم العلاقات بين الدولة والمواطن؛ والبدء بتشريع قوانين الأساس، أبقت على السجال بشأن يهودية الدولة وحقوق الأقليات، في حين عمّقت قوانين الأساس الخلافات بشأن مساحة “الوطن القومي للشعب اليهودي”، وحدود “إسرائيل”؛ بعد احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والجولان السوري في حرب 1967 .
من هنا، تُثار قضية كيفية احترام هذا الكيان لحقوق الانسان، في ظل انعدام وجود دستور موحد متفق عليه. وتفتح هذه القضية الباب على مصراعيه في فهم هذه الجدلية بين حقوق الانسان؛ وكيفية احترامها محليًا من خلال القانون، والتمييز العنصري الممارس على الأرض، والمنبثق من ثقافة دينية قديمة منذ الأسر البابلي، وشوفينية مرتكزة على تفسيرات خاصة للتوراة والتلمود، لا ترى في الآخر ندَّا أو حتى شريكًا.
ينظم القانون “الإسرائيلي”، حقوق الإنسان بناء على قانونين أساسيّين، القانون الأساس العاشر: الكرامة الإنسانية والحرية وقانون أساس: حرية المهنة، وقوانين أخرى. تشمل مواضيع حقوق الإنسان في “إسرائيل” وضع حقوق الإنسان للفلسطينيين وسياسات “إسرائيل”؛ وممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحقوق المجموعات السكانية المختلفة، وحقوق العمال الأجانب وغيرها.
صدر هذا القانون في الأيام الأخيرة للكنيست الثاني عشر في 17 مارس/ آذار عام 1992. انتشر هذا القانون في خطاب حقوق الإنسان؛ وفي قضايا حرية التعبير بعد وقت قصير من تقديمه في الوثائق الدستورية “الإسرائيلية”.
ورد في القانون الأساس، وعلى الرغم من أنه يعترف بقيمة الانسان وقدسية حياته في المادة الأولى، أن غايته إرساء قيم دولة “اسرائيل” بقانون أساسي “باعتبارها” دولة يهودية وديموقراطية. وفي المقابل؛ ورد وفق المادة 9، أنه لا تقيّد الحقوق الواردة في هذا القانون الأساسي لمن يخدمون في جيش الدفاع “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني)، وفي شرطة “اسرائيل” وفي مصلحة السجون؛ وفي المنظمات الأمنية الاخرى التابعة للدولة؛ ولا يجوز الاشتراط على تلك الحقوق؛ إلا بموجب قانون؛ وبما لا يتجاوز ما تتطلبه ماهية الخدمة وطبيعتها. ويترتب على كل سلطة من سلطات الحكم؛ احترام الحقوق الواردة في هذا القانون الأساس.
هذا القانون؛ لا يمتلك القوة القانونية بوجود ممارسات وقوانين أخرى تتعارض معه؛ وإذا ما قورن بالانتهاكات الصهيونية للشعب الفلسطيني على أرض الدولة المزعومة. فالكيان الصهيوني يرتكب بشكل مستمر جرائم التطهير العرقي، مهددًا باستمرار كل مقومات الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزّة، وفي كل الأراضي الفلسطينية. فالمشروع الصهيوني؛ مبني بعنصرية مفرطة على قاعدة نمو الحضور اليهودي، على حساب أصحاب الأرض، ولذلك، تسعى السلطة “الإسرائيلية” الى التضييق على الحضور التاريخي الفلسطيني، من خلال اجتثاث أصحاب الأرض، بتبريرات مختلفة، والعمل على محو أيّ شكل من أشكال الوجود الفلسطيني ومعالمه التاريخية والحضارية؛ بل إن عمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل الممنهجة على رؤوس أصحابها، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية، وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية، وعمليات التنكيل والقمع تدخل جميعها في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة.
ويتأثر هذا القانون سلبًا وبقوة بالقانون الرابع عشر، أي “إعلان إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي” فقط! حيث ورد في المبادئ الأساسية: “إن أرض إسرائيل؛ هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية! وأن لليهود فقط في إسرائيل الحق في تقرير المصير!”، من هنا، تطرح جملة من الإشكاليات حول مفهوم ديموقراطية “إسرائيل”، ومدى احترامها لحقوق الشعوب الأخرى في تقرير مصيرها؟ وهل تعتبر الأغيار شريك في الدولة، أم رعايا فقط، من دون حق المشاركة السياسية؟! وأكّد هذا القانون بمواده الإحدى عشرة، على تهميش اللغة العربية، على اعتبار أنها لغة لها مكانة خاصة، ولكن ليست رسمية، ولا يصبح استعمالها في الدوائر إلا بموجب قوانين أخرى. كما فتح مجال القبول لكافة القادمين اليهود من أرض الشتات. لقد ضرب هذا القانون إسفين التمييز العنصري عميقًا في بنية التجمعات البشرية التي تتوطن أرض فلسطين، ولا سيما بين العرب، مسلمين وغير مسلمين، وهم سكان الأرض، وبين الوافدين “الإسرائيليين” بالعقلية الصهيونية، وبذهنية الإلغاء والتهميش.
ففي 25 مايو/ أيار 2003، رداً على “خارطة الطريق إلى حلّ الدولتين” التي عرضتها الولايات المتحدة على الجانبين “الإسرائيلي” والفلسطيني، طالبت الحكومة “الإسرائيلية” بزعامة أريئيل شارون، بأن تشير خارطة الطريق بصراحة إلى “حق إسرائيل بالوجود كدولة يهودية”.
وفي رسالة من أريئيل شارون إلى جورج بوش في 14 أبريل/ نيسان 2004، بشأن نيّة “إسرائيل” فك الارتباط مع قطاع غزّة، أعلن وجوب أن يستند السلام المرجو إلى مبدأ “دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني”. ومنذ ذلك الحين، أصبح الاعتراف الفلسطيني بـ”إسرائيل” دولة يهودية؛ شرطاً مسبقاً للاستمرار في التفاوض. ففي الاجتماعات التحضيرية لقمة أنابوليس (نوفمبر/تشرين الثاني 2007)، والمحادثات التي تبعتها، عبّرت وزيرة الخارجية “الإسرائيلية” تسيبي ليفني، في حكومة إيهود أولمرت؛ عن هذا الموقف بكل قوة .
بعد نحو أربعة أشهر، في 3 أغسطس/ آب 2011، أودع آفي ديختر، عضو كنيست من “حزب كاديما” المعارض، مقترح قانون أساسي “إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي” في مكتب الكنيست، بدعم من عدد لا بأس به من الأعضاء/ 39 نائباً/. غير أن ديختر؛ سحب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011؛ مقترح القانون من جدول أعمال الكنيست في ولايته الثامنة عشرة، بطلب من تسيبي ليفني، رئيسة “كاديما”، التي رأت أن النصّ قد يقلب التوازن الدقيق؛ بين ما اعتبرته القيم التأسيسية للدولة: هويتها اليهودية والديموقراطية.
خلال الولاية البرلمانية التالية الـ19 (فبراير/ شباط 2013 – مارس/ آذار 2015)، أثار مقترح قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإحياء مسودة القانون معارضة “حزب تنوعاه” بزعامة ليفني؛ وحزب “يش عتيد” بزعامة يائير لبيد، وكانا عضوين في الائتلاف الحكومي. تسبب الخلاف في حلّ الكنيست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في مارس/ آذار 2015، لولاية الكنيست العشرين. غير أن الانتخابات أدّت إلى زيادة ملموسة في عدد مقاعد “حزب الليكود”، وتشكيل حكومة أكثر يمينية برئاسة نتنياهو مرة أُخرى. ثم أعطى تولّي “دونالد ترامب” رئاسة الولايات المتحدة في بداية سنة 2017، دفعاً جديداً في هذا الاتجاه، فاستؤنف العمل على مشروع القانون في مايو/ أيار من السنة نفسها، إلى أن حظي بالقراءات المطلوبة في الكنيست، وسُنّ في 19 يوليو/ تموز 2018.
وعلى الرغم من الجدلية التي أثارها هذا القانون لدى المجتمع العربي، وفي أوساط الكنيست والطبقة السياسية، كان هذا القانون بقوته المرتكزة على المبادئ الصهيونية أكثر ثباتًا وحسمًا للجدال في الوسط اليهودي. وتلقت المحكمة العليا “الإسرائيلية” 15 التماساً تطالب بإبطاله، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الدولة التي يطلب فيها من المحكمة العليا الحكم في قانونية قانون أساسي. وفي 8 يوليو/ تموز 2021، أصدرت المحكمة قرارها الذي أكدت فيه على دستورية القانون، وبذلك تجنبت التطرق إلى مسألة تملكها صلاحية النظر في قانونية القوانين الأساسية بصورة عامة.
وكان محتمًا أن تشمل التشريعات كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مسعى لإحداث تغيير ديموغرافي عميق؛ عبر طرد أصحاب الأرض؛ وتهجيرهم قسرًا؛ وحصرهم في أماكن ضيقة، بغية تقليص مشروع الدولتين، والوصول تدريجيًا الى دولة أمر واقع، تسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزّة، من دون الأخذ بعين الاعتبار التاريخ، أو السياسة الدولية واتفاق غزة/ أريحا؛ بل ولجأت الى العبث بالديموغرافيا التاريخية لفلسطين، من دون رادع أخلاقي، وعملت على تغليب الانتشار اليهودي؛ عبر المستوطنات مقابل الهدم والتهجير، للتغلب على أي حضور فلسطيني عمراني.
في الخلاصة، يبدو أن المواثيق الدولية ظلت غائبة عن الممارسة الصهيونية، فيما سيطرت ذهنية التمييز لصالح اليهود. فذهنية التوراة والتلمود، في اعتبار اليهود شعب الله المختار، ولهم من دون الأغيار كل الصلاحيات على الأرض التي اختاروها سكنًا لهم، من دون باقي البشر؛ وذلك على اعتبار أن هؤلاء من الأغيار، ولا يتمتعون بذات المواصفات التي تسمح لهم أن يكونوا مواطنين على أرض كانت بالأساس ملكهم. والمفارقة الغريبة، والتي يمارسها اليهود بحماية القانون، هي الاستيلاء على أراضي الفلسطينيّين من دون خوف، ووفق مبدأ القوة والقهر، تحت بند تشريعي، يعتبر هذا الاستيلاء بحسن نية، ناتج عن عدم معرفتهم أن هذه الأرض خاصة، أيّ يملكها أحد ما! وكيف يعرف المستوطن أنها ملك خاص؛ وهو الآتي بذهنية الاستيلاء والطرد والاقصاء، على اعتبار أنه أحق بهذه الأرض، بغض النظر عمن عليها!
الممارسات “الإسرائيلية” تجاه الشعب الفلسطيني
دوليًا؛ ساعد إلغاء القرار 3379 منذ 1991، ثم الإصدار المحلي لقانون الدولة القومية عام 2018، على استمرار الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني، وتمادي التعاطي بذهنية الاستعلاء والاستيلاء على الأرض الفلسطينية من دون سكانها، مما دفع السلطة “الإسرائيلية” الى ابتكار أساليب وممارسات عنصرية، تجاوزت ما حصل في جنوب افريقيا في العصر الحديث. وعلى أساس هذه الذهنية، تجرأ الكنيست “الإسرائيلي”، بعد 100 عام على وعد بلفور، على إعادة صياغة الوعد بوطن قومي لليهودي في فلسطين، على هيئة قانون أساس في دولة اعترف بها المجتمع الدولي منذ عام 1948. وكان هذا التشريع يترافق مع أساليب جديدة مغرقة في العنصرية، تستهدف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني. ولعل “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في العالم الحديث، التي تتحدّى كل المواثيق الدولية الداعية لحماية حقوق الانسان، وتؤكد حضورها كدولة قومية عنصرية من خلال قوانينها.
ويبدو أن رواسب الأنظمة العنصرية لم تنتهِ مع انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، إذ انتقل وبصورة أبشع الى بؤرة أخرى، على أرض فلسطين. يقول البروفيسور جون دوجارد، منذ عام 2005، حين قرر عقد مقارنة علنية بين نظام جنوب افريقيا سابقاً، و”إسرائيل” حالياً، حول ممارسة التمييز العنصري فيهما، أكّد أن النظامين يتشابهان في ممارسة التمييز العنصري، والقمع/ الاضطهاد، والتشظية الإقليمية المناطقية، أما الفارق الرئيس؛ فيكمن في أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا؛ كان أكثر صراحة ووضوحًا، حيث تمّ تشريعه من قبل البرلمان. أما القوانين التي تحكم الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ فإنها تستند بشكل كبير على قرارات عسكرية غامضة؛ وقوانين طوارىء متوارثة لم تعد صالحة للتطبيق منذ عقود.
ومن التقارير الحديثة لمناهضة هذه الممارسات، تقرير أعدته منظمات دولية حول جرائم التمييز العنصري في الكيان الصهيوني الغاصب، والذي أصدرته منظمة “الإسكوا” المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، في 15 آذار/ مارس 2017؛ والملفت أن الرئيسة التنفيذية لتلك المنظمة د. ريما خلف، اضطرت الى تقديم استقالتها؛ بعد أن رفضت الانصياع لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بعدم نشر التقرير. وكان هذا التقرير الذي أعده الباحثان ريتشارد فولك وفرجينيا تلي، قد أثار عاصفة من الانتقادات “الإسرائيلية” والأميركية، بحيث تعرض الأمين العام للأمم المتحدة لضغوط هائلة من أجل سحبه.
يخلص هذا التقرير إلى أن “إسرائيل”، أسست نظام “أبارتايد” يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمع. ومن الأدلة التي أوردها التقرير، الهندسة الديموغرافية التي تمثل مجالاً حيث تخدم السياسات غرض الحفاظ على “إسرائيل” دولة يهودية. وأشهر قانون في هذا الصدد هو قانون العودة الذي يمنح اليهود، أياً يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول “إسرائيل” والحصول على الجنسية “الإسرائيلية”؛ بصرف النظر عمّا إذا كان بوسعهم تبيان صلاتهم بالأرض، في حين يُحجب عن الفلسطينيين؛ أيّ حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق؛ تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود لأجيال في البلاد. وعلى نطاق أوسع، تعتمد “إسرائيل”؛ سياسة رفض عودة أي فلسطيني من اللاجئين والمنفيين قسراً، ومجموعهم حوالي ستة ملايين إلى أراضٍ تقع تحت السيطرة “الإسرائيلية”.
ويشير التقرير أيضًا الى عجز الفلسطينيين؛ عن التمتع بمواطنة ضمن هذه الدولة العنصرية. فمنذ عام 1967، يتوزّع الشعب الفلسطيني، على أربعة فضاءات قانونية، يُعامل فيها السكان الفلسطينيون؛ معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام “الأبارتايد”.
وأحدث التقارير التي أشارت الى الممارسات العنصرية الصهيونية في فلسطين؛ ودوّنتها، هو تقرير “منظمة العفو الدولية” الصادر للعام 2022/ 2023، حول وضع حقوق الانسان في العالم. يبدأ تقرير “منظمة العفو الدولية” لعام 2023 ديباجته كالآتي:
“شكّل نظام الحكم القمعي والتمييزي المجحف، الذي تنتهجه إسرائيل ضد الفلسطينيين في إسرائيل؛ والأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو مستمر، نظام فصل عنصري “أبارتايد”؛ وارتكب المسؤولون الإسرائيليون جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي… وصعّدت إسرائيل قمعها حرية الفلسطينيين في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كما فرضت إجراءات الإغلاق والقيود التعسفية على حرية التنقل التي بلغت حد العقاب الجماعي، وبخاصة في شمالي الضفة الغربية… وبلغ عدد حالات احتجاز الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 14 عامًا، واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة… وتقاعست السلطات عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الآلاف من طالبي اللجوء، وفرضت قيودًا على حقهم في العمل”.
ولعل هذه المقدمة من منظمة عالمية؛ تشير الى الوضع المأساوي الذي يعاني منه الفلسطينيون في ظل هذا النظام القمعي. ويوثق هذا التقرير الصادر حديثًا، آخر من اقترفته تلك الذهنية العنصرية، على أرض فلسطين بحق الشعب الفلسطيني. ويمكن من خلال هذا التوثيق، وغيره من الأدلة الدامغة دون التباس، تفصيل بعض الممارسات العنصرية الصهيونية، على سبيل المثال لا الحصر، والتي تستمر الدولة المزعومة على القيام بها، من دون رادع، وبحجج مختلفة، على أرض احتلتها بطريقة ممنهجة منذ بداية القرن العشرين…
4-1- الاعتقال الإداري التعسفي والإقامة الجبرية
يشمل مفهوم التعسف اشتراطين معاً هما: أن يكون اللجوء إلى شكل من أشكال الحرمان من الحرية وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وأن يكون ذلك متناسباً مع الغاية المتوخاة ومعقولاً وضرورياً. وصفة (التعسّف) لا ينبغي أن تعني (المخالفة للقانون)، بل ينبغي أن تفسر تفسيراً أعمّ لتشمل عوامل مثل عدم اللياقة، والحيف، والفجائية وعدم مراعاة الأصول القانونية.
ومن جهة ثانية، يُطلق الاعتقال الإداري على قيام سلطة ما باعتقال شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحقه الشخص المعتقل، ويبرر هذا الفعل بأنه جاء بناءً على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد الشخص المعتقل، ويمارس الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) هذا النوع من الاعتقال ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتراوح مدة الاعتقال الإداري من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد .
وتمارس السلطة “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة ممنهجة، حيث يتم تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعًا لائقًا. وقد احتفظت “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريًا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة. والمفارقة، ان القوانين العسكرية “الإسرائيلية” المتعلقة بالاعتقال الإداري تعود إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945! وتبرر إسرائيل ممارساتها العنصرية بحق العرب، بنص المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتنص على أنه “إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم” .
حتى عام 2020، كان عدد المعتقلين الإداريين يبلغ قرابة 500 معتقلًا؛ كما صدر 8,700 أمر اعتقال إداري “إسرائيلي” بحق فلسطينيين منذ 2015 . غير أن هذه الاعداد تضخمت حتى عام 2023، وفق الرسم البياني الآتي:
ومع مجموع المعتقلين الإداريين، وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن “إسرائيل” تعتقل في سجونها 4760 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا و33 أسيرة . وفقًا لمعطيات مصلحة السجون، تحتجز “إسرائيل”، حتّى آذار 2023، 1,017 شخصاً رهن الاعتقال الإداريّ، بينهم 10 قاصرين أبناء 16-18 عامًا. 1,002 من هؤلاء المعتقلين هم فلسطينيون. هذا هو عدد المعتقلين الإداريين الأعلى منذ نيسان 2003، إذ بلغ عددهم حينذاك 1,140. من بين المعتقلين الإداريّين الـ 1,017 حتى آذار 2023، كان 366 مسجونين منذ أقلّ من ثلاثة أشهر، 550 مسجونين منذ ما بين ثلاثة أشهر وسنة، و98 معتقلًا إضافيًّا مسجونين منذ ما بين سنة وسنتين، وكان ثلاثة آخرون مسجونين منذ أكثر من سنتين.
وتتراوح مدة الاعتقال الإداري بتبريرات مختلفة بين شهرين الى عدة سنوات، وقد تتجاوز حدود القانون والمنطقة، وقواعد احترام حقوق الانسان. وحسب مركز المعلومات “الاسرائيلي”، وهناك 23 أسيرا من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية [أوسلو] داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرًا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011، وأعيد اعتقالهم عام 2014 .
وتتقاطع هذه الاحصائيات مع ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، فحتى حزيران 2023، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين بالمجمل في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” نحو (5,000) أسيراً، يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق، حتّى 12 حزيران 2023، من بينهم (31) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، و(1,083) معتقلًا إداريًّا، من بينهم ثلاث أسيرات و19 طفلًا. وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو (23) أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك (11) أسيرًا من المحررين وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، وهناك (17) أسيراً صحافيًا.
ويعتبر المعتقل نائل البرغوثي، أقدم معتقل إداري لدى السلطة “الإسرائيلية”. فقد دخل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عامه الأربع والأربعين في سجون الاحتلال، ليكون أقدم معتقل فلسطيني، وعميد الأسرى بالغًا من العمر 65 عامًا . أفرج عن البرغوثي عام 2011 في صفقة تبادل بين “حركة حماس” و”إسرائيل” بعد أن أمضى 34 عاما متواصلة بالسجن ليعاد اعتقاله عام 2014. حينها صدر حكم بحقه لمدة 30 شهرًا، وبعد انتهائها أعيد له حكم الاعتقال السابق وهو مؤبد و18 عامًا.
ولا تعتبر ظروف وشروط حياة المعتقلين الإداريين في معسكرات الاحتجاز العسكرية أو في كل من سجون النقب، عوفر ومجدو، مرضية، وتحت سقف حقوق الانسان. إذ يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما، الذي يجرّم حرمان أيّ أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، كما أن جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجرى بشكل غير علني، وبالتالي يحرم المعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية، الأمر الذي يخالف ما نصّ عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية. لذلك يمكن فهم الأسباب التي دفعت الأسرى الإداريين منذ أواخر 2011 وحتى نهاية 2021، الى تنفيذ أكثر من 400 إضراب فردي عن الطعام، إضافة إلى آخر جماعي خاضه المعتقلون عام 2014، واستمر 62 يومًا .
ليس هذا فحسب، بل أشار تقرير منظمة العفو الدولية، للعام 2022-2023، الى التعذيب في السجون. إذ استمرت القوات “الإسرائيلية” في إخضاع المحتجزين الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكما كان الحال في السنوات السابقة، لم تجر وحدة التحقيق الداخلي في الشرطة “الإسرائيلية” (محاش) تحقيقـًا وافيـًا بشأن شكاوى التعذيب. ووفق التقرير، على سبيل المثال لا الحصر، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، مددت المحكمة المركزية في بئر السبع، لأربعة أشهر، الحبس الانفرادي لأحمد مناصرة الذي سـُجن في 2015 عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، ويـُحتجز في الحبس الانفرادي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو فعل يرقى إلى مستوى التعذيب. وكانت المحكمة نفسها قد رفضت في أيلول/ سبتمبر الطعن الذي قدمه للإفراج المبكر عنه لأسباب طبية، رغم خطورة حالته الصحية الذهنية النفسية .
وحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1993 تمّ رصد أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية “أوسلو”، من بينها قرابة 20 ألف طفل، و2500 سيدة وفتاة، بالإضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية .
فسلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية، فيما يخصّ قضية الأسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، وآخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية “أوسلو”، وما يعرفون بـ”الدفعة الرابعة”، وما تزال تحتجزهم في سجونها وعددهم 25 أسيرًا فلسطينيا، بينهم 8 أسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35 عاما، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني عام 1983 .
كما سٌجل استشهاد 117 فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق “أوسلو”، الأمر الذي أدى الى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (231) شهيدا، وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء منهم، وهم: أنيس دولة، المحتجز جثمانه منذ العام 1980، وفارس بارود، وعزيز عويسات، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر، وسامي العمور، وآخرهم الشهيد الأسير داوود الزبيدي الذي استشهد بتاريخ 15 مايو/أيار من العام 2022. وهؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من 350 جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب، محتجزين لدى سلطات الاحتلال، فيما يعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى .
4-2- الهجمات والاغتيالات داخل فلسطين
منذ اتفاق أوسلو لم تسلم المناطق الفلسطينية من الغارات والاعتداءات “الإسرائيلية”. وفي الواقع تم تقسيم الضفة الى ثلاثة أقسام إدارية مستقلة مؤقتة، وهي المناطق (أ وب وج)، حتى يتم وضع اتفاق نهائي لهذه الحالة. وهذه المناطق غير متجاورة، ولكنها مجزأة حسب المناطق السكنية المختلفة فضلاً عن المتطلبات العسكرية “الإسرائيلية”. في المنطقة (أ) سيطرة مدنية وأمنية كاملة من قبل السلطة الفلسطينية): حوالي 3% من الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية). في المنطقة ب هناك السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة: (حوالي 25%). وفي المنطقة ج سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة، ما عدا على المدنيين الفلسطينين: (حوالي 72%). ولم تسلم الضفة الغربية، من الهجمات الإسرائيلية التي طالت النشطاء، بل وعمدت “إسرائيل” الى اتباع سياسة الاغتيال على كافة أراضي فلسطين، وفي كثير من الأحيان خارجها. ولم يسلم قطاع غزة من التنكيل العسكري وألأمني، بل طاله الفصل العنصري، كما تعرض للتضييق العسكري والحيوي على المستويات كافة.
4-2-1- الهجمات على المناطق الفلسطينية
لعل أبرز الهجمات، والتي لها بصمة واضحة في القضية الفلسطينية، هي مسألة اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى. إذ أعلنت وزارة الأوقاف الشئون الدينية الفلسطينية، أن انتهاكات “إسرائيل” في عام 2022 ضد المقدسات الدينية في الضفة الغربية المحتلة بلغت 262 اقتحاما للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن عدد مقتحمي الأقصى وصل إلى أكثر من 49 ألفا من المستوطنين “الإسرائيليين” (الإرهابيّين الصهاينة). ويبدو أن اعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية على الأماكن الدينية، بدءًا من المسجد الأقصى، ممنهجة، وتصب جميعها في إطار التضييق على الفلسطينيين، ومحاولة تهجيرهم بشتى الوسائل. كما قالت الأوقاف الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان بالمسجد الإبراهيمى 613 مرة لافتة إلى أنه تم الاعتداء على 24 مسجدًا في الضفة الغربية المحتلة كاقتحامها أو إيقاف العمل بها وصولا إلى حرقها وهدمها، ومضيفة أنه تم الاعتداء على 12 مقبرة، وأداء صلوات تلمودية فى فى 20 مقاما إسلاميا من قبل المستوطنين “الإسرائيليين”.
وثقت الإحصاءات وفي عام 2022 وحده، تنفيذ هجمات عدة على المناطق العربية. ونفذ المستوطنون 1.187 اعتداء، تراوحت بين مشاركة الجيش “الإسرائيلي” في اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية والاعتداء المباشر على المواطنين وممتلكاتهم. وكان لمحافظة نابلس (شمال) الحصة الأكبر من تلك الاعتداءات بواقع 417 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ203 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ172 اعتداء. وشن المستوطنون 354 عملية اعتداء على أشجار الزيتون، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 10,291 شجرة. في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قتلت القوات “الإسرائيلية” 151 فلسطينيـًا وأصابت9,875 بجروح، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية/ الأرض الفلسطينية المحتلة، وسط تصاعد التوغلات العسكرية التي شملت استخدام القوة المفرطة بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع، والإعدامات خارج نطاق القضاء حسبما يبدو. وأفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين أن القوات “الإسرائيلية” أو المستوطنين الإسرائيليين قتلوا 36 ًطفلا في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولم تستهدف القوات “الإسرائيلية” أمن المناطق الفلسطينية من خلال التخريب والاعتداء والاعتقالات العشوائية فحسب، ولكنها أيضًا، وللتغطية على ممارساتها القمعية والعنصرية، طالت اغتيالاتها العاملين في الصحافة والاعلام، لاسيما خلال العمليات العسكرية والهجمات التي كانت تقوم بها من دون رادع على مرأى من العالم. ففي 11 أيار 2022، شيرين أبو عاقلة وهي صحافيّة فلسطينيّة، كانت تعملُ لدى “قناة الجزيرة” (القطرية)، وقد اغتالها جيشُ الاحتلال “الإسرائيلي” حينما كانت تُغطّي اقتحامًا لمدينة جنين.
4-2-2-الاغتيالات
لم تكن هذه الهجمات الأولى ولا الأخيرة، كما لم تكن الاغتيالات حديثة العهد في الآداء العنصري الإسرائيلي على أرض فلسطين. إذ منذ أوائل السبعينات نفذت “إسرائيل” مجموعة من عمليات الاغتيال لقيادات بارزة في منظمة التحرير الفلسطينية وممثليها في أوروبا، وطالت الاغتيالات غيرها من الفصائل خارج أرض فلسطين منذ اندلاع المقاومة عبر لبنان وحتى أواخر الثمانينات.
ثم انتقل بنك أهداف “إسرائيل” الى داخل فلسطين، بعد نمو حركة “المقاومة الإسلامية/ حماس”، التي وزعت الحركة بيانها التأسيسي في 15 ديسمبر/ كانون الأول 1987 م، إبان الانتفاضة الأولى التي اندلعت في الفترة من 1987 وحتى 1994، قبل أن يصدر ميثاق الحركة 18 أغسطس/ آب 1988. وعدا عن ملاحقة بعض عناصر الحركة خارج فلسطين، اغتيل عدد كبير من قادة حركة حماس وفتح والفصائل الأخرى .
ولم توفر القوات “الإسرائيلية” استعمال سلاح الجو في عمليات الاغتيال، فاغتالت صلاح شحادة زعيم كتائب القسام (غزة 2002) بمتفجرات بوزن 2,205 باوند، والتي تم إسقاطها من “طائرة إف 16″، وقتلت زوجته وأولاده التسعة في نفس الهجوم. واغتيل عام 2003 إبراهيم المقادمة وثلاث من مساعديه، من خلال صواريخ أطلقت من طائرة مروحية فوق مدينة غزة. ولم يسلم الشيخ المقعد أحمد ياسين مؤسّس وزعيم “حماس”، اغتيل عام 2004 مع حراسه الشخصيّين في قطاع غزة من خلال طائرة أباتشي مقاتلة. كما استهدف بصواريخ أطلقت من طائرة مروحية عبد العزيز الرنتيسي مؤسس وزعيم “حماس” وخليفة أحمد ياسين الزعيم السابق لـ”حماس”.
كما استعملت “إسرائيل” القصف الجوي لأماكن سكن، وتواجد قادة وشخصيات فلسطينية بارزة دون الأخذ بعين الاعتبار وجود عائلاتهم أو مدنيين قد يطالهم القصف ايضًا. وكان من بين هذه العمليات في يناير/كانون الثاني 2009، اغتيال عبد القادر محمد ريان العسقلاني ويُعرف باسمِ نزار ريان داعية إسلامي وسياسي وأستاذ جامعي، عدا عن كونهِ قائد سياسي وعسكري في “حركة حماس”، في قصفٍ جوي “إسرائيلي” طالَ منزله في مخيّم جباليا. وفي الشهر نفسه، اغتيل بالقصف في غزة، أبو زكريا الجمال، القائد العسكري البارز في القسام، وبعده سعيد محمد شعبان صيام وزير الداخلية في أول حكومة لـ”حركة حماس”، كما كانَ نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني. وآخر هذه العمليات كانت في مايو/أيار 2023، حين اغتيل علي غالي، وهو عضو في المجلس العسكري لـ”حركة سرايا القدس” ومسؤولُ الوحدة الصاروخية للحركة، في غارة جوية إسرائيلية”، استهدفت موقعه في مدينة خان يونس ضمنَ عملية السهم الواقي، بعد أن كانت تل أبيب قد اتهمَت غالي بالمشاركة في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ نحو “إسرائيل”.
4-3-الهندسة الديموغرافية العنصرية.. نفي وتهجير وإبعاد….
حسب تقرير الاسكوا الصادر عام 2017، والذي أثار زوبعة من الاعتراضات، “تعـد الهندسـة الديموغرافيـة السياسيـة العامـة الأولى التـي تتخذهـا “إسـرائيل” مـن أجـل تحقيـق أغلبيـة يهوديـة سـاحقة فـي “إسـرائيل” والحفـاظ عليهـا” .
وإضافة الى الإجراءات العنصرية والتعسفية التي ما فتئت تقوم بها “إسرائيل” على أرض فلسطين منذ عام 1948، جاء القانــون الدولة القومية (2018)، لترســيخ الهيمنــة اليهوديــة العنصريــة كمبــدأ أساســي فــي الحفــاظ علــى الأغلبية اليهوديــة. ولعبــت هــذه الممارســات مجتمعــة دورًا فاعلاً في جعل اليهود الأكثرية الساحقة في فلسطين، حيـث كانـت نسـبة الفلسـطينيين إلـى اليهـود عـام 1948، حوالـي 1:2 (أي حوالـي 1.3 مليـون عربـي مقابـل 630,000 يهـودي). أمــا اليــوم شــكل المواطنــون الفلســطينيون حوالــي 20 بالمائــة مــن السـكان فقـط، ممـا يجعـل الفلسـطينيين أقليـة دائمـة .
وطُبقت السلطة “الإسرائيلية” العنصرية “سياسة الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي سياسة خطيرة مارستها العصابات الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما بعد هزيمة الجيوش العربية عام 1948″. أما السند القانوني الهزيل الذي اعتمدت عليه “إسرائيل” في هذه السياسة، فهو نصّ المادة (112) من قانون الطوارئ لسنة 1945 م. فسواء كان المبعد الفلسطيني خارج البلاد، تأمر سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” ببقائه خارج وطنه فلسطين؛ أو كان داخل البلاد فتأمر سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” بإبعاده بعد توقيفه ثم نقله بالقوة إلى خارج فلسطين، ويمكن أن يكون الأمر ضد شخص واحد أو شخصين أو أكثر” .
بعد موجة 1948، في عام 1967 أعادت سلطات الاحتلال السناريو بتشريد الفلسطينيين عن أرضهم إلى مخيمات اللجوء في الدول المجاورة، حيث بلغ عدد النازحين الفلسطينيين منذ بداية حرب عام 1967 وحتى نهاية عام 1968 حسب المصادر الفلسطينية، 408 آلاف: منهم 361 ألفًا من الضفة، و47 ألفًا من قطاع غزة. وفي الأعوام بين 1967 و1987، رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده أكثر من 8,000 مواطن في عملية واحدة. وطالت هذه السياسة بشكل منهجي الكوادر والناشطين، فأبعدت الكتاب، والصحافيين، والنقابيين، ورؤساء الجامعات والبلديات، وأعضاء الغرف التجارية، ورؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين، والمدرسين وعلماء الدين، والطلبة، والناشطات في الحركة النسائية. ومن أبرز موجات الإبعاد خلال هذه الفترة: مبعدي مرج الزهور . إذ أبعدت “إسرائيل” الى مرج الزهور في حاصبيا (مناطق لبنانية) في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1992، 415 ناشطاً إسلامياً فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة .
كما كانت سياسة الترحيل تستهدف تفريغ المناطق من السكان أو من الكوادر، فمع انطلاقة انتفاضة الأقصى عام 2000، أبعدت عام 2002 تسعة وثلاثين مواطنًا فلسطينيا احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، 13 إلى خارج فلسطين، وتم نقلهم إلى قبرص، ومن ثم وزعوا على عدة دول أوروبية؛ و26 فلسطينيًا تم إبعادهم إلى قطاع غزة؛ وأبعدت عددًا من الأسرى الإداريين إلى قطاع غزة؛ ففي 14 أكتوبر/ تشرين أول 2003، أبعدت 18 معتقلاً إداريًا فلسطينيًا من أبناء المحافظات الشمالية إلى قطاع غزة؛ وأبعدت عددًا من الأسرى المضربين عن الطعام كشرط لإطلاق سراحهم مثل: هناء الشلبي. وجاءت موجة الإبعاد الكبرى إلى خارج فلسطين وإلى قطاع غزة في إطار صفقة التبادل بين “حركة حماس” و”إسرائيل” بالجندي الأسير (الإرهابي الصهيوني) “جلعاد شاليط” حيث أبعدت سلطات الاحتلال 43 أسيرًا إلى خارج فلسطين؛ و163 إلى قطاع غزة.
4-4-الفصل العنصري أو “الأبارتايد”
من ضمن سياسات التمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية، لجأت السلطة “الإسرائيلية” الى إنشاء أكبر معتقل على الاطلاق في العالم، عبر تشييد جدار أمني يعزل الضفة الغربية عن الأراضي “الإسرائيلية”، ويمنع حرية التنقل بين الضفة وباقي مناطق فلسطين، وعملت على جدار آخر أحاط بغزة. إن السّمة المميّزة لأـ”أبارتايد/ الإسرائيلي” أو الفصل العنصري، هي استدامة الهيمنة على الفلسطينيين بغرض تعزيز دولة يهودية من خلال تجزئة الشعب الفلسطيني إلى أربعة فضاءات منفصلة خاضعة للسيطرة التمييزية والإخضاع.
بعد استمرار الهجمات الفلسطينية على “إسرائيل”، ارتأت حكومة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق (الإرهابي الصهيوني) أرييل شارون بناء جدار عازل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر. بدأ بناء الجدار في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى، واستمر على الرغم من عدم قانونيته نسبةً الى محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9 يوليو/ تموز 2004،ومطالبة “إسرائيل” بوقف البناء فيه .
وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية. وأنجز منه 539 كيلومترا حتى عام 2014، أي نحو 70%، وهناك نحو 62 كيلومترا قيد الإنجاز تشكل 8% منه، ليبقى ضمن المخطط نحو 170 كيلومترا، أي نحو 22%. ولم تذكر الوزارة “الإسرائيلية” نسبة اكتمال شبكة الجدران الإسمنتية والسياجات والخنادق والطرق العسكرية المغلقة، والبالغ طولها 712 كيلومترا. وبناء على الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة، لا يزال 214 كيلومترا من هذه الشبكة غير مكتمل .
يـرى تقريـر الاسكوا لعام 2017 أن “إسـرائيل” تعمـل علـى اسـتدامة نظـام “الابارتايد” مـن خلال تقسـيم الفلسـطينيين إلـى مناطـق جغرافيـة مختلفـة تـدار مـن خلال مجموعـات مختلفـة مـن القوانيـن .
حسب موقع (هيومن رايتس وواتش)، وفي تقريرها السنوي لعام 2005، واصلت السلطات الإسرائيلية انتهاج سياسة الإغلاق، حيث فرضت قيوداً مشددة، وتعسفية في كثير من الأحيان، على حرية الانتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وأدت هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تتسم بتفشي الفقر المدقع والبطالة وفقدان الأمن الغذائي؛ كما كانت هذه الإجراءات عائقاً شديداً يحول بين السكان الفلسطينيين وبين الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات. وعلى مدى العامين الأخيرين صارت هذه القيود أكثر حدة، كما باتت في كثير من الأماكن أكثر دواماً مع بناء “حاجز الفصل” داخل الضفة الغربية؛ والمبرر الأمني “الإسرائيلي” المعلن لبناء هذا الحاجز هو منع الجماعات الفلسطينية المسلحة من تنفيذ هجمات داخل “إسرائيل”، غير أن 85 في المائة من مساره يمتد داخل الضفة الغربية ويضم إلى “إسرائيل” فعلياً معظم المستوطنات اليهودية غير المشروعة الكبيرة التي أُقيمت على مدى العقود الأخيرة، فضلاً عن مصادرته بعضاً من أكثر الأراضي الزراعية الفلسطينية خصوبة وموارد المياه الأساسية .
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2004 أقر الكنيست خطة رئيس الوزراء أرييل شارون الخاصة “بفك الارتباط” مع قطاع غزة في عام 2005 من خلال سحب القوات العسكرية والمستوطنات اليهودية، غير أن الخطة تبقي لـ”إسرائيل” سيطرتها على حدود غزة وسواحلها ومجالها الجوي. وهذه الخطوة ليس من شأنها وضع نهاية لاحتلال “إسرائيل” لقطاع غزة أو مسؤوليتها عن رفاهية سكانها.
في فبراير/شباط 2023، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مؤلـّفـًا من 280 صفحة يبيـّن كيف تفرض “إسرائيل” نظامـًا مؤسسيـًا من القمع والهيمنة على الشعب الفلسطيني حيثما تمارس السيطرة على حقوقهم، فتشرذم وتعزل وتفرق الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، والمقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من الحق في العودة. ومن خلال عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات على نطاق واسع، وأعمال القتل غير المشروع، وتكبيد الفلسطينيين إصابات بالغة، وعمليات النقل القسري، وفرض قيود تعسفية على حريتهم أخرى في التنقل، وحرمانهم من الجنسية، فضلا عن أفعال أخرى لاإنسانية، يتحمـّل المسؤولون “الإسرائيليون” مسؤولية الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري الواقعة ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب تقرير مركز المعلومات “الإسرائيلي” لحقوق الانسان، والصادر عام 2017، “ما فعلته إسرائيل بواسطة الجدار أنّها فصلت السكّان عن أراضيهم في نحو 150 تجمّعًا سكّانيًّا فلسطينيًّا في الضفة الغربية وبضمنها أراضٍ زراعيّة وأراضٍ للرعي إذ حبست هذه الأراضي بين الجدار وبين الخطّ الأخضر. هكذا أغلقت “إسرائيل” في وجه آلاف الفلسطينيين إمكانية الوصول بحرّية إلى أراضيهم وحرمتهم من استخدامها. صحيح أنّ “إسرائيل” جعلت على امتداد الجدار التي أُنجز بناؤه 84 بوّابة يمكن للفلسطينيين عبورها – نظريًّا؛ لكنّ هذه البوّابات لا تتيح فعليًّا الوصول بحرّية إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار بل كانت الغاية منها خلق صورة زائفة تُوهم بأنّ الحياة تستمرّ عاديّة. ينكشف هذا الوهم في لمعطيات (OCHA) التي تفيد بأنّه طيلة العام 2016 لم تُفتح بشكل يوميّ سوى تسع بوّابات؛ وهناك عشر بوّابات فُتحت فقط في بعض أيّام الأسبوع وفي موسم قطاف الزيتون؛ و65 بوّابة فُتحت فقط في موسم قطاف الزيتون”.
(يُتبع)…
المصدر: المدار نت







