
لم يكن من الممكن أن يكون الحراك الشعبي السوري في عام 2011 تعبيرًا عن ثورة ياسمين، بسبب ديمومة الاستبداد لخمسة عقود ومحدودية الثقافة السياسية لدى أغلب النخب السورية، إضافة إلى غياب الحياة السياسية، وقصور وعي الأحزاب السياسية المعارضة بكل تنوعاتها القومية والإسلامية واليسارية. كل ذلك يعتبر من تحديات الانتقال الديمقراطي بعد عملية التغيير السياسي إثر سقوط سلطة آل الأسد، خاصة بعدما أظهرت الأعوام الأربعة عشرة للحراك عمق الانقسامات القومية والطائفية والعشائرية والجهوية لأغلب السوريين، مما يضيف تحديات ليس من السهل تجاوزها.
إذ ينطوي التحوّل الديمقراطي على مجموعة من التغيّرات المختلفة، التي تنعكس على طبيعة سلطة الدولة. فالانتقال إلى الديمقراطية في دول تسلطية يطرح مشكلة عملية تندرج ضمن خيارين: التدرج، بما يتطلبه من وقت ومراحل، من خلال فتح المجال للقوى الديمقراطية، ودمقرطة الدولة بالانتقال إلى المؤسسات والحكم الرشيد. أو حمل الحاكم على التنازل تحت ضغط القوى السياسية والاجتماعية.
ففي حين أنّ شعوبًا عديدة أنجزت عملية الانتقال بشكل سلمي في مواجهة أنظمة تسلطية، فإنّ حراك الشعب السوري، الذي طغت عليه العسكرة والتوجهات الإسلامية المتطرفة، سوف يجعل عملية التحوّل الديمقراطي أكثر صعوبة.
وفي الواقع فإنّ التجربة العالمية لا تقدم وصفة جاهزة للتحوّل، ولكنها تؤكد على أهمية التوافقات الوطنية لنجاح العملية. والمشكلة أنّ أغلب السوريين يشككون في متطلبات نجاح الانتقال الديمقراطي، خاصة حيادية الدولة عن الأيديولوجيات والأديان. مما يؤكد أهمية التوافق بين مجمل المكوّنات الفكرية والسياسية والاجتماعية لإنجاز عملية التحوّل، بهدف التعاطي المجدي مع التحديات التي تواجه السوريين.
إذ إنّ سورية بحاجة ماسّة إلى دولة الحق والقانون التي تضمن حقوق المواطنين، باعتبارها دولة الكل الاجتماعي، من خلال دستور عادل لا يميّز بين المواطنين على أساس ديني أو مذهبي أو قومي. وفي هذا السياق، تندرج أهمية البحوث الاجتماعية والسياسية لأفضل السبل لضمان نجاح عملية التحوّل الديمقراطي، وإعادة بناء الدولة السورية الحديثة بعد عقود من الدولة التسلطية.
ولا شكَّ أنّ التغيير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 قد أدخل سورية في المرحلة الأولى للتحوّل، ويبقى السؤال عن المراحل اللاحقة لنجاح العملية. وفي كل الأحوال طالما أنّ الديمقراطية تتطلب إرثًا من التقاليد القانونية والمؤسسات السياسية والمدنية، فإنّ عملية الانتقال من النظام السلطوي السابق إلى الديمقراطية غير مضمون، بل يمكن أن تؤدي إلى نظام سلطوي آخر.
وهكذا، تكمن أهمية البحث في الكشف عن أهم تحديات التحوّل الديمقراطي في سورية، ومحاولة بلورة رؤى عن كيفيات التعاطي المجدي مع هذه التحديات لنجاح التحوّل، بما يفتح أفقًا لاستكشاف هذه الكيفيات، بالاستفادة من الدراسات والتجارب السابقة ذات الصلة بعمليات الانتقال، تعثرًا ونجاحًا. وسوف أعتمد لإعداد البحث على منهج مركب (وصفي – تحليلي – مقارن)، لضمان انتقال سورية من الاستبداد إلى الديمقراطية.
وتنقسم الدراسة إلى خمسة محاور: أستعرض في الأول الإطار المفاهيمي باختصار، والثاني المقارنة مع دراسات وتجارب سابقة حول عملية التحوّل الديمقراطي، والثالث أهم تحديات التحوّل الديمقراطي في سورية، والرابع كيفيات التعاطي المجدي مع التحديات، والخامس أهم الاستنتاجات والتوصيات، وأختم بأهم مراجع البحث.
أولًا. الإطار المفاهيمي: تكثيف مفاهيم التحوّل الديمقراطي
الديموقراطية هي جملة من الأدوات الإجرائية التي تسمح بتنظيم الشأن السياسي العام من خلال: علوية القانون، والفصل بين السلطات، وتوزيع السلطة بدل مركزتها، واستقلال المجتمع المدني عن المجتمع السياسي، وضمان الحريات الفردية والعامة، والسماح بتنظيم الأحزاب والجمعيات المستقلة، والانتخابات الدورية، وتداول السلطة سلميًا، بما ينطوي على ثلاثة أبعاد رئيسية: توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان، واحترام مبدأ تداول السلطة طبقًا للإرادة الشعبية، والقبول بالتعدّد السياسي والفكري. أي أنها خيار استراتيجي لتفكيك بنية النظام التسلطي السابق، وإعادة بناء سورية الجديدة مما يقتضي تجريم أشكال العنف ويضمن السلم الأهلي والعيش المشترك لكل مكوّنات الشعب الطائفية والمذهبية والقومية.
وبذلك فإنّ للنظام الديمقراطي مزايا عديدة منها1: القدرة على الترميم الذاتي والقابلية للتعديل على ضوء تداول السلطة، والتطور مع الزمن من خلال برامج الحكم، والحرية وعدم الإكراه، والأفضل في مكافحة الفساد. ومن المؤكد أنّ الديمقراطية ليست محصلة حريات فردية غير مضبوطة، بل هي مقيّدة بالقانون، وهي ليست بالضد من الدولة بل هما متلازمان، من خلال تقييد الدولة بالقانون.
وفيما يتعلق بحالنا في سورية فإنّ مصطلح التحوّل الديمقراطي هو أكثر دقة وشمولًا من الانتقال الديمقراطي، إذ إنه ينطوي على عملية متدرجة بعد 54 سنة من النظام التسلطي، تهدف إلى ترسيخ مشروع التحوّل من خلال مجموعة من الإصلاحات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بحيث يقوم على دولة المؤسسات، التي تضمن الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية. أما مصطلح الانتقال فهو يحيل إلى توافق بين نظام الاستبداد وقوى التغيير، أي بين نظامي الماضي التسلطي والمستقبل الذي يتوجه إلى تغيير بنية النظام القائم.
إنّ التحّول الدّيمقراطي هو مفهوم حديث، تباينت بصدده المواقف والآراء الفكرية والسياسية ” يحيل عمومًا إلى المواطنة وحقوق الإنسان وتوسيع المشاركة السياسية، كما يرتبط أيضًا بالتغييرات الجذرية المستمرّة التي تطال بنيات النظام السياسي، ويحيل أيضًا إلى التحوّل الذي يطال السلطة السياسية على مستوى تجاوز مظاهر الشمولية والاستبداد وتقويضها، نحو وضع جديد، تترسّخ فيه دولة المؤسسات وتتعزّز المشاركة السياسية للمواطنين”2.
إنّ التحوّل الديمقراطي يشمل الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يمكن أن تنقل سورية من الدولة التسلطية إلى الدولة الديمقراطية. ولا شكَّ في أنّ ثمة إمكانية لأية دولة بهذا التحوّل فيما إذا توفرت مجموعة شروط، من أهمها: حاضن اجتماعي للعملية، ونخب سياسية تحمل برامج واقعية، وإعلام حرٍّ، ونظام قضائي مستقل، وطبقة وسطى نشطة لتفعيل اقتصاد سوق اجتماعي، وتوافقات سياسية تضمن مصالح جميع القوى الفاعلة في المجتمع بما يضمن العدالة والمساواة، ومحيط إقليمي ودولي يساعد على عدم عودة الدولة التسلطية.
وفي الواقع، ينشغل حقل دراسات التحوّل الديمقراطي بآليات الانتقال من نظام سلطوي إلى آخر ديمقراطي، خاصة الفترة الزمنية اللازمة لبداية زوال آليات عمل الأول وترسيخ أخرى لممارسة السلطة الجديدة، ويبدو أنّ الأمر يتعلق في الخيارات التي يتخذها صنّاع القرار خلال هذه الفترة، مما سيكون له أثر كبير على حصيلة تغيير النظام، وبالتالي النظام الذي سيتلو مرحلة الانتقال. مما يتطلب تجاوز الاستقطاب السياسي والتوافق بين أطراف العملية السياسية لتأمين الانتقال السلس إلى الديمقراطية.
وعموما، يتحقق التحوّل عبر مداخل أفقية، في علاقة ذلك بترسيخ وعي مجتمعي ديمقراطي وثقافة تدعم التحوّل والتغيير، وأخرى عمودية، ترتبط بتعزيز الحقوق والحريات، وبناء مؤسسات وتشريعات تعزّز دولة القانون..
ثانيًا. المقارنة مع دراسات وتجارب سابقة، خاصة ما يتعلق منها بأهم تحديات التحوّل الديمقراطي، وكيفيات التعاطي المجدي معها.
لا يمكن الحديث عن تحديات التحوّل الديمقراطي في سورية بمعزل عن المقارنة مع دراسات وتجارب العالم المعاصر، مع العلم أنّ بعض دراسات الانتقال تتسم بالغائية، بمعنى أنها تنزل الهدف محل الواقع، حين تعتبر أنّ الديمقراطية هي غاية البحث، لذلك يصعب تعميمها، ولكن لا يمكن إهمالها بالرغم من مضامينها الأيديولوجية. إذ إنّ التجارب تتباين من حيث سياقاتها ومداخلها ومخرجاتها، فهي تجسّد في مجملها تراكمًا إنسانيًا مهمًا، مما يمكننا من الاستفادة منها. بالرغم من اختلاف المداخل النظرية ” بين من يربطها بالتنمية الاقتصادية، وبين من يربطها بإرساء المؤسسات وترسيخ الثقافة الديمقراطية “3.
لقد تعددت الدراسات التي بحثت في العوامل المؤثرة في التحوّل الديمقراطي، تبعًا لاختلاف المدارس الفكرية ومنهجياتها. حيث تباينت أشكال التحوّل، تبعًا لمحددات الفضاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تمتّ فيه، فهناك تحوّلات أعطيت فيها الأولوية للإصلاح الاقتصادي، في عدد من دول شرق آسيا، وأخرى للإصلاح السياسي، في جنوب أفريقيا وبعض دول أوروبا الشرقية.
إذ ثمة دراسات عديدة تناولت الموضوع، بما فيها في العالم العربي بعد موجتي ربيع الثورات العربية في عامي 2011 و2019. كما شهدنا تجارب عديدة للتحوّل الديمقراطي في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وإسبانيا، بما فيها دول تسلطية شبيهة بحالنا في سورية، تساعدنا على استخلاص دروسها لبحثنا.
وعلى الصعيد العربي اطّلعت على عدة دراسات وكتب، وقد كان لمساهمات عزمي بشارة أهمية كبيرة للباحثين، إذ أصدر عدة كتب ذات صلة بموضوع بحثنا: ” الثورة والقابلية للثورة “، و” الانتقال الديمقراطي وإشكالياته “، و” سورية: درب الآلام نحو الحرية… محاولة في التاريخ الراهن “. وأيضًا إدريس لكريني، الذي أصدر عدة دراسات وكتب منها: ” تدبير أزمات التحوّل الديمقراطي “، ومساهمته في كتاب ” أطوار التاريخ الانتقالي/مآل الثورات العربية ” وغيرهما من الكتّاب والباحثين.
ويتضح من متابعتنا للمساهمات العديدة أنّ أغلبية الباحثين يدعون إلى الإصلاح التدريجي للدول كي تصل إلى نجاح الانتقال الديمقراطي، بينما عسكرة الثورات تؤدي إلى إضعاف الدولة، وقد تؤدي إلى حروب أهلية.
ويُعتبر كتاب ” الانتقال الديمقراطي وإشكالياته “، بما تناوله من نظريات وتجارب عملية مقارنة، مرجعًا مهمًا لبحثنا. إذ تناول عزمي بشارة نشأة دراسات الانتقال الديمقراطي، ومدارسها المختلفة، وتتبع التطورات في داخل هذا التخصص من السياسة المقارنة، نظريات التحديث السياسي، أي النظريات الكلاسيكية حول الديمقراطية. وأيضًا النظريات الانتقالية، التي تناولت الإشكاليات الرئيسية لعملية الانتقال الديمقراطي، انطلاقًا من تجربتي أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية. خاصة ما طرحه دنكورات روستو في مقاله ” نحو نموذج ديناميكي للانتقال الديمقراطي ” منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، الذي أكد على أهمية التوافق الوطني لنجاح العملية مقارنة بما يطرحه التحديثيون.
وفي حين أنّ المدرسة الأولى التحديثية تشترط الثقافة السياسية الديمقراطية لنجاح عملية الانتقال، وهي ” ليست محل اهتمام جوهري لافت في معظم أنحاء العالم فحسب، بل إن لها أهمية من الناحية البراغماتية أعظم من كيل المزيد من المديح لفضائل الديمقراطية، وربما كان مسوّغ الربط بين الانتقال الديمقراطي، هو انشغاله بمسألة نشوء الديمقراطية حيث لا توجد “4.
في حين أنّ المدرسة الثانية تراها ليست شرطًا وإنما نتيجة لنجاح العملية، ولو أنها تتحدث عن ضرورة تمتّع النخبة بهذه الثقافة، وبالتالي خياراتها الاستراتيجية، على ضوء الصراعات الأساسية بين رموز النظام التسلطي وإمكانية فرض قواعد جديدة للحياة السياسية، بما يميّزها عن الحتميات السياسية الليبرالية لمدرسة التحديث.
وفي الوقت نفسه، أشار بشارة إلى أنّ المدرستين تتفقان على أفضلية الانتقال التدريجي عن الانتقال الثوري، باعتباره يساعد على إمكانية تجاوز الأزمات التي ترافق انهيار الأنظمة التسلطية.
وفي الواقع شهد العالم عدة تجارب في الانتقال الديمقراطي، حيث شارك فاعلون سياسيون في عمليات الانتقال، خاصة بعد أن فضّل رجال الأعمال العملية بعد إدراكهم أنها ستحمي مصالحهم، كما أنّ قوى تقليدية أعادت النظر في برامجها، كما حصل مع أحزاب شيوعية في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين. حيث سيكون استحضار تجارب التحوّل الديمقراطي في دول أوربا الشرقية التي حقّقت مكتسبات سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة، سيكون مفيدًا لسورية الجديدة. وقد كان لعامل المحيط الإقليمي أثر كبير ومحوري في دعم التحوّل في مجتمعاتها ودولها، حيث أسهم ذلك في تشكيل ثقافة تؤمن بالحريات وحقوق الإنسان، بعدما نجحت أوربا الغربية في الترويج لتجربتها وثقافتها. حيث ” تجاوزت شعوب أوروبا الشرقية أثقال الحقبة الشيوعية بالحوارات البينية، وتوصلت عبر الحوار إلى أنّ الجميع شركاء في الوطن، متكافئون ومتساوون في الحقوق والواجبات، وخرجت من عزلتها، على الرغم من أنها رزحت تحت نير استبداد الأنظمة الشمولية في الحقبة الشيوعية لأكثر من نصف قرن… فمثلًا تشكلت الطاولة المستديرة في بلغاريا، واستمرت المشاورات السياسية حولها من 3 كانون الثاني/ يناير حتى 14 أيار/ مايو 1990. وبدأت بلغاريا بتنفيذ إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، تهدف إلى الانتقال الفعلي إلى اقتصاد السوق والإدارة الديمقراطية “5.
وبعد عهود من الانقلابات العسكرية والفوضى في أفريقيا وأميركا اللاتينية اختارت عدة دول منها الانتقال الديمقراطي طبقًا للمقاربة الثانية التي ذكرناها، وهي اليوم تتمتع بالاستقرار ورفاهية شعوبها، كما هو الحال في رواندا وموريشيوس وبوتسوانا والرأس الأخضر وغانا وجنوب أفريقيا. بحيث أنها ” تعاملت مع المطلب الديمقراطي من منظور الإجرائية المؤسسية المعيارية دون اعتبار المحددات المطلوبة من الانتقال الديمقراطي نفسه في الواقع الفعلي، أي الاكتفاء بضوابط التنظيم السياسي من منظومة دستورية وقانونية وتعددية حزبية وانتخابات عامة مفتوحة. طبقًا لما كان قد ذكره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو عن ما يسمى ” الأوهام الاجتماعية ” التي قد ” تفضي إلى تشكيل واقع موضوعي ليس في ذاته وهميًا، بل يقوم على تواطؤ ضمني بين فاعلين متعددي المصالح والرؤى يستفيدون من عملية الاختراع الوهمي السائد “6.
وتشير التجارب الأفريقية إلى ” أهمية المؤتمرات الوطنية كسبيل لتدبير مرحلة التحوّل، وهي من أبرز مناهج التغيير السلمي للأنظمة التسلطية التي ظهرت في أفريقيا من خلال المفاوضات التي تتم غالبًا تحت ضغط شعبي “7 .
وخلاصة القول، إنه وإلى جانب التحديات التي يفرضها التنوع العرقي والديني والإثني المميّز للمجتمعات في أفريقيا، يطرح أيضًا التحدي الاقتصادي بشكل أساسي وملحّ، حيث أن التحوّل السياسي يصطدم بمجموعة من الإكراهات في علاقة مع ضعف البنيات التحية، وتفشّي الفقر والأمية والبطالة والفساد، الأمر الذي يطرح إشكالات كبرى في ارتباطها بتعزيز مسار التنمية.
ففي سياق التحول الديمقراطي لجنوب أفريقيا، لعبت الحكومة الانتقالية دورًا حاسمًا في بناء ديمقراطية قوية. كانت هذه الحكومة ائتلافية، حيث تشكلت حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابات 1994، مما سمح بمشاركة جميع الكتل السياسية في إدارة الحكم من خلال بناء تحالفات موسَّعة. لم تكن هذه الحكومة تكنوقراطية بشكل رئيسي، بل كانت تعتمد على توافق سياسي بين مختلف الأطراف السياسية8.
ولا شكَّ أنّ للتجارب الأفريقية خصوصيتها الناتجة عن التكوين الاجتماعي القبلي، لذلك نجد أنّ أغلبها اكتفت بالمعايير الإجرائية للديمقراطية، البعيدة عن متطلباتها الرئيسية خاصة المشاركة الفعّالة في بلورة السياسات العامة.
كما لا تخفى أهمية التحوّلات الكبرى التي شهدتها مجموعة من دول أميركا اللاتينية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وبسعيها إلى طي مراحل قاتمة من تاريخ الانقلابات العسكرية والصراعات الدموية على السلطة، بما خلق دينامية سياسية وتحوّلًا بنّاء نحو الديمقراطية. وكان تقديم أجندة إصلاحية للقوات المسلحة أمرًا حاسمًا، مكنّت القيام بالتحويل الديمقراطي للجيش بشكل فعّال، إذ كانت ثمة سيطرة سياسية مستقلة وواضحة للسلطة المدنية، مع الحاجة إلى منع حلقة جديدة من التهميش المدني للقضايا الأمنية والعسكرية.
وجدير بالذكر أنّ التحوّل في العديد من هذه الدول ” اقترن بدعم الولوج إلى اقتصاد السوق، وانتعاش وتطوّر فعاليات المجتمع المدني، فيما تم تحييد الجيوش عن السياسة بصورة متدرجة “9.
أما التجربة الإسبانية في الانتقال الديمقراطي فهي تتميز بأنها تجاوزت 40 سنة من محنة ديكتاتورية فرانكو، بما فيها الحرب الأهلية عام 1936، خاصة أنها احتوت النزعات القومية الخاصة في إطار الدولة الإسبانية الموحّدة، حين مكّنتها من الحكم الذاتي. وهي أحد النماذج التي استلهمتها تحوّلات أغلب دول أوروبا الشرقية. وقد امتدت تجربة الانتقال لمدة 7 سنوات، من وفاة فرانكو عام 1975 إلى سنة 1982، حيث تمت عودة الحزب الاشتراكي إلى السلطة بانتخابات ديمقراطية وشفافة. وقد تمَّ ذلك بفضل إدراك الملك خوان كارلوس لتوجهات العصر ومصالح الشعب الإسباني، ونجاح مفاوضات مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية على التوافق لصياغة الدستور الذي اعتمد اللامركزية والحكم الذاتي لمنطقتي الباسك وكتالونيا، وقطع مع مخلّفات الحرب الأهلية ومرحلة ديكتاتورية فرانكو. وكان لهذا الانتقال نتائج إيجابية على الشعب الإسباني، أهّلته كي يكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
أهم خلاصات تجارب التحوّل الديمقراطي
من خلال مراجعة بعض دراسات عمليات الانتقال إلى الديموقراطية حول العالم، يمكن استخلاص بعض الافكار والملاحظات: سقوط نظام سلطوي لا يضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي، بل قد تنحدر إلى حرب أهلية. ومما يساعد على نجاح عملية التحوّل توفّر إرثٍ من تقاليد دستورية وقانونية وتعددية، إضافة إلى قضاء مستقل واقتصاد حرٍّ، كما هو الحال في نجاح الانتقال في إسبانيا، على عكس ما شهدناه في رومانيا مثلًا. والانتقال السلمي أضمن لديمومة الانتقال، كما حصل في البرازيل والبرتغال وإسبانيا واليونان.
وهكذا، فإنّ عوامل نجاح عملية الانتقال الديمقراطي تتطلب ” الفضاء الديمقراطي الإقليمي المؤثر، والمستوى الثقافي والتعليمي العالي الذي تتمتع به شعوب هذه الدول، وضعف العامل الديني في التدافع السياسي، وإدراك السلطات، في غالبية هذه البلدان، أنّ التغيير أضحى حتمية تاريخية. غير أن تجارب بلدان وشعوب عديدة، خاصة في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، تبين أنّ هذا الانتقال ممكن، فيما لو توفرت نخبة تتمتع بثقافة ديمقراطية، وتتبنى القيم الديمقراطية، كي تلعب الدور في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وحينها ستبدأ الثقافة الديمقراطية بالنمو “10.
الهوامش:
1 – توفيق المديني، سورية الجديدة: أهمية التحوّل الديمقراطي والدستور الجديد، ” مجلة البلاد ” – بيروت 27 كانون الأول/ديسمبر 2024.
- – إدريس لكريني، تدبير أزمات التحوّل الديمقراطي، المطبعة الوطنية – مراكش، ط1 2020 ص 20.
3 – إدريس لكريني، تدبير أزمات التحوّل الديمقراطي، المرجع السابق، ص20.
4 – راجع محمد حمشي، عن الحاجة الملحّة إلى مساهمة عربية في حقل دراسات الانتقال الديمقراطي، مقدمة كتاب: مقالات مرجعية في دراسات الانتقال الديمقراطي، ترجمة مجموعة مترجمين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الدوحة/ بيروت 2023.
5 – علي الحاج حسين، تجربة بلغاريا في الانتقال الديمقراطي.. الطاولة المستديرة كانت الحلّ، مركز حرمون للدراسات المعاصرة – 9 كانون الأول/ديسمبر 2024.
6 – السيد ولد أباه، ديمقراطية أفريقيا والتحوّل السياسي – صحيفة ” الاتحاد ” الإماراتية، 11 حزيران/يونيو 2023.
7 – إدريس لكريني، تدبير أزمات التحوّل الديمقراطي، المرجع السابق، ص 171.
8 – راجع شيخاوي أحمد، الديمقراطية التوافقية في دولة جنوب أفريقيا ما بين النجاح والإخفاق، مجلة ” قراءات أفريقية ” – 27 تموز/يوليو 2016.
9 – إدريس لكريني، تدبير أزمات التحوّل الديمقراطي، المرجع السابق، ص 155.
10 – بول سالم، الربيع العربي وتجارب التحوّل الديموقراطي في العالم، صحيفة ” الحياة ” – لندن 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
/*/ – مقاربة نُشرت على ثلاث حلقات في ” منتدى الفارابي للدراسات والبدائل ” – بتونس.


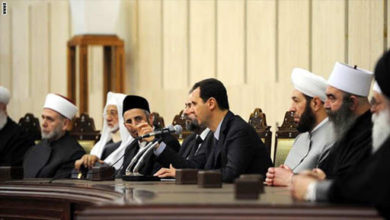





التحوّل الديمقراطي يشمل الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يمكن أن تنقل سورية من الدولة التسلطية إلى الدولة الديمقراطية، قراءة دقيقة وموضوعية للوضع السوري والتي تحقق هذه الإجراءات للتحول الديمقراطي .