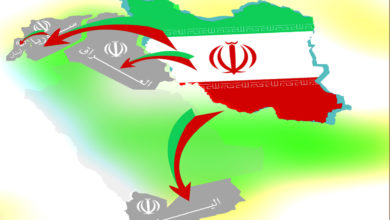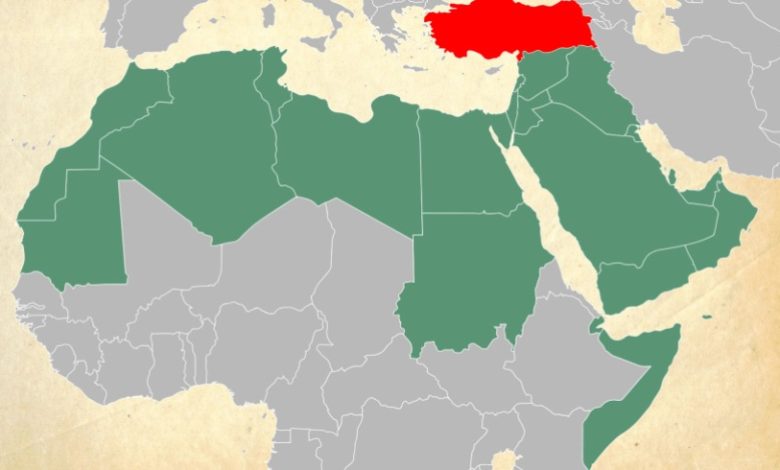
في حين تلعب تركيا، كقوة صاعدة، دورًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط باتجاه الاستقرار واحترام قواعد الانتخابات الديمقراطية، فإننا نفتقد، حتى تاريخ إعداد هذا المقال، إلى أنموذجٍ عربيٍّ يستطيع أن يقود المنطقة إلى طريق الحرية والكرامة والاستقرار، وأن يحاول التوسُّط تفاوضيًا للمساهمة في حلّ صراعات المنطقة، أو على الأقل نزع فتيل انفجارات محتملة، وبناء علاقات تعاون اقتصادي متطورة بين الدول العربية ومع دول الجوار أيضًا.
إذ لم يتجدّد المشروع العربي، لا في هويته الفكرية والسياسية، ولا في حضوره الاجتماعي، إذ يبدو أنّ قوىً مؤثرة في هذا المشروع لم تُدرِك بعد أنّ العروبة، ودولة الحق والقانون، والمواطنة، مرتكزاتٌ متكاملةٌ في بحث شعوب هذه المنطقة عن تماسكها، وعن سلمها واستقرارها وأمنها الاجتماعي، وعن طموحاتها وتطلعاتها إلى المستقبل.
وفي الواقع، لا يمكن أن نتحدث عن الدولة الأنموذج دون أن نؤكد أنها دولةُ الحق والقانون، وأنها دولةُ مجتمع المؤسسات السياسية والمدنية التي تنظِّم حياة الناس وتدافع عن حقوقهم، ومجتمعُ الواجبات الذي يؤدي فيه كلُّ فردٍ واجبه تجاه المجتمع.
ظل الفكر السياسي العربي، بجميع تياراته، يعاني من شُحِّ الثقافة الديمقراطية، وضعف الوعي الحقوقي، لا سيما في مسألة التنوُّع، والتعدُّدية، والاعتراف بالآخر، وتداول السلطة سلمياً.
وفي الوقت الذي تغيب فيه عن المشهد الإقليمي نماذجُ عربية ناجحة، تبدو تركيا أنموذجًا متكاملًا ورؤيةً متسقةً لمستقبل الشرق الأوسط، إذ تقف معبِّرةً عن إمكانية الجمع الناجح بين علمنة مؤسسات الدولة والمجال العام، والتحوُّل نحو ديمقراطية تقبل المشاركة في الحياة السياسية، بضمانات دستورية وقانونية واضحة.
وفي المقابل، وعلى الرغم من نجاح عدة دول عربية في المحافظة على استقرار الحكم – إلى حد بعيد – معتمدةً في ذلك على ريع الوفرة النفطية أو قمع الأجهزة الأمنية أو كليهما، إلا أنّ ثنائية المجتمع المتطوِّر – نسبيًا – والدولة التقليدية، تنذر بتوترات، كما هو الحال في العديد من الأقطار العربية بعد ربيع الثورات العربية بموجتيه في عامي 2011 و2019، تعبِّر عن نزوع قوى المجتمع الحيّة إلى الاصطدام بحكّام الدول لانتزاع المزيد من الحريات المدنية والعامة، ولدفع عجلة تحديث المؤسسات.
والحقيقة أنّ أبرز إرهاصات هذا الرفض الشعبي باتت ترتبط، في المقام الأول، بتواتر الاحتجاجات الاجتماعية ذات الخلفيات المحددة، كمكافحة الغلاء والبطالة، وتحسين الخدمات الأساسية، ومستويات الأجور، والإعانات المقدمة لمحدودي الدخل، وغيرها، وبدرجة أقل بالعزوف الشعبي عن المشاركة في الحياة السياسية الرسمية، بمقاطعة الانتخابات الصورية، والابتعاد عن الأحزاب، بعدما شاع التحاق أكثرها بالسلطات المستبدة، وبالتالي التشكيك في صدقيتها وقدرتها على التعبير عن مطالب وتطلعات المواطنين.
وفي الواقع، ظل الفكر السياسي العربي، بجميع تياراته، يعاني من شُحِّ الثقافة الديمقراطية، وضعف الوعي الحقوقي، لا سيما في مسألة التنوُّع، والتعدُّدية، والاعتراف بالآخر، وتداول السلطة سلمياً، وسيادة مبادئ القانون، والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، وغيرها. ولم تكن البيئة الثقافية العربية قد أفرزت مطالب وشعارات تربط بين الدولة، ككيان قائم ومستمر، وليست السلطة كحالة متغيِّرة، وبين الإصلاح الديمقراطي الداخلي والتخلص من الهيمنة الأجنبية.
في معظم الأقطار العربية، تراجعت نسبة وأهمية ودور الطبقة الوسطى، وتزايدت الفجوة اتساعًا بين القلّة المالكة للثروة والنفوذ، وبين الأكثرية الساحقة من المواطنين.
وهكذا، يواجه العالم العربي تحديات غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، فالنظام الإقليمي العربي فاقدٌ للمناعة تجاه الضغوط والتدخلات الدولية والإقليمية، وغالبية أنظمته تفتقر إلى استقلال الإرادة والقرار، بينما أكثر من قُطرٍ مهدَّدٌ بوحدة نسيجه المجتمعي وترابه الوطني.
وقد تراجعت نسبة إسهام الأنشطة الإنتاجية، الصناعية والزراعية، مقابل ارتفاع نسبة مساهمة الخدمات والمداخيل الريعية في الاقتصاديات العربية. فضلًا عن القصور في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة واستثمار عوائدها، ومحدودية قنوات الاستثمار الوطنية والقومية، مما أسهم في هجرة الأموال والعقول. ولا أدلَّ على التأخر الاقتصادي العربي من أنّ المداخيل الوطنية العربية مجتمعة لا توازي دخل هولندا أو إسبانيا.
وفي معظم الأقطار العربية، تراجعت نسبة وأهمية ودور الطبقة الوسطى، وتزايدت الفجوة اتساعًا بين القلّة المالكة للثروة والنفوذ، وبين الأكثرية الساحقة من المواطنين، وارتفعت نسب البطالة ومن هم دون خط الفقر، مما ينذر باستمرار الانفجارات الاجتماعية المطالِبة برحيل الديكتاتوريات العربية.
المصدر: تلفزيون سوريا