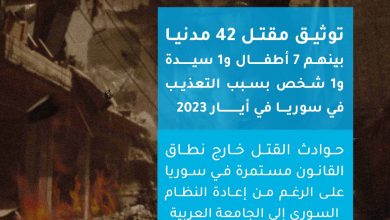الحلقة التاسعة: الإخوان المسلمون ـ محاولة تفسير 5/6
الفكر والعقيدة
من المتفق عليه بين جميع الباحثين في تاريخ هذا الحزب وفكره أنه إذ يعتمد على الإسلام أيديولوجيا له، فإنه يتعمد أن يترك هذه المسألة في إطار التعميم الشديد، فلا يحدد منها إلا الإطار العام، وينأى بنفسه عن البحث في تفاصيل الموقف الإسلامي من القضايا التي تحرك المجتمع، أو توجهه، واستمر هذا الموقف عاما إلا في القضايا التي فرضت نفسها على مفكريه بقوة، وشكلت نقاط صدام دموية معهم، فقد أعطوا فيها رأيهم، واعتبروا ذلك رأي الإسلام، وفي المقدمة من هذه القضايا القضية القومية، ثم قضية العدالة الاجتماعية.
بعض الباحثين يعيد دوافع هذا التعميم إلى منهجهم وعقيدتهم، حيث الأصل عندهم هو التوحيد، والإسلام، أي خلع كل ما يتنافى مع مدلولات هذا التوحيد على مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، وحين يتحقق هذا الخلع، فإن الإسلام رحب، ويستطيع الباحث فيه أن يجد ضالته على كل تلك المستويات، ولا يعود الخلاف الإسلامي في فهم قضايا المجتمع هو المشكلة، لأنه يصبح الخلاف عندئذ خلافا في إطار الإسلام ودائرته، وليس خلافا عليه كما هو حاصل اليوم.
والبعض الآخر يعتقد أن وراء هذا التعميم حذرا من أن يؤدي الدخول في دائرة الجزئيات والتفريعات إلى انقسام الجماعة، وبالتالي إضعاف قدرتها على التأثير، وأصحاب هذا الاعتقاد يرون أن في هذا التفكير ملامح ذكاء قيادي سياسي بالغ، وهو إذ يحقق إجماعا حول التنظيم، فإنه يبتعد بالتنظيم عن دوامة تنافس البرامج بين الأحزاب.
إن النظر في الفكر والعقيدة هو وحده الكفيل بتحديد موقع الجماعة في الخارطة الاجتماعية، وهو الذي يحدد دورها الفعلي في دعم حركة وقدرة المجتمع على الخروج من دائرة التبعية والجهالة، أو في إعاقتها عن هذا الهدف.
وحتى يكون النظر متحررا من الضغط النفسي والعقلي الذي يتعرض له أي باحث يرغب في الحديث حول الإسلام كإيديولوجيا، لا بد له أن نحدد زاوية النظر إلى هذه المسألة.
إن الإسلام كعقيدة يضمها كتاب الله ” القرآن العظيم”، والسنة النبوية شيء، والإسلام كإطار فكري، ونظرية حياة، شيء آخر، وقد يتطابق هذا مع ذاك، وقد يختلفان، ومن التبسيط غير العملي محاولة حصر دواعي هذا التباين في اختلاف وتباين الاستعدادات والملكات عند المفكرين الإسلاميين، ووضعها كلها في إطار الحديث النبوي حول أجر المجتهد، ولو كان الأمر مجرد اختلاف في الاجتهاد لما شهد تاريخنا العربي الإسلامي، والتاريخ الإسلامي عموما، ذلك الصراع العميق والشامل الذي لا تزال آثاره مستمرة حتى الآن، ولما شهد واقعنا العربي والإسلامي اليوم هذا التباين الشديد في منهج الجماعات الإسلامية في التعامل مع ظواهر الحياة المختلفة، والتي تصل إلى درجة تكفير بعضهم بعضا.
نحن نعتقد أن نقطة البدء الصحيحة لفهم هذه الظاهرة هي أن نفرق بين الدين، والفكر الديني، بين الإسلام، والفكر الإسلامي، … فإذا كان الدين واحدا، والإسلام واحدا، ثابتا محددا، فإن الفكر الديني ليس كذلك، وحين نقول الفكر الديني فنحن نعني بدقة مستويين أساسيين:
** فهم الرجالِ، المفكرين، الفقهاء، لهذا الدين الواحد، الثابت، المحدد.
** تكييف الرجال، المفكرين، الفقهاء، لظواهر الحياة على ضوء ذلك الفهم.
وقد عبر توجيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن مستوى من مستويات تباين فهم الرجال حينما قال لسلمة بن قيس الأشجعي أحد قواده العسكريين يرشده إلى كيفية التصرف مع أعدائه: فإن تحصنوا منكم بحصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله، فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم، وإن سألوكم أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله، وذمة رسوله، وأعطوهم ذمم أنفسكم…”.
وعبر الصراع الذي تفجر منذ المرحلة الثانية لحكم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتصاعد بين علي كرم الله وجهه، ومعاوية، عن مستوى من مستويات تكييف الرجال لظواهر ووقائع الحياة.
إننا إذ نقول هذا فحتى نحدد إطار النظر، وصراع الأفكار، فلا تعود الخشية تسابق العقل، وحتى تصبح المقابلة فكرا بفكر، وعقلا بشريا بآخر مثله، ونتخلص من المقابلة المنحرفة والمصطنعة التي تصادم الكثير ممن يروا غير ما نرى، حينما يقال: هذا حكم الله، فكيف تخالفون حكم الله؟ أي حينما تصبح المقابلة بين فكر البشر، وكلام الله.
وعلى هذا القاعدة من النظر نبسط رؤيتنا لقضية العقيدة والفكر عند الإخوان:
1ـ أولى قضايا العقيدة التي يرفعها فكر الإخوان، والتي تشكل الركيزة الأساسية لديهم هي مفهوم ” الجاهلية” وحكمهم على المجتمعات الراهنة كلها بأنها جاهلية، حيث الجاهلية لديهم “حالة” وليست مرحلة زمنية، بها قال مفكروهم من “أبو الأعلى المودودي إلى سيد قطب، إلى سعيد حوا”، ، وأهم ما ينتج عن هذا المفهوم ضرورة الخروج من هذه الحالة، أي الانفصال عنها، وتغييرها، وقد يمتد هذا المعنى عند بعضهم ليشمل المجتمع كله: سلطة وناسا، وقد يقتصر عند بعضهم الآخر على السلطة، حيث الناس، العامة متأثرون ببيئة السلطة وقوانينها وفكرها.
مفهوم الجاهلية هذا يعكس نفسه مباشرة على ثلاثة مستويات تتكامل فيما بينها لتعطي الجماعة التماسك المنشود، ولتبرر في الوقت نفسه ذلك التصميم الذي التزمته إزاء قضايا المجتمع وصراعاته:
** فهذا المفهوم يخرج عضو الجماعة عن حركة المجتمع ويعطيه استقلاليته الخاصة، وليس القصد هنا أنه يعطل حركته في المجتمع، وإنما يحرره من أي معيار اجتماعي واقعي، ويجعل معياره الأساسي هو فهم الجماعة، وقرارها، ولا يعود للموقف الشعبي أي تأثير ـ وقد رأينا هذا في المحطات التي وقفنا عليها ـ ولا ارتباطات الحكام، ولا منهجهم، ولا يعود مهما كيفية تعاملهم مع الناس، فالوضع كله جاهلي، وهم وحدهم ممثلو مجتمع المؤمنين.
** وإذ يُخرج هذا المفهوم العضو من المجتمع، فإنه يحصره في إطار الجماعة، وتصبح الجماعة عنده هي كل شيء، هي مجتمعه، وهي عائلته، وهي شرفه الخاص، وتعود عنده منزهة عن الخطأ، فتأخذ الجماعة ككيان والمرشد كموقع ومركز، فوق الجميع، وتصبح الجريمة الكبرى التي لا تغتفر هي التعرض للجماعة، سواء جاء هذا التعرض من قبل فرد أو مؤسسة أو سلطة دولة، وتصبح مهادنة الجماعة هي المدخل لأية علاقة ممكنة معها، ولا يعود هناك معيارا آخر، ووفق هذا الحصر فإن الجهاد هو الدفاع عن الجماعة، لذلك نراهم يقتلون القاضي الذي أصدر حكما على بعض أعضائها، ويصبح مستساغا لديهم الشروع في تفجير دار القضاء العالي، أما قتل النقراشي فهو واجب يصغر أمامه أي واجب آخر ما دام قد أقدم على حل الجماعة، وحينما اعتبروا الثورة متمردة على إرادة الجماعة، وغير قابلة للخضوع لها، فإن الصدام معها بات أمرا لا مفر منه.
إننا هنا لا ننظر فيما إذا كانت الجماعة أصدرت قرارات القتل والصدام هذه، أم أن ذلك جاء كتصرفات فردية، كما جاء ادعاؤها في غالب القضايا التي اعترفت بصلتها فيها، وإنما ننظر في أثر عقيدة ” تجهيل المجتمع” على سلوك الفرد والجماعة.
** يضاف إلى ذلك أن مفهوم الجاهلية يلغي التاريخ العربي الإسلامي، ويجعل الوصل مباشر بين جماعة الإخوان المسلمين ـ أي جماعة الدعوة في هذا العصرـ، وبين عهد الخلفاء الراشدين، باعتباره العهد الذي مثل الإسلام تمثيلا صحيحا.
ولو قمنا بتمحيص العهد الراشدي وفق فكر الجماعة لخرجنا بنتيجة مفادها أن جزءا من ذلك العهد فقط هو الذي يمثل الإسلام الحق.
إن هذا الإلغاء يصادر، وبالتالي يشطب، التساؤلات والاستفسارات التي قد يثيرها العقل تجاه حالة الإسلام الواقعي، أي حالة المجتمعات الإسلامية، بما مر عليها من عدل وظلم، ومن تسلط وشورى، ومن تجاوز لحدود الله وتمسك بها.
وإذ تتحقق هذه المصادرة فإنها في الوقت نفسه ترفع من مكانة الجماعة، ومن مكانة المرشد، ومكتب الارشاد. ترفع هذه المكانة إلى مستوى أولئك المؤمنين الأوائل “الصحابة”، وأولئك الخلفاء العظام، أي أن هذا الإلغاء يعزز مكانة القيادة وحصانتها ضمن الجماعة، ومكانة الجماعة وحصانتها ضمن المجتمع، فكما كانت جماعة المؤمنين هي رمز الخلاص الأول من مجتمع الجاهلية الأول، وكانت دولتهم هي رمز الخلاص ضمن واقع الدول والامبراطوريات في ذلك الزمن، كذلك شأن الجماعة اليوم.
لنعاود النظر في ذلك المنهج الذي سجله المرحوم سيد قطب بخط يده، نرى المعاني التي أتينا عليها واضحة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بمكانة الجماعة، ودورها، والموقف منها، ويصبح مفهوما عندنا ذلك الدور الذي حدده للسلطة، أي سلطة من الجماعة، وهو إفساح المجال لها لتزاول أعمالها، وذلك الاستعداد الذي أوجبه على الجماعة لمواجهة تمرد السلطة على هذا الدور، وتصادمها مع الجماعة، كنتيجة من نتائج هذا التمرد، ويصبح مفهوما لدينا أيضا آلية تصادم الجماعة من حلفائها، مع السلطات التي دعمتها ووقفت إلى جانبها.
ومفهوم “الجاهلية ” مفهوم عام وشامل، لذلك لا يواجه عندهم إلا بنقيضه، وهو التوحيد المتجسد في معنى “لا إله إلا الله”، هذا المعنى الذي يجرد الفرد من التبعية لأي شيء سوى رب العالمين، يتطلب الخضوع الكامل لله عز وجل، خضوعا يشمل معنى التسليم الكلي للخالق.
والإخوان هم الذين يجسدون هذا الخضوع، لذلك فإن مزاولة التوحيد على نحو ما أراد الله، تقتضي الدخول في هذا المجتمع المؤمن “مجتمع الإخوان”.
ومن هذا المفهوم فإن المجتمعات الجاهلية لا تواجه بدعوات الإصلاح الاجتماعي، أو التوحد القومي، أو التقويم الأخلاقي، فكل هذه الدعوات اتجاه خاطئ منحرف في مواجه حالة خاطئة منحرفة.
وعلى هذا المنهج “منهج التوحيد” جاء الرسول الكريم، ولو كان هناك منهاج آخر لمواجهة حالة الجاهلية، منهاج قويم، لكان أولى من يأخذ به الرسول الكريم نفسه.
وللتأكيد على صحة تحليلهم هذا فإنهم يقفون أمام الدعوة الإسلامية فيرون أن الرسول الكريم جاء إلى مجتمع ممزق، مقسم، وصل وضعه الأخلاقي والاجتماعي إلى الدرك الأسفل، وكان من الممكن لو أعلنها ثورة قومية أن يجمع حوله العرب، فيوحدهم، ويقيم دولتهم الواحدة، ويواجه بهم الدول السائدة، والمستبدة، لكنه لم يفعل ذلك، لأنه لا يريد أن يصحح خطأ بخطأ، فينزع قومه من حالة الضعف، والرضوخ للآخرين، والتفتت، ليوقعهم ويوقع الآخرين لحكمهم، وطغيانهم.
وجاء في مجتمع بلغ الظلم الاجتماعي فيه مداه، والتردي الأخلاقي أخذ كامل أبعاده، ومع ذلك لم يعلنها ثورة طبقية، أو أخلاقية، ولو فعلها لجمع حوله أغلبية الناس
ـ الفقراء ـ لكنه رمى بكل ذلك، ورفع شعار التوحيد “لا إله إلا الله”، فبهذا الشعار وحده يتحقق للإنسان وجوده، وللإنسانية عافيتها.
2ـ يتبع هذا المفهوم مباشرة ويرتكز عليه، رفضهم البحث عن قوانين اجتماعية، رغم حديثهم عن سنن الله في خلقه، فالله قد أمر ونهى، وليس لنا أن نشرع غير شرع الله، فلا إضافة ولا حذف، وإلا وقع المسلمون بما وقع فيه سابقوهم من اليهود والنصارى، ويستبقون عقل الإنسان، فيثيرون السؤال الطبيعي: أليس مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم؟، ويجيبون على ذلك بآيات من القرآن الكريم: “ءأنتم أعلم أم الله”…”والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.
هذا الفهم الإسلامي يطرح رؤيتهم هم، لكنه لا يطرح المسألة على حقيقتها، فإذا كان الصحيح المطلق أن الله هو العليم الحكيم، وأنه أعطانا بالإسلام ما يصلح شأننا، فإن أهم ما أعطانا إياه بعد الرسالة هو العقل، بل إن الله عز وجل عقد التكليف وربطه بالعقل، وأمرنا أن نعمل عقولنا، ونفتح بصيرتنا، ونكتشف سنن الله في خلقه، ومعرفة هذه السنن هي الشرط الأساسي للسير على الطريق الإسلامي القويم، وسنن الله تمتد لتشمل الطبيعة والانسان، والمجتمع، وكل كائن حي، وقد دعانا الله أن ننظر في كل ذلك حتى نتبين الطريق الصحيح.
ولأنهم يرفضون النظر في القوانين الاجتماعية فإنهم في موقع المخاصمة المباشرة للدعوة القومية، وعلى وجه التحديد لدعوة ” القومية العربية”، ولقانون تبدل النظم الاجتماعية وتغيرها، ولقانون ارتباط السلطة السياسية بطبيعة القاعدة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع. لذلك فإن الحديث عن النظام الاقطاعي، أو الرأسمالي، لا يعنيهم بشيء، مثله في ذلك مثل الحديث عن النظام الاستبدادي، والنظام الديموقراطي، والنظام الملكي، والنظام الجمهوري، فكل هذه الأنظمة “جاهلية”، أما في الإسلام ـ وفق ما يرون ـ هذه كلها معدومة الوجود. وحين يشير متسائل إلى ما مر في التاريخ العربي الإسلامي من هذه النظم، فإنهم غير معنيين في البحث في هذا الشأن، فقد سبق وأعلنوا أنها كلها مجتمعات جاهلية، لا يصدق عليها اسم ” المجتمع الإسلامي”، ولا تؤخذ دلالة عليه، أو شاهد دراسة له، وحينما يتعرضون إلى هذا النظام أو ذاك، فإنما يفعلون ذلك من باب المقارنة، وإطهار مفاسد هذه النظم، لا من باب دراستها، وإظهار أثر الإسلام في التخفيف من سوءاتها، ولجم الآثار السلبية فيها، ولأجل ذلك نراهم لا يقفون أمام حركات التغيير والثورة الاجتماعية في التاريخ العربي، وهي حركات يوليها مفكرون عرب ومسلمون أهمية بالغة في فهم تأثيرها على حركة تلك المجتمعات.
إن موقفهم المضاد لمبدأ وجود قوانين اجتماعية جعلهم عاجزين عن فهم الكثير مما يدور في الحياة بدءا من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى مشاكل العصر، وما تواجهه الأمة في هذه المرحلة.
صحيح أن الرسول الكريم لم يأت باعتباره داعية قومي، أو داعية إصلاح اجتماعي، أو أخلاقي، لكن التفسير الذي مضوا فيه، وجعلهم في موقع الصراع من الدعوة القومية، والرفض لأي دعوة اجتماعية ليس له أدنى علاقة بمنهج الرسول الكريم.
إن تفسير طبيعة ومنهج الدعوة الإسلامية يتأتى من حقيقة أن الإسلام خاتم الرسالات، وأن الله عز وجل ربط ” الحساب” ب ” التبليغ”، وحين يكون الرسول الكريم خاتم الأنبياء، فإن رسالته بالحتم ستكون للبشرية كلها.
إن هذه الحقيقة لا تعطل، ولا تناقض أيا من قواعد تكوين وتشكيل المجتمعات البشرية، من القبيلة إلى الأمة، ومن نظام الرق، إلى النظام الاشتراكي، لكنها بالحتم تعطل وتناقض كل ما يتنافى مع الضرورات البشرية، وما لا تستدعيه طبيعة هذا النظام أو ذاك.
إن الإسلام لم يلغ الرق، لكنه ألغى كل الصور الشاذة التي كان يمارس فيها، كما أنه لم يقر الرق، لأن هذه المسألة جزء من النظام الاجتماعي، تزول بزواله، ولعلنا نطالع كثيرا من آراء مفكرين إسلاميين محدثين في دفاعهم عن مسألة الرق في الإسلام، وهو دفاع إذ يكشف عن جهد الإسلام في مواجهة الشذوذ الإنساني في التعامل مع الرقيق، ويكشف السبل التي فتحها وشرعها الإسلام لتحرير الرقيق، فإنه لا يجيب على السؤال الأساسي، وهو موقف الإسلام من الرق كظاهرة، كجزء من نظام قائم، وحين نلحظ هذا العجز في الإجابة، فيجب أن ندرك مباشرة أن السبب الكامن وراءه هو عدم النظر في طبيعة النظام “الاجتماعي ـ الاقتصادي” القائم وقوانينه.
كيف يمكن للإسلام أن يناقض ويصادم الدعوة القومية؟!
وكيف يمكن له أن يقف ضد وحدة الأمة العربية وقوتها وعلو شأنها؟!
يقولون إن القومية العربية دعوة” عنصرية، جاهلية”، فمن أين استمدوا هذا الحكم؟
أمن قول الرسول الكريم: “دعوها فإنها نتنة”، وهو الحديث الذي يصدره دوما مفكرو الاخوان.
إن الاستناد إلى هذا الحديث وغيره في هذا المجال هو من قبيل الاستخدام المتعسف، وهو استخدام يكشف عن تطويع قسري لشواهد ومواقف تاريخية، ونزعها من ظرفها، من زمانها ومكانها، من سياقها، واستخدامها في غير موضعها.
يقولون إن مجتمعاتنا جاهلية، لا تمت إلى الإسلام بصلة، أو ليست مجتمعات “المماليك” بهذا المفهوم جاهلية؟، ومع ذلك فإن مفكرا إسلاميا عظيما مثل ابن تيمية، يناقضهم الرأي، ويدعو إلى نصرة هذا المجتمع حين يطل خطر التتار، ويعتبر هؤلاء المماليك من أحق الناس شمولا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة”.
ثم ماذا يتبقى من تاريخنا العربي الإسلامي، والتاريخ الإسلامي عموما، إذا نحن اعتنقنا مفهوم ” الجاهلية ” هذا، وإذا عزفنا عن النظر في قوانين تطور المجتمعات، منذ بدأ الصراع حول عثمان رضي الله عنه، وحرب علي كرم الله وجهه في مواجهة معاوية بين ابي سفيان، والعصر الأموي كله، والعصر العباسي كله، وبقية عصور المسلمين، أليست هذه بمعايرهم نظم ومجتمعات “جاهلية”.
إن الذي ينظر إلى التاريخ نظرة العارف بقوانينه، المؤمن بسننه، لا تغيب عنه جوانب السلب فيه، لكن حينما يريد أن يصدر حكمه، فإنه يجري المقابلة بين هذا الجانب، وجوانب الايجاب، ثم يقيس محصلة هذا كله، أما عند مثل هذا الفكر فإن الأمر كله إما أبيض أو اسود، وفي التدقيق فإنهم لن يجدوا في تاريخنا أبدا بقعة بيضاء بالكامل، ولا في أي تاريخ، لا في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ولا في الوضع العقيدي والتشريعي.
هذا العزوف عن النظر في قوانين المجتمع، وقواعد بنائه، إذ يعكس رغبتهم في عدم الدخول العملي في محك واختبار رؤية تاريخ المجتمعات الإسلامية، وطبيعتها، فإنه يكشف عن الطبيعة المتخلفة لفكرهم، وليس هذا من الإسلام في شيء، الإسلام على النقيض من ذلك.
يقولون إن الشورى وإن كانت لازمة وجوبا على الحاكم، فإن نتائجها غير ملزمة له، فقد يعطي الله الهداية، والبصيرة للفرد مالا يعطيه للجماعة، ودلالتهم على ذلك الزعم بانفراد أبي بكر الصديق رضوان الله عليه بحرب ما نعي الزكاة، وكيف كان رأي الجماعة مخالف لرأيه، وبهذا المعنى تتحول الشورى عندهم من ضابط لجنوح الحاكم، وأسلوب للحكم الرشيد، إلى أداة في يد الحاكم.
ونحن نقول: كيف يكون الأمر على هذا النحو وقد جعلها الله من صفات المؤمنين حينما قال “وأمرهم شورى بينهم”، وأمر بها رسوله الكريم حين قال جل وعلا “وشاروهم في الأمر”، وربط العزم بالمشاورة فجاء تاليا لها ” فإذا عزمت فتوكل على الله”، وسيرة الرسول الكريم تعزز هذا الفهم وتؤكده.
3ـ كذلك يتبع هذا الموقف بالضرورة موقفا فكريا من التيارات الفكرية الإسلامية التي عمر بها تاريخنا الطويل إذ تصبح هذه التيارات مضافا إليها آراء الفقهاء، مجرد وجهات نظر لا تلزم الإخوان في موقف، أو رأي، فقط يلتزمون بها حينما يأتي متوافقا مع تفسيرهم، وآرائهم، وتوجهاتهم.
ويحمل هذا الموقف جانبي الحق والباطل:
** ففي جانب الحق نقول: إن آراء الفقهاء، والقضايا التي وقفت عندها تيارات الفكر الإسلامي، إنما جاءت استجابة لوقائع عصرهم، وإبداعا فكريا في مواجهة مسائله، ومن الطبيعي ألا تكون هذه ملزمة حينما يختلف الزمان، أو المكان، فأولئك الفقهاء أنفسهم علمونا هذه القاعدة، ومن الواجب علينا أن نتحرر من نظرة التقديس والاتباع لما أعطوه، وأن نملك عقولنا، ونحن ننظر في انتاجهم وإبداعهم.
جانب الحق هذا لقي الكثير من الترحاب، لأن الأمة وقد أخذت بإغلاق باب الاجتهاد تجاوبا مع ظروف دعت إلى ذلك، بدأت نهضتها المعاصرة تنوء بهذا الموقف، وصارت تنتظر من أبنائها، أولئك الذين يعاودون النظر في أمور الحياة، وتحدياتها المعاصرة، على ضوء المقاصد الاسمية، والشرع الإسلامي.
** أما جانب الباطل: فإنه يكشف عن نفسه حينما تصبح الآراء المطروحة، فتوى قاطعة، ومحصورة، ومحددة بجهة واحدة، فلا يبقى مجرد اجتهاد، ووجهة نظر، ولا يبقى الأمر عطاء إنسانيا، المسلم حر في الموقف منه، وإنما يصبح هذا وذاك هو “موقف الإسلام”، ويصبح الخروج عليه خروجا على الإسلام. وما أبعد هذا عن موقف الإسلام الحق، وما أبعد هذا عن موقف أولئك الفقهاء الذين أناروا دروب المسلمين في كل مرحلة.
لو اقتصر الأمر على قضايا العقيدة ـ بالمعنى الشرعي لها ـ فإن التباين فيها والاختلاف فيها حين التدقيق قليل جدا، وشبه معدوم، بل إن الاجتهاد فيها غير وارد أصلا. لكن الأمر امتد ليشمل مصالح الناس وشؤونهم، ومصالح الأمة وضروراتها، ويصبح الأمر شديد السلبية حينما يختصر كل ذلك بمصالح الإخوان وشؤونهم وضروراتهم، كما يرونها هم أنفسهم.
من هنا فإن مواقف الإخوان الفكرية من القضايا الاجتماعية بقيت تحافظ، وترعى القوى المسيطرة على الاقتصاد، والمتحكمة بشؤون المال، وجل ما استطاع أن يطرحه هذا الفكر هو استرجاع مواقف فقهاء المسلمين في قضايا التضامن الاجتماعي الإسلامي، وإذ استطاعوا التعايش مع النظام الرأسمالي ـ بكل عيوبه التي يشيرون إلى بعضها ـ فإنهم لم يستطيعوا التعايش إطلاقا مع النظام الاشتراكي، ووقفوا يصارعونه، ورغم أن النظامين: الرأسمالي الصليبي، والشيوعي الملحد، يقفان ـ في أقل تقديرـ على المسافة نفسها من الإسلام، فإنهم ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا قوة مضافة إلى النظام الرأسمالي.
وحينما طرحت الثورة العربية المعاصرة شعار الاشتراكية، وراحت تعطي فقراء الأمة حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وتعزز وحينما طرحت الثورة العربية المعاصرة شعار الاشتراكية، وراحت تعطي فقراء الأمة حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وتعزز إيمانهم بالله، وهي تطرد عنهم كفر الفقر، وتجعل بناءها هذا في إطار متميز من الايمان بالله، ومن حق هؤلاء في الحياة الإنسانية الحقيقية، ارتضوا لأنفسهم أن يصبحوا قوة مضافة إلى النظام الرجعي العربي. ولم يروا في الدعوة القومية العربية غير جاهلية مقيتة، ورغم أنهم نهضوا في ظل حكومات ونظم إقليمية لم يروا باسا في التعامل معها، والنشاط في إطارها.
وإذا كانت المسافة بين السلطة الإسلامية كخلافة، وبين دولة تجمع العرب كلهم في إطار واحد شبرا، فإن بينها وبين الدويلات الإقليمية القائمة مسافات يصعب قياسها، فأصبحوا بمواقفهم هذه قوة مضافة إلى نظم الإقليمية العربية، وإلى دفاعاتها، ومنطقها.
إن الناس لا يعانون من عبقرية الرجل الفذ الذي يلهمه الله الصواب، ويعطيه منطق الحق الذي قد لا يتحصل للجمع الغفير من الناس، ولكنهم يعانون من قهر ديكتاتوريات عاتية، ومع ذلك فإن موقف الإخوان من قضية الديموقراطية جعلتهم حلفاء طبيعيين لأكثر الحكام ديكتاتورية وعنف في تاريخنا الراهن.
إن هذا الفكر لا يعالج الواقع المعاش، ولكنه يبني مجتمعا مثاليا ورجعيا بآن، لا صلة له على الإطلاق لا بالدعوة الإسلامية، ولا براهن المسلمين.
بين هذا الموقف للإخوان والموقف الإسلامي العملي والثوري مسافة واسعة جدا، نتبينها حينما نقارن موقفهم هذا بموقف المفكر والفقيه المسلم ” ابن تيمية ” الذي وقفنا معه آنفا، الذي كان دائما مضطهدا من قبل سلطات المماليك، ـ إلا ما ندرـ حينما صارت المواجهة بين هؤلاء والمغول، وقف مع مضطهديه بحسم وقوة، وعرف أن النزاع والخلاف بين الأمة ممكن، ومقبول، أما النزاع والخلاف على الأمة: وجودا وعدما، فهم النزاع المرفوض كلية، والمنافي للتوجه الإسلامي الحق.
وكان صراع ابن تيمية مع المماليك صراع ضمن الأمة، وقد خاضه إلى أبعد مدى، دفاعا عن رايه، وأصابه على هذا الطريق الكثير، وكان في هذا الصراع دائما صلبا، واضحا، وعنيفا أيضا، أما حينما واجهت الأمة صراعا مع الخارج ” المغول”،ـ وكان هؤلاء يرفعون شعار الإسلام ـ وكانت الأمة هي مادة الصراع، وهدفه، فإنه وقف مع المماليك، بنفس الصلابة والوضوح.
إنه كان يعلم أن هؤلاء “المماليك” لا يطبقون الشريعة الإسلامية، وأن حكمهم مليء بالجور والظلم، ومع ذلك اعتبرهم ـ كما أسلفنا القول ـ راية الإسلام وسنده، لأنه كان يعلم تماما أن انتصار أولئك الغزاة لن يبقي ولفترة طويلة أمة حتى تطبق فيها الشريعة.
وعلى الموال نفسه كان الموقف الحاد حينما وقف مصري إقليمي، يتغنى بمصر، تغنيا تتضح فيه معالم فصل مصر عن الجسد العربي فرد قائلا: …أنا لا أعرف هذا التمييز لجنس أو أرض…. لا تقل إلا العرب، ولا ينبغي أن يدعو مسلم لغير وحدة العرب، والعرب من كان لسانهم باللغة العربية… ولا يقابل العرب إلا العجم…
ويتبين مدى تخلف هذا الفكر لدى الإخوان حينما نقارنه بمواقف مفكرين من أمثال جمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي، في دفاعهم عن الأمة العربية، أو عن الديموقراطية والحرية، أو في موقفهم الاجتماعي. وضوحا وصلابة.
4ـ ويبقى أن نلاحظ أن الفكر الذي يطرحه الإخوان هو فكر انتقائي براغماتي من أفكار الخوارج في التكفير، والشيعة في موقع ومكانة القيادة الدينية، وأهل الظاهر في النظر إلى المسائل الاجتماعية.
** فمن الخوارج: جاءت بدايات فكرتهم حول “جماعة المؤمنين الخاصة”، ثم تطورت حتى كادت تنطبق على ما قاله هؤلاء من تكفير كل المجتمع الآخر، بل وصل الأمر عند متطرفين في تيار الإخوان، ومنشقين عنه، أن أحلوا أموال وأنفس ذلك المجتمع، وقالوا بالهجرة منه، مقدمة للهجوم عليه.
** ومن الشيعة: جاءت نظرتهم للقيادة الدينية “الحزبية عندهم”، ونظرة الشيعة لمسألة وكيل الإمام والقائم بأعماله في فترة الغيبة، وإذا كان الشيعة تميزوا بحرية التفكير والاجتهاد، وبكثير من سمات التفتح العقلي، فإن الإخوان لم يدخلوا هذا الميدان، واكتفوا بإعطاء قيادتهم المكانة المميزة والممتازة، وانحصر فيها حق الفهم والوعي للمسائل الدينية، وحق التحديد والتقدير في المسائل الحياتية، ووصل بهم الأمر إعطاء “حق الحكم بالقتل” لمن يتعرض لجماعتهم.
** ومن أهل الظاهر: جمودهم في النظر بالمسائل الاجتماعية، واكتفاؤهم بالحقوق المقررة نصا في الأموال، دون إمعان النظر بحاجة المجتمع، وأيضا دون التدقيق في شرعية امتلاكهم هذه الأموال أصلا. وكذلك الأمر في قضايا الديموقراطية، والسلطة …. الخ.
وتبدو هذه العناصر” الخوارج، الشيعة، أهل الظاهر” متناقضة، وهي كذلك فعلا، لذلك يفتقد فكر الإخوان المسلمين لسمة التماسك الداخلي المفترض توفرها في التيارات العقيدية.