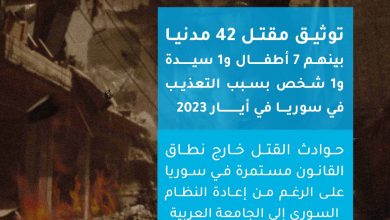الحلقة الثامنة: الإخوان المسلمون ـ محاولة تفسير 4/6
نظرية الحركة
للمرة الأولى في تاريخ حزب الإخوان المسلمين في سوريا ، ينتهج هذا الحزب طريق القوة المسلحة في محاولة منه لحل التناقض بين رؤيته، والواقع، لكن كان قد سبقه في هذا النهج الحزب نفسه في مصر ولأكثر من مرة، ورغم الكثير من الحديث الذي يقول به الجماعة عن ” الجدال بالتي هي أحسن”، والاهتمام بتربية الفرد قبل الشروع في تغيير المجتمع، وعن اعتقادهم الراسخ بأن تطبيق ما يرون أنه ” المنهج الإسلامي” في الحكم والمجتمع غير مطروحة في مثل هذه الظروف ما لم تتهيأ المقدمات الضرورية لذلك، فإن الوقائع تشير إلى أن هذا الحزب مارس أكثر من مرة محاولة حل التناقض بالقوة، فهل هذا السبيل جزء من طبيعة، وبنية الإخوان المسلمين؟ أم أنه أمر عارض، ولدته أحداث معينة، وجاء استجابة لتحد، ولمواجهة، فرضتها ظروف طارئة؟
بعض الباحثين يأخذ بالرأي الثاني، مستندا في ذلك إلى طبيعة القيادات التي مرت على الإخوان، ويعزز استناده بنصوص نظرية عن مكانة العنف في حركة الإخوان، ويرمي القيادات التي دأبت التأكيد على ضرورة المواجهة، وضرورة تغيير الواقع بالقوة، بأنها مجرد تيارات صغيرة في إطار الحركة، لم يكن لها السيطرة على قرار الجماعة يوما ما، بل إن مركز القيادة في الجماعة: المرشد أو مكتب الارشاد، كان دائما يرفض العنف، ويتبرأ منه، ومن القائلين به، والعاملين في إطاره، حتى أولئك الذين يتهمون بهذا المنهج، ويوضعون على رأس القائلين به، فإن موقفهم النظري ضده، ولا يلجؤون إليه إلا اضطرارا، ودفاعا عن النفس.
وإذا كان المرحوم “سيد قطب” يعتبر عند البعض صاحب تيار جديد في جسم الجماعة، وعلى يديه، وعلى فكره، تربت أجيال من الإخوان مارست العنف في أكثر من إقليم وموقف، فإنه ما قال بهذا كمنهج، وإنما دعا إلى الاستعداد لممارسته، دفعا للظلم، وتوقيا منه، وهو الذي حدد تصوراته لمنهج العمل عام 1964 فأقامه على ست نقاط لا تحتوي العنف في صلبها، وهذه النقاط الست هي:
1ـ المجتمعات البشرية بجملتها قد بعدت عن فهم وإدراك معنى الإسلام ذاته، ولم تبعد عن الأخلاق الإسلامية فقط، والنظام الإسلامي، والشريعة الإسلامية.
إذن فإن أي حركة إسلامية يجب أن تبدأ من إعادة تفهيم الناس معنى الإسلام، ومدلول العقيدة الإسلامية، وهو أن تكون العبودية لله وحده، وسواء في الاعتقاد بألوهيته وحده، أو تقدير الشعائر التعبدية له وحده، أو الخضوع والتحاكم إلى نظامه وشريعته.
2ـ الذين يستجيبون لهذا الفهم، يؤخذ في تربيتهم على الأخلاق الإسلامية، وفي توعيتهم بدراسة الحركة الإسلامية، وتاريخ وخط سير الإسلام في التعامل مع كل المعسكرات والمجتمعات البشرية، والعقبات التي كانت في طريقه، والتي لا تزال تتزايد بشدة، وبخاصة في المعسكرات الصهيونية، والصليبية الاستعمارية.
3ـ لا يجوز البدء بأي تنظيم إلا بعد وصول الأفراد إلى درجة عالية من فهم العقيدة، ومن الأخذ بالخلق الإسلامي في السلوك والتعامل، ومن الوعي الذي تقدم ذكره.
4ـ ليست المطالبة بإقامة نظام إسلامي، وتحكيم الشريعة، هي نقطة البدء، لكن نقطة البدء تكون بنقل المجتمعات ذاتها ـ حكاما ومحكومين ـ عن الطريق السالف إلى المفهومات الإسلامية الصحيحة، وتكوين قاعدة، إن لم تشمل المجتمع كله، فعلى الأقل تشمل عناصر وقطاعات تملك إمكانية توجيه ودفع المجتمع كله نحو الرغبة والعمل على إقامة النظام الإسلامي، وتحكيم الشريعة الإسلامية.
5ـ وبالتالي لا يكون الوصول إلى إقامة النظام الإسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية عن طريق انقلاب في الحكم يجيء من أعلى، ولكن عن طريق تغييرات في تصورات المجتمع كله ـ أو مجموعات كافية فيه لتوجيه المجتمع كله ـ وفي قيمه، وأخلاقه والتزامه بالإسلام يجعل تحكيم نظامه وشريعته فريضة لا بد منها في حساباتهم.
6ـ في الوقت ذاته تجب حماية هذه الحركة، وهي سائرة في خطواتها هذه، بحيث إذا اعتدى عليها، وعلى أصحابها رد الاعتداء وما دامت هي لا تريد أن تعتدي، ولا أن تستخدم القوة في فرض النظام الذي تؤمن بضرورة قيامه على الأسس المتقدمة، وبعد التمهيدات المذكورة، والذي لا يتحقق إسلام الناس إلا بقيامه حسب ما يقرره الله وسبحانه، ما دامت لا تريد أن تعتدي، ولا أن تفرض نظام الله بالقوة من أعلى، فيجب أن تترك تؤدي واجبها، وألا يعتدي عليها وعلى أهلها، فإذا وقع الاعتداء كان الرد عليه من جانبها.
ولعل المرحوم “سيد قطب” يشير إلى هذا المنطق صراحة في نهاية شهادته الأخيرة التي أشرنا إليها، وذلك حين يقول: “إن منطق العنف الذي عومل به الإخوان سنة 1954 بناء على حادث مدبر لهم، وليس مدبرا منهم، ـ وهو حادث المنشية ـ والذي عوملوا به وحدهم دون سائر الأفراد والطوائف الذين اتهموا بمؤامرات لقلب نظام الحكم، أو التجسس، أو لغير ذلك، العنف الذي يتضمن التعذيب، والقتل، والتشريد، وتخريب البيوت …هذا العنف هو الذي أنشأ فكرة الرد على الاعتداء ـ إذا تكررـ بالقوة”.
بعيدا عن تناقضات في طبيعة الحركة ومنهجها يحتويها هذا التصور، فإن من الواضح أنه يؤكد أن سبيل الحركة إلى النصر هو كسب العقول والقلوب، قبل أو بدون النظر إلى إحداث التغيير بالقوة، والأخذ بالإقناع سبيلا لردم الهوة بين ما يعتقدونه صحيحا، وما هو جار في حياة الناس ومجتمعاتهم، وهو منهج قريب الشبه بذلك الذي قال به “عبد الحكيم عابدين” حين حدد قواعد التعامل بين الإخوان وثورة يوليو أو أي حكم آخر….. فهل هو فعلا منهج الإخوان في الحركة؟
قبل البدء في تحليل وتحديد منهج الإخوان في عملية التغيير لا بد من التقديم بملاحظتين أساسيتين:
الملاحظة الأولى: أنه على الرغم من تعدد الشخصيات التي تسلمت موقع ” المرشد العام”، وبالتالي تباين طبائعها وميولها، فإن ظاهرة استخدام ” القوة”، أو الرد بها، استمرت كمنهج غير متأثر كثيرا بتغيير شخصية المرشد العام، وإذ يعتبر البعض أن ” سيد قطب” هو رائد العنف في تيار الإخوان المسلمين، فإن الأمر عنده لا يعدوا ضبط وتوجيه الأدوات القائمة، والأفكار الراسخة، فهو لم يخترع مفاهيم جديدة، وإنما أعاد صياغتها بشكل أكثر نضجا، وفاعلية، وكان فيما عمله متجاوبا مع الظروف الجديدة، حيث السلطة تحكم قبضتها بشدة.
الملاحظة الثانية: أن الأقاليم العربية التي لم تشهد اتجاه القوة والعنف لدى الإخوان في بداية مسيرتهم، لم تلبث أن لحقت بهذا الاتجاه، ولا نجد تفسيرا لذلك غير النظر في ظروف هذه الأقاليم، والقيم العامة التي كانت تسود الحياة السياسية، وإذ يدخل الاخوان المسلمون في سوريا ضمن هذا الاستثناء في بداية حياتهم، فإن تفسير ذلك يعود كما أشرنا إلى ظروف الإقليم السوري آنذاك.
وأيضا قبل البدء في تحليل منهج الحركة عند الاخوان لابد من التأكيد أن استخدام القوة لا يعتبر أسلوبا مدانا بحد ذاته، ذلك أن أي قوة سياسية موجودة أصلا حتى تطبق مبادئها، وسياساتها، وسبيلها إلى ذلك ” السلطة”، أي استلام الحكم، فإن استخدام القوة أمر محتمل، ولا يمكن إدانته إلا إذا جاء من غير تبرير:
**كأن تكون تقاليد المجتمع تتيح انتقال السلطة بأسلوب ديموقراطي، فيبتعد هذا الحزب أو ذاك عن الطريق الديموقراطي، ليفرض سلطته بقوة السلاح.
**أو يكون استخدام القوة للدفاع عن النفس، وليس للدفاع عن المبادئ والسياسات، أي حينما يصبح الفكر، وجهاز التنفيذ، “المبدأ والأداة”، على نفس القدر من الأهمية، فلا يعود لأي مبدأ معنى إلا إذا جاء عن طريق الأداة نفسها.
**أو أن يأتي استخدام القوة بغرض توريط” الناس” في الصراع، وفتح المجال لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
وإذا كان واضحا لأي متبصر في تاريخ الإخوان ألا علاقة لهم البتة بقضية الديموقراطية الليبرالية، فإنه من المهم أن ننظر في حقيقة استخدام السلطة عندهم وأصولها.
فكرة الإسلام هي في الأصل فكرة قوة، هذه حقيقة لا مراء فيها، والعلاقة بين الإسلام والدولة علاقة متينة لا ينكرها إلا جاهل، وإذا كان القول بدينية السلطة قول ضعيف فيه جدل متسع، فإن للسلطة دوما علاقة وطيدة بأهداف الدين ومقاصده، ومقاصد الشريعة الإسلامية لابد لها من أداة لتحقيقها، وسلطة الدولة هي الأداة.
وقد يحدث خلل ما في قيام سلطة الدولة بهذه المهمة، أو يحدث فيها انحراف، وقد تباينت آراء الفقهاء حول أسلوب التصرف إزاء هذا الوضع، وإذا كنا في غنى الآن عن الخوض في غمار هذه الآراء، فإن ما يهمنا هنا أن ننظر في موقف الإخوان.
من حيث المواقف، فإن الإخوان المسلمين يرون أن معظم القوانين القائمة لا تنافي قواعد الشريعة الإسلامية، وحتى ما يتصل بإنفاذ قواعد القصاص في الإسلام فقد اعتبروه من إجراءات” الوقف” التي يحق للحاكم أن يأخذ بها وفق الظروف التي يمر بها المجتمع، واعتبروا العقوبات البديلة والأخرى من باب “التعزير” وهو حق صرف للحاكم.
لكن بنية الإخوان: فكرهم، وأجهزتهم، وعلاقاتهم، لا تشير إلى تمثلهم وصدقهم في هذه المواقف النظرية، وسوف نلاحظ هذا الأمر ونحن نتابع هذه البنية وتفاعلاتها في واقع الحياة:
1ـ لقد وحد الإخوان بين تنظيمهم ودعوتهم، وبين الإسلام. وإذا كانوا قد مثلوا في البدء دور ومكانة الدعاة والمرشدين، فإنهم ما لبثوا أن مثلوا دور ومكانة “مجتمع المؤمنين” في مواجهة “المجتمع الجاهلي”. وكان من أهم ما تخلف عن هذا الوضع أنهم سلبوا الناس، كل الناس إيمانهم وإسلامهم، وأصبح جواز هذا الإيمان والإسلام متعلقا برأي الاخوان، وهنا لم يعد الأمر دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما تجاوزها إلى أبعد من ذلك بكثير، فصار للناس كلهم “شيء ما” في دعوة الاخوان المسلمين، يصارعونهم عليه، أو يحالفونهم فيه.
بشكل مبكر جدا تمت الإشارة الى هذا المعنى، ففي محاكمات الإخوان المسلمين عقب محاولة قتل الرئيس جمال عبد الناصر يتحدث “محمود الحكواتي”، أحد عناصر الإخوان، عن صفة الإخوان المسلمين: هل هم جماعة إرشاد، أم هم تمثيل لجماعة المؤمنين؟ وكان واضحا في ذلك الحين أن الأمر غير محسوم، يقول الرجل: “كل من خرج على جماعة المؤمنين جزاؤه القتل في الإسلام. وجماعة الاخوان ليست جماعة المؤمنين، بل جماعة كجماعة إرشاد، وبالتالي فالخارج عليها لا يقتل…..، هذا التفكير لم يكن واضحا لدى النظام القديم (ويقصد هنا التنظيم السري بقيادته السابقة)”، لكن هذا الموقف يحسم تدريجيا، وتستقر الجماعة على اعتبار نفسها “جماعة المؤمنين”، ويعتبر المرحوم سيد قطب، القمة في هذا التفكير على الساحة العربية.
وإذ يفسر هذا “التوحيد، والتطابق” بين جماعة الاخوان وجماعة المؤمنين شدة تماسك تنظيم الإخوان، وروح التعاطف الابتدائي معهم من قبل الجمهور، فإنه في الوقت نفسه يفسر سرعة انهياره، وتبدد هذا التعاطف.
إن هذه الفكرة القادرة على الدفع بالمؤمنين بها إلى أي موقف دون تردد، ما دامت النتيجة محددة بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، هي نفسها تسقط هذا الاندفاع الحاسم مرة واحدة حينما يتبين لأتباعها دينيا أنهم ليسوا كذلك، وأن عمليات القتل هذه قد تودي بصاحبها إلى الخلود بجهنم.
ولا يزال الإخوان في مصر يذكرون بألم شديد الأثر البالغ للبيان الذي أصدره المرشد العام الشيخ حسن البنا في أعقاب اغتيال “النقراشي باشا” رئيس الوزراء المصري بأن منفذي العملية “ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين”.
2ـ كذلك أعطى هذا “التوحيد” بين جماعة الاخوان وجماعة المؤمنين مكانة خاصة للقيادة ممثلة بالمرشد العام، ولم تقتصر هذه المكانة على المرشد وحده، وإنما أصبحت كل قيادة تأخذ هذه المكانة المميزة، أياً كانت درجة تسلسلها التنظيمي.
وإذا ركزنا النظر على موقع القيادة العليا “المرشد العام”، فإننا نراهم قد أنزلوه منزلا هو أقرب إلى منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، إن لم يكن متميزا عليهم، هذه المكانة آتية بالتسلسل المنطقي، فإذا كان هؤلاء هم” جماعة المؤمنين”، في بحر الجهالة، والمجتمع الجاهلي، فإن قائدهم هو إمام المسلمين، وإمام المؤمنين وقائدهم.
وإذ وضحت هذه المكانة في التعامل مع نموذج “الشيخ حسن البنا” فإنها لم تعدم في غيره، وإن لم يتح لها الوقت لتأخذ أبعادها كاملة…. ولم تكن هذه المكانة نوعا من “الإجلال”، الذي يسبغه الأتباع على قائدهم، وإنما هي أيضا حالة تعبر بدقة عن قناعة هذه القيادة بنفسها ومكانتها، فهي تعتقد لنفسها ب “إمامة المسلمين”، وأتباعها يعتقدون ذلك، وحتى نتبين نظرتهم هذه إلى مرشدهم العام، ونظرة المرشد العام لنفسه، ومكانته، لنتابع حدثا يرويه لنا عن الشيخ حسن البنا، الأستاذ “محمود عبد الحليم” في مذكراته، وهو حديث طويل، ولكن إيراده كاملا كفيل برسم هذه الصورة بوضوح، يقول الرجل:
“حدثني مرة ـ ويقصد الشيخ حسن البنا ـ أنه قرأ في كتاب، سماه لي وقتها ـ ولكني نسيت اسمه الآن ـ أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل، وشكا له أن أخاه تنتابه حالة يفقد فيها وعيه، ويمزق ملابسه، ويهاجم من حوله، ويريد أن يفتك بأقرب الناس إليه، وقال: إنه عرضه على الأطباء حتى يئسوا منه، ولا يدرون ماذا يفعلون…. وكان الإمام أحمد بالمسجد، فقال للرجل: أحضر أخاك، وهو في هذه الحال، فلما أحضروه أمره أن يرقد ثم أخذ الإمام يقرأ القرآن حتى سمع الجميع صوتا منبعثا من جسم الرجل المريض، يستغيث بالإمام، ويقول له: حسبك، سأفعل ما تريد. فقال الامام: دع هذا الرجل واخرج من أصبع قدمه، قال الصوت: سمعا وطاعة، وخرج من أصبع الرجل، وإذا بالمريض يستيقظ كأنما حل من عقال، وكأنه لم يكن مصابا من قبل.
قال لي الأستاذ: وقد شغلتني هذه القصة وأنا أتأهب ـ حسب جدول زياراتي ـ لزيارة إخوان السويس، وركبت القطار، وظللت طيلة الطريق أفكر في هذه القصة وأتعجب لما فيها. وأقول: أهو سر الإمام أحمد، أم هو سر القرآن؟ أم أن القصة فيها مبالغة!… ولم تزل هذه الأفكار تراودني حتى وصل القطار محطة السويس، ونزلت من القطار، فوجدت الإخوان مجتمعين في انتظاري، فعانقتهم، ولاحظت أن واحدا منهم كان يقف وحده بعيدا، فقربت منه، فرأيت على وجهه أثر الحزن، فتركت الإخوان وانتحيت به جانبا، وسألته عما يحزنه، فقال لي: إن الذي يحزنني أمر خطير، وإني قد ضقت ذرعا بالحياة، وسدت أمامي الطرق، وأحاط بي اليأس من كل جانب…. إن زوجتي امرأة صالحة مطيعة، ولي منها أبناء صغار، وقد اعتراها منذ عام مرض ينتابها بين الحين والحين، تفقد فيه رشدها، وتتحول إلى وحش كاسر، إذا استطاعت الوصول إلى أي منا حاولت قتله، وتحطم كل شيء أمامها، …. وقد عرضتها على الأطباء هنا، وفي القاهرة حتى يئسوا…. وقد انتابها المرض اليوم، ولما كنت أعلم بقدومك اليوم، أدخلتها حجرة أغلقتها عليها، وجئت أنتظرك لأعرض عليك مصيبتي لعلك تعينني فيها…
يقول الأستاذ لي: فابتسمت، والأخ لا يعلم لماذا أبتسم..، وتذكرت قول إبراهيم عليه السلام ” رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من لطير فصرهن إليك..” الآية. قال الأستاذ: قلت له، هيا بنا إلى البيت، واستأذنت من الإخوان، ودخلنا البيت، ودخلنا الحجرة المغلقة، فرأيت امرأة فيها، فقلت له: ادخل غطها تماما بملاءة، بحيث لا يبين منها شيء، ففعل، ثم دخلت الحجرة، ووقفت بجانب السرير، وأغمضت عيني، وأخذت أقرأ القرآن، وظللت أقرأ حتى سمعت صوتا ينبعث من جسم المرأة، لكنه صوت رجل يقول: كيف تكون يا بنا “إماما للناس” وتنظر إلى عورات النساء، ففتحت عيني فرأيت جزءا من ساق المرأة قد انكشفت، نتيجة ما ينتابها من حركات عنيفة… فأمرت زوجها فغطاها، ثم واصلت قراءة القرآن، حتى سمعنا صوت الرجل المنبعث من جسد المرأة يقول في نغمة استعطاف : “إنك إمام المسلمين“، وتريد أن تحرقني وأنا مسلم!.. قال الأستاذ: إن كنت مسلما فلماذا آذيت مسلمة…. قال : وماذا تريد مني؟ قلت: دع هذه المرأة واخرج. قال: أمهلني.. فواصلت القراءة. فقال بعد قليل: استحلفك بالله إلا أمسكت عن القراءة، حتى لا أحترق، وسأخرج. قلت إن كنت خارجا فاخرج من إصبع قدمها فأراد أن يساوم، فواصلت القراءة، فصرخ مستغيثا، وخرج من إصبع قدمها، فقامت المرأة كأنما حلت من عقال، وكأن لم تكن أصيبت من قبل”.
هذه الرواية، وبغض النظر عما يمكن أن تثيره من تساؤلات، فإننا عرضناها كنموذج لمدى اقتناع المرشد العام بأنه ” إمام الناس، إمام المسلمين”، وهو اقتناع حاسم جازم رواه الأستاذ البنا نفسه على لسان ذلك “الجان” الحال في جسد المرأة المريضة. وكنموذج لنظرة “الأتباع” للمرشد العام، والمكانة التي أنزلوه بها، هذه “المكانة، المنزلة”، ليست غريبة، ولا شاذة، لأننا ونحن ننظر إليها يجب أن نضعها في إطار الفكر العام لهم، حيث هم جماعة “المؤمنين”، فمن الطبيعي أن يتخذ إمامهم هذه المكانة الفريدة، والمميزة، ويبدو غير ذلك شاذا، ومخالفا للطبيعة عندهم.
3ـ وما دام هذا التوحد بين التنظيم والهدف قائما فإن من الطبيعي أن يبني التنظيم أداة تحميه، وقد بنيت هذه الأداة تدريجيا حتى أصبحت بمثابة جيش خاص بها، هدفها الأصيل حماية الجماعة، وإنفاذ أهدافها، وإذا كان السؤال الطبيعي: الحماية ممن؟، فإن الإجابة واضحة، الحماية من كل ما هو خارج عن الجماعة، خصومها، وحلفاؤها على السواء، حتى أولئك الأعضاء الخارجين عليها.
إن دور التنظيم الخاص بالنسبة للجماعة هو تماما كدور الأمن السياسي، ووحدات حماية الرئاسة في كل سلطة أو نظام، لذلك جاء التنظيم الخاص ككيان سري قائم بذاته، يخضع للجماعة عن طريق قناة محددة ومتصلة بالرئيس الأعلى.
بهذا التصور يصبح التنظيم كله، بجهازيه ” العام والخاص” حالة منعزلة عن المجتمع، وتعمل فيه، حالة خاضعة لقوانينها الخاصة، وأي تدخل بهذه القوانين هو اعتداء على الجماعة، وهو اعتداء يتطلب الرد.
حينما “اعتدى” قاض على أفراد من الجماعة، ردوا على هذا الاعتداء بقتله، كان اعتداؤه أن ارتضى النظر في قضية متفجرات متهم فيها عدد من الإخوان، ووفق هذا النظر أصدر القاضي قراره بالسجن على أولئك، وقد اعتبر الإخوان هذا الحكم اعتداء عليهم، فردوا على ذلك بإصدار قرار بقتله، وهكذا سقط أحمد الخازندار رئيس محكمة الجنايات.
وحينما سقطت بالصدفة أوراق وملفات تكشف خبايا ” التنظيم الخاص” بيد السلطة، فإنهم اعتبروا وقوع هذه الوثائق اعتداء عليهم، فوجهوا سيارة مليئة بالمتفجرات لتزيل “دار القضاء العالي”، الذي يحتوي في بعض أدراجه هذه الوثائق، دون النظر إلى ما يمكن أن يؤدي إليه هذا التفجير من فواجع، وكذلك الأمر مع “محمود فهمي النقراشي” حينما أمر بحل الجماعة، ومع جمال عبد الناصر حينما اصطدم بهم.
ولأن للتنظيم الخاص هذه الطبيعة، فإنه يجعل استخدامه خارج هذا الإطار ـ حماية الجماعة ـ استخداما رمزيا، ويعوض عن هذا الرمزية التنظيم العام نفسه، فحينما جاء وقت الجهاد في فلسطين، فإن القسم الأكبر ممن ساهم فيه كان من التنظيم العام، وإذ احتاج هؤلاء إلى التدريب والإعداد ـ لأن التنظيم العام غير مدرب ـ فإنهم اعتمدوا على السلطة في التدريب وإعداد المتطوعين، ودفعوا بهم مع القوات النظامية.
4ـ وإذ تمتلك “جماعة المؤمنين” القوة، فإنها مدعوة لاستخدامها انفاذا لمبادئ المؤمنين وأهدافهم، ويصبح أمر استخدام هذه القوة مجرد توقيت وظروف لا أكثر.
لقد منعت جماعة المؤمنين الأولى “صحابة الرسول الكريم رضوان الله عليهم” من استخدام القوة إبان الفترة الأولى للدعوة، لكن ما إن صارت على قدر معين من القوة، وانتشرت الدعوة، حتى جاء توجيه الله جل وعلا باستخدام القوة” إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن الله على نصرهم لقدير ….”، وهذا هو وضع جماعة الإخوان، في المرحلة ألأولى سلم وموادعة، وحتى إذا امتلكوا القوة، فهم مدعوون إلى استخدامها تماما كما في سيرة الدعوة الأولى، وليس فيما نقول أي قدر من التحامل على موقف الجماعة، أو على دينامية استخدام القوة لديهم، ذلك أن البنا سبق وأن حدد هذه الدينامية في مقال نشره في مجلة النذير الأسبوعية في مايو 1938، وفيه يقول: “منذ عشر سنوات بدأت دعوة الاخوان المسلمين خالصة لوجه الله، مقتفية أثر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، متخذة من القرآن منهاجها، تتلوه، وتتدبره، وتقرأه، وتتفحصه، وتنزل على حكمه، وتوجه أنظار الغافلين عنه من المسلمين، وغير المسلمين,…هذه المرحلة من مراحل الإخوان التي اجتزناها بسلام وفق الخطة الموضوعة لها، وطبق التصميم الذي رسمه توفيق الله…. والآن أيها الإخوان، قد جاء وقت العمل، وآن أوان الجد، ولم يعد هناك مجال للإبطاء، فإن الخطط توضع، والمناهج تطبق، ولكنها لا تؤدي إلى غاية ولا تنتج ثمارها، … سننتقل من دعوة الكلام فحسب إلى دعوة الكلام المصحوبة بالنضال والأعمال، سنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلد، وزعمائه، ووزرائه، وكافة حكامه، وشيوخه، ونوابه، وأحزابه، وسندعوهم إلى منهاجنا، ونضع بين أيديهم برامجنا،… فإن أجابوا الدعوة ، وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرناهم، وإن لجأوا إلى المواربة…. سنعلنها خصومة لا سلم فيها، ولا هوادة، حتى يفتح الله بيننا بين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين،….لسنا في ذلك نخالف خطتنا، أو ننحرف عن طريقنا… فلا ذنب لنا أن تكون السياسة جزءا من الدين، وأن يشمل الإسلام الحاكمين والمحكومين، فليس في تعاليمه: أعط ما لقيصر، لقيصر، وما لله، لله، ولكن من تعاليمه: قيصر وما لقيصر لله الواحد القهار”.
5ـ ومن طبائع هذا التفكير أن تمثل القوة الرئيسية في المجتمع عدوا رئيسيا له، ويرتبط معنى القوة الرئيسية، ومواقع وجودها، بهدف هذا التفكير وتوجهه، وأهدافه في كل مرحلة.
إن دعوتهم موجهة إلى الناس أساسا، وبالتالي فإن من يمتلك الاتجاه العام للناس يكون في الحقيقة قد وضع نفسه في موضع استجلاب عداء الإخوان له، وسيبقى هذا معيارهم الأساسي حتى تصبح قوتهم جاهزة لاستلام السلطة، حينذاك تصبح السلطة هي العدو الرئيسي.
نلحظ هذا الجانب الحركي المنعكس من نظرية القوة لديهم في عدائهم المستمر للوفد في مصر، ثم في عدائهم المستمر والمتصاعد لجمال عبد الناصر، ولقد لخص الأستاذ البشري هذا المنحى الحركي عند الإخوان المسلمين بدقة وهو يتحدث عن علاقتهم بالوفد حين قال: “وقد يكون الوفد على رأس من يعاديهم الإخوان، لا لأنه الأبعد عن الإسلام، ولا لأنه الأعظم أخذا من الغرب، ولكنه لأنه الأعظم شعبية، والأقوى في تحديه لدعوة الإخوان”.
إن القضية إذن ليست موقفا مبدئيا من هذه القوى، وإنما موقف حركي في الأساس، لم يكن حلفاؤهم في السلطة ـ أحزاب الأقلية ـ هم الأقرب إلى الإسلام من الوفد، ولا الأبعد منه عن الغرب، ولكنهم كانوا هم الغرب نفسه في صورته المكثفة والمشوهة في مصر، لكن لم تكن لهؤلاء الحلفاء قوة حقيقية، كانوا مجرد وجود مصطنع يستند إلى سلطة القصر والاحتلال، ولم يكن لهم بين الناس من تأثير، أما الوجود الفعلي المستند إلى القوة الجماهيرية فقد كان من نصيب الوفد، لذلك استحق منهم العداء الدائم.
ويبدو أن الملاحظة نفسها التي رصدها البشري في علاقة الاخوان مع الوفد تصدق في علاقتهم بثورة يوليو، فلو بقيت هذه الثورة مجرد قوة في السلطة، ما لقيت منهم هذا العنف والعداء.
هذا هو الأساس ” الحركي ـ العقدي” لاستخدام القوة في مواجهة الخصوم، والحلفاء على السواء، وهدفهم واحد، هو إرغامهم على الأخذ بما تراه الجماعة، ومن هنا نفهم لماذا منهج الإخوان كان باستمرار رفض التحالف مع القوى الشعبية، ونفهم أيضا دواعي قبولهم للتحالف في بعض الظروف.
أما أنهم يرفضون التحالف فالسبب الأصيل عندهم كامن في تصورهم ل” جاهلية الآخرين”، ولا يؤثر على هذا الحكم أن الناس في غالبيتهم يقفون مع هذه القوة أو تلك، ” الوفد، عبد الناصر”، أو يقفون ضد هذه القوة أو تلك ” صدقي، النقراشي، السادات، النميري”، فهؤلاء ضمن إطار مجتمع جاهلي، والإخوان المسلمون وحدهم” جماعة المؤمنين” من يحدد “مجتمع الجاهلية”.
ولا يقبلون التحالف إلا وهم في حالة ضعف وعجز عن تحقيق أهدافهم، أو عن صيانة وجودهم التنظيمي، وهكذا جاءت علاقة التحالف الاستثنائية مع الوفد، وهكذا نفهم علاقتهم مع الثورة في مرحلتها الأولى، وأيضا دعوتهم إلى العمل الجبهوي في سوريا بعد أن رفضوها أمدا طويلا.
ومن هنا نفهم أيضا رفض الإخوان المسلمين لحرية الأحزاب، وللديموقراطية، الليبرالية كما عرفت، ذلك أن الديموقراطية تعني قدرة الأحزاب على الوصول إلى السلطة سلميا، والاحتكام إلى الناس في تحديد فترة المكوث، والخروج من السلطة، وهذا يتنافى مع أصول فكر الإخوان.
ولا يعود هناك من معنى لقولهم بالدفاع عن الديموقراطية، فإن فكرهم هنا ليس من ثوب هذا الشعار، ولا يعود هناك أي معنى فعلي لدفعهم “تهمة” استخدام القوة، واعتبارهم أن استخدامها جاء ردا على ما أصابهم من محن، ذلك أن العرض التاريخي من جهة، وعرض منطقهم من جهة أخرى لا يدع مجالا لمثل هذا الدفع.