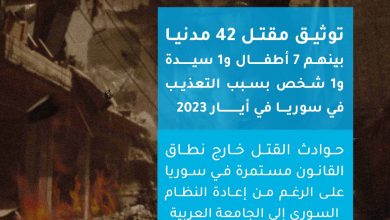الحلقة السابعة “البرنامج السياسي، وقفة حاسمة في حياة الحزب” 3/6
تاريخ الحزب
والقصد بتاريخ الحزب هنا تحديداً: مواقف الحزب، وفكره، إزاء القضيتين السابقتين: الوحدة، وفلسطين، وعبر هاتين القضيتين سوف نلحظ العديد من التفريعات سواء في إطار التحالفات الاجتماعية، أو في إطار حركة التغيير الاجتماعي. والتي لا يمكن فهمها إلا من خلال هاتين القضيتين تحديداً.
وأيضاً حينما ننظر إلى تاريخ الحزب تجاه: الوحدة وفلسطين فإننا لا نقصد رؤية غير الشيوعيين لمواقف الحزب الشيوعي، سواء كان هذا الغير: المنشقين عن الحزب الشيوعي. أو أولئك المتمايزين والمتناقضين مع الفكر الشيوعي، فمثل هؤلاء وأولئك كتبوا كثيراً في هذا التاريخ، وسواء كانوا قد أصابوا، أو أخطأوا، فيما ذهبوا إليه فإنها على الوجهين ستبقى رؤيتهم. رؤية من خارج الحزب، المهم عندنا أن ننظر في رؤية الحزب نفسه لهذا التاريخ، ورؤية كوادره وقيادته الرئيسية.
في نص البرنامج، فإن هناك إشارة خفيفة جداً، وعابرة إلى هذا التاريخ، وقد تعمد واضعوا البرنامج أن يجعلوها في مقدمة البرنامج، وليس في داخله، أو تحت فقرة أو عنوان خاص. وجاءت هذه الإشارة في سياق عام حين أكد البرنامج أن الحزب الشيوعي “يضع برنامجه الكفاحي هذا مستنداً إلى كل ما في تجربته الثورية من انتصارات، وإخفاقات، ومن نجاحات، وأخطاء”. وغير هاتين العبارتين “الإخفاقات، والأخطاء” فلا يوجد شيء آخر يمس هذا الجانب. ويبدو أن هذه الفقرة من الفقرات التي أشرنا إلى أنها صيغت “صياغات دقيقة وحرجة”. وكان الهدف من هذه الصياغة تجنب إثارة المزيد من المشاكل، أمام هذا المشروع، إضافة إلى طبيعته ذاتها التي ليس من شأنها أن تحتوي نقداً عاماً لتاريخ الحزب.
إلا أن هذا البرنامج، وقد صار فجأة محور الصراع في الحزب، لم يعد يحتمل مثل هذه الصياغات الحرجة، لذلك جاءت المناقشات، والكلمات، ومداخلات قادة الحزب وكوادره لتكشف هذه الإخفاقات والأخطاء، ولتعطيها حجمها الحقيقي، وواضح لكل من يراجع تطور أزمة الحزب أن المحاولات لتجاوز هذه الأزمة كانت جادة ومخلصة، وهي التي دفعت إلى تلك الصياغات الحرجة، ولولا أن الأقلية رفضت الانصياع إلى مبادئ العمل الحزبي، وخرقت المركزية الديموقراطية، وراحت تعمل في إطار محاور وتكتلات لبقيت تلك الصياغات في حدودها، ولتولت حركة الحزب، وتطوره. تحقيق التجاوز العملي لأخطاء الماضي، والتثبيت العملي أيضاً للقناعات المتفتحة. ومن هنا نلاحظ أن الوقوف العيني على تاريخ الحزب، تطور نحو مزيد من الكشف والتشخيص، كلما تطورت الأزمة نحو مزيد من التعقيد، وكلما كشفت عن نفسها باعتبارها حركة انشقاق.
إن قضية فلسطين، وقضية الوحدة العربية، وما يتبعهما ويتفرع عنهما، في الحقيقة ذات جوهر واحد، والخلاف حولهما ينطلق من الاختلاف في تعيين زاوية الرؤية لهاتين المسألتين ومن ثم تحديد مهمة الحزب ذاته تجاههما.
وإذا كانت القوى الثورية العربية نظرت دائماً باستغراب إلى موقف الأحزاب الشيوعية، – وهنا الحزب الشيوعي السوري – من هاتين القضيتين، واعتبرت هذا الموقف غير مفهوم، وغير مبرر، فإن الطرح الذي صاحب البرنامج السياسي قد كشف بوضوح أن الحزب الشيوعي كان يعيش هذه القضايا، وكان يتفاعل معها، لكن ظرفه الخاص قد حال دون تمكنه من جعل هذا التفاعل إيجابياً علنياً.
محاور الخلاف:
عبر كل الكلمات، والمداخلات، التي صاحبت أو لحقت هذا البرنامج. والتي اختتمت أخيراً بانقسام الحزب الشيوعي السوري. فإن محورين أساسيين وضح تشكلهما وضوحاً لا يخفى على أحد. ولم يكن خافياً أبداً على قيادات الحزب وكوادره.
- كان هناك من وقف خلف هذا البرنامج، وعمل على إقراره، وأراد أن يثبته كبرنامج سياسي للحزب، كأهداف رئيسية في مرحلة ممتدة من الزمن. ويحدد بالطبيعة، المسالك التي يجب على القيادة أن تلتزم بها في تلك المرحلة، وأن تعيد رسم دورها في الحزب، وحركة الحزب ذاته، على ضوئها.
- وكان هناك من لحظ أن هذه الوثيقة هي تعبير عن اتجاه الأغلبية الساحقة في الحزب، فاضطر إلى الموافقة عليها مناورة، وليس اقتناعاً، انتظاراً للفرصة المناسبة للانقضاض على البرنامج كله، ونسفه من أساسه، وإعادة الحزب إلى عهده السابق، وخطه القديم، هذا الاتجاه إذ اضطر إلى الموافقة على مشروع البرنامج بداية، فإنه كان يرى فيه خطرين اثنين:
الأول: خطر يتمثل في نتائج توجيه الحزب نحو اتجاه يحقق له فاعلية قومية، ويحوله من حزب نخبة، إلى حزب جماهيري يدفع بحركة الوحدة العربية، ويندفع معها ليس فقط في اتجاه النضال من أجل إقامة دولة الوحدة، وإنما في اتجاه النضال لنظم مختلف القضايا المطروحة، والتي يمكن أن تطرح، بالناظم “القومي – الطبقي”. وبرزت هنا كل مخاوف الأقليات القومية التي بقيت تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة الحزب طوال الفترة السابقة.
والثاني: خطر يتمثل في خضوع الحزب كله: مؤسساته، وقياداته، وأفراده، إلى قواعد الماركسية – اللينينية في التنظيم، وهي القواعد التي تجعل من مبادئ المركزية الديموقراطية ناظماً لحركة الجميع. أي أنها ستفتح الباب واسعاً لتصحيح هيمنة القيادة التاريخية للحزب على مقدراته، وبالتالي إخضاعه أكثر للفهم المتنامي حزبياً لاحتياجات الواقع، وللمدركات الحسية التي تكشف عنها حركة الحياة العربية نفسها. وهي كلها تصب في اتجاه الإرادة العامة للأغلبية القومية.
إن الخطرين معاً، يعنيان تحول الحزب الشيوعي، إلى حزب شيوعي عربي، مرتبط فعلاً بواقع الأمة، وبآفاقها، يبدو أن هذا الأمر لم يخطر يوماً على بال القيادة التاريخية.
لتوضيح حقيقة هذين الاتجاهين، لابد أن نعرف الموقف الأولي لقيادة الحزب الشيوعي من مشروع البرنامج، وكيف تطور هذا الموقف بعد ذلك.
في مداخلته المركزة يتحدث “بدر الطويل” عن الموقف الأولي من البرنامج فيقول: “إنكم تعرفون أيها الرفاق ولا شك أن الذي صاغ مشروع البرنامج هذا، والذي ُشتم ويشتم منذ زمن هم خمسة رفاق: أبو عمار “خالد بكداش”، دانيال، مراد يوسف، موريس، والداعي، وهؤلاء الرفاق هم من صاغ الصياغة الأولى. وجرى نقاش واسع حوله، فكرة فكرة، وجملة جملة! وكنا نعرف بعضنا وما بيننا من اختلاف في وجهات النظر حول العديد من القضايا، وكل رفيق منا سعى جهده للدفاع عن وجهات نظره واقتناع الآخرين بها. بعد الصياغة الأولى عرض على المكتب السياسي، ثم عرض على اللجنة المركزية، فناقشته، وصاغته. وهو بين أيديكم بعد المناقشة وإدخال العديد من التعديلات، وافقت اللجنة المركزية عليه بالإجماع ما عدا التحفظ الذي وضعه الرفيق خالد على شعار الحزب العربي الموحد، ومصدر تحفظ خالد كان يدور حول: هل ينبغي أن يوضع الشعار في المقدمة، أم يبقى في فصل الوحدة. ورفضت اللجنة المركزية تحفظ خالد وأقرت وضعه في المقدمة. وإبقاء الصيغة الواردة في فصل الوحدة”.
ويكشف ظهير عبد الصمد في كلمته بعضاً من جوانب صورة التعامل مع المشروع، وكيف بدأت المواقف تتغير، وتتبدل، دون أن يكون لهذا التغيير أساس فعلي في حياة الحزب. فيقول: “إن اللجنة المركزية في أكثر من اجتماع قد درست هذا المشروع بهذا الشكل؟ واتفقت على كل مواده ونصوصه، وأقرته بالإجماع. واللجنة التي كتبته وصاغته كانت برئاسة الأمين العام وعضوية عدد من أعضاء المكتب السياسي، والسكرتاريا، واللجنة المركزية، والمستغرب أن بعض أعضاء هذه اللجنة يقفون من المشروع موقفاً غير طبيعي، ويعارضون أقساماً هي من صياغتهم؟
إن المشروع أقر بالإجماع باستثناء نقطتين تمت تسوية حولهما هما:
1ـ الفقرة التي تتحدث عن الحزب الشيوعي العربي في مقدمة المشروع، بعض الرفاق كانوا يرون ضرورة حذف هذه الفقرة وإبقائها في فصل الوحدة العربية، أي أن هناك إجماعاً في اللجنة المركزية على وجود فكرة حزب شيوعي عربي في فصل الوحدة العربية، والخلاف كان على مكان وجود هذه الفكرة، لا على وجودها.
2ـ الفقرة التي تتحدث عن إزالة المؤسسات الصهيونية. إن هذه الفقرة الموجودة في مشروع البرنامج وضعت بهذا الشكل بعد بحث طويل، وتم الاتفاق بالإجماع على النص الموجود في المشروع، وفسر هذا النص بعض الرفاق بأنه يمكن دولياً أن يقال: المقصور بهذا النص هو إزالة آثار العدوان، وداخلياً يمكن أن يقال المقصود هو تحرير فلسطين، أي بكلمة أن هذه الفقرة لم تكن موضع خلاف، وأقرت بالإجماع”.
ويستكمل أحمد فايز الفواز رسم صورة الجدل حول هذه الفقرات، ويعرض نمطاً محدداً في كيفية التعامل مع الفقرة السابقة الخاصة بالقضية الفلسطينية، يقول الفواز:
“وعندما اتفقنا على الصيغة الموجودة في المشروع حول القضية الفلسطينية، سأل أحد الرفاق، الرفيق خالد بلهجة التوكيد، هذه الصيغة تعني التحرير.. تحرير فلسطين! .. تعني تثقيف الحزب بروح التحرير! .. وأجاب أبو عمار: في داخل الحزب نعم: أم في الميدان الدولي، فلا”.
إن أحداً من قيادات الحزب في كل الكلمات التي ألقيت والمداخلات التي قدمت، لم ينكر حقيقة أن مؤسسات الحزب وافقت كلها على “مشروع البرنامج”. ومع ذلك فإن الحزب وقع في فخ الانقسام. وصار هناك بداية حزبين شيوعيين! وهكذا تتكشف إلى حد بعيد آلية الروح الانقسامية. كيف تنمو وتفعل فعلها.
لقد استخدم التكتل، وتجميع الأنصار، من قبل الأقلية التي وقف على رأسها الأمين العام خالد بكداش من أجل تعطيل إقرار هذا المشروع، وحينما تأزمت الأمور إلى درجة باتت تهدد وحدة الحزب، تم اللجوء إلى الاتحاد السوفياتي ليضع ملاحظاته العلمية والسياسية على المشروع، للاسترشاد بها في ترشيد عملية الجدل داخل الحزب، واشترط السوفيات ألا تصبح هذه الملاحظات محوراً للصراع أو أداة من أدواته، وألا يتم تعميمها في الحزب، وحصل على وعد قاطع بهذا الشأن، وفجأة تنقلب هذه الملاحظات إلى سلاح داعم للانقسام، وتصبح هي بحد ذاتها ستاراً لوقف هذا البرنامج، أو لإحداث انقسام في الحزب، وذلك حسب إمكانية أي من الاحتمالين.
من مراجعة نص البرنامج ومقارنته مع الحوارات والمداخلات يتضح أنه لم يكن هناك خلاف على:
- وجود الأمة العربية.
- حق هذه الأمة بإيجاد دولتها الموحدة.
- ضرورة وجود دور فاعل للحزب الشيوعي في صناعة دولة الوحدة.
- ضرورة النظر إلى بناء حزب شيوعي عربي كهدف استراتيجي.
- تشخيص الكيان الصهيوني باعتباره كياناً استعمارياً إمبريالياً.
- حق تحرير فلسطين كهدف استراتيجي.
- ضرورة أن تكون مواجهة العدوان والوجود الصهيوني مواجهة قومية.
- أهمية الوضع الدولي وضرورة مراعاته.
لكن بعد أن وردت ملاحظات العلماء والسياسيين السوفيات والبلغار، بدأت كسوة الخلافات باللباس الفكري.
وإذا كانت هذه الملاحظات قد ألقت ظلال الشك حول وجود أمة عربية مكتملة التكوين حين أشارت إلى أن الأمة العربية تناضل من أجل استكمال تكوينها، وأن عملية الاستكمال تحدث من خلال وإثناء المواجهة والتقدم الاجتماعي، والنضال الاشتراكي، وأن قضية الوحدة وأشكالها قضية مستقبل من الصعب تحديدها من الآن، وأن الشيوعي لا يمكن أن يؤيد أي وحدة إن لم يتحقق فيها الجوهر التحرري والاقتصادي. وملاحظتهم أن هناك خطين متناقضين للعمل الوحدوي: خطا إسلاميا، وآخر تقدميا، وأسسوا على رؤيتهم القومية هذه أن مسألة الحزب الشيوعي العربي الموحد ليست مسألة راهنة، وإنما هي قضية مستقبلية بعيدة الأمد، وممكنة التحقيق في حال وجود دولة عربية موحدة.
وإذا كانت هذه الآراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قد تحفظت أيضا على رفع شعار إزالة المؤسسات الصهيونية، واعتبرته متضمنا معنى إزالة “إسرائيل”, وأعادت مرة ثانية معالجة هذه القضية إلى إطارها الدولي، وربطت بين التطورات الاجتماعية الثورية في البلدان العربية وعملية مواجهة العدوان الإسرائيلي، وحذرت من شعار “وطنه المغتصب”، ورأت أنه يعكس رؤية قومية صرفة، واستبعدت أساليب النضال المظهرية التي سلكتها المقاومة الفلسطينية.
وإذا كان هؤلاء الخبراء قد أكملوا ملاحظاتهم بأن اقترحوا صياغات محددة بديلة لتلك التي اعترضوا عليها، فإنهم في كل الأحوال قد انطلقوا بداية واختتموا حديثهم نهاية بعدد من الاعتبارات والتقييمات أهمها:
- أن المشروع جيد، ووثيقة نظرية مهمة.
- أن هذه الملاحظات لا يجوز بشكل من الإشكال أن تستخدم في عملية الصراع ضمن الحزب.
- أن البرنامج هو في الأصل برنامج الحزب الشيوعي السوري، وهو المسؤول عن تنفيذه.
- أن اعتماد المبادئ التنظيمية للماركسية اللينينية “القيادة الجماعية، التزام الأقلية برأي الأكثرية، ..الخ” وبالاستناد إلى الأساس الفكري الطبقي الذي يقدمه البرنامج يمكن للحزب تجاوز أزمته.
- أنه رغم مظاهر الأزمة المتعددة فليس هناك مبرر فعلي لأي انقسام.
إن اللجوء إلى السوفيات والبلغار من أجل مزيد من التفاعل والتمحيص في أجزاء البرنامج لم يؤد إلى تقليل شقة الخلاف، وإنما زاد الأمر تفاقما، وشيئا فشيئا تكشفت الخلفيات التي تقف وراء المواقف الفكرية والسياسية المعلنة التي اتخذها الحزب خلال المرحلة الماضية، والتي جعلته باستمرار “متخلفا” عن الموقف الجماهيري، ومتناقضا معه، رغم الامكانات النضالية المعتبرة التي كان يحتويها.
وأيا ما كان الموقف من ملاحظات الخبراء، فإن جعلها مادة خلاف، لا يعبر عن حقيقة موضوعية، إذ إن هذه الملاحظات نفسها قد تستخدم أداة للالتزام القومي، وقد تستخدم أداة لتبرير الموقف الانفصالي.
لقد كشف “بدر الطويل” في مثل ضربه في مداخلته التناقض الحاد في زاوية الرؤية لهذه الملاحظات، وبين في هذا المثل كيف أن الاتفاق حول هذه الملاحظات لا يتضمن الاتفاق حول موقف عملي واحد في الحياة تجاه المسألة نفسها، يقول الطويل:
“لنأخذ موضوعا آخر من آراء الرفاق السوفييت، رأيهم حول الأمة العربية: يفضل الرفاق السوفييت الحديث عن الشعب العربي بدل الأمة العربية التي هي في رأيهم ما تزال في طريق التكوين، لم تكتمل بعد، إن هذه القضية ليست قضية جوهرية كبيرة إذا أخذت من الجانب العملي فقط، ولكنها يمكن أن تغدو مثار نقاش وخلاف شديد إذا ما بدأت استنتاجات متناقضة تستند إليها، فعلى هذه الموضوعة يمكن أن ينهض استنتاجان متناقضان:
الاستنتاج الأول
إذن استناداً إلى موضوعة “أمة عربية في طريق التكوين” – نحن لسنا بعد!
والأمر كذلك، فلا حاجة لنا نحن الشيوعيين السوريين أن نهتم اهتماماً مناسباً بالقضية التي تواجه الشعوب العربية. فالوحدة إذن مطلب “طوباوي”، ولا حاجة لطرحة بين شعوب أمة ينقصها عامل أساسي هو العامل الاقتصادي المشترك، وفي الوقت الذي يتجه فيه التطور التاريخي في هذه المنطقة من العالم نحو تشكيل أمم عربية (أمة سوريا، أمة عراقية … الخ). وإذا ما جرت المبالغة في هذه القضية يمكن إيجاد ناس من حزبنا يقترحون أن يكون شعار الحزب هو الانفصال. بدل شعار الوحدة المشروطة وغير المشروطة.
إن هذا ليس خيالاً أو تخيلاً. لقد حدث هذا بالنسبة للحزب الشيوعي الجزائري في أوائل الخمسينات، لقد انطلق الحزب الجزائري من موضوعة مشابهة وهي أن الأمة الجزائرية، أمة في طريق التكوين، ولم تكتمل بعد (بسبب وجود مليونين أو أكثر من الفرنسيين). فماذا نتج عن هذه الموضوعة؟ توصل الحزب الجزائري إلى استنتاج يقول بصحة هذه الموضوعة. ورسم خطاً سياسياً معارضاً أو على الأقل محايداً من حركة التحرير الجزائرية عندما نشبت ثورتها، ووجد نفسه خارج هذه الحركة الثورية المعادية للإمبريالية، وبالرغم من أنه صحح فيما بعد بعض مواقفه إلا أنه لا يزال يعاني العزلة الجماهيرية من جراء هذا الاستنتاج والموقف السياسي الخاطئ.
ولنأخذ مثالاً ملموساً آخر ظهر في مداخلات أحد الرفاق – في مداخلة الرفيق موريس – بالرغم من أن مداخلته احتوت أفكاراً جدية، وصحيحة، في موضوع تهيئة الظروف الموضوعية لإنجاح وترسيخ أية وحدة. إلا أن كل هذه الأفكار فقدت تأثيرها ومكانها – وخرجت عن الموضوع – عندما اتضح جوهر موقف موريس من قضية الوحدة، ويمكن تلخيص موقفه فيما يلي:
الميل الانفصالي في حركة التحرر العربي هو السائد، وهو الأقوى بسبب الفشل الذي أصاب العديد من المحاولات الوحدوية، وبواقع ازدياد عدد أعضاء الدول العربية في الجامعة العربية من جهة أخرى. وإذا كان الأمر على هذه الصورة – التي قدمها موريس – أي أن الحتمية التاريخية للتطور هي ضد تنفيذ الوحدة، فتغدو المحاولات التوحيدية في حلم “الطوباويين، وبقايا العصور السابقة” خاصة، والحزب الشيوعي لا يمكن أن يعارض الحتمية التاريخية، أو أن ينجر وراء الطوباويين، فلننبذ إذن شعار الوحدة.
الاستنتاج الثاني:
نحن “أمة في طور التكوين”. إذن لابد أن نناضل من أجل تفادي الخلل القائم في تكوين الأمة العربية. من أجل تكوين أمة، ولن يكون هذا من شأن البورجوازية الصغيرة أو غيرها، بل هو من شأن البروليتاريا العربية، وينتصب شعار تحقيق الوحدة العربية كأحد الخطوات الجدية على طريق تكوين الأمة. ويصبح هذا الشعار أكثر إلحاحاً إذا توصلت الطبقة العاملة العربية إلى الاقتناع أن نضالها من أجل الوحدة بحد ذاته أمر يصب في مصلحة إنجاز بناء الاشتراكية. والشيوعيون، كما أكد الرفاق السوفيات يناضلون من أجل تكومين أممهم، ورفع الطبقة العالمة إلى درجة تصبح فيها هي الأمة، وبالتالي فإن كل خطوة على هذا الطريق تؤيدها البروليتاريا، وتناضل من أجل إنجازها.
وفي البلدان العربية سيأتي الوقت الذي يكون فيه ميزان القوى – وستناضل البروليتاريا العربية من أجل ذلك – لصالح الأنظمة التقدمية، وستكون الحدود بينها عقبة أمام تطور هذه البلدان نحو الاشتراكية، وعندها ستكون الطبقة العاملة أول من يرفع شعار إزاحة الحدود!، ولكن هل يكون لنا شأن بكل ذلك إذا لم يكن شعار الوحدة العربية، وإنشاء الدولة العربية الواحدة شعاراً استراتيجياً لجميع القوى التقدمية في الوطن العربي.
هاكم استنتاجان متناقضان لموضوعة واحدة.. على أساس أحدهما يمكن أن يكون الحزب إما انفصالياً أو وحدوياً.
هذا أيها الرفاق، هو جوهر الموقف من آراء الرفاق السوفيات”.
إن هذا المثل الذي ضربه “الطويل” يكشف بشكل ساخر عن وجود عقليتين في الحزب نفسه، عقلية انفصالية، وأخرى وحدوية، لا علاقة لهما البتة بملاحظات العلماء والسياسيين، وإنما يجري استخدام هذه الملاحظات من أجل دعم هذا المنطق بشكل مشوه، ولعل هذا المثل ذاته يمكننا من فهم التناقضات التي وقع بها الحزب الشيوعي تجاه مسألة الوحدة تاريخياً، وهي تناقضات لا يمكن أن يمحوها الزمن وإن كان من الممكن أن يتجاوزها بالتصحيح والنقد.
لقد وقف الحزب الشيوعي مع دعوة القومية العربية، والوحدة العربية، وقال فيها قولاً بزَّ أقوال القوميين التقدميين، وحينما تحققت وقف ضدها، وحاربها، وحارب إجراءاتها التقدمية، ومشى في موقفه المعادي للوحدة إلى درجة رفض فيها ما لا يمكن لشيوعي أو اشتراكي أن يرفضه “التأميم، والإصلاح الزراعي”. ووقف مع قوى الانفصال والرجعية وساندها ضد الوحدة.
جاء في القرار الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية في 11-12-13 كانون الثاني 1958 حول تأييد الاتحاد بين سوريا ومصر، ما نصه:
“ليست القومية العربية مجرد مسألة عاطفية فقط، وإنما هي واقع عملي يتبلور ويتطور، وقوة ثورية تعبر عن نهضة ثمانين مليون إنسان، وعن طموحهم الجارف إلى احتلال مكانهم تحت الشمس. وفي صف الأمم المتقدمة … إن المحتوى الرئيسي للقومية العربية هو محتوى تقدمي ديموقراطي. وهكذا فإن القومية في نضالها من أجل تحرر العرب ووحدتهم تلعب عملياً دوراً تقدمياً ديموقراطياً على الصعيد الدولي”.
ويلاحظ “الطويل” أن هذه الفقرة جاءت في وقت لم تَبن فيه بعد الاجراءات التقدمية اجتماعياً لنظام الوحدة، وجاءت بشكل “أكثر تقديراً وجمالاً”، مما ورد في مشروع البرنامج، ومع ذلك فإن الاتجاه المضاد وصف هذا المشروع بأنه “متعصب قومي”.
- وقبل قرار اللجنة المركزية في هذه الدورة كان خالد بكداش قد وقف في البرلمان السوري في 7 تشرين الأول يعلن رؤيته لقضية الأمة العربية، والقومية العربية. ويقابل الوجود الموضوعي المتحقق لهذه الأمة، بالادعاء الصهيوني بأن اليهود أمة واحدة، ويجعل سند قوله في القضيتين: الأمة العربية، والادعاء الصهيوني: الاشتراكية العلمية أي الماركسية اللينينية. يقول بكداش:
“إن الاشتراكية العلمية تقرر على أساس درس تاريخ الأمم والقوميات، وتطورها، أن الأمة (هي جماعة ثابتة من الناس، مؤلفة تاريخياً، ذات لغة مشتركة، وأرض مشتركة، وحياة اقتصادية مشتركة، وتكوين نفسي مشترك يجد تعبيراً عنه في الثقافة المشتركة… ومن الواضح أن هذه المقومات والمميزات غير متوفرة بتاتاً في يهود العالم حتى يقال إنهم يؤلفون أمة أو قومية، فأي رابطة مثلاً بين يهود أمريكا، ويهود الصين؟ أو بين يهود بولونيا ويهود تركيا أو غيرهم؟ … لا رابطة أبداً. فلا لغة مشتركة، ولا أرض مشتركة، ولا تاريخ مشترك، ولا تكوين نفسي مشترك، ولا ثقافة مشتركة … ولا بأس من القول بهذه المناسبة بأن الوقاحة بلغت بالصهيونيين اليوم درجة أنهم بينما يدعون أن اليهود يؤلفون قومية، ينكرون ذلك على العرب. بينما جميع مقومات الأمة الآنفة الذكر التي تقررها الاشتراكية العلمية متوفرة عند العرب، كما هو واضح ساطع كالشمس في رابعة النهار”… “ولنقل هنا إن هذا الاتجاه من الصهيونيين لنفي القومية العربية يتفق تماماً مع موقف عصابة القوميين السوريين بإنكار القومية العربية إنكاراً تاماً”.
- مقابل هذا الموقف النظري للحزب، ولأمينه العام، قبل قيام الوحدة، وفي مراحل التحضير لها، فإن أحمد فايز الفواز يسجل الموقف العملي للحزب، فيقول:
“يجري الحديث عن – البنود الثلاثة عشر – .. وأنا لا أريد أن أناقش مضمونها هنا. يزعم البعض أنها كانت أساس سياستنا خلال الوحدة .. لكن لم تكن كذلك .. أساس سياستنا كان الانفصال، والدعوة إلى الانفصال .. وسأعطي مثالاً من كراس معروف (خالد بكداش). “الوحدة السورية المصرية كيف تمت وكيف أفلست وأشرفت على الانهيار” – ملحق الأخبار العدد 352، المقال مكتوب في أواسط 1960 أي بعد تأميم بنكي مصر والأهلي في 11 شباط 1960. ص 29
“أصبحت سوريا اليوم، ولما يمضي على الوحدة سوى سنتين أو أكثر قليلاً في وضع لا يوصف من الفوضى والأزمة الشاملة، سواء في ميدان الاقتصاد أو في سائر الميادين الأخرى، وبعد أن أبعد عن الحكم حزب البعث، وكذلك ممثلو مختلف أوساط البورجوازية الوطنية السورية، صار من الواضح تماماً أن الوحدة لم تقم في سبيل “إنقاذ سوريا من الخطر الشيوعي” كما صرح عبد الناصر في حديثة إلى مجلة “بليتز”. بل من أجل استعمار سوريا طبقاً لمشاريع البورجوازية المصرية الكبرى .. وتجربة الفترة التي مرت منذ إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة، أقنعت الشعب السوري تماماً بأن الوحدة لم تتحقق لمصلحة سوريا، ولا لمصلحة الحركة التحررية للشعوب العربية، وإنما تحققت لمصلحة الرجعية، بل وفي آخر تحليل لمصلحة الاستعمار… إن طريق الخلاص هو في إقامة.. جبهة شاملة هدفها النضال في إعادة النظر في الوحدة من الأساس، وفي سبيل إنقاذ سوريا المعذبة، وطنهم الحبيب”.
ويتابع الفواز رصد موقف الحزب من الانفصال الرجعي قائلاً:
“أما الانفصال الرجعي البورجوازي الاقطاعي الذي كان الاستعمار وراءه، فقد قيمناه كما يلي: “وهكذا فإن انتفاضة 28 أيلول التي انتصرت بفضل تضامن الشعب الواعي، والجيش الباسل، كانت أمراً محتوماً، ساق إليه منطق الحوادث نفسها، وجاء تتويجاً لنضال مرير خاضه الشعب السوري ضد حكم الديكتاتورية، والتمصير، وكان للحزب الشيوعي في هذا النضال دور طليعي”.
إن هذا التناقض، هذا الانتقال من الموقف الوحدوي، إلى الموقف الانفصالي. لا يمكن فهمه إلا على ضوء حركة الحياة نفسها، على ضوء التطورات الجارية على الأرض، وعلى ضوء بنية الحزب الشيوعي، ومراكز التأثير فيه أيضاً.
لقد نظر الحزب الشيوعي إلى الوحدة عام 1958 بمنظارين لا يحمل كلاهما أي قدر من الموضوعية، أو المواقف المبدئية:
المنظار الأول: أن هناك اندفاعة وحدوية في سوريا أشد قوة مما تطرحه مصر، أو مما يعتقد أنها تتحمله، وكان غالب الظن أن هذه الوحدة لن ترى النور، وإذا رأته فستكون في إطار مهلهل يبقى كل إقليم فيها يتصرف في شؤونه الخاصة، ولما جاءت على غير هذه الهيئة نمت بسرعة “دواعي الحذر المعروفة عند الأقليات”، وكشفت عن نفسها في قيادة الحزب الشيوعي، لكن المد الوحدوي كان طاغياً إلى درجة لا يمكن الوقوف في وجهه. وهكذا بدأت قيادة الحزب في إيجاد مخرج لعملية التراجع.
المنظار الثاني: حين غطت تراجعها بوضع ما دعته بالشروط الثلاثة عشر للوحدة، ولم تكن هذه الشروط غير ستار للموقف الانفصالي الحقيقي، حيث عملت على محاربة الوحدة، وادعت لنفسها بفخر دوراً طليعياً في صنع الانفصال، وراحت تزوِّر الوقائع التاريخية حين ادعت أن الشعب السوري وقف إلى جانب الانفصال، في حين أن هذا الشعب وعلى الأخص قطاعي: العمال والطلاب، هما اللذان قادا أضخم حركة تمرد، وأكثرها امتداداً في تاريخ سوريا، ضد الانفصال ومنذ اليوم الأول، وسقط العديد من الشهداء من العمال والطلاب نتيجة الصدام مع الجيش المؤتمِر بالقيادة العسكرية الرجعية الانفصالية …
إن “عمر قشاش”، مثله مثل غالبية أعضاء المكتب السياسي، واللجنة المركزية، وكوادر الحزب، لم يعد راضياً أن تبقى الأمور المتعلقة بالوجود القومي موضع شك أو تقلقل، لذلك فإنه يقدم في هذه القضية بحثاً مميزاً لكشف مدى عمق هذه القضية في تفكيره، وفي وجدانه. يبنيه – وفق ما يرى – عبر تطبيق خلاق للماركسية اللينينية على الواقع العربي. إنه يفرق بين النضال لوحدة الأمة، والنضال لاستكمال عوامل وشروط وجود الأمة، ويكشف معنى أن الأمة بنيان تاريخي، محصلة تطور تاريخي، ليست مرتبطة بالصعود الرأسمالي، وبالتالي ليس حتماً أنها مهمة للقوى البرجوازية. ويكشف في الوقت نفسه الطبيعة الثورية للعملية الوحدوية، حينما يسلط الضوء على جبهة الأعداء الذين أثبتت حركة الحياة أنهم ضد هذه العملية دون هوادة، فإذا هم قوى الاستعمار والرجعية، نفس الأعداء الذين يقفون في مواجهة أي تقدم اجتماعي. أو بناء اشتراكي. يقول القشاش:
” نحن لا نناضل من أجل استكمال تكوين أمة عربية، بل من أجل توحيد الأمة العربية المجزأة، لكي تسهم هذه الدولة في تطوير القوى المنتجة، وتحقيق العملية الثورية لدولة الوحدة”.
ويستشهد في هذا الصدد بالتقرير السياسي، حين يقول “الأمة ليست وليدة الرأسمالية، ولا من صنع البرجوازية وما يرتبط بها من مفاهيم وأصناف، هي وليدة تطور طويل بدأ قبل الرأسمالية، وسيبقى بعدها، والجماهير هي التي لعبت دائماً الدور الأساسي في هذا التطور في جميع مراحله، ولهذا فإن عدم وجود دولة مركزية اتحادية أو موحدة لا ينفي وجود وحدة الأمة”.
“لقد أثبتت تجربة الحياة نفسها أن الاستعمار والرجعية هم أعداء الوحدة العربية، وقد حاربوها في الماضي وسيحاربونها في المستقبل لحرفها عن اتجاهها الوطني التقدمي”.
أما رؤيته للوحدة الرائدة، وحدة 1958، فإنه يحددها بشكل قاطع ويحدد السبب الرئيسي للانفصال قائلاً: “إن الوحدة السورية المصرية التي قامت عام 1958، رغم كل الصعوبات، والآلام التي لحقت بحزبنا، فإن محصلتها كانت تقدمية في مجرى التطور العام… لقد تحقق إصلاح زراعي، وأممت الصناعات والمعامل الكبرى التابعة للبرجوازية. ونتيجة لهذه التحولات التقدمية قامت الرجعية السورية عام 1961. بفصل الوحدة، مستغلة الأخطاء التي وقعت”.
إنه هنا يوجه إدانة كاملة، ونقداً عنيفاً لموقف الحزب الشيوعي الذي اعتبر الوحدة. استعماراً مصرياً، واعتبر الإصلاح الزراعي لمصلحة البرجوازية المصرية، والتأميم إفقارا للبلد وإضاعة لثروته.
بعد أن يؤكد على أن تقدمية الوحدة، وليس رجعيتها هي التي ألبت قوى الرجعية عليها، يستدل أحمد فايز الفواز من واقعة الانفصال على حقيقة القوى التي تقف في مواجهة تقدم الحياة قائلاً:
“إن انفصال الوحدة لا يعني فشل حركة الوحدة العربية، كما يزعم البعض، بل يكشف مدى حقد الإمبريالية والرجعية على الوحدة العربية، ويستدعي بالضرورة نهوض الطبقة العاملة وكل القوى الديموقراطية الثورية بواجبها في توحيد الوطن العربي”.
ثم يكشف عن نموذج من النماذج في تعامل بعض الشيوعيين مع قضية الوحدة، ويحدد واجب الحزب الشيوعي:
“هناك عندنا من يتحدث عن عملية الوحدة. كما لو أنها عملية زواج رجل وامرأة!!! ونحن نجلس في مكان قاضي الشرع.. نستطيع أن نرفض عقد القران أو نستطيع أن نباركه!!! الوحدة حتمية … الوحدة تصنعها حتى الآن قوى أخرى.. وهي تصنعها على مثالها. وحسب مفاهيمها … المطلوب من الحزب الماركسي اللينيني أن يفهم هذا الاتجاه التاريخي، ويعمل على أساسه من أجل قضية الطبقة العاملة، من أجل الاشتراكية”.
على ضوء الموقف من الأمة العربية، وجودها، وحركة توحدها، يتحدد الموقف من شعار “الحزب الشيوعي العربي الموحد”، وعلى ضوء هذا الموقف أيضاً تتحدد النظرة إلى قضية فلسطين، والوجود الصهيوني، لكن قبل أن ننظر في هذا. يجب أن نلاحظ التباين الشديد في النظرة إلى الأمة العربية داخل الحزب الشيوعي:
- أغلبية متوفرة في المكتب السياسي، واللجنة المركزية، والمؤتمر، وجسم الحزب كله، تقف إلى جانب البرنامج السياسي. وتؤكد إيمانها بوجود أمة عربية، وبضرورة وضع جهد الحزب في اتجاه بناء دولة واحدة لهذه الأمة الواحدة.
- وأقلية في كل هذه المواقف لا ترى ذلك، بل إنها ترجح الاتجاه الانفصالي في حركة هذه “الأمة” ولا ترى للحزب أي دور في حركة الحياة العربية باعتبارها حركة “وطنية”.
أغلبية تكشف موقفها بوضوح وصراحة، وأقلية تحاول أن تتخفى وراء عبارة معينة، ووراء شروط معينة، وتتقوى بملاحظات قدمها “الرفاق السوفيات” من أجل أن تخفي موقفها الانفصالي!!! والغريب أن هذه الأقلية التي تتخذ من تجزئة الأمة العربية دليلاً على انتفاء وجودها، ومن التباينات الطبيعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم عليها قوى التجزئة في كل إقليم عربي، دليلاً على انتفاء عامل “الاقتصاد المشترك” الذي وضعه ستالين في تعريف الأمة.
نقول الغريب أن هذه الأقلية تسمح، وترضى، وترى الأمر طبيعياً، في أن يناضل الأكراد الموزعون بين أربع دول، وثلاث أمم، ويخضعون وفق توزعهم هذا إلى أساليب تنمية اقتصادية متباينة، ومتناقضة، من أجل وحدتهم، وبناء دولة تتسع لحجم أمتهم التي يتصورونها، ثم ترضى. وتسمح أن تمارس هذه القناعات داخل صفوف الحزب الشيوعي نفسه.
إن وجه الاستغراب هنا لا ينبع من رؤيتهم للقضية الكردية، وإنما من التعارض العنيف، وغير المبرر في رؤيتهم للقضية العربية، قياساً على رؤيتهم للقضية الكردية.
يروي “بدر الطويل” حادثاً جرى في الحزب الشيوعي، وهو يرويه انتقاداً للنظرة الطبقية الضيقة التي تسود هذا الحزب، لكن الدلالات القومية لهذا الحادث غنية وصاعقة، يقول الطويل: “في الأيام الأولى للمناقشة جاءني أحد الرفاق. وقدم لي ورقة مرسوماً عليها العلم الكردي، قمت أنا ورسمت عليه منجلاً، ومطرقة، وأعدتها إليه معقباً: أنا لا أريد أن تنشأ دولة كردية تحت قيادة برجوازية. “وشتم أحد الأغوات، ونسيت اسمه”.
ويأتي السؤال هنا: ما هي دوافع هذه الأقلية في موقفها هذا؟
حتى لو انطلقنا من صحة تحليل العلماء والسياسيين السوفيات والبلغار لموضوعة الأمة العربية. باعتبارها أمة في مرحلة التكوين، ولما تستكمل تكوينها بعد، فإن “الطويل”. كشف بمثله السابق وجود موقفين متعارضين من هذا الرأي: موقف انفصالي، وموقف وحدوي.
ما هي دوافع أصحاب الموقف الانفصالي؟
في أحاديث الرفاق تم كشف هذه الدوافع. ونحن مدعوون لأن نتابع أحاديثهم حتى نقف على رؤيتهم هم كشيوعيين لهذه الدوافع.
بدر الطويل يؤكد: “أن الرفاق الذين رفضوا بصورة قاطعة طرح هذا الشعار – الحزب الشيوعي العربي الموحد، انطلقوا من رفضهم، بل وكرههم لقضية الوحدة العربية”.
ثم يسترجع ماضي الحزب في مسألة الوحدة، ليبين إلى أي مدى مضى بهم هذا الكره، ونحو أي المواقع جرهم:
“لقد تمت الوحدة السورية المصرية فأيدناها شكلاً، وحاربناها فعلاً.. إن الكره للوحدة دفعنا للوقوف مع الرجعيين والبرجوازيين ضد التأميمات، والإصلاح الزراعي، جعلنا سياسياً، نقف مع الرجعية، واستمرينا على هذه المواقف السياسية الخاطئة حتى فترة الانفصال. انتقد ذلك، لا أبرئ نفسي من هذه الأخطاء، فأنا كنت واحداً من المسؤولين عن هذه السياسة الخاطئة”.
ونفس التأكيد يأتي عليه “ظهير عبد الصمد” حينما يقول: “أعتقد أن وضع الشروط للوحدة من قبل بعض الرفاق – كما ظهر في هذا الكونفرانس – يعكس روح الخوف من الوحدة، إن هؤلاء وأمثالهم يريدون بقاء روح التجزئة المصطنعة الموجودة في العالم العربي”.
لكن الخوف ليس سبباً بحد ذاته، إنه حالة لها أسبابها، ويعلم هؤلاء الرفاق بدقة أن هناك أسباباً تقف وراء هذا الخوف. لذلك يتولى ظهير عبد الصمد طرح هذه الأسباب فيقول:
“إن المخاوف التي تبرز لدى بعض الرفاق عندنا طبيعية، فهي قد تعود إلى ظروف الإرهاب التي تعرض لها الحزب في فترة الوحدة المصرية السورية، وربما تعود إلى أسباب أخرى مفهومة، كرواسب مشاعر أقليات قومية، أو رواسب بقايا العقلية الإقطاعية، أو رواسب الإقليمية، أو بسبب الخوف البرجوازي من التقدم الاجتماعي.. ولكن هذه المخاوف كلها يجب ألا تكون الأساس في رسم سياسة الحزب”.
إن عرض هذه الأسباب على هذا النحو المجمل وعلى قدم المساواة، فيه خلل واضح، “فالإرهاب” الذي تعرض له الحزب لم يمنع أغلبية الحزب أن ترى القضية القومية بشكل صحيح، مع العلم أن هذه الأغلبية هي التي تعرضت أكثر من غيرها “للإرهاب”. والبحث الحقيقي في دواعي الموقف الانفصالي يجب أن ينصب حول الرواسب بمختلف أشكالها حتى يتم تحديد الأوزان الفعلية لكل منها في مواقف وسلوك الأفراد.
على كلٍ فإن دواعي عرض الأسباب بهذا الشكل الإجمالي مفهومة في مسيرة الحزب، وفي محاولات هؤلاء القادة المحافظة على وحدة الحزب، وفي توقعهم إمكانية تشذيب كل هذه الرواسب في مسيرة الحزب المستقبلية.
على الوجه الآخر لقضية الوحدة، تأتي قضية فلسطين، وقد كشف الصراع الفكري حول هذه القضية بعداً آخرعميقاً من أبعاد الفكر الإقليمي، والفكر القومي تجاه هذه المسألة. إن القضية هنا ليست طبقية النظرة، أو عدم طبقيتها، ولا أممية النظرة، أو عدم أمميتها، وإنما التقابل كائن بين إقليمية النظرة، وبين قوميتها.
إن أحداً من الشيوعيين الذين وقفوا خلف هذا البرنامج لم يطرح أي شعار غير طبقي، أو غير أممي، أكثر من ذلك، فإنهم جميعاً أبدوا استعدادهم لنزع أي عبارة يفهم منها ولو خطأ أنها تدين “الشعب اليهودي” كله، أو تدعو إلى إلقائه في البحر، أو تغامر في الدفع نحو حرب عالمية لحل قضية فلسطين، أو ترى أن حل هذه المسألة مطروح اليوم. لكن هؤلاء كلهم أرادوا أن يملكوا الحزب رؤية صحيحة للقضية الفلسطينية، وأن يدفعوه للممارسة الصحيحة في هذا الاتجاه، ثم يتركون للزمن، لتطور الأحداث أن تحدد الكيفية النهائية لشكل حل القضية الفلسطينية، إنهم انطلقوا في تحديد موقفهم من قضية فلسطين، من قاعدة وضعها لينين تقول: “في القضايا القومية تكفي مبدئية الشعار لوحدها”. ومبدئية الموقف من القضية الفلسطينية حددها قادة الحزب الشيوعي تأسيساً على ما ورد في البرنامج فجاءت لتضم عدداً من العناصر:
- إنها قضية الأمة العربية، وليست قضية الشعب الفلسطيني وحده.
- إن الهدف البعيد هو إنهاء وجود المؤسسات الصهيونية، وإقامة كيان عربي في فلسطين يعيش فيه الجميع بمن فيهم اليهود.
- إن على الحزب الشيوعي أن يقوم بدوره المفترض في هذا الاتجاه.
وما وصلوا إلى هذا الموقف المبدئي إلا بعد تحليل تاريخي، وعياني، واجتماعي لنشاط الكيان الصهيوني ودوره.
لقد تمسك الأمين العام للحزب بملاحظات العلماء والسياسيين، واتخذ من هذه الملاحظات أساسً فكرياً له، في حين لم يكن هذا وارداً قبل ورود هذه الملاحظات، واستند كغيره من قادة الحزب إلى القاعدة التي رفعها لينين فيما يتعلق بالقضايا القومية المبدئية. لكنه طوع هذه القاعدة لشعار حق تقرير المصير، فاعتبر هذا الحق هو الموقف المبدئي الصحيح، وإن كان غير عملي. في حين قال أصحاب الرؤية “القومية – الطبقية”، إن شعار التحرير هو الموقف المبدئي الصحيح، وإن كان في ظروف الواقع غير عملي. واعتبر خالد بكداش أن رفع شعار التحرير “ليس له أساس طبقي، كما أنه غير واقعي”. وزاد على ذلك أن هذا الشعار يخدم “مآرب الدعاية الصهيونية والاستعمارية”.
إن الأمين العام لا يواجه المسألة مواجهة مباشرة، لا من حيث كونها موقفاً مبدئياً، ولا من حيث الموقف التاريخي للحزب منها، إنه يروي حادثة جرت معه في ندوة عامة للطلاب عقدت في بلغاريا، سأله فيها أحد الحاضرين عن موقف الحزب الشيوعي السوري إذا وصل الحزب الشيوعي الإسرائيلي إلى الحكم. وجاء في إجابته: “إذا وصل الحزب الشيوعي الإسرائيلي إلى الحكم انحلت المشكلة، لأن معنى هذا هو أولاً: أنه تم القضاء على البرجوازية الكبرى، وكبار ملاكي الأراضي اليهود. وثانياً: انقطعت السلسلة التي تجمع بين إسرائيل وبين الصهيونية العالمية والإمبريالية العالمية، ولا يبقى هناك لا سيطرة استعمارية، ولا صهيونية، ولا عدوان، وينفتح المجال لعودة الشعب العربي الفلسطيني إلى وطنه وتقرير مصيره بنفسه، وتبقى القضية بين كادحين عرب وكادحين يهود. ومن الواضح أنهم في ظل الاشتراكية يمكن أن يتفقوا بسهولة على كل شيء بما في ذلك التسمية”.
ويعقب على هذه الإجابة بأن القاعة استقبلتها بالتصفيق، ويقول إن هذا دليل على وعي جماهير الشعب العربي، والشباب العربي.
مثل هذا التفكير، هذه المعاجلة للقضية الفلسطينية، يشير بوضوح إلى قدر عال جداً من الالتفاف على القضية الفلسطينية، ويكشف إلى أي مدى يمكن أن تذهب الرؤية الإقليمية.
ففي مواجهة المسألة الكردية، يعتبر نضال الأكراد من أجل إقامة دولتهم نضالاً مشروعاً، ولا ينظر الشيوعيون إلى أن حل هذه المسألة يأتي من خلال حل المسألة الطبقية في المجتمع الذي يعيشون فيه.
أما في مواجهة المسألة الفلسطينية، فإن القضية محلولة حين يصل الحزب الشيوعي الإسرائيلي إلى السلطة؟!
إنه ممنوع على الفلسطينيين أن يحلموا بوطن لهم، ولم يكن قد غاب هذا الوطن عن بعضهم غير عشرات السنين، والكثيرون منهم لا يزالون يعيشون على أرضه، ثم هو لا يرى في المسألة أي بعد قومي. أما فلسطينية الدولة أو إسرائيليتها، فإنها مسألة تسمية لن يختلفوا عليها، أو هي لا تستحق خلافاً فعلياً.
الأمين العام لم يسأل نفسه تحت أي مشروعية أصبح الشيوعي الذي جاء من أوروبا الشرقية أو الغربية منذ عشرين عاماً ضمن سياق هجرة منظمة من القوى الاستعمارية إلى فلسطين مالكاً لهذا البلد، وأصحابه الذين بقوا آلاف السنين فيه غرباء!
ولم يسأل نفسه كيف كان موقف هؤلاء الشيوعيين في العدوان المستمر على أرض فلسطين. ومروراً بالأعوام 1947، 1948، 1956، 1967!
وكيف يكون شيوعياً يحارب الاستغلال هذا الذي يقف على أرض ما كان يمكن أن يقف عليها لولا أنه طرد منها صاحبها الأصيل، ثم أخيراً يتناسى حساب واقعية هذا الافتراض الذي طرحه، وأيضاً إمكانيته!
لقد تولى “بدر الطويل” كشف وهم هذا التغيير المتصور في الكيان الصهيوني، دون أن يبخس – كشيوعي – حقه في رؤية الشيوعيين الإسرائيليين بمنظار متميز – ويربط قدرة “الحركة الثورية الإسرائيلية” على فعل شيء إيجابي جدي، بقدرة حركة التحرر الفلسطينية على التقدم نحو هدفها. يقول الطويل:
“ولكن أيحق للشعب العربي الفلسطيني، ولحركة التحرر الوطنية العربية، أن تقعد منتظرة نعيم تلك التغيرات المنتظرة، وغير الواقعية برأيي، وهي تملك أيضاً كل الحق لاستخدام مختلف الشعارات والأساليب التي تؤدي بحركة التحرر الفلسطينية والعربية إلى تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة.. ويهيأ لي أن مستقبل الحركة الثورية في إسرائيل مرتبط بعمق الضربات التي توجهها حركة التحرر العربية إلى العسكرية والعدوانية الإسرائيلية”.
ويكشف عن العلاقة الجدلية بين وجود إسرائيل، وبين استمرارها بلعب دورها في العدوان والاغتصاب، ليستخلص أن هذا الوجود، وجود قائم على دور، وليس وجوداً قائماً على أسس موضوعية مكونة تاريخياً، لذلك فإن سقوط هذا الدور أو انتفاءه. يسقط الوجود ذاته وينفيه، وسوف تتولى الجهة التي أوجدت إسرائيل لتلعب هذا الدور. إزالتها حين تصبح عاجزة عن القيام به. وبألفاظه فإنه يقول:
“واسمحوا لي أن أقول إنه عندما تكف إسرائيل عن أن تكون قاعدة عدوانية إمبريالية، عندما تكف عن لعب دور الدركي في وجه حركة التحرر العربية يهيأ لي أن الإمبريالية الأمريكية بنفسها ستجد كل المبررات للقضاء على هذه الدولة”.
إن طرح الأمين العام لا يرى أبداً تناقضاً ما بين الحق، والاغتصاب، ولا بين الأمة العربية، والمغتصبين لأحد أقاليمها.. بين حقها في التقدم والتهديد القائم فوقها.. فقط هو عنده قضية سلطة برجوازية مرتبطة بالإمبريالية، ولعل إجابته السابقة تتحمل القول إنه ينظر إلى الفلسطينيين كنظرته إلى المطاردين المضطرين إلى الإقامة في أرض المهجر – من نظام حكم رجعي مرتبط بالإمبريالية مثل “النظام السعودي”، حيث سقوط هذا النظام وإقامة نظام شعبي سوف ينهي مشكلة هؤلاء.
إلى جانب الأمين العام يقف “أحمد نصري” ممثل الطبقة “موقع بناء سد الفرات” ليكشف خلفية هذه الرؤية لقضية فلسطين، وهو في معرض الدفاع عنها، يعتبر وجود اليهود في فلسطين أصبح حقيقة تاريخية! وأن اغتصاب فلسطين بالهجرة اليهودية ليس أمراً مفرداً أو طارئاً في التاريخ، فقد حدث من قبل الشيء نفسه، بل بوحشية أكثر، ويشير إلى الهجرات العربية، وإلى الاستعمار الأوروبي لأمريكا يقول نصري:
“ولكن وجود اليهود أصبح حقيقة تاريخية في فلسطين، إن مجتمعاً بشرياً طبقياً، تنطبق عليه كل مواصفات المجتمعات البشرية الطبقية في إسرائيل حالياً … لقد عرف التاريخ الكثير من الهجرات الشبيهة التي تمت في مراحل تاريخية سادت فيها أنظمة اجتماعية عمادها استثمار الإنسان للإنسان، وأخذت أشكالاً أكثر همجية وسادية من الهجرة اليهودية نفسها، الهجرة الأوروبية إلى أميركا والفتك بأهالي البلاد الأصليين، وقبلها الهجرة العربية إلى الكثير من مناطق آسيا، وأفريقيا والهجرات المتتالية التي انطلقت من أواسط آسيا، باتجاه تركيا والمجر وغيرها.. الخ، وطبعاً فإن أحداً اليوم حتى ولو كان من أغلى غلاة القوميين لا يمكن أن يخطر على باله رفع شعار تحرير المجر أو أميركا مثلاً…”.
إن نصري في هذه الرؤية لم يكتف بأن جعل قضية الفلسطينيين شبيهة بقضية الهنود الحمر في أميركا، ولم يكتف بأن جعل المسألة بين شتات فلسطيني، ومجتمع يهودي مكتمل، أي عالجها من منظور أقل من إقليمي. بل راح يماثل بين هذه الهجرات الاستعمارية، وبين الهجرات العربية، فألقى بظلال محرفة وكئيبة على التاريخ العربي، ثم في موقع آخر يدافع عن موقف الحزب من قرار تقسيم فلسطين، ولم يكتف بذلك، بل راح يشبه وقف إطلاق النار عقب عدوان 1967 بقرار التقسيم، وكأنه يبشرنا “بحق إسرائيل” في دعواها عدم العودة إلى خطوط ما قبل العدوان كشرط من شروط شعار “إزالة آثار العدوان”.
وينسى هذا الكادر الشيوعي أن مليونين من الفرنسيين استقروا في الجزائر أكثر من مائة عام، وولدت لهم أجيال على أرض الجزائر – لكن السنين الطويلة هذه لم تغير من حقيقتهم الاستعمارية – ولو جرينا على هذا المنطق لكان من الواجب ليس فقط بقاؤهم في الجزائر. وإنما من واجب الحزب الشيوعي الجزائري أن يقاتل حتى يحتفظ هؤلاء بحقهم في البقاء في الجزائر بعد قيام ثورة التحرير فيها. ولكان واجباُ أن يقف الحزب الشيوعي ـ أي حزب شيوعي، وكل حزب شيوعي ـ في مواجهة حركات التحرير الإفريقية التي تريد أن تنزع الرجل الأبيض من بلادها، وأن تزيل مؤسساته العنصرية. ولو جرينا على هذا المنطق كان من المفروض أن نرى في فلسطين الصليبية الأوروبية التي احتلت هذه البلاد على مدى مائتي عام. ولكان واجباً علينا أن نقف لندين تلك الحرب الطويلة التي خاضها العرب والمسلمون لطرد الصليبيين.
في مقابل هذه النظرة: الإقليمية والشعوبية معاً، يطرح “أحمد فايز الفواز” النظرة الواقعية قبل أن يحدد الهدف، حين يصوغ سؤاله على النحو التالي:
هل ننظر إلى المسألة كحق شخصي، فردي، أم كحق أمة وشعب؟
هل مسألة حقوق الشعب الفلسطيني تنتهي حينما نحدد مَن مِن أفراد هذا الشعب المهجر يريد العودة؟! ومن يريد التعويض!؟ فيأخذ ثمن أرضه في وطنه ولا يرجع إليه.
إذا كان الأمر وفق هذا المنطق فإن الوطن يتحول إلى مجموعة أراض مملوكة ملكية شخصية، لا رابطة بينها غير إرادة مالكيها. ولا يعود هنا للوطن معنى غير التملك؟!
ويحدد أيضاً النظرة إلى العدو حيث السؤال:
هل هجرة اليهود إلى فلسطين كالهجرة الشامية إلى أميركا الجنوبية في أوائل هذا القرن. أفراد يبحثون عن مواطن استقرار لهم نتيجة الفقر أو الاضطهاد أم أنها هجرة قائمة في إطار “منظمة غزو”؟!
إذا كانت هجرة أفراد فليس من الإنسانية الوقوف في وجه أفراد يبحثون عن مأوى لهم، أما إذا كانت في إطار “منظمة غزو”. فيجب تحطيم هذه المنظمة. ويؤكد: “هم لا يأتون كأفراد، بل كمنظمة غزو، وعندما نحطم منظمة الغزو لن يعني ذلك ذبح اليهود أو رميهم بالبحر.. ما يريد شعبنا تحطيم منظمة الغزو التي تتوسع”.
نظرتان مختلفتان للقضية الفلسطينية، لا تجمع بينهما أية عناصر مشتركة، وقفنا عليهما في إطار التعرض لتاريخ الحزب، لأنه على أساس هاتين النظرتين يجري تقييم هذا التاريخ.
إذ بينما يسلط الأمين العام الأضواء على مواقف الحزب ضد الهجرة إلى فلسطين، وضد التقسيم، ويتناسى المواقف المناقضة لهذه المواقف، حين يقول في التقرير السياسي الذي قدمه إلى المؤتمر الثالث 1969 “هكذا ترون أن موقفنا المبدئي من قضية فلسطين كان صحيحاً. إذ نبهنا إلى خطر الصهيونية، ومؤامراتها مع الاستعمار، وقاومنا الهجرة إلى فلسطين. ووقفنا كما تقدم ضد مشروع التقسيم، ولكن النقص الذي وقعنا فيه في الفترة التالية، وخلال مدة طويلة هو أننا أغفلنا التذكير بموقفنا المبدئي حتى أن العديد من رفاقنا وخصوصاً الشباب منهم، ما كانوا يعلمون مثلاً أن الحزب قاوم مشروع التقسيم”.
يتولى “أحمد فايز الفواز” كشف ما في هذا القول من مداورة، ومن محاولة لحني الرأس أمام العاصفة، وذلك حينما يسلط الضوء على ذلك الجزء الذي تناساه الأمين العام في تحديده السابق فيقول: “أما الحقيقة فهي أننا كنا ضد مشروع التقسيم. ولكننا أيدنا قرار التقسيم فور صدوره. كما تشهد على ذلك وثائق حزبية. وكما جرى الاعتراف بذلك في اللجنة المركزية عام 1969.. ذلك بينما كانت جماهير الشعب تملأ الشوارع مستنكرة قرار التقسيم، المهم ألا نتنصل مما قمنا به، وألا نخشى قول الحقيقة للحزب وللشعب، وألا نقول بعنف الحقيقة ” ويؤكد الفواز أن من صفات الثوري أن يقول الحق كاملاً ذلك أن “الرائد لا يكذب أهله”. هكذا قال “محمد” قبل ألف وأربعمائة عام”.