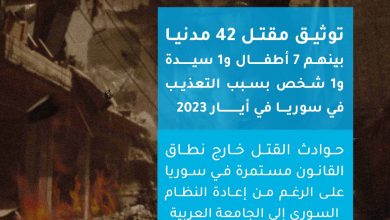الحلقة الثالثة: قراءة في المسار العام للتيار الناصري في سوريا /1
سورية قلب العروبة النابض
منذ 28 أيلول / سبتمبر 1961، اليوم الذي وقع فيه الانفصال الرجعي، وتمت تصفية أول وحدة في التاريخ العربي المعاصر، مثلت الحركة الناصرية في الإقليم السوري الجسم الرئيس في التيار الشعبي المسيس، ومثل رصيدها النضالي الحجم الأكبر من تاريخ النضال الوطني والوحدوي في هذا الإقليم، واستطاعت باستمرار أن تهيمن على مراكز الحركة الشعبية والطلابية والعمالية والفلاحية والتجمعات المهنية، واستمر هذا الوضع حتى بداية السبعينات حين بدأت الصورة تتغير ودخلت عوامل جديدة أدت فيما أحدثته من تغييرات في الواقع الاجتماعي إلى تشويه الطبيعة السياسية لجماهير هذا الإقليم.
ورغم أن خارطة توزع القوى الناصرية تظهر العديد من الأسماء والتشكيلات، منها ما ظهر كرد فعل مباشر وآني على أحداث معينة، ومنها ما دفعت إليه أو نمته وحافظت عليه أجهزة السلطة الحاكمة نفسها في مراحل معينة، ولأغراض مختلفة، فإن المتتبع لهذه الخارطة يلحظ دون عناء أن العمل السياسي الناصري النابع من حاجة جماهيرية حقيقية تمحور حول أداتين تنظيميتين، سادت كل واحدة منهما جزءا من هذه المرحلة، ولم يوجد في ساحة الإقليم السوري تنافس حقيقي ومستمر بين تنظيمات ناصرية.
ففي المرحلة الأولى الممتدة من حدوث الانفصال وحتى تكوين الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1964 كان تنظيم الوحدويين الاشتراكيين هو التنظيم الرئيسي والمهيمن على الحياة السياسية العامة، وعلى جنبات هذا التنظيم وجدت تنظيمات عديدة، جزئية الانتشار والفاعلية، وكان أهم هذه التنظيمات في هذه المرحلة حركة القوميين العرب “فرع سوريا”.
وأما بعد ذلك التاريخ فإن حركة الاتحاد الاشتراكي العربي تستطيع أن تختصر وتمثل معظم تاريخ الحركة الناصرية في الإقليم السوري.
وإذ يظهر العرض المقدم تناقضا واضحا بين الإمكانات الجماهيرية الواسعة للحركة الناصرية، وبين قصور قدرتها عن تحقيق أهدافها رغم جسامة التضحيات التي قدمتها، فإن فهم هذا التناقض يستدعي الوقوف على طبيعة هذه الحركة جماهيريا، وعلى طبيعة الجسم القيادي الذي تولى إدارة صراعاتها، وعلى المراحل التي مر بها، وسيقودنا هذا بالطبيعة إلى تحديد آفاقها من خلال وقفات تحليل وتقييم للأشكال النهائية التي أخذتها في هذه المرحلة.
أولا: الوحدة في الضمير الشعبي في سوريا
بشكل مبكر مثلت قضية الوحدة العربية الضمير الشعبي في سوريا، وإذ نلحظ ولادة الأحزاب والحركات القومية انطلاقا من هذا الجزء من الوطن العربي، فإن هذا لم يكن اتجاها عفويا، وفرضا خارجيا، وإنما جاء تجسيدا للحس الشعبي، وتجاوبا مع طبيعته، ولعل أسبابا عديدة لعبت دورها في الدفع بهذه المسألة إلى الصدارة بين عامة الناس، منها التفتيت الذي مارسه الغرب الاستعماري لبلاد الشام في العصر الحديث، ومنها الخيبة التي نشأت بعد خديعة الشريف حسين في تحركه الذي دعي ب”الثورة العربية الكبرى”، ومنها طبيعة العلاقة التي كانت تربط بين هذه البلاد والسلطنة العثمانية، ومنها أيضا الآثار المترتبة على قضية فلسطين، ونستطيع أن نضيف إلى كل ذلك طبيعة التركيب السكاني / الثقافي لبلاد الشام ، الحاوية على فسيفساء أقليات قومية ودينية ومذهبية، وهذه الطبيعة التي تجعل الاتجاه نحو الوحدة هو المخرج الوحيد من مأزق التفتت والضياع.
واستوعبت قضية الوحدة في الإقليم السوري في داخلها مباشرة وبشكل دائم قضيتي التنمية / الاشتراكية، والحرية / الديموقراطية. لذلك كانت باستمرار تعبيرا عن اتجاه الأكثرية في هذا البلد، ولم يتناقض مع هذا الاتجاه غير نوعين من التشكيلات الاجتماعية / الثقافية:
** النوع الأول: تمثل بكبار الاقطاعيين والرأسماليين وممثليهم في قطاعي المثقفين والجيش. وبالنظر لدرجة النمو الاجتماعي والاقتصادي في سوريا فإن هؤلاء بقوا قلة بكل المقاييس.
لقد أدرك هؤلاء بشكل مبكر أن الوحدة تعني الاتجاه نحو عامة الشعب، بكل ما يتطلبه هذا الاتجاه على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، لذلك إذ أرغم هذا التكتل بالضغط الشعبي، وبحكم الظروف العامة التي كانت تحيط بسوريا على قبول الوحدة، فإنه منذ اللحظة الأولى أدرك بوعي تناقض الوحدة مع مصالحه، وراح يتآمر عليها حتى استطاع ـ حين نضجت الظروف ـ أن يفصمها.
** النوع الثاني: تمثل بالأقليات القومية والدينية، وهذه الأقليات بطبيعة الظرف التاريخي الذي أحاط بها في هذا العصر، وبطبيعة العلاقات التي اصطنعها الغرب معها كانت باستمرار تتخذ موقف المتحفظ من أي اتجاه وحدوي بغض النظر عن المضمون الاجتماعي لهذا الاتجاه، وفي الغالب لم تعبر هذه عن مواقفها من خلال تشكيلاتها الثقافية / الاجتماعية ذات التميز، وإنما من خلال تبنيها الدعوات الأيديولوجية التي تناهض الوحدة، لذلك اندفعت هذه الأقليات باتجاه الحزب الشيوعي، والحزب القومي السوري، وكانت في المقدمة من القوى التي أيدت الانفصال أو تمسكت به.
يجب أن نستدرك هنا فإن هذا التعميم يحتوي في إطلاقه على خطأ داخلي لا يجوز التساهل معه، فالموقف المضاد للاتجاه الوحدوي لم يلف بردائه هذه الأقليات كلها، فعلى المستوى الشعبي أي داخلها كان الموقف أقرب إلى موقف الأغلبية الشعبية الوحدوية، أما على مستوى مثقفي هذه الأقليات فيجب أن لا ننسى أن هناك نماذج يعتز بها، وقفت باستمرار إلى جانب النضال الوحدوي ودفعت الكثير في نضالها هذا المسار الوحدوي، كذلك يجب إدراك الظروف التي دفعت الأقليات أو بعضها على الأقل إلى اتخاذ الموقف المتحفظ من الوحدة، ويأتي في مقدمة هذه الظروف ما لاقته من عنت أواخر حكم العثمانيين، ومن ظلم أيام الحكومات الوطنية الأولى.
إننا هنا لا نحكم على هذا الموقف، فالحكم على الموقف يستدعي تحليل ظروف تشكله، وإنما نصف واقعا كما هو.
ومما يستدعي الرؤية الجادة أن تحالفا حقيقيا ظل قائما بين هذين النوعين من القوى التي وقفت ضد الوحدة رغم تباين الدوافع، ورغم تناقض الأهداف المعلنة بين الإطارات السياسية المجسدة لهذه القوى، بل ورغم الظلم والقهر الذي مارسه الاقطاع ورأس المال ضد الأقليات أو بعضها، فقد وضح هذا التحالف في حدث الانفصال، وفي كل مرحلة من مراحل الحكم الانفصالي المتعاقبة.
إن إدراك الحجم الفعلي لهذا التحالف المضاد للعمل الوحدوي، ووزن تشكيلاته الاجتماعية والسياسية في الحياة العامة في سوريا، يُبقي صحيحا ودقيقا قولنا السابق: إن القضية الوحدوية مثلت باستمرار الضمير الشعبي، وكانت باستمرار في المقدمة من أهداف الحركة النضالية في هذا الإقليم.
ثانيا: الناصرية في الضمير الشعبي السوري
وبقدر مكانة الوحدة في الضمير الشعبي في سوريا حلت الناصرية، وبشكل أكثر تحديدا ومباشرة حلت القيادة الناصرية، ولعل الطريقة التي طرحت فيها الوحدة مع هذه القيادة، والوضع الذي كان الإقليم السوري يعيشه، والطبيعة التي كان يجسدها جمال عبد الناصر، والإقليم الذي كان يقف على رأسه، ساهمت كلها في توكيد التطابق بين مكانة الوحدة، ومكانة الناصرية.
عام 1956، كان عام الشرارة القومية على مستوى الوطن العربي كله، وقد اختلف هذا العام عما سبقه، وسيكون مميزا عما سيلحقه، لأنه العام الذي ارتبطت فيه المعركة القومية بجمال عبد الناصر، وبثورة يوليو، وبمصر، في ضمير الشعب، وفي وعيه وفطرته، وفي حسه السياسي، واتخذت الحركة القومية في هذا الارتباط اتجاهها ومسارها الصحيح.
قبل هذا العام كان الاتجاه القومي لثورة يوليو يسير حثيثا، ويمتد ليعطي تأثيره في أكثر من إقليم عربي، من الجزائر وأقاليم المغرب العربي، إلى اليمن، لكن هذا الاتجاه والدور لم يكن مكشوفا وواضحا أمام الجماهير العربية، وكانت ثورة يوليو تصوغ نظرتها الخاصة والمميزة لجميع شؤون المجتمع: من الإصلاح الزراعي، إلى كسر احتكار السلاح، إلى عدم الانحياز، لكن ذلك كله كان ينتظر حدثا معينا حتى يضعه في أعماق الضمير القومي.
في العام 1956 كان الحدث: التأميم، والعدوان الثلاثي، والانتصار.
لقد خرق جمال عبد الناصر بهذا الحدث كل المتوارث السياسي في التعامل مع الخارج، ومع مصالح الأمة والناس، ولم يكن هذا متوارثنا نحن فقط ـ نحن العرب ـ، وإنما متوارث كل الدول والشعوب والأمم التي أطلقوا عليها اسم” العالم الثالث”، … فهشم بضربة واحدة القوى التي كانت تمثل العدو الأول للجماهير، وكان الحقد عليها يتراكم عميقا في وجدان الشعب.
في هذا العام بالتحديد، وبنتيجة هذا الحدث بالذات، اكتشفت الجماهير مدى التطابق بين مكانة الوحدة عندها، وبين المكانة التي احتلتها هذه القيادة الصاعدة، ومع صوت جمال عبد الناصر من على منبر الأزهر: سنقاتل ….. استرجع وعيها وبلحظة واحدة كل رموز القوة، والوحدة، والعدل والكرامة في تاريخها العربي الإسلامي الطويل، وأسبغت ذلك كله على صاحب هذا الصوت، ولم يكن في وعيها هذا أي قدر من الوهم، بل تعزز هذا الإحساس بمقدار ما عززت مسيرة هذه القيادة تقدمها، وإذ انتفض الشعب العربي في كل العواصم العربية، وفي كل الأرياف العربية يوم الاستقالة عقب النكسة، 1967، ويوم الوفاة 1970، فإنه بذلك كان يعبر عن هذه المكانة لهذه القيادة التاريخية.
من هذه المكانة بالذات يجب أن نفهم ذلك التجسيد الشعبي الذي مثلته الحركة الناصرية في سوريا. وعزز من هذا التجسيد ما كان الإقليم السوري يعيشه منذ الاستقلال وحتى إعلان الوحدة، في شباط / فبراير 1958.
وبعيدا عن الأوهام التي أثارها البعض حول دور “الخطر الأحمر” على سوريا في دفعها إلى الوحدة في تلك المرحلة، فإن ما كان يعتمل في قلب الحياة الشعبية والسياسية العامة في سوريا نستطيع إيجازه في عدد من النقاط:
** حالة من القلق والتفتت في الحياة السياسية الداخلية تمثلت في التنازع السياسي الفج بين القوى البرجوازية وحلفائها على السلطة.
** دخول الجيش في الحياة السياسية على شكل انقلابات، أو مشاريع انقلابات، الدافع الأساسي لها: المغامرة، والارتباط بالخارج، واندماج تلك القوى السياسية مع ممثلي هذه الانقلابات.
** الانفصام الحاد بين حركة الشارع السياسية، وبين المهيمنين على السلطة، وتشكل قوة جماهيرية هائلة وضاغطة، تمثلت في الاتجاهات القومية والبعثية.
** التحام هذه الحركة السياسية الشعبية مع قطاعات عسكرية مثلت امتدادا طبيعيا لها، وقوة أساسية من قواها.
** صراع دولي عنيف حول سوريا بغرض جرها إلى أحلاف ومشاريع استعمارية بأشكال ومسميات عديدة.
** فساد في السلطة السياسية، وفي التحالف الطبقي القائد، لا يمكن ستره، وتلاعب بأرزاق الناس، وتراكم مشاكلهم ووضعهم الاقتصادي والمادي المتردي.
بشكل مختصر، كانت السلطة في سوريا على النقيض من السلطة في مصر، وقد استطاع حدث السويس أن يفتح قنوات الاتصال بدون حدود بين القيادة الناصرية والضمير الشعبي، فجاءت الوحدة خلاصا لسوريا مما كانت تعيشه، وخلاصا للقوى القومية عامة من حالة التوتر والعجز التي اكتنفتها، وتوافقا مع روح هذا الشعب، وأصبح الموقف من أي قوة، ومن أي فكرة يتحدد بمقدار مكانتها: قربا أو بعدا، من تلك القيادة، وسوف يستمر هذا الموقف ثابتا ما استمرت هذه القيادة على قيد الحياة.
ثالثا: الناصرية جدل العلاقة بين الشعبية والحزبية
هذا التطابق بين قضية الوحدة والقيادة الناصرية، وبين قضية الوحدة والتقدم والعدالة، يكشف حقيقة مهمة، يعتبر إدراكها شرطا أساسيا لفهم حقيقة التيار الناصري، ويفسر بعض خصائصه.
إذ استنادا إلى هذا التطابق فإن الجماهير ” الناصرية”، لا تعود تمثل حزبا بعينه، وليست تعبيرا عن نضال حزب أو حركة منظمة محددة، وإنما هي تعبير عن حركة تاريخية ثورية رأت تجسيدها في قيادة جمال عبد الناصر: في المفاهيم والأفكار، في النهج والسلوك الذي عبرت عنه هذه القيادة.
وبطريقة تكاد تكون فريدة بدأت الأحزاب الناصرية تنشأ وتتولد لتستوعب هذه الجماهير، ولتؤطر حركتها، أي أن الأمر هنا صار وكأنه على عكس المألوف.
ونتج عن هذه الحقيقة عدد من النتائج المهمة لابد من تحديدها وفهمها، حتى لا نقف حيارى أمام ظاهرة التناقض بين إمكانات هذه الجماهير وبين ما حققته أحزابها:
** أولى هذه النتائج: تجسدت في ضعف الانتماء الحزبي عند هذا التيار، ولا نقصد عهنا استعصاء هذا التيار على إمكانية التنظيم، وإنما نقصد تولد بعض العوامل التي جعلت ارتباط العضو بالتنظيم، والتيار السياسي لهذا التنظيم أو ذاك، يتسم بالضعف، ونستطيع في هذا الجانب أن نحدد عاملين رئيسيين تولد عنهما هذا الضعف:
العامل الأول: أن الناس في كل تنظيم ناصري مرتبطون أولا بحركة القيادة الناصرية، بفكرها ورؤيتها، واستنادا إلى هذا الارتباط هم مرتبطون بأحزابهم، وهذا يعني أن هذه الأحزاب افتقدت الارتباط الحقيقي لأعضائها، وأصبحت بمثابة وكيلة عن القيادة الناصرية، وصار من السهل على أعضاء تنظيم ما الانتقال إلى تنظيم آخر كلما أحسوا بأن تنظيمهم لا يعبر عن القيادة الناصرية التعبير الصحيح، ولعل هذا الوضع أصبح أكثر وضوحا في المرحلة التي افتتحت بالصدام “البعثي ـ الناصري”، عقب فشل مشروع الوحدة الثلاثية، وانفراد البعث بالسلطة، ومجزرة 18 تموز 1963، إذ صارت هذه المرحلة أشد تعقيدا، وطرحت بعض السياسات المرحلية التي تتطلبها، والتي لا يبدو أن لها ارتباطا مباشرا بقضية الوحدة.
العامل الثاني: أن القيادات في كل تنظيم كانت تستشعر طبيعتها ك”وكيلة” عن القيادة الناصرية أمام حزبها، لذلك اتسمت تصرفاتها دائما بطابع وضرورة تعزيز هذه “الوكالة”، تجاه كل موقف وتصرف، وتجاه كل قضية فكرية، أو تكتيكية، وكان يتولد لديها شعور عميق بضرورة تلقي دعم لها من جمال عبد الناصر، لكن عبد الناصر كان يرعى روحيا كل الحركة الناصرية في سوريا، وكان يكن تقديرا لكل رموزها الناصرية التي استطاعت أن تحتفظ بنقائها الوحدوي وبصحة سلوكها الشخصي، وفي الغالب لم يتعد الدعم هذه الحدود، وهو ما يحرج كثيرا هذه القيادات ويفقدها المكانة المميزة التي تحتاجها لسياساتها ولمواجهة القوى الأخرى، لذلك راحت تستخدم هذا التقدير، والعلاقات التي كانت تقام بينها وبين ورجالات الحكم في مصر للإشارة إلى توفر دعم جمال عبد الناصر لها ولسياساتها.
لقد خلف هذان العاملان ضعفا حقيقيا في البناء التنظيمي، وشل إلى حد ما قدرة التيار الناصري على السير بخطوات حاسمة تجاوبا مع أوضاع معينة بدأت تستجد على الساحة السورية.
** وثاني هذه النتائج: تجسد في الموقف الجماهيري العام من قضية الحزبية، والعمل الحزبي، فتجربة الثورة في مصر مع الأحزاب، وإلغاء عبد الناصر لها، وإعلانه ضرورة أن يكون هناك إطار تنظيمي واحد تعمل وتتفاعل الجماهير من خلاله، دفعت بالتيار إلى اتخاذ موقف سلبي من العمل الحزبي، ولأن قيادة هذا التيار في سوريا كانت بمرتبة ” الوكيل” فإنها راحت تفلسف هذا الوضع، وتحاول أن توجد له قواعد نظرية، ويجب أن نشير هنا إلى أن موقف شطر من هذه القيادات لم يكن فقط تعبيرا عن المضي خلف الانطباع المتولد لدى الجماهير الناصرية من هذه المسألة، ولكنه جاء أيضا متوافقا مع النزوع الطبيعي عندها في عدم الانصياع الى قواعد الضبط والربط، والالتزام برأي الأغلبية، وسيادة مفاهيم الديموقراطية، وكل ما يتولد عن البناء الحزبي من قواعد ومبادئ، هذا النزوع المتأتي من طبيعتها الطبقية، ومن تربيتها العشائرية أو البيروقراطية.
لقد لعبت هذه القيادات دورا كبيرا في إعاقة نمو القدرة التنظيمية لهذا التيار، واتخذت من وضعية ” الوكيل” المضعِف لها، نقطة قوة تصارع من خلالها أي بادرة لبناء حزب ناصري، واستندت في ذلك إلى الجو العام السائد من قضية الحزبية، وكانت تعلم علم اليقين أن جمال عبد الناصر يحاول جاهدا أن يبني في مصر حزبا طليعيا، وأن قضية الحزبية في مصر وموقف الثورة منها مرتبط أشد الارتباط بتجربة الثورة في مصر وبظروفها المرحلية، ولم تفرق هذه القيادات على الإطلاق بين قاعدة “الوحدة الوطنية” التي كانت من أهم مميزات الفكر الناصري، وبين تعدد السبل في تحقيق هذا الشعار، مع العلم أن تجربة الثورة في مصر تشير إلى هذا التعدد، وإلى بحث الثورة المستمر عن أنسب الوسائل لتحقيقها.
وفي العام 1968حين أخذ الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا بصيغة الحزب، ومفهومه، فإنه خاض صراعا حقيقيا مع هذا النوع من القيادات، وقام بجهد متسع على مستوى قواعده ليثبت هذه المسألة، وكان جهده على هذا المستوى مثمرا وفعالا.
** وثالث هذه النتائج: تجسد في تخلف عموم العقل القيادي للحركة الناصرية في سوريا عن الطبيعة التي عبر عنها وجسدها جمال عبد الناصر، وإذا كان جزء من هذا التخلف طبيعيا لما مثله جمال عبد الناصر من “قيادة تاريخية”، ـ وهذا الجزء يشمل كل الحركة الناصرية قوميا، وعموم العقل السياسي العربي ـ، فإن الجزء الآخر يجد تفسيره في مواقع هذه القيادات الاجتماعية والطبقية.
إن الفاصل الجغرافي، والحياتي، بين مواقع هذه القيادات، وبين الثورة الاجتماعية والفكرية التي كانت مصر تعيشها، جعلت إمكانية فرز القيادات في سوريا، وإسقاط بعضها، وتصليب بعضها الآخر، إمكانية عسيرة تحتاج إلى جهد شاق على مستوى العلاقة مع الجماهير، والنضال خلف شعار الوحدة.
وساهمت المواجهة المستمرة مع ” سلطة البعث ” التي ترفع شعارات الاشتراكية وهي في عزلة عن الجماهير وبتصادم معها، وتفرغ هذه الشعارات من مضامينها الحقيقية إبان عملية التطبيق، ساهمت في التمويه على الطبيعة المتخلفة لهذا النوع من القيادات الناصرية، كما ساهمت أيضا في إبقاء شعار الوحدة هدفا استراتيجيا معلقا في الهواء، دون أن يترجم الى خطط مرحلية، إلى خطط تكتيك ثوري في مقدور انجاز بعض مراحله أن يدفع إلى تحقيق المراحل الأخرى.
إن محاولة تكتيل الجهد الشعبي خلف شعار “إزالة آثار العدوان”، ـ وهي المحاولة التي اندفع لتحقيقها الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا، وكانت الدافع لتجربة الجبهة الوطنية في العام 1968 ـ احتاجت منه إلى جهد جد كبير على مستوى التيار الناصري، وإلى صراع مرير على مستوى ذلك النوع من القيادات، لأنه كشعار يتطلب تجميع الطاقات، وحشد الجهود، وتسليط الأضواء حول هدف مرحلي سابق على هدف الوحدة، أي يعني دخول مرحلة تكتيكية محددة، وهذا منطق حين تقبله هذه القيادات تكون قد اقتربت من احتياجات المرحلة، وبالتالي عرضت نفسها للاختبار والكشف، وهذا ما دعاها إلى دخول هذا الصراع، والوقوف في وجه التجربة، وبصورة أكثر دقة وشمول، هو ما دعاها للوقوف في وجهة أي محاولة لمرحلة شعار الوحدة ـ أي جعل الوصول إليها على مراحل ـ، مهما كان الدافع إلى ذلك.
كان الفارق بين جمال عبد الناصر وبين قيادات التيار الناصري في سوريا فارقا رهيبا، يزداد اتساعا مع نمو الثورة في مصر وتجذرها، واستفادت هذه القيادات من كل العوامل والظروف المحيطة بها لتثبيت أدوارها ضمن هذا التيار. وبالتالي في إضعافه، وضاع كثير من جهد التيار وطاقاته، وتبددت إمكاناته على الفعل نتيجة هذا الوضع.
كان التيار الناصري يبدو للناظر إليه من الخارج ” قوة جماهيرية عظمى”، لكن نتيجة تضارب اتجاهات الحركة لدى قياداته، وتنازعها، وتعطيل بعضها البعض الآخر جاءت المحصلة ضعيفة.
وأخيرا فإن التركيبة الاجتماعية للتيار الناصري عامة، وللتيار الناصري في سوريا وهي تركيبة قائمة على قاعدة “تحالف قوى الشعب العامل”، تحول بالتدريج من عامل قوة له، إلى عامل ضعف، وذلك نتيجة غياب الحزب وتغييب الديموقراطية، أي نتيجة غياب الاستراتيجية الواضحة والتكتيك المحدد، وغياب القوة الجاذبة الطليعية المتماسكة.
فالتيار الناصري هو التيار الشعبي، وهو حركة شعب بأسره، لكن هذا الشعب ريفي بالغالب، فلاحي بأكثره، لذا هو أكثر تعلقا بالمفاهيم الذاتية والفردية، وضعيف الارتباط بالفكر الحزبي، والبنية الحزبية، وقد أفادت تلك القيادات من هذه الظاهرة وجعلتها مركز قوة إلى جانبها بحيث كانت باستمرار تقاوم اتجاهات البناء الحزبي بسعة تأثيرها في القطاع الريفي من التنظيم، وبسهولة الامتدادات الفكرية والشخصية التي حققتها في هذا القطاع.
وحين أمكن إسقاط هذا النوع من القيادات بخروج “مجموعة الجراح” ـ عقب عدوان 67 ـ وبدأت عملية بناء حزب ناصري في سوريا فإن الثمن كان غاليا، حيث افتقد الجهاز الحزبي فاعليته المميزة في قطاع الريف، وافتقد أيضا قابلية التفاعل مع الرأي الآخر، أي مع المعارضة، إذ كانت كل معارضة في السابق هي تمهيد لانقسام أو سقوط، وبدلا من أن تصفي هذه الانقسامات بنية التنظيم ونقيها، وتجعلها أكثر قدرة على تمثل الطبيعة الحزبية حيث هناك دائما رأيان، ودائما هناك تعايش بين الأغلبية والأقلية، وبين المستويات الأدنى والأعلى، على قاعدة المؤتمرات، واللجنة المركزية، ودور واختصاص كل منهما، فإن الآية انقلبت، وتم تثبيت النظرة إلى أي معارضة على أنها بداية خلل كبير، وخطوة نحو انقسام آت، وبالتالي أصبحت تواجه بحذر شديد، ويتم التعامل معها بتوجس وخشية، تدفع بها إلى أن تتحول إلى ظاهرة انقسام حقيقي، أو إلى ظاهرة انكفاء مؤذية لقدرة التنظيم وإمكاناته.
رابعا: القوة المنظمة للناصرية في مواجهة عوامل الضعف
رغم هذه الأوضاع، ورغم تدني مستوى المشاركة الشعبية في العمل السياسي المنظم على المستوى الناصري، فإن القوة المنظمة لهذا التيار كانت كثيفة إلى درجة غطت على ما أصابها من ضعف، وتتضح هذه الكثافة حين مقارنتها مع الحركات والأحزاب السياسية الأخرى.
لقد أثبت هذا التيار قوته في حدثين منفصلين، ومختلفين بالطبيعة والظرف، وكان ذلك بعد كل مراحل التطور التي مر بها، والانقسامات والتساقطات التي أصابته، لكن أيضا بعد بناء حزب متماسك له.
ففي العام 1969 أجرت السلطة في سوريا انتخابات للنقابات العمالية والمعلمين، وهما قطاعان من أضخم القطاعات في البلد، وضمت قائمة السلطة في الغالب تحالفا من: حزب البعث، الحزب الشيوعي، حركة الوحدويين الاشتراكيين، حركة الاشتراكيين العرب. وتقدم الاتحاد الاشتراكي العربي لمواجهة هذا التحالف وحده في عدد من المحافظات الرئيسية، وحتى تستقيم رؤية هذه المواجهة، وحتى نقدر الثقل الحقيقي الذي برز به الاتحاد الاشتراكي، لابد من الإشارة الى أن هذا التنظيم غير معترف به، وتقوم السلطة باستمرار بملاحقة عناصره وكوادره، وفي هذا التوقيت بالتحديد، كان لايزال عدد وافر من قياداته في السجن ـ نتيجة تجربة جبهة 1968. كذلك لابد أن نضع إلى جانب أحزاب السلطة، أجهزتها المختلفة وفي المقدمة منها: أجهزة الأمن، وتنظيمات الشبيبة، والاتحاد النسائي، وكل إمكانات الحركة، والإمكانات المادية والمعنوية التي توفرها السلطة.
ورغم أن قوائم السلطة خرجت بنصيب وافر، فإن اختبار القوة هذا جاء لصالح الاتحاد الاشتراكي، وخلف وراءه توترا فيما بين هذه القوى المتحالفة بعد أن عجزت عن تحقيق التكافؤ وهي مجتمعة مع هذا التنظيم المنفرد.
في العام 1971 عقب الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ الأسد ـ وزير الدفاع آنذاك ـ ضد سلطة الحزب السابقة المتجسدة بالثلاثي” صلاح جديد، يوسف زعين، نور الدين الأتاسي”، فإن الاتحاد الاشتراكي المؤيد لهذه الحركة ـ آنذاك ـ استطاع أن يؤمن لها غطاءً جماهيريا تتضاءل أمامه أي معارضة، في الوقت الذي كانت فيه أجهزة الحزب الحاكم كلها، ومنظماته النقابية، والنسائية، والشبيبة، وحلفاؤه الشيوعيون، يقفون ضد هذه الحركة علنا وبشكل حاسم، ولم يكن الدعم الجماهيري الذي وفره الاتحاد الاشتراكي ـ بالحجم والفاعلية ـ يخطر على بال قيادة الحركة، ولا على بال القوى المضادة لها، حتى أن هذه الكثافة ولدت حساسية مباشرة عند الحزبيين القلائل المؤيدين لحركة 16 تشرين الثاني.
هذان الاختباران لقوة الاتحاد الاشتراكي والتيار الناصري لهما أهمية خاصة تختلف عن كل الاختبارات السابقة، وتتميز عنها بالطبيعة وبالظروف المحيطة بها.
** فالاختبار الأول جاء في وقت كانت فيه قيادة جمال عبد الناصر توجه كل اهتمامها إلى البناء العسكري داخليا، وإلى مواجهة العدو الإسرائيلي من خلال حرب الاستنزاف، كما كانت على المستوى القومي تقوم بالمحاولات المستمرة لتجميع الجهود المتنافرة والمتصارعة لأنظمة الحكم العربيةـ تلك الجهود التي تتمحور حول سياسة مؤتمرات القمة، ومحاولات بناء الجبهة الشرقية، ثم سياسة العمل المشترك مع “الأنظمة التقدمية”، وجاءت أيضا بعد أن أعيد فرز الاتحاد الاشتراكي في سوريا، وخرجت منه القيادات ذات الفكر المتحفظ واليميني، بما أحدثه هذا من هزة عامة على مستوى الحكم، والعضوية، والانتشار.
** والاختبار الثاني جاء بعد رحيل جمال عبد الناصر، ووصول التوتر العسكري والسياسي بين مصر والعدو الصهيوني، إلى أقصاه مع قبول مبادرة روجرز، وبعد مجازو أيلول في الأردن، أي أن الناصرية في هذه المرحلة كانت بأفكارها وسياساتها في موقع اختبار، وفي وضع مواجهة مع تيارات عدة، وسط ظروف بالغة التعقيد.
باختصار فقد كان الاختباران بمثابة مؤشر على مدى نضج هذا التيار، ونضج المسألة التنظيمية لديه، أي مدى ارتباطه بالتنظيم، وتجاوبه مع رؤية ومواقف طلائعه المنظمة، وأثبتت التجربة أنه أصبح على درجة عالية من الانضباط*.
وأعطى هذه التيار ثقة عزيزة جدا وثمينة جدا لقيادة الاتحاد الاشتراكي التي جسدها باستمرار الدكتور جمال الأتاسي، وكان هذا تفاؤل جاد في أن يستطيع هذا التنظيم أن يعطي الكثير على مستوى تحقيق الأهداف التي جمعت الجماهير الشعبية تحت راياتها.