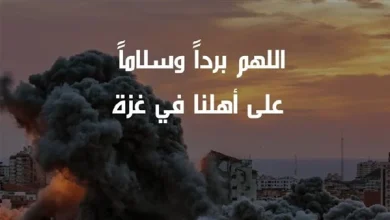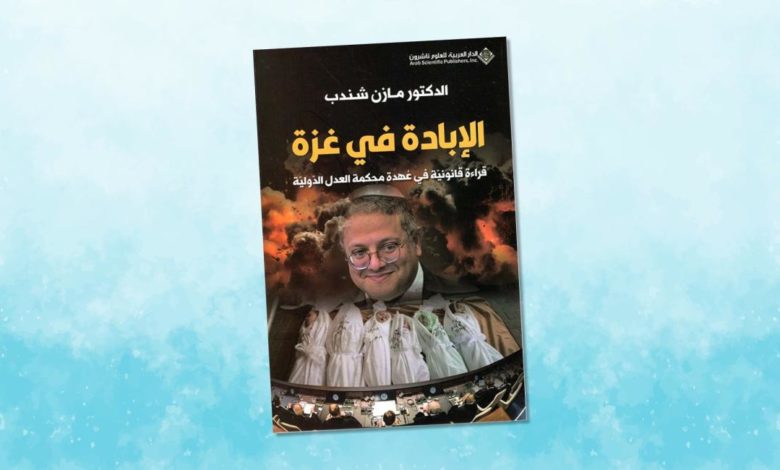
صدر لأستاذ القانون في الجامعة اللبنانية، مازن شندب، كتابه “الإبادة في غزّة… قراءة قانونية في عهدة محكمة العدل الدولية” (الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2025)، يعيد، للمرّة الألف، طرح السؤال بشأن العدالة الدولية ووجودها وفاعليتها، فيما تبدو تلك العدالة غارقةً في سبات طويل أو حالة غيبوبة سريريّة (كوما)، غير معلوم إن كانت ستستيقظ منها أو تفارق الحياة. هذا النوع من الشكّ نقع عليه في المبحث الثالث من الفصل الأخير، إذ يوضّح الباحث أنّ العدالة الدولية مرتبطة بالمصالح السياسية للدول الكبرى، ما ضاعف الالتباس النصّي والقانوني، حتى باتت ازدواجية المعايير سمةً غالبةً في المقاربات للجرائم الدولية من خلال منح مجلس الأمن (وهو سياسيّ بامتياز) حقّ الإحالة، فهذا خطأ في النصّ والآلية القانونيَّين.
يُقدّم الفلسطينيون غالباً “ضحايا” لا “أصحاب حقّ قانونيّ”، ما يقلّل من ثقل مرافعاتهم أمام المحاكم والهيئات الدولية
بهذه الطريقة، استخدمت دول دائمة العضوية في مجلس الأمن حقّ النقض (فيتو) لمنع إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على سبيل المثال إلى المحكمة، على حساب عدم الإفلات من العقاب. كما يوضّح الدكتور شندب أن مجلس الأمن يملك وفقاً لنظام المحكمة الدولية امتيازاً آخر نصّت عليه المادة 16، فيحقّ للمجلس وقف البدء أو الاستمرار في التحقيق أو المقاضاة في قضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مدة 12 شهراً قابلةً للتجديد. ومن الجليّ أن هذا النصّ يلغي كل هيبةٍ للمحكمة أمام مجلس الأمن الذي يحقّ له التدخّل في أيٍّ من مراحل المحاكمة، أي إنّ القانون والعدالة يعطّلان نفسيهما، بنفسيها.
الأدهى، بحسب القانونيّ الباحث، أنّ تدخّل مجلس الأمن في طلب التأجيل، في أيّ مرحلة، يفضي إلى ضياع الأدلة، وفقدان آثار الجريمة، وتقييد الإجراءات، ومن ثم التحقيق والمتابعة، ما يحدّ من تطبيق الولاية القضائية التكميلية، فضلاً عن أنّ هذا الامتياز المُعطى لمجلس الأمن يشكّل عائقاً أمام تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وإذا كان صحيحاً أنّ العدالة الدولية هي أسيرة السياسة والمصالح السياسية، فإن الولايات المتحدة تملك استراتيجيةً مزدوجةً حيال هذه العدالة، يمكن تسميتها بـ”استراتيجية الاستخدام والتمييع”، تستخدم صروح العدالة الجنائية أداةً، وتسخفّ ضرورتها في مكان آخر.
مشكلة أخرى، بحسب شندب، تبدّت جليّةً في الهمجية الإسرائيلية في غزّة، إذ تعمد الأمم المتحدة إلى مقاربة ما يحدث في القطاع المنكوب من الباب الإنساني لا من الباب الجرمي القانوني، لتبدو هذه المنظمة الدولية إلى جانب “إسرائيل” سياسياً، وإلى جانب الغزّيين إنسانياً. وشتّان بين وجهتي النظر هاتين. ثمّة تحدٍّ في الاعتراف العالمي بأن هناك إبادة جماعية قائمة فعلاً، فالمناقشات غير المنتهية بين الخبراء القانونيين والسياسيين تؤدّي إلى تأخير في إطلاق التوصيف النهائيّ، عدا تجاهل الدول الفاعلة والقوية للإبادة حين يعرّض الاعترافُ بها مصالحَها الاستراتيجية أو الاقتصادية للخطر. ومن هنا يرى شندب أن العديد من التعديلات يُفترض أن تطاول اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ونظام روما الأساسيّ الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، ومنها وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليَّين حينما تظهر مؤشّرات حقيقية تفيد بقرب ارتكاب إبادة جماعية، وإلزامه باتخاذ قرار يمنع حدوث الإبادة.
تفرض التجربة الفلسطينية إعادة التفكير في مفهوم العدالة الدولية ذاته، فهل العدالة ممكنة في ظلّ نظام دولي غير ديمقراطي تتحكّم فيه خمس دول؟ وهل يمكن أن تبقى فكرة العدالة حيّةً في ظلّ تضارب المصالح واحتكار القوة والمال؟ كشفت القضية الفلسطينية أن العدالة الدولية، كما تُمارس اليوم، ليست عالميةً وليست عادلةً، بل هي مرآة للهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية للدول القوية والفاعلة في المسرح الدولي. فمنذ ثمانية عقود يعيش الفلسطينيون تجربةً استثنائيةً من الإقصاء الممنهج عن العدالة. ومع كل مجزرة ومذبحة إبادية في غزّة، يتضح أن العدالة ليست مبدأً دولياً بقدر ما هي امتياز تمنحه القوى الكبرى لمن تشاء.
ثمّة ازدواجية في المعايير، فالقانون الدولي والعدالة الانتقالية (التدابير القضائية للمحاسبة والتعويض وضمان عدم التكرار) تُطبّق بصرامة على دول أو جهات معينة (كما في حالتي يوغوسلافيا أو أوكرانيا) فيما يتمّ تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة، رغم توثيقها من منظمات أممية تابعة للأمم المتحدة، وسواها من المنظمات الدولية المُعترَف بها. وثمّة عجز في منظومة الأمم المتحدة، فالقرارات التي تصدر عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، والمتعلّقة بفلسطين، تُنتهَك بانتظام من دون أيّ آلية تنفيذ. كما يُصدر مجلس حقوق الإنسان تقاريرَ قويةً، لكنها تبقى رمزية وغير ملزمة. فضلاً عن غياب آليات الردع التي تجعل الاحتلال يواصل ممارساته من دون خشية من العقاب. الخلل إذن ليس في النصوص القانونية، بقدر ما هو في احتكار القوة التنفيذية للعدالة الدولية من القوى الاستعمارية القديمة نفسها.
العدالة الدولية اليوم، ليست عالميةً وليست عادلةً، بل مرآة للهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية للدول القوية
بات الخطاب الحقوقي الدوليّ فارغاً من مضمونه، حين يطبّق على فلسطين، إذ يساوي بين الضحية والمعتدي باسم التوازن والحياد، فالسرديّة الفلسطينية تُهمّش في المحافل القانونية الدولية، ويُقدّم الفلسطينيون غالباً “ضحايا” لا “أصحاب حقّ قانونيّ”، ما يقلّل من ثقل مرافعاتهم أمام المحاكم والهيئات الدولية. وتقصير العدالة الدولية في فلسطين ليس عجزاً قانونياً بقدر ما هو إخضاع للسياسة الدولية المنحازة. ففي حين أنّ الجرائم الإسرائيلية موثّقة على نحو تام، تغيب إرادة المحاسبة بفعل الهيمنة الأميركية ـ الغربية على بنية النظام الدولي. ولذلك، فإنّ العدالة الدولية، التي أضحت مصطلحاً خاوياً، هي أمام امتحان وجوديّ (أي متعلّق بوجودها أو عدم وجودها)، فإمّا تُنصف القضية الفلسطينية، أو على الدنيا وعدالتها السلام.
المصدر: العربي الجديد