
في مقالي السابق «الهجري: هل يقود الدروز إلى الفناء؟» تناولتُ شخصية حكمت الهجري وخياراته الراهنة التي بدت وكأنها تقود الطائفة الدرزية نحو عزلة قاتلة. غير أنّ النقاش لا يكتمل من دون العودة إلى التاريخ الطويل الذي صنع هذه الجماعة وحدّد مسارها. فالأحداث الكبرى التي عاشها الدروز عبر ألف عام من الزمان، منذ نشأتهم في القاهرة سنة 1021م وصولًا إلى مأساة 1860، ثم الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانقسام الموقف بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، كلها تشكّل مرآة تعكس حاضرهم. وما لم تُقرأ هذه الدروس بوعي، فإنّ الأخطاء ذاتها مرشحة للتكرار، وبنتائج ربما تكون أشد فتكاً.
أولاً: البدايات في القاهرة
الحاكم بأمر الله، الخليفة الفاطمي السادس، حكم مصر ما بين 996 و1021م. شخصيته المتناقضة وقراراته الغريبة أحاطتها الأساطير. حين اختفى فجأة، أعلن الداعية حمزة بن علي أنّ الحاكم لم يمت بل غاب وسيعود في آخر الزمان. ومن هنا انطلقت الدعوة الجديدة، التي صاغها حمزة والمقتنى بهاء الدين عبر رسائل الحكمة.
عقيدتهم تمحورت حول التوحيد، وتأويلات خاصة للقرآن، واستلهام من الفلسفة اليونانية والعهد القديم، مع إيمان ثابت بـ”تناسخ الأرواح”. ومع إغلاق باب الدعوة سنة 1043م، تحوّلت الطائفة إلى جماعة مغلقة، تورّث العقيدة بالميلاد فقط.
هذا الانغلاق منحها قوة تماسك، لكنه أورثها عزلة. وحتى اليوم يظل التفريق قائمًا بين “العُقّال” الذين يُسمح لهم بمعرفة الأسرار بعد سن الأربعين، و”الجُهّال” الذين يظلون بعيدين عن عمق العقيدة. وهذا الغموض جعلها عرضة للتأويلات والاتهامات، من تأليه الحاكم إلى اعتباره مجرد مظهر للعدل الإلهي أو المهدي المنتظر.
ثانياً: من الاضطهاد إلى الجبال
بعد رحيل الحاكم وصعود ابنه الظاهر، بدأ الاضطهاد يلاحق أتباع الدعوة. فرّ كثيرون إلى بلاد الشام حيث كان للمقتنى بهاء الدين نفوذ. هناك، في الجبال الوعرة، وجدوا المأمن والملجأ. استقروا في الشوف اللبناني، وفي وادي التيم قرب حاصبيا وراشيا، وفي قرى فلسطين مثل الجليل وجبل الكرمل.
منذ ذلك الحين صار الجبل هوية. الانعزال في القمم، التحصين بالحجارة السوداء، والعيش في مجتمعات مغلقة. وكأن التضاريس تحوّلت إلى عقيدة ثانية.
ثالثاً: الزعامات الأولى – من المعنيين إلى الجنبلاط والأطرش
رغم العزلة، لم يبقَ الدروز خارج السياسة. تحالفوا مع الأسرة المعنية في جبل لبنان، ثم آل شهاب. وفي القرن السابع عشر حدث استثناء نادر: سُمح لوالي حلب السني علي جنبلاط باعتناق المذهب سنة 1611م، ثم لمحمد الأطرش القادم من اليمن. ومن هذين البابين وُلدت زعامتان كبيرتان: آل جنبلاط في لبنان وآل الأطرش في سوريا.
هذا الاستثناء غيّر مسار التاريخ. صار للموحدين زعامات إقطاعية مسلحة، تجمع بين العصبية الدينية والتحالفات السياسية.
رابعاً: نحو 1860 – توازن هش
منذ القرن السابع عشر، اشتد الصراع بين الدروز والموارنة في لبنان. فرنسا دعمت الموارنة، وبريطانيا دعمت الدروز. الجبل تحوّل إلى ساحة صراع بالوكالة. وكان ما حذّر منه ابن خلدون واضحاً: “العصبية إذا استقوت بغيرها أفسدت على الناس اجتماعهم”. لقد انقسم الناس بين رعايا فرنسا ورعايا بريطانيا، حتى جاء الانفجار الكبير سنة 1860.
خامساً: مجازر 1860 – الدم الذي غيّر وجه المنطقة
في ربيع 1860، أوهمت بريطانيا الدروز بإمارة لهم في جبل لبنان، فانطلقوا إلى الحرب مدجّجين بالسلاح. بعض التقارير الأوروبية ذكرت أنّهم استعانوا بمقاتلين غير محليين، بينهم مرتزقة (كما تشير ليلى طرازي فواز وأسامة مقدسي)، فيما يرى مؤرخون آخرون أنّ تلك الإشارات كانت جزءاً من خطاب دعائي فرنسي–ماروني لتضخيم حجم العنف المنسوب للدروز.
لكن المؤكد أنّ الصراع تحوّل إلى مجازر واسعة النطاق. ففي جبل لبنان قُتل ما بين 12 و15 ألف مسيحي، ودُمّرت 380 قرية و560 كنيسة و42 ديرًا و28 مدرسة. وفي دمشق، حيث لجأ الآلاف، وقعت الكارثة الثانية: خلال ثمانية أيام من تموز، قُتل 5 آلاف، وأُحرقت 1500 دار، ودُمّر 270 منزلاً و200 متجر.
الحصيلة النهائية كانت مرعبة: ما بين 17 و20 ألف قتيل، 5 آلاف أرملة، 16 ألف يتيم، وعشرات الآلاف من النازحين. لقد قُتل 15% من مسيحيي لبنان ودمشق، أي نحو 5% من سكان المنطقة كلها.
سادساً: فرنسا والمتصرّفية
ردّت فرنسا بإرسال 6000 جندي. وبسطت سيطرة الموارنة على الجبل، وأُنشئت “المتصرّفية” سنة 1861: جبل لبنان تحت حكم والٍ مسيحي كاثوليكي أجنبي. انتهت بذلك زعامة الدروز للجبل، وتحولوا إلى جماعة خاسرة تبحث عن ملاذ جديد.
سابعاً: دمشق – بين الدم والرحمة
في دمشق امتزج المشهد بالدم والإنقاذ. وبينما ذُبح الآلاف، كان الأمير عبد القادر الجزائري يفتح بيوته وخاناته لحماية المسيحيين، ويرسل رجاله لردع المهاجمين. سجّل الرسام الفرنسي جان بابتيست هويسمانس ذلك في لوحاته الشهيرة.
إلى جانب ذلك، فتحت عائلات دمشقية بيوتها للنازحين. أحمد فارس الشدياق كتب أن الدمشقيين “واسوا اللاجئين بما استطاعوا”، ومحمد كرد علي وصف كيف جُهّزت الأسواق والحمامات خصيصًا لهم. إنها دمشق التي تجمع بين الدمعة والرحمة في آن.
ثامناً: من لبنان إلى حوران وإدلب
بعد 1860، دفعت بريطانيا الدروز إلى حوران لتأسيس إمارة بديلة. استقر معظمهم في السويداء، حيث أعادوا إحياء القرى المهجورة. قلة بقيت في صحنايا وجرمانا، بينما اتجهت بعض الأسر شمالًا إلى جبل السماق في إدلب.
هناك وُجدت أصلاً قرى درزية منذ القرن السادس عشر: قلب لوزة، كنصفرة، معرة مصرين. لكن في 1954، شنّ أديب الشيشكلي حملات ضدهم متهماً إياهم بالانفصال، فأُجبروا على الرحيل. انتهى بذلك الوجود الدرزي في الشمال السوري، وصار جبل العرب هو معقلهم الأساسي.
تاسعاً: زعامات السويداء – السيف والعقل
في السويداء تبلورت معادلة خاصة ميّزت الجبل عن سواه: آل الأطرش أمسكوا بزمام السيف والزعامة الميدانية، فيما آل الهجري احتكروا المرجعية الروحية والعقل. ومع صعود الشيخ إبراهيم الهجري (1804–1889) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أصبح المرجع الأوحد تقريبًا في جبل العرب، يُلقّب بـ«شيخ العقل» أو «الشيخ الأكبر»، رغم أنّ التقليد الدرزي التاريخي يقوم على وجود شيخي عقل في كل بلد، أحدهما في الشوف بلبنان والآخر في حوران بسوريا. غير أنّ الظروف السياسية والاجتماعية آنذاك جعلت من إبراهيم الهجري صاحب الكلمة الفصل بلا شريك فعلي في الجبل.
ومع دخول القرن العشرين وبداية الانتداب الفرنسي، أعيد تنظيم الموقع الديني للطائفة في سوريا على نحو أوضح، فأصبح العُرف يقضي بوجود شيخي عقل رسميَّين يتقاسمان المرجعية، حفاظاً على التوازن الداخلي. وفي العقود الأخيرة استقر المنصب بين الشيخين يوسف الجربوع وحمود الحناوي، غير أنّ حكمت الهجري خرج عن هذا الإطار بابتداع صفة جديدة لنفسه هي «الرئيس الروحي للطائفة»، وهو لقب لا أصل له في التقاليد الموروثة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول مشروعيته ودلالاته
عاشراً: الدروز والعروبة
في القرن العشرين، حمل شكيب أرسلان راية العروبة، حتى لُقّب بـ”أمير البيان” لفصاحته. أعلن انتماءه إلى الفقه السني الشافعي وكتب دفاعاً عن قضايا الأمة. كمال جنبلاط، زعيم لبنان، أرسل طلابه إلى الأزهر ووقف مع الفلسطينيين حتى اغتياله سنة 1977. سلطان باشا الأطرش رفع شعار “الدين لله والوطن للجميع”.
لكن الوجه الآخر كان قاتماً. بعض الدروز في فلسطين تعاونوا مع العصابات الصهيونية عام 1948، ثم التحقوا بالجيش الإسرائيلي عام 1956 بقرار من مشيخة العقل. ومع ذلك، ظلّت أصوات مثل سميح القاسم تذكّر بأن العروبة قادرة على استيعاب الجميع.
أحد عشر: حكمت الهجري – استعادة العزلة؟
اليوم، يقف حكمت الهجري في موقع بالغ الحساسية. شيخ العقل الذي ورث منصبه، لم يكتفِ بالروحيات، بل اقتحم السياسة. خطابه الأخير، حين شكر واشنطن وتل أبيب وتجاهل المكوّن السني العربي، بدا وكأنه يعيد إنتاج أخطاء 1860، يوم راهن الدروز على بريطانيا وخسروا لبنان.
المفارقة مريرة: سلطان باشا الأطرش جعل الجبل منصة للوحدة، وحكمت الهجري يبدو كأنه يسحبه نحو عزلة قد تفضي إلى الفناء.
الخاتمة
التاريخ واضح في دروسه. حين اندمج الدروز في قضايا الأمة كانوا في طليعة الصفوف. وحين انعزلوا أو راهنوا على الأجنبي، دفعوا أثماناً باهظة. ابن خلدون قال: “من اعتصم بعصبيته دون جامع الأمة، غلبته عصبية أشد منها”. هذا هو الاختبار الذي يواجههم اليوم.
فهل يتعلم حكمت الهجري من سلطان باشا الأطرش وعبد القادر الجزائري، فيجعل العروبة حصن البقاء؟ أم يكرر خطايا الماضي، فيقود طائفته إلى عزلة لا عودة منها؟
المراجع
1- أحمد فارس الشدياق – رسائل وتقارير عن أحداث 1860: شهادات معاصرة نشرها في الصحافة والمراسلات العثمانية والأوروبية، تكشف تفاصيل دقيقة من قلب الحدث.
2- محمد كرد علي – خطط الشام، الجزء السادس (دمشق، 1925): عمل موسوعي تناول تاريخ دمشق وجغرافيتها، خصّص فيه فصولًا عن مجازر 1860 وآثارها الديموغرافية والاجتماعية.
3- أرشيف القناصل الأوروبيين (فرنسي، بريطاني، نمساوي) في بيروت ودمشق، 1860: تقارير دبلوماسية رسمية وثّقت أعداد الضحايا والقرى المدمرة، وأظهرت حجم التدخل الأوروبي في رسم مستقبل الجبل.
4- لوران دارفيو – مذكراته وتقاريره عن جبل لبنان والدروز: كتب في القرن السابع عشر، لكن أعيد الاستشهاد به لفهم البنية الاجتماعية والسياسية السابقة للانفجار الطائفي.
5- جان-باتيست هويسمانس – لوحاته ووثائقه عن الأمير عبد القادر الجزائري: مصدر بصري وأرشيفي يصوّر الدور البطولي للأمير في حماية المسيحيين بدمشق.
6- ليلى طرازي فواز – An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860 (University of California Press, 1994): دراسة حديثة رائدة تربط بين العوامل الاجتماعية والسياسية والدولية التي فجّرت العنف.
7- أسامة مقدسي – The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon (University of California Press, 2000): يقدّم إطارًا فكريًا لفهم نشوء ثقافة الطائفية وتحوّلها إلى عنف منظّم.
8- إيغور تيموفييف – Kamal Jumblatt (بالروسية، مترجم): يربط بين أحداث 1860 وبروز وعي سياسي درزي ولبناني جديد، أثّر في زعامات القرن العشرين مثل كمال جنبلاط.


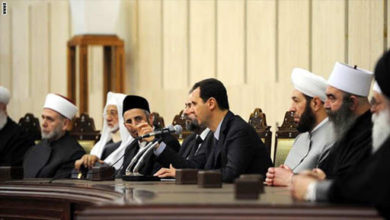





في القسم الثاني من مقال الكاتب”الهجري: هل يقود الدروز إلى الفناء؟” يضيف لمحة عن تاريخية الصراع بين الموحدين الدروز والطوائف الأخرى بالمنطقة والتدخلات الخارجية التي تقود هذه الصراعات لتضعهم في منطقة الخطر والتهجير و… ليخلص بقوله “فهل يتعلم حكمت الهجري من سلطان باشا الأطرش وعبد القادر الجزائري، فيجعل العروبة حصن البقاء؟ أم يسير بمشورة الخارج؟.