
(1)
لم تعد المجاهرة بالدعوة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل تتطلّب جرأةً، أما نبرة التحدّي الزائفة المطلّة من غياب الحرج فتُفشي سوءَ توقيتٍ في ظروف التغوّل الإسرائيلي الأميركي في الإقليم الذي يُغني المستقوي به عن الجرأة والشجاعة غير الأدبية. إضافة إلى ذلك، تنمّ تبريرات هذا التأييد عن جهلٍ (أو استهبال) سادرٍ في وهمٍ مفادُه بأن التطبيع مع إسرائيل هو إكسير الحياة وحلّال الاستعصاءات الداخلية والخارجية.
لا سحر في العلاقات الدولية، ولا ترياق لقضايا المجتمع والاقتصاد؛ فعلاجها مرهونٌ بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة نظم الحكم وبنية المجتمعات وثقافة نخبها. ويعزّز الاندفاعُ نحو التطبيع قناعةً إسرائيلية مفادُها بأن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة؛ ما يشجّعها على الاستثمار فيها، والتمسّك بنهج الإملاءات في التعامل مع العرب.
يصحّ هذا كله من المنظور العملي البراغماتي؛ أي إذا حيّدنا الأخلاق جدلاً، مع أن تحييدها خطيئةٌ تجاه المجتمعات، حتى من الناحية العملية. ففي مراحل التغير والتطور السريع والاضطراب الاجتماعي الذي يرافقها، ليس ثمّة ما يفوق صمود الأخلاق العمومية أهمية، أو يعلو منزلة على المعايير المشتركة التي تقوم عليها الثقة المتبادلة بين الأفراد، وقدرتهم على توقّع سلوك الآخرين وردود فعلهم.
يعزّز الاندفاعُ نحو التطبيع قناعةً إسرائيلية مفادُها بأن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة؛ ما يشجّعها على الاستثمار فيها، والتمسّك بنهج الإملاءات في التعامل مع العرب
تُمارَس هذه الجرأة الزائفة في تكرار الكلام عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مشرقنا لتعويد الناس على الفكرة (تطبيع التطبيع)، فيما هم على مسافة صفر زماناً ومكاناً من اقتراف الإبادة. وفي الوقت الذي تصبح فيه قضية فلسطين رمزاً للعدالة وعنواناً لتمرّد الشباب في الغرب على التواطؤ مع الجريمة الإسرائيلية، كما تجلّى أخيراً في مهرجان غلاستونبيري، الذي رفرفت فيه أعلام فلسطين فوق مئات الآلاف من الشباب، جمهوراً ومؤدّين، يهتفون “الحرّية لفلسطين”، ويدينون الممارسات الإسرائيلية بنبرةٍ خاليةٍ من الاعتذار وتبرير الذات.
تلويث البيئة التواصلية المرئية والمسموعة بتكرار الكلام عن التطبيع مع إسرائيل، بالتزامن مع ارتكابها ما ترتكب من جرائم على مرأى ومسمع الجميع، هو محاولة في دفع الناس إلى تبليد مشاعرهم، والدوْس على قيمهم. وقد تفيد آثار هذه الصيرورة على مناعة الناس الأخلاقية في سياقات أخرى أيضاً.
يأتي هذا التحلّل الاحتفالي من الضوابط الأخلاقية بعد هزيمة إسرائيل ما يسمّى محور المقاومة، التي يفاخر بها بنيامين نتنياهو؛ إذ ينسب إلى نفسه دحْر حزب الله، والتخلّص من النظام السوري السابق. إنه لا يفعل ذلك لأغراض الدعاية الانتخابية الداخلية فحسب، بل لتذكير معارضي هذا المحور من العرب أيضاً بأن إسرائيل هي التي تحميهم وتقود المنطقة، وليس تحالف الأنظمة مع أميركا، ولا أوهام الديمقراطية عند من أيّدوا عملية التغيير في البلدان العربية من هذا المنطلق.
لا ترتبط عدالة قضيّة فلسطين بنُظمٍ حاكمة استترت بها وبالصراع مع إسرائيل. ولا يجوز أن يفوتَنا أن تلك الأنظمة استخدمت التمسّك بالصراع مع إسرائيل بوصفه أحد مصادر شرعيّتها بسبب عدالة قضية فلسطين ومركزية الصراع مع إسرائيل عند شعوبها، فعدالة الموقف من إسرائيل سابقةٌ على استخدامه، وهي التي جعلت هذا الاستخدام مُجدياً لمن مارسه.
من اتهم نظام الأسد بالتفريط بالجولان لا يُعقل أن يستخفّ بعد سقوط النظام بضمّ إسرائيل الجولان وباعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الضمّ
حسبان بعض من عارضوا تلك الأنظمة (مع التشديد على كلمة بعض) أنه بانهيارها تصبح الدعوة إلى التحلّل من فلسطين سائغة يعني إمّا أنهم لم يؤمنوا يوماً بعدالة قضيتها وبضرورة الصراع مع إسرائيل، وإما أن معارضتهم هذه الأنظمة لم تكن مبدئيّة فعلاً. من عارض نظاماً مثل نظام الأسد لأنّه نظامٌ مستبد وظالم بحقّ شعبه لا لأسباب أخرى، كأسباب الذين عارضوا نظام الأسد وأعجبوا بنظام صدّام حسين، يفترَض أن يُعارض الظلم عموماً، بما في ذلك الظلم الاستعماري. من اتهم نظام الأسد بالتفريط بالجولان لا يُعقل أن يستخفّ بعد سقوط النظام بضم إسرائيل الجولان وباعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الضم؛ إلا إذا كان يعرف أنّ نظام الأسد لم يُفرّط بالجولان، وأنه يمكن أن يكون النظام دكتاتوريّاً مستبدّاً بغيضاً ومعادياً لإسرائيل فعلاً في الوقت ذاته. ولكن الموضوع برمّته لا يخصّه، فقد استخدم هذه التهمة جزافاً لأغراض التشهير السياسي فحسب، مع أن الطغيان تهمةٌ كافية، ولا يعوزها أن تُلصق بالدكتاتور تهمة العمالة لإسرائيل إمعاناً في تقبيحه. لكن يبدو أنه بالنسبة إلى البعض (البعض فقط من المبشّرين بالتطبيع) لم يكن أساس المشكلة في الطغيان، كما هو بالنسبة للشعب السوري فعلاً، بل في هوية الطاغية، ولا في احتلال الجولان أو التفريط بأرضٍ سورية، بل في أمور أخرى. ولم تكن المشكلة في الدوْس على حقوق الإنسان، إذ لا حساسية خاصة لديه تجاه هذا الموضوع. ولا سيّما أن ترامب، أول من اعترف بضم الجولان والقدس لإسرائيل، أعلن جهاراً نهاراً أن لا حساسية لديه تجاه حقوق الإنسان، ويمكن للنظم التي تعترف بزعامته العالمية أن تفعل ما تشاء داخل دولها.
(2)
كان جليّاً أنّ إسرائيل سوف تُهاجم إيران بعد تمكّنها من توجيه ضرباتٍ قاسيةٍ إلى حزب الله والمقاومة الفلسطينيّة في غزّة عموماً، وحركة حماس خصوصاً، وذلك بثمن حرب إبادة حقيقيّة شُنّت على الشعب الفلسطيني. كانت المسألة مسألة وقت. وقد تحكّمت الإدارة الأميركية بتوقيت الهجوم على إيران، فقد حاولت إخضاع إيران من دون اللجوء إلى الحرب. ونرجسية ترامب تدفعه إلى التصريح بما يشاء متوقّعاً أن تحصل أمورٌ بمجرّد إطلاق تصريحاته. وفي المقابل، حاول نتنياهو جاهداً، منذ بداية هذا العام، أن يُبكّر الهجوم كي لا تفوَّت فرصة فقدان إيران عنصر الردع الذي تمثل بالحلفاء المحيطين بإسرائيل. كان يعلم أن الخطابات الإيرانية وغير الإيرانية عن إزالة إسرائيل من الوجود ليست جوفاء وعقيمة وغير رادعة كالعادة فحسب، بل مفيدة له أيضاً للاستعطاف والتمسكن على الساحة الدولية وتسويق العدوان المخطّط له بوصفه دفاعياً ضد من يبغي إزالة إسرائيل من الوجود، ويعلن ذلك في كل مناسبة. ووقعت الحرب وانضمّت الولايات المتحدة كما خطّطت إسرائيل.
لا إسرائيل كلية القدرة كما يصوّرها دعاة التطبيع، ولا هي هشّة سريعة الانكسار، أوهى من خيوط العنكبوت، كما يصوّرها التهريج الذي أَدلج ومَذْهبَ حتى لفظي الانتصار والهزيمة، فأعطبهما
وقع الهجوم على إيران، الدولة المفترض أنّها في حالة استنفار وتأهّب منذ أربعة عقود. ومع ذلك، بانت رثاثة أمنها الداخلي وفداحة اختراقه، وهو موضوعٌ يطول شرح أسبابه. وعلى الرغم من الاختراق الأمني الواسع والتفوّق التكنولوجي الهائل المتمثل أساساً بسلاح الطيران المتقدّم والمزوّد بآخر تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفتك الأسلحة، والذي يكاد يقسّم البشرية بين من يملكونه ومن لا يملكونه، لم يسقط النّظام الإيراني ولا انهارت الدولة. فلا إسرائيل كلية القدرة كما يصوّرها دعاة التطبيع، ولا هي هشّة سريعة الانكسار، أوهى من خيوط العنكبوت، كما يصوّرها التهريج الذي أَدلج ومَذْهبَ حتى لفظي الانتصار والهزيمة، فأعطبهما، وأخرجهما من التواصل العقلاني بين البشر.
تقف إيران في مواجهة معضلاتٍ حقيقيةٍ داخليةٍ وخارجية، والخيارات أمامها محيّرة: إعادة البناء التي تقتضي رفع الحصار من جهة، ومواصلة مشروعها النووي تحدّياً لمزاعم أميركا وإسرائيل في إخضاعها من جهة أخرى (هل يشكل توثيق العلاقة مع الصين وروسيا بديلاً فعليّاً من رفع العقوبات الأميركية والأوروبية؟ ربما)؛ ومواجهة الاختراق الأمني بتشديد القبضة الأمنية داخليّاً من جهة، وتقوية التيار الإصلاحي وتخفيف القبضة الأمنية والانفتاح على مجمل الشعب الإيراني الذي سوف تزداد ضغوطُه من جهة أخرى. وتقف حركات المقاومة منذ ما قبل “7 أكتوبر” أمام معضلاتٍ أخرى متعلقةٍ بفهمها إسرائيل ومجتمعاتها والدول العربية. كانت تعرف المعضلات، ولكنها عاشت حالة إنكار، وأصبحت الآن مضطرّة إلى مواجهتها. وجميعها قضايا يطول الشرح فيها.
ربما يرى الذين تعالت أصواتهم داعية إلى التطبيع مع إسرائيل أن فلسطين قضيّة إيران ومحور المقاومة حصريّاً، كما تدّعي إيران، وإسرائيل وأتباعها في دكاكين التحليل السياسي الأميركيّة في واشنطن، التي تصدّر موظفين إلى الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، والتي تبشّر بأنه أزفت ساعة ضم دول عربية جديدة (“عظيمة” و”جميلة”، بتعابير ترامب) إلى معاهدات السلام المُسمّاة إبراهيميّة. فبدلاً من أن تعوق الحرب على غزّة المسيرة “الإبراهيمية”، فإنها سرّعتها في نظرهم؛ لأن القوة ببساطة تنفع، وثمّة عربٌ جاهزون لمكافأة إسرائيل على المقتلة والإبادة وجميع القبائح المرتكبة في غزّة، والتي لا عدّ ولا حصر لها.
غنيٌّ عن القول إن هذا ليس موقف الفلسطيني الذي تُحتل أرضه وشقيقاه الأردني واللبناني اللذين يخشيان ما ينتظر بلديْهما، والوطني السوري الذي تحتل إسرائيل أرضه، والعربي عموماً؛ المشرقي والمغربي، الذي لا يعجبه تغييب العرب في الإقليم، وتقاسم النفوذ في دوله بين دول إقليمية غير عربية، ويرفض أن يكون بلدُه وحكّامه خاضعين للهيمنة والعربدة في منطقة نفوذ لدولةٍ تتعامل مع المنطقة كلها بوصفها خطراً استراتيجياً، ولا تثق بأحدٍ إلا إذا اصبح عميلاً لها، وتؤمن بمنطق القوة لا غير. وقد قدّمت النموذج تلو الآخر على ثقافتها العنصرية ورؤيتها إلى العرب. الفلسطيني ابن الضفّة الغربيّة المتضامن تضامناً تامّاً مع شعبه في قطاع غزّة، مع أنه لا يتفق مع عمليّة حركة حماس في 7 أكتوبر، يعرف جيّداً أن الاستيطان في الضفّة يتوسّع بشكلٍ مذهل، وأنّ ضم أجزاء منها إلى دولة الاحتلال قادمٌ لا محالة ضمن سكرة القوّة الإسرائيليّة نفسها، والتواطؤ الأميركي الكامل معها، ودعوات التطبيع العربي التي تشجّع إسرائيل على ارتكاب ما يحلو لها.
ثمّة عربٌ جاهزون لمكافأة إسرائيل على المقتلة والإبادة وجميع القبائح المرتكبة في غزّة، والتي لا عدّ ولا حصر لها
من ناحية أخرى، غير الفلسطيني الرافض للتطبيع مع إسرائيل لا يقدّم مكرمةً إنسانيةً لشعب آخر ولا يتجاوز الوطنية إلى القومية العربية بالضرورة، مع أنه لا خطأ في ذلك بحدّ ذاته. فثمّة بعد وطني في هذا الموقف؛ في سوريّة، مثلاً، ثمة مسألة وطنية خالصة متعلّقة بوحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه. ومن دون ذلك، يستحيل التفكير بمستقبل سورية؛ فهذه شروط ابتدائية لأي استقرار وازدهار اقتصادي. ولنضع الديمقراطيّة جانباً ونتحدّث عن بناء الدولة السوريّة الحديثة! لا يُمكن بناء دولة سوريّة حديثة من دون وطنيّة سوريّة تقوم على المواطنة السورية وتتجاوز التقسيمات السياسية الطائفية الدخيلة، ويُعزّز تماسكها الانتماء العربي لغالبيّة سكّانها، وكذلك الاعتراف بالهويّة القومية الكرديّة والعيش معها في ظل مواطنة متساوية ووطن سوري واحد.
أحد أهم عناصر ذلك كلّه الانتماء إلى الوطن السوري والتمسّك بسيادة الدولة وحدودها الترابيّة، وهذا يشمل هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. فالتنازل عن ذلك ليس مسألة هامشيّة، بل إنه تعبيرٌ عن هشاشة الوطنيّة السوريّة، وهشاشة الانتماء إلى الوطن، وتقديم الطائفيّة السياسية والإقليمية الجهوية على الانتماء الوطني؛ وهي الرزايا التي تُعرقل بناء دولةٍ حديثةٍ في سورية والعراق ولبنان (ولا أرى أن أحداً سوف يقدم عليه، ولذلك يجري البحث عن بدائل لا تتطلب مثل هذا التنازل).
لا يمكن بناء سوريّة الحديثة على أساس تفضيل الولاءات الطائفيّة سياسيّاً على الانتماء الوطني وعلى المواطنة المتساوية في دولة حديثة. مسألة الدولة التي تثيرها الطائفية السياسية والعصبيات على أنواعها هي أساس مصيبة المشرق العربي، ولا سيما قوس العراق وسورية ولبنان المعوّل عليه في نهضة الشرق، والمنكوب بالطائفيات السياسية على أنواعها. تلك الطائفية السياسية التي تنتج الطوائف السياسية العابرة حدود الدولة الوطنية وتُضعفها من الداخل والخارج.
لا يُمكن بناء دولة سوريّة حديثة من دون وطنيّة سوريّة تقوم على المواطنة السورية وتتجاوز التقسيمات السياسية الطائفية الدخيلة
ليس على من يُفكّر بأنّ الصراع مع إسرائيل هو العائق أمام النمو الاقتصادي والازدهار إلا أن يتأمل قليلاً بالطرف المقابل في هذا الصراع، الذي يعيش حالة حربٍ متواصلة حتى بعد أن حقق سلاماً مع دولتين عربيتين وهدوءاً مستداماً على الحدود السورية. يزدهر اقتصاد إسرائيل على الرغم من الحروب التي تخوضها، وحوفظ على دولة مؤسّسات، وديمقراطية لليهود على الأقل. ولا تجد الدول المعادية عملاء في أجهزة دولة الاحتلال التي يصعُب اختراقها، لأن ثمّة إجماع على الأمن الوطني. توجد بالطبع مصالح متعدّدة متنافسة وصراعاتٌ لا حصر لها، ولكنها لا ترتفع فوق الأمن الوطني. يسهِّل البعض التحدّي المطروح بالقول إنّه الدعم الأميركي والتحالف مع الغرب. ولا شكّ في أن إسرائيل لن تصمُد في أي حرب أكثر من أسابيع معدودات من دون الدعم الأميركي، كما أن التبنّي الغربي لإسرائيل عنصر أساسي في قوتها. لكن الأساس هو حسم مسألة الدولة، وبناء دولة المؤسّسات الحديثة التي يتغلب الإجماع الذي تحظى به على الانتماءات الطائفيّة، وحتى على الاستقطاب الديني العلماني. على هذا الأساس، تُفيد المُساعدات الغربيّة، ومن دونها لا يُفيد المال أحداً، مثلما لم يفد في حالات عربية كثيرة.
من لا يكفيه إمعان النظر في حال الطرف الإسرائيلي في الصراع، تكفيه ملاحظة الطرف المصري في السلام، ومدى إسهام السلام مع إسرائيل في حل مشكلاته، أو مدى تضييقه الفجوة التكنولوجية بين مصر وإسرائيل. إسرائيل المُعسكرة التي تُحارب باستمرار تزدهر وتتقدّم؛ وتتوسّع الفجوة بينها وبين مصر التي لم تخض حرباً منذ عام 1973 والمتمسكة بمعاهدة السلام رغم المجازر التي تُرتكب بحق أشقائها الفلسطينيين قاب قوسين من حدودها، والتي كان يمكنها وقفها.
(3)
لا دعوة إلى الحرب هنا، فالحروب كارثة على الجميع، بل حديثٌ عن “مزايا” التطبيع المزعومة. ليس المطلوب من الدول العربيّة أن تُحارب إسرائيل بموجب توقيتٍ تُحدّده المقاومة الفلسطينية أو غيرها، ولا شنّ حروبٍ عموماً، بل يتوقع منها رفض الهيمنة الإسرائيلية، ومنعها من إبادة شعبٍ شقيق. وثمّة وسائل عديدة للقيام بذلك.
الحرب على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة قائمة منذ عام 1948، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل ليست دعوةً إلى السلام العادل الذي تقبل به شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الفلسطيني، بل هي، في الحقيقة، دعوة إلى التحالف مع إسرائيل بوصفها طرفاً في هذه الحرب المتواصلة في غياب سلام عادل.
الدعوة إلى التطبيع، في الحقيقة، دعوة إلى التحالف مع إسرائيل بوصفها طرفاً في هذه الحرب المتواصلة في غياب سلام عادل
والمبتغى إدراك أنّ آخر ما تحتاجه المجتمعات العربيّة انهيار الأعراف والمعايير الأخلاقيّة التي تُنظّم التفاعل بين الناس في مجتمع متحضّر. بناء الأمّة على أساس المواطنة (من دون التخلي عن الهويّة القوميّة للأغلبيّة)، وبناء المؤسّسات الحديثة، ومحاربة الطائفيّة بأشكالها كافة، والتّخلّص من العقليّة المليشياويّة والفصائليّة القائمة على التعالي على المجتمعات الوطنية، والتعسّف والعداء للقانون وسيادة القانون، عوامل كفيلة بتحقيق الاستقرار والنهوض بالاقتصاد وكسب احترام العالم وفتح الأبواب للاستثمارات والتفاعل مع الدول الأخرى. يتطلب ذلك التمسّك بالسيادة على أراضٍ احتلتها إسرائيل بالقوة، واستشهد شباب الوطن دفاعاً عنها (شباب من الوطن العربي كله في حالة جبل الشيخ)، والتحلّي بالإيمان بالقضايا العادلة، والتمييز بين الدولة والوطن من جهة، والحكومة والسلطة المتغيرة من جهة أخرى، فالدولة والثوابت الوطنية لا تتقلب مع تعاقب السلطات. لا دولة من دون سلطة، ولكن من دون هذا التمييز بين السلطة والدولة لا تُبنى دولٌ حديثة.
المصدر: العربي الجديد



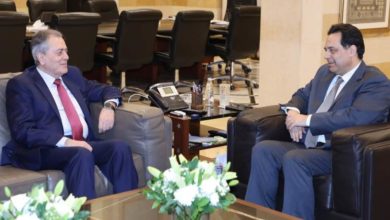



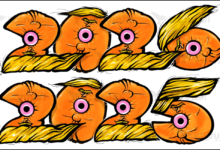
إنطلاقاً من قناعة قادة الكيان الصhيوني والإدارة الأمريكية بأن الأنظمة العربية لا ينفع معها سوى القوة والتهديد بها للإنصياع لإرادتها ، لتكون الحرب الإSرائيلية المتوحشة القذرة بغزة وحربها على لبنان بحجة حزب الله ومن ثم على إيران وإستمرار إنتهاكها للسيادة السورية بدون رد، فهل التطبيع الإبراهيمي قادم مع سورية ولبنان والسعودية؟ أم إختلاف الأجندات سيلغيها؟؟