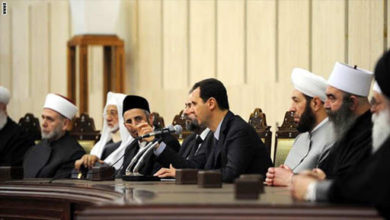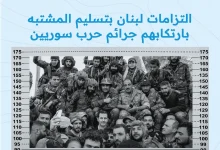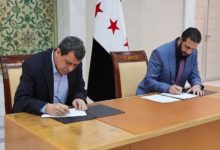أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتاريخ 13 أيار/مايو 2025 عن قراره برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في حدث مثّل انعطافاً محورياً من شأنه إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد، وذلك بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات والانهيار المؤسسي. حيث لا يقتصر أثر هذا القرار على تخفيف القيود المالية والتجارية المفروضة فحسب، بل يمتد ليعيد فتح أبواب النظام الاقتصادي السوري نحو العالم، ويوفّر نافذةً واسعةً لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي حين يشكّل هذا الرفع انفراجاً قانونياً وسياسياً مهماً، إلا أن أثره الاقتصادي يتجلّى بشكل تدريجي ومتعدد المراحل، تبعاً لمدى قدرة الدولة ومؤسساتها على التقاط الفرص وتجاوز التحديات البنيوية العميقة التي خلّفتها الحرب. حيث تبدأ هذه المراحل من التأثيرات النفسية والنقدية المباشرة، مروراً بإعادة تنشيط القدرات الإنتاجية والبنية التحتية، وصولاً إلى إعادة اندماج الاقتصاد السوري في السوق العالمية وتحول نمط نموه من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير.
المرحلة الأولى: على المدى القريب ما بين ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً
يتوقّع أن تشهد سوريا بداية تحوّل اقتصادي تدريجي لكنه واضح، مدفوع في الأساس بتغيّر جذري في المناخ النفسي العام للأسواق، إلى جانب التحوّل المؤسساتي الأولي في آليات السياسة النقدية والمالية. وربما سيلاحقه استقرار في سعر الصرف في هذه المرحلة لا يُفهم فقط كنتيجة مباشرة لتخفيف الضغط على سوق القطع، بل كمؤشر مركّب لما يُسمّى في علم الاقتصاد بتوقّعات السوق أو “توازن التوقّعات”، حيث يؤدي رفع العقوبات إلى تحوّل جذري في سلوك الفاعلين الاقتصاديين من حالة الترقب السلبي إلى الانخراط الإيجابي. هذا الانخراط يتجلّى بانخفاض الطلب المضاربي على الدولار، وتراجع ظاهرة الاكتناز بالعملة الأجنبية، وعودة الثقة بالعملة المحلية كأداة للادخار والمعاملات.
مصرف سوريا المركزي سيكون في موقع أكثر فاعلية خلال هذه المرحلة؛ حيث يبدأ العمل على المواضيع التقنية اللازمة لربط سوريا بمنظومة “السويفت”، كما يُفترض أنه سيمتلك مرونة أعلى في التدخّل في السوق من خلال أدوات وآليات التدخّل المباشر، خاصة مع تخفيف القيود المفروضة على التعاملات الخارجية. وهو ما سيسمح له بإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي من خلال القنوات النظامية. ومن المتوقّع أيضاً أن ينخفض الهامش بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء نتيجة لانخفاض الحافز على التحويلات غير النظامية، ما يحدّ من دولرة الاقتصاد ويُعيد جزءاً من السيولة إلى النظام المصرفي الرسمي، الأمر الذي يعزّز من فاعلية السياسة النقدية ويُخفّض مستوى التوقّعات التضخمية.
أما على صعيد السوق السلعي، فإن تحسّن قدرة القطاع التجاري على تأمين السلع الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية والدوائية، نتيجة تخفيف القيود على الاستيراد وإعادة تفعيل منظومة التوريد الدولية، سيؤدي إلى ارتفاع مرونة العرض في السوق المحلية. حيث إن هذه المرونة تسمح بامتصاص جزء من الطلب المتراكم خلال السنوات السابقة، وتؤدي إلى انحسار تدريجي في الضغوط التضخمية التي كانت ناجمة عن اختناقات العرض، وليس عن زيادة فعلية في الطلب، ما يخلق حالة من تصحيح تدريجي للأسعار من الأعلى نحو التوازن.
ومن الناحية القطاعية، فإن التحسّن المتوقع في خدمات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، سيكون له أثر اقتصادي مضاعف، يتمثّل من جهة في تخفيض الكلف التشغيلية للصناعات والخدمات، ومن جهة أخرى في تحسين نوعية الحياة الحضرية، ما يعزّز الاستقرار الاجتماعي. حيث إن دخول قطع الغيار والمستلزمات التقنية لمحطات الكهرباء ومحطات الوقود، فضلاً عن عقود التوريد التي قد تُبرم مع أطراف إقليمية، يسمح باستعادة جزء من القدرة الإنتاجية لشبكة الطاقة الكهربائية، وبالتالي تحسين الإنتاجية العامة للاقتصاد.
على المستوى المالي، من المرجّح أن تشهد التحويلات الخارجية ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة لخفض درجة المخاطر المرتبطة بإرسال الأموال إلى سوريا، وتحسّن القدرة على استخدام القنوات المصرفية النظامية. وهذا التدفق النقدي، وإن كان مصدره غير إنتاجي، إلا أنه يُشكّل في هذه المرحلة عنصراً محورياً في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً مع استقرار نسبي في الأسعار وتحسّن العرض. كما أن هذه الحوالات قد تبدأ في التحول التدريجي من مجرد دعم معيشي إلى مساهمات في تمويل مشاريع صغيرة، وهو ما يحدث عادة في المراحل الانتقالية لاقتصادات ما بعد العقوبات.
من جهةٍ أخرى، فإنّ النشاط التجاري الداخلي سيشهد تحسّناً واضحاً، ليس فقط بسبب عودة تدفّق السلع، بل أيضاً نتيجة تحسّن المزاج الاقتصادي العام الذي يلعب دوراً كبيراً في تحريك الأسواق، حيث يبدأ التجّار والمستهلكون بالخروج من حالة التقشّف والانكماش النفسي التي ميّزت سنوات الحرب. هذا التحسّن في المزاج يُترجم عملياً إلى زيادة في دورة رأس المال القصير الأجل، ما يعزّز السيولة في السوق ويرفع من دوران النقد، وهو أحد مؤشّرات النشاط الاقتصادي الحيوي في الأمد القصير.
في الحقيقة، إنّ المرحلة الأولى ستشكّل فترةً مفصليةً لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية، حيث يجب على الحكومة أن تستثمر هذا المناخ الإيجابي المؤقّت في إعادة تنظيم السوق، ومكافحة الاحتكار، وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية. فالفترة الأولى بعد رفع العقوبات غالباً ما تشهد اندفاعاً كبيراً من السوق الموازي للعودة إلى الشرعية، ما يتيح للدولة إمكانية فرض ضوابط عادلة وفعّالة قبل أن يتم تثبيت أنماط جديدة من الفساد أو التهرّب. بالتالي، إنّ النجاح في هذه المرحلة يعتمد على قدرة الدولة على تحويل الفرصة السياسية إلى بنية اقتصادية جديدة أكثر مرونةً وانفتاحاً وانضباطاً.
المرحلة الثانية: على المدى المتوسّط بين عام إلى ثلاثة أعوام
في المرحلة الثانية، سيبدأ الاقتصاد السوري في الانتقال من مرحلة “الاستجابة النفسية والمؤسساتية الأولية” إلى ما يمكن تسميته بمرحلة “إعادة التكوين الإنتاجي”، حيث تتبلور التحوّلات الهيكلية في القطاعات الرئيسية، وتبدأ الديناميكيات الاقتصادية الفعلية بالظهور، نتيجة لتحسّن بيئة الأعمال، وتراجع التكاليف الخارجية، وتعزيز الثقة النظامية بالمؤسّسات الاقتصادية الوطنية. هذه المرحلة تتميّز بدخول عناصر حقيقية في معادلة النمو، وتُرصد عادةً من خلال ارتفاع معدّلات الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي الحقيقي، ونمو في معدّلات التوظيف والإنتاج، مع تحسّن تدريجي في بنية الميزان التجاري.
الركيزة الأساسية لهذه المرحلة هي استعادة دورة الإنتاج المحلي في القطاعات الأساسية، خاصةً الزراعة والصناعة التحويلية، وهما القطاعان اللذان تضرّرا بشكل مباشر نتيجة القيود المفروضة على تدفّق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والصيانة. حيث إنه مع رفع العقوبات، يبدأ توفّر هذه المدخلات بالتحسّن تدريجياً، من خلال إعادة الربط مع الأسواق العالمية المزوّدة للآلات، والأسمدة، والمبيدات، والخامات الصناعية، وقطع التبديل، والتجهيزات التكنولوجية المتوسّطة والخفيفة، ما يسمح بإعادة تشغيل منشآت كانت معطّلة أو تعمل بأقلّ من طاقتها التصميمية. وهذا التحوّل في العرض الإنتاجي المحلي يدفع نحو حالة من “الإزاحة الاستيرادية”، حيث تبدأ المنتجات المحلية بمنافسة المستوردات التي كانت تهيمن على السوق بفعل غياب البديل.
في الزراعة، سيؤدّي تحسّن الوصول إلى المدخلات الزراعية المحظورة سابقاً إلى زيادة الإنتاجية الكلية للعامل الواحد وللوحدة الزراعية، ما يُترجم إلى توسّع تدريجي في الرقعة المزروعة ونموّ في الإنتاج الفعلي للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن، إضافةً إلى المحاصيل التسويقية ذات العائد السريع. هذا التحسّن لن يكون كمّياً فقط، بل نوعيا أيضاً، نتيجة دخول تقنيات زراعية حديثة، بما فيها نظم الريّ الحديث وأساليب الزراعة البيئية والعضوية، خاصةً مع انفتاح محتمل على المنظمات الدولية المعنيّة بالتنمية الزراعية. وعلى المدى المتوسّط، قد تشهد بعض المناطق الزراعية انتعاشاً ديمغرافياً، نتيجة عودة الفلاحين الذين هجّرتهم الحرب.
أمّا في الصناعة، فستبدأ عملية إعادة تموضع تدريجية للقطاع الصناعي ضمن الخارطة الاقتصادية، حيث يُتوقّع أن تنتعش الصناعات الصغيرة والمتوسّطة أولاً بسبب مرونتها وقربها من المستهلك، لا سيما الصناعات الغذائية، والكيماوية، والنسيجية، في حين تحتاج الصناعات الثقيلة إلى أفق زمني أطول بسبب متطلّبات رأس المال الكبير والتمويل المؤسّسي. كما أنّ دخول معدّات إنتاج جديدة، وعودة دورات الصيانة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، كلّها عناصر تسهم في إعادة تدوير الطاقة الإنتاجية، وتُعزّز ما يُعرف في علم الاقتصاد بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، والتي تُعدّ مؤشّراً على كفاءة الاقتصاد وقدرته على النمو من دون الاعتماد الكامل على التوسّع الكمّي في رأس المال والعمل.
التأثير الآخر المحوري في هذه المرحلة هو استعادة الثقة بالاستثمار، سواء من الداخل أو من الخارج؛ حيث إنّ الانفراج في البيئة القانونية والمالية، وعودة الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالضمانات الدولية أو التعاون مع مؤسسات مالية تنموية، سيجعل من المناخ الاستثماري في سوريا أكثر جاذبية، خصوصاً ضمن قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والطاقة. حيث تسعى شركات من الدول المجاورة أو من الجاليات السورية في الخارج إلى دخول السوق، مستفيدة من فجوة العرض الكبيرة والفرص الواعدة، ومن المرجّح أن تبدأ شراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع محدّدة تتطلّب تمويلاً متوسّط الأجل ومخاطر معتدلة، كإنشاء وحدات توليد طاقة متوسّطة، أو معامل إنتاجية في مناطق صناعية مخططة، أو إعادة تشغيل منشآت حيوية كانت خارج الخدمة.
على مستوى البنية التحتية، سيكون للمرحلة الثانية دور محوري في تفعيل مشاريع إعادة التأهيل الكبرى، سواء في قطاع النقل عبر إصلاح الطرقات، أو في قطاع الصحة من خلال ترميم المستشفيات وتزويدها بالمعدات التي كانت محظورة، أو في التعليم عبر إعادة بناء المدارس وتحسين شروط التعليم الفني والتقني. حيث إنّ هذه العملية، وإن كانت تُموَّل تدريجياً في البداية، إلا أن أثرها الاقتصادي متعدّد الجوانب؛ إذ تسهم من جهةٍ في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن جهةٍ أخرى ترفع من الإنتاجية المستقبلية للعنصر البشري، وتعزّز جودة رأس المال البشري، ما يُمهّد لمرحلة نموّ أكثر عمقاً واستدامة.
سوق العمل في هذه المرحلة سيبدأ في التمدّد النوعي، حيث لا يقتصر الأمر على زيادة عدد الوظائف فحسب، بل على تنويعها وتحسين شروطها. فمع تحرّك عجلة الإنتاج والاستثمار، تتولّد فرص تشغيل جديدة تتطلّب مهارات مختلفة، ما يدفع باتجاه إعادة تأهيل القوّة العاملة، ودخول فئات عمرية جديدة إلى سوق العمل، لا سيما بين الشباب والنساء. وهذا الانتعاش في التوظيف سينعكس على الطلب الكلّي، وعلى تحسّن الحالة المعيشية للأسر، ما يرفع مستوى الادخار ويزيد من القدرة الاستهلاكية بشكل مستدام، من دون أن يقود بالضرورة إلى تضخّم إذا كانت الاستجابة الإنتاجية كافية.
أما على مستوى القطاع المالي، فإنّ المصارف السورية ستبدأ باستعادة جزء من دورها التقليدي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، خاصةً مع عودة الربط الجزئي بالنظام المالي العالمي، وإمكانية الحصول على خطوط تمويل خارجية، أو عبر مؤسسات تنموية متعددة الأطراف. هذا الانفتاح المالي سيُحدث تغييراً هيكلياً في وظيفة النظام المصرفي، الذي سينتقل من التركيز على خدمة الرواتب والتحويلات إلى تقديم أدوات تمويل استثماري وإقراضي أكثر تطوراً، ما يضع أسساً أولية لاقتصاد أكثر حيوية ومبنيٍّ على علاقة إنتاج–تمويل حقيقية.
وفي موازاة ذلك، فإنّ التجارة الخارجية ستبدأ في التوسّع مجدداً، مع توجّه سوريا لإعادة تموضعها التجاري الإقليمي، خاصةً في أسواق العراق والأردن ولبنان، وربما لاحقاً الخليج وشمالي إفريقيا. إنّ إزالة القيود المالية ورفع الحظر عن التعاملات البنكية سيسمح بعودة الصادرات السورية تدريجياً إلى أسواقها التقليدية، خصوصاً في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمنتجات الزراعية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز في الحساب الجاري.
بالتالي، تتّسم المرحلة الثانية بكونها مفصلية في إعادة بناء الأسس الإنتاجية للاقتصاد السوري، حيث تتلاقى عناصر التحفيز مع عناصر إعادة التمكين، ويتم الانتقال من اقتصادٍ منهك يعتمد على الخارج للبقاء، إلى اقتصادٍ يحاول استعادة عناصر اكتفائه الذاتي والانخراط الفاعل في محيطه الإقليمي والدولي، ضمن أطر جديدة تدمج بين المرونة والإصلاح المؤسسي. فنجاح هذه المرحلة يتوقّف بشكل كبير على قدرة المؤسسات الوطنية على استيعاب التدفّقات الجديدة، وتنظيمها ضمن أولويات واضحة، وخلق بيئة تشريعية مرنة وعادلة قادرة على جذب وتوجيه رأس المال المحلي والخارجي بطريقة تحقق أقصى منفعة اجتماعية واقتصادية.
المرحلة الثالثة: على المدى البعيد أكثر من ثلاثة أعوام
تبدأ بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى من رفع العقوبات وتمتدّ إلى الأمد البعيد. يبدأ الاقتصاد السوري بالخروج من نطاق التعافي المرحلي والانتقال إلى مسار أكثر استقراراً وعمقاً على مستوى إعادة البناء الاستراتيجي وإعادة هيكلة الاقتصاد ضمن سياق اندماجه التدريجي في الاقتصاد العالمي. ففي هذه المرحلة لا يكون التركيز على تحسّن المؤشّرات السطحية كسعر الصرف والتضخّم فحسب، بل يتّجه نحو تحسين نوعية النموّ نفسه، من حيث استدامته وشموليته وارتباطه بقدرة الاقتصاد على الابتكار والإنتاج والتصدير، مع تحوّل واضح في بنية المؤسسات الاقتصادية ووظيفة الدولة ضمن المنظومة التنموية.
أحد أبرز ملامح هذه المرحلة هو إعادة تفعيلٍ كامل للروابط المصرفية والمالية مع النظام العالمي، ودخول المصارف المحلية في شراكات مع مؤسسات مالية دولية، ما يعيد الثقة بالقطاع المالي الوطني، ويجعله مؤهّلاً لتقديم خدمات مالية متقدّمة، ليس فقط للأفراد والشركات، بل للمستثمرين الأجانب أيضاً. حيث إنّ هذا التكامل مع النظام المالي العالمي يفتح الباب أمام تمويلات ميسّرة طويلة الأجل من بنوك التنمية وصناديق الاستثمار السيادية، تُستخدم في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والطاقة، والبيئة، والتعليم، ما يخلق بيئة خصبة لتوليد نموّ نوعي طويل الأمد.
يبدأ نمط الاقتصاد السوري بالتحوّل تدريجياً من اقتصادٍ استهلاكي غير منتج يعتمد على التحويلات والإعانات الخارجية، إلى اقتصادٍ إنتاجي–تصديري قائم على القيمة المضافة. فهذا التحوّل لا يحدث تلقائياً، بل نتيجة سياسات صناعية وزراعية متوسّطة الأجل تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف خلق سلاسل قيمة متكاملة في قطاعات ذات إمكانيات عالية للتصدير، مثل الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية، والصناعات الدوائية والنسيجية، والسياحة العلاجية، والتقنيات الخدمية. ويصبح التركيز أكبر على جودة المنتجات السورية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، ما يتطلّب تحسين معايير الجودة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وبناء مؤسسات اعتماد ومواصفات تعمل وفق المعايير الدولية.
على الصعيد الاجتماعي، سيشهد المستوى المعيشي تحسّناً ملموساً يتجاوز مجرد زيادة الدخول نحو تحسّن شامل في نوعية الحياة، حيث تتوسّع الطبقة المتوسّطة مجدداً نتيجة لخلق وظائف مستدامة ذات دخل كافٍ، وتتحسّن الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل، وتصبح أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع. ومع تراجع معدّلات التضخّم واستقرار سعر الصرف على المدى الطويل، يتّجه الاقتصاد نحو بيئة أكثر قابليّة للتخطيط الاستثماري الأسري، ما يشجّع على الادخار، ويزيد من الاستثمارات في التعليم والسكن والمشاريع الصغيرة، ممّا يعزّز بدوره الديناميّة الداخلية للاقتصاد.
أما على صعيد البنية المؤسساتية، فإن أحد التحوّلات الجوهرية في هذه المرحلة يتمثّل في تغيّر العلاقة بين الدولة والسوق، إذ تتراجع وظائف الدولة كفاعل مباشر في النشاط الاقتصادي، وتتزايد كفاءتها كمُنظّم ومراقب ومُحفّز للنمو. ويُتوقع أن تنضج السياسات الاقتصادية لتصبح مبنيّة على قواعد وسياسات واضحة، ويُعاد بناء الأجهزة الرقابية والتنظيمية بما يسمح ببيئة أعمال عادلة وشفافة، ويضمن الحماية القانونية لحقوق المستثمرين والعاملين والمستهلكين على حدٍّ سواء. هذا التحوّل المؤسسي يُعدّ ضرورة حتمية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي لا يكتفي في هذه المرحلة بالفرص قصيرة الأجل، بل يبحث عن بيئة مستقرة وآمنة على المستوى القانوني والسياسي.
يُتوقّع أيضاً أن يبدأ التشكّل التدريجي للمدن السورية الجديدة – سواء من حيث العمران أو من حيث الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية – حيث يتمّ إعادة تنظيم الحيّز الحضري على أسس تخطيطية أكثر كفاءة وعدالة، تُراعي التوزيع المتوازن للخدمات والفرص، وتقلّل من التفاوتات الجغرافية بين المناطق، ويُعزّز التماسك الاجتماعي. حيث إنّ المدن الكبرى ستستعيد دورها كمحرّكات للنمو، مع بروز مراكز حضرية جديدة تؤدّي وظائف اقتصادية متخصّصة في الصناعة، أو الزراعة المتقدّمة، أو السياحة، أو التعليم العالي والبحث العلمي.
من الناحية الخارجية، ستكون سوريا قد استعادت موقعاً وظيفياً في الاقتصاد الإقليمي والدولي، ليس فقط كممرّ جغرافي أو سوق استهلاكية، بل كمصدرٍ للسلع والخدمات، ومشاركٍ في سلاسل الإمداد العابرة للحدود. وتبدأ في استثمار موقعها الجغرافي كبوّابة بين الخليج وتركيا وأوروبا، من خلال تطوير موانئها، وربط سككها الحديدية، وتحديث معابرها الحدودية، ما يُحوّلها إلى مركز ترانزيت تجاري إقليمي. هذا الدور يُعزّز مكانتها الجيو–اقتصادية، ويمنحها نفوذاً جديداً في معادلات العلاقات الاقتصادية الدولية.
ومع تحوّل الهيكل الاقتصادي، يصبح الحديث عن الاستقرار الاجتماعي أمراً أكثر واقعية، حيث يبدأ التراجع في البطالة والفقر بالاقتران مع تحسّن في الحوكمة، ومكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات العامة. لا سيما إذا ترافق هذا التحوّل الاقتصادي مع إصلاحات سياسية حقيقية تُعزّز من المشاركة، وتُوسّع قاعدة القرار، وتبني نموذج دولة قانون ومؤسسات.
بشكل عام، يُشكّل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا فرصة تاريخية لإعادة رسم المسار الاقتصادي للبلاد، وذلك بعد سنوات من الانهيار والعزلة. إلا أنّ هذه الفرصة، رغم أهمّيتها، لا تضمن بحد ذاتها تحسّناً تلقائياً، بل تتطلّب رؤية اقتصادية شاملة، وإرادة سياسية واضحة تستثمر الانفتاح الخارجي في بناء اقتصاد منتج ومستقرّ. حيث إنّ نجاح التحوّل الاقتصادي سيعتمد على قدرة الدولة على تفعيل أدواتها المؤسسية، واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يكفل خلق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على معيشة المواطنين واستقرار المجتمع السوي.
المصدر: تلفزيون سوريا