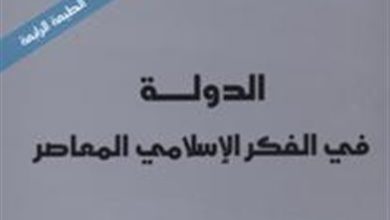كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “الأزمة الطائفية في سورية”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
مقدمة
في لحظات التحوّلات الجذرية التي تمرّ بها المجتمعات الغنيّة، بتنوعها الديني -كما في الحالة السورية- لا تظهر الطائفية كعرضٍ طارئ للفوضى، ولا كمجرد نكوص في الوعي الجمعي، بل يتم تصنيعها كأداة لإعادة ترسيم الحقول السياسية والاجتماعية، وكآلية لإعادة التموضع وتوزيع النفوذ، في ظل انعدام الأفق الوطني وتعرّي البُنى.
الطائفية هنا لا تُختزل في كونها ردّة فعل سطحية أو استدعاء ميكانيكيًا لذاكرة ماض مقموع، بل تمثّل تصدّعًا داخليًا في نسيج التجربة المشتركة، وتتحول إلى أحد أنماط إعادة إنتاج الصراع، حين يتداعى العقد السياسي مُمثّلًا في دولة جامعة، ويتقوّض العقد الاجتماعي كأساس للتماسك والعدالة، فتغدو الدولة فراغًا سلطويًا وأمنيًا قابلًا لملئه بالانتماءات ما دون الوطنية.
بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، لم تكن البُنى المجتمعية والسياسية والمؤسساتية السورية تحمل الحد الأدنى من مقوّمات الدخول في مشروع وطني جامع. على العكس، انكشفت البلاد دفعة واحدة على آثار أربعة عشر عامًا من العنف، وعلى إرثٍ طويل من التفكيك البنيوي للدولة والمجتمع معًا.
لم تكن لحظة الانهيار بداية بناء، بل لحظة انكشاف مرير على هشاشات راكمتها عقود الاستبداد وصراعات الثورة والحرب، ما فتح الباب أمام مرحلة انتقالية غامضة، تتداخل فيها احتمالات سقوط الدولة مع مؤشرات تفكك الاجتماع الوطني. وفي مثل هذه السياقات، يسود فراغ هرمي يبتلع الحدث ويُقطّع تسلسله، فتنبثق عنه تكتلات وانقسامات تسعى إلى احتلال الحقل العام، وغالبًا ما تتشكّل جماعات مغلقة، تلتفّ حول سردياتها الخاصة، وتبني آليات حمايتها بالانغلاق حول ذاتها. تندفع هذه الجماعات نحو اصطفافات وتفاهمات تُؤسَّس على المصلحة والخوف، وسرعان ما تتحول إلى ديناميات طائفية متسارعة. وهذا التصاعد ليس مجرّد استجابة تلقائية لسقوط النظام، بل نتيجة مركبة لتفاعل هشاشات متجذّرة مع فراغ سلطوي، ومخاوف غير مؤطّرة، وبُنى تمثيل مجتمعي لا تزال أسيرة مرجعيات ما قبل وطنية.
الطائفية، بهذا المعنى، لا تُفهَم ضمن حدود الوعي أو الأخلاق فحسب، بل تُقارب كبنية سياسية–خطابية، ومصلحية–وظيفية، تستعيد فاعليتها كلّما غابت السياسة كمجال جمعي منظم، أو فشلت في إدارة التعدد ضمن مشروع وطني متماسك. من هنا، فإن تشخيص الظاهرة الطائفية في سورية ما بعد ديسمبر 2024 لا يُعدّ ترفًا نقديًا ولا تمرينًا توصيفيًا، بل ضرورة معرفية وسياسية عاجلة، تتطلب تفكيك الشروط العميقة التي تعيد إنتاجها، لا الاكتفاء بإدانة تمظهراتها.
المحور الأول: تشخيص الظاهرة وتحليلها
المعطيات الملموسة منذ ديسمبر 2024
منذ سقوط الأسد في ديسمبر 2024 شهدت الساحة السورية تصاعدًا ملحوظًا للطائفية، لا كمجرد خطاب تعبوي، بل كبنية فاعلة تتجلى في ممارسة سياسية-اجتماعية متعددة المستويات:
أولًا: على صعيد السلطة الجديدة، كشفت التعيينات الرئاسية أو الوزارية في مواقع تنفيذية، أمنية، وقضائية حسّاسة عن تموضع أحادي ضمن لون طائفي واحد، ما عمّق شعور الإقصاء لدى “مكونات” سورية أخرى، أوحى بأن الدولة الناشئة يُعاد تشكيلها على قاعدة تمثيل ضيق ومغلق.
ثانيًا: على مستوى الخطاب السياسي، تبنّت بعض القوى السياسية الصاعدة سرديات تستند إلى مقولات مثل “حماية الأقليات” أو “رفع المظلومية التاريخية” ضمن تأطير طائفي أو إثني، ما أعاد تفعيل منطق المحاصصة، وإن بِصورة غير معلنة.
ثالثًا: على المستوى المجتمعي، شهدت الساحة السورية انكماشات وانزياحات هوياتية متبادلة، ترافقت مع استدعاء سرديات ماضوية تُعيد التاريخ القريب والبعيد بمنظار طائفي، مما قوّض إمكانات بلورة خطاب وطني جامع وأدّى إلى عزلة متزايدة بين الجماعات، سواء بشكل منفرد أو عبر تحالفات ضيقة.
رابعًا: على المستوى الأمني ـ الميداني، برزت تشكيلات محلية ذات طابع طائفي واضح في مناطق عدة كالساحل والسويداء وبعض مناطق الشمال، ما كرّس الطائفية لا كخطاب فحسب، بل كأداة فعلية للسيطرة الميدانية.
خامسًا: على الصعيد الاقتصادي، تداخلت شبكات الولاء والانتماء الطائفي مع فرص الوصول إلى الموارد والتمثيل المحلي، خصوصًا في ظل إفلاس الدولة وتعثر الإعمار، مما جعل من الطائفة في كثير من الحالات المسار الأقصر نحو النجاة المعيشية. وهكذا، لم تملأ الطائفية فراغ المعنى فقط، بل فراغ الخبز والحماية.
رؤية تحليلية:
لا تولد الطائفية من وعي جاهز، بل من شروط اجتماعية وسياسية تولّد الحاجة إليها كملاذ أخير. فحين تعجز السياسة عن تنظيم التناقضات ضمن الفضاء العام، تتقدّم الطائفة كبديل دفاعي للانتماء، لا يّعِد بالعدل، بل بالحماية.
منذ عام 2011، مع العجز التدريجي للقيام بوظائف الدولة، بدأت الجماعات المحلية تعيد إنتاج ذاتها عبر الولاءات الأولية: الطائفة، العشيرة، الدين، والمنطقة. جاء هذا التحول في ظل تآكل شبكات التضامن الأفقي (النقابات، الجمعيات، الروابط المهنية) التي كانت تتيح بعض أشكال التماسك المجتمعي، ليحلّ محلها منطق الحماية الفئوية والسلاح والولاء. لم تكن هذه الدينامية حتمية، لكنها حدثت بفعل تحلل الحقل السياسي، وتحول منطق الثورة من مشروع وطني جامع إلى حلبة تمثيل للهويات المغلقة، في لحظة كشفت الفراغ الوطني عن تموضعات ما قبل وطنية.
في أعقاب السقوط، لم تحضر الطائفية كوعي مجرد، بل تجسّدت كمنظومة إدراكية وخطابية تداخلت فيها وظائف عدة منها:
أولًا: كنمط إدراك للذات والآخر، يُعاد من خلاله بناء الهوية على أساس التمايز لا التشارك، وتُصنّف الذاكرة الجمعية وفق مواقع الانتماء الهوياتي لا وفق أفق وطني مشترك.
ثانيًا: كأداة صراع على الهيمنة، تُستخدم الطائفية لإقصاء الآخر واحتلال موقع لها في الحقل السياسي الجديد، فتتحول إلى معيار لما هو ممكن وممنوع سياسيًا.
ثالثًا: كآلية للانكماش والحماية، حيث تُستدعى الهوية الطائفية بوصفها شبكة أمان مادية ورمزية في غياب الضمانات الوطنية.
في كل هذه الوظائف، لا تظهر الهوية الطائفية كمعطى مسبق، بل كعلاقة سياسية دينامية يُعاد إنتاجها في شروط الانكشاف والانهيار. فتصبح الطائفية فاعلًا ومفعولًا به في آن، خطابًا وأداةً، آلية صراع ودرع نجاة.
الجذور البنيوية الممتدة
لفهم دينامية الطائفية بعد سقوط الأسد، لا بدّ من العودة إلى البنى التي مهّدت لتحولّها إلى أفق للصراع ولو بعجالة. لم يؤسّس النظام الأسدي دولة مؤسسات فعلية تخضع لمنطق القانون العام، بل شيّد منظومة سلطوية هجينة، لعبت فيها المؤسسات دور الواجهات الخدماتية، في حين تولت الأجهزة الأمنية والعنفية التحكم الفعلي بالمجتمع عبر الزبائنية والتسلط. وأعادت هذه الأجهزة تشكيل المجال العام على حساب الحريات والقانون، وحلّ الحزب الحاكم محل السياسة كأداة إخضاع، في حين تحول المجتمع المدني إلى واجهة فارغة المضمون.
وعلى مدى عقود، جرى تفكيك الروابط الأفقية التي تشكل نسيج المجتمع، من خلال ترييف المدن وضرب الطبقة الوسطى، وتحويل النقابات إلى أدوات ضبط، وتعزيز الولاءات العشائرية والمناطقية. لكن هذه “الهشاشات” ظلّت مضغوطة تحت قشرة الطغيان، ما جعل لحظة السقوط لحظة انكشاف، لا لحظة تفكك جديدة.
لم تكن الطائفية غائبة عن هذا المشهد، بل كانت مُستثمرَة بذكاء سلطوي، لنتذكر -مثلًا- إطلاق الجهاديين من سجن صيدنايا لتطييف الثورة، أو سابقًا تمركز أجهزة العنف بأيدي فئة من الطائفة العلوية، مع تغليف ذلك بتحالف فوق طائفي هش مع برجوازيات سنية وريفية. وفي ظل اختناق السياسة وانكماش المجال العام، تحوّلت الطائفية إلى أحد أشكال استمرار الدولة التسلطية، لا بكونها معتقدًا دينيًا بل بوصفها أداة إدارة وتحكّم.
الطائفية ليست ظاهرة دينية بالدرجة الأولى
بالرغم من ارتداء الطائفية لباسًا دينيًا واستنادها إلى رموز لاهوتية، فإنها لا تُشتق من العقيدة، بل من علاقات القوة والانقسام الاجتماعي. بهذا المعنى، ليست جماعة “الطائفة” جماعة إيمان، بل وحدة تمثيل تعاد صياغتها داخل الحقل السياسي كأداة للفرز والإقصاء، لا للتدين أو التعبّد. اختزال الطائفية إلى ظاهرة دينية يطمس بنيتها الفعلية كأداة أيديولوجية لإدامة السلطة وتفتيت الصراع الحقيقي بين سلطة استحواذية وجماعات شعبية مهمشة.
تنتج الطائفية هوية مغلقة، تتغذى من الخوف والمظلومية، وتُشرعن الانغلاق والخضوع، ولكي تؤدي هذا الدور، تُبنى ذاتٌ جمعية شمولية تُمنح هالة رمزية خَلاصية، يبدو التقوقع داخلها شكلًا للنجاة. يتحوّل الانتماء من خيار حرّ إلى علاقة يُعاد فيها تشكيل الذات على نحو يجعل مغادرتها تهديدًا للوجود.
وقد تجلّت هذه الدينامية في ممارسات سلطوية متراكمة، بدأت منذ عهد الأسد الأب، حين استُخدمت الطائفية كأداة لإنتاج السيطرة والطاعة، وتعمّقت في عهد الابن ضمن استراتيجية أكثر تركيبًا، حيث وُظفت لتفكيك الروابط المجتمعية عبر خطاب إخضاع متواصل وممارسة قسرية ممنهجة. من الأمثلة البارزة على ذلك بعد 2011، العقاب الجماعي والتدمير المنهجي للبنى التحتية في مدن ذات أغلبية سنية، مقابل أنماط قمع انتقائية في مناطق أخرى، ما عزز صورة النظام كـ “حامٍ للأقليات”، في مواجهة أغلبية دينية ذات تنميط مُتخيّل، وكرّس تفاوتًا مدروسًا في تصميم الفرز الطائفي كأداة ضبط وسيطرة.
وفي مرحلة ما بعد السقوط، استمر هذا المنطق عبر وقائع عديدة: ففي الساحل السوري، شهد آذار 2025 جريمتين متتاليتين: الأولى هجوم نفذته مجموعات من فلول النظام السابق ضد عناصر الأمن العام، والثانية ردّ انتقامي تمثل في انتهاكات وجرائم جسيمة ضد عدد كبير من المدنيين من أبناء الطائفة العلوية، ثم تبع ذلك مشهد السويداء، بما حمله من مؤشرات على تصاعد الاستقطاب وصناعة “العدو من الداخل”، كآلية لإعادة رسم حدود الجماعات على أساس الخوف والشك المتبادل وفقدان الثقة.
خلال سنوات الثورة والحرب، تحوّلت الطائفية من أداة تحكم فوقية إلى منطق تمثيل متصارع بين الفاعلين، ثم أعيد تفعيلها بعد السقوط في تموضعات السلطة واصطفافات الفصائل. وهكذا تتبدّى الطائفية في التجربة السورية كبنية متجددة نابعة من تقاطع الاستبداد والانقسام والانتماء. ومستمرة في إعادة إنتاج ذاتها عبر صيرورة التحوّلات.
المحور الثاني: مقاربات المواجهة والمخرجات الممكنة
أـ تفكيك الشروط المنتجة للطائفية
الطائفية ليست انحرافًا أخلاقيًا يُكتفى بإدانته، بل نمط إنتاج اجتماعي ـ سياسي يُمنح شرعية من خلال بنى الانقسامات، لذا فإن مواجهتها لا تقتصر على الشجب، بل تبدأ بتفكيك الشروط التي تجعلها ممكنة، فهي لا تنشأ من فراغ، بل تتجذر في بنيات داخلية معقدة، تعيد إنتاجها باستمرار، ومن أبرز هذه البنى: التعليم الذي يعيد تكوين الذاكرة الجمعية على أسس إقصائية أو طائفية مبطنة؛ والإعلام الذي يرسّخ صورًا نمطية ويُسوّق بخطابه التحيّز ضد الآخر الوطني؛ وبنيات الأمن المحلي التي تربط الحماية بالهوية لا بالقانون؛ والاقتصاد الزبائني الذي تُوزّع فيه الامتيازات على أسس فئوية، ما يولّد شعورًا جماعيًا بالغبن، يُستثمر لاحقًا في بناء مظلومية تعبّئ الاصطفاف.
وبالتالي لا تبقى قيمة لأي برنامج في مواجهة الطائفية مع استمرار منطقها غير المُعلن، ولا جدوى من خطاب مدني دون مشروع وطني يضمن العدالة والتمثيل والحماية. المطلوب ليس تدمير الطوائف، بل حمايتها كخصوصيات اجتماعية وتجاوزها كمرجعيات سياسية، عبر عقد اجتماعي جديد يُعطّل الحاجة للطائفة كملاذ أمني أو كواسطة للتمثيل السياسي.
ب ـ إعادة بناء الحقل السياسي على أسس وطنية-اجتماعية
لا يمكن تصوّر سورية جديدة بلا استبداد، من دون تفكيك الحقل السياسي الطائفي وإعادة بنائه على أسس العدالة الاجتماعية والمواطنة، وهذا المسار يبدأ بثلاثة أعمدة رئيسية ولا ينتهي عندها:
1ـ دستور يضمن المساواة الفعلية: لا توازنات أو امتيازات هوياتية، بل مواطنة كقيمة قانونية-سياسية تستند إلى نظام قانوني يحمي الأفراد من التمييز، ويضمن استقلال السلطات، ويقيد منطق التعيين والقرار على الولاء الطائفي أو الاثني أو الفئوي، ويمنح السلطة التشريعية صلاحيات فعلية في التشريع والرقابة.
2ـ أحزاب سياسية تطرح برامج لا هويات: فالحقل السياسي لا يُعاد بناؤه إلا بأحزاب تتنافس على السياسات والرؤى، فلا سياسة وطنية بدون أحزاب.
3ـ قانون انتخابي يتجاوز الهويات الأولية: فأيّ صيغة انتخابية تُقنن التمثيل الطائفي تعيد إنتاج الانقسام.. المطلوب قانون يقوم على دوائر واسعة وقوائم وطنية، مع فصل واضح بين التمثيل السياسي والمرجعيات الدينية.
ج ـ العدالة الانتقالية كمسار لتفكيك المنطق الطائفي
لا تُختزل العدالة الانتقالية إلى مجرد إجراء قانوني للمحاسبة، فهي عملية مجتمعية-سياسية وقضائية تهدف إلى تفكيك دوافع الانتقام والانقسام، وبناء الثقة من خلال مسار متدرّج يشمل الإنصاف، والمكاشفة، والمساءلة غير الانتقامية، والتعويض.
فالطائفية تزدهر حين تُترك المظالم دون اعتراف، ويُختزل الصراع في ثنائيات ضيقة من قبيل: “نحن الضحايا، وهم الجناة”. أما العدالة الانتقالية، فهي لا تُدين جماعة، بل تُسائل الفاعل، وتعيد الاعتبار للضحايا دون إنتاج شيطنات جديدة. وهي ليست لحظة فاصلة، بل مسار طويل، لا يُكتب له النجاح دون شفافية واحترام القانون الدولي ومراعاة تعقيد السياق المحلي. تقع مسؤولية إطلاق هذا المسار أولًا على عاتق السلطة الجديدة، بصفتها الجهة المخوّلة بوضع أسس العدالة، لا إعادة إنتاج المنظومة القديمة بثوب مختلف.
د ـ مواجهة الاقتصاد السياسي للطائفية
لا يمكن اجتثاث الطائفية دون تفكيك بنيتها التحتية المتجذرة في شبكات الولاء والمحسوبية. المواجهة الفعّالة لا تكون بالشعارات، بل بإعادة هيكلة الاقتصاد السياسي وفق مبادئ العدالة والمواطنة:
- بناء سياسات اقتصادية تعيد التوازن الطبقي، عبر نظام ضريبي عادل يوزع الدخل والثروة، ويكسر الاحتكارات.
- توزيع الموارد بعدالة جغرافية-اجتماعية، لإنهاء تهميش الأطراف وتفكيك مركزية الامتياز.
- إخضاع العقود والتوظيف وآليات التمويل لمبدأ الكفاءة والشفافية.
- فرض رقابة تشريعية على المؤسسات المالية، لمنع استخدامها كأدوات فرز طائفي أو مناطقي.
- ضمان النفاذ العادل إلى الفرص الاقتصادية، خارجوساطة المرجعيات، لكسر الاحتكار الطائفي لسبل العيش.
- تفكيك التحالف الثلاثي(بين رجال الدين، ورجال الأعمال، ورجال الميليشيات) الذي حول الطائفية إلى أداة تراكم ثروة ونفوذ.
ه ـ إعادة بناء اللغة والخطاب
لا تنمو الطائفية في الواقع فقط، بل في اللغة والخطاب أيضًا. فهي تتغذى من الكلمات التي نختارها، ومن الرموز التي نعيد بها ترسيم حدود الجماعة. لذلك، لا بد من مساءلة البنى الخطابية التي تصوغ الوعي والانتماء، بدءًا من اللغة اليومية، مرورًا بالإعلام، وصولًا إلى المناهج التعليمية والخيال الثقافي. إعادة بناء اللغة لا تعني فرض لسان واحد، بل خلق فضاء لغوي-مدني، يسمح بتخيّل الجماعة السياسية خارج القوالب الطائفية، حيث لا يكون التعبير عن الذات مشروطًا بنفي الآخر، بل نابعًا من مشاركة الذاكرة والمعاناة والمصير.
ومن يتحمّل المسؤولية؟
المسؤولية جماعية، لكنها متفاوتة:
- السلطة الانتقالية تتحمّل العبء الأكبر، إذ يقع على عاتقها تأسيس مؤسسات تُعيق إعادة إنتاج الطائفية، عبر سلطة تشريعية مستقلة، إعلام وطني، وآليات تمثيل سياسي منفتحة.
- القوى السياسية المدنية مطالبة بتقديم صيغ بديلة عابرة للهويات الأولية والخطابات الأقلوية.
- منظماتالمجتمع المدني مسؤولة عن بناء الثقة الأفقية وتفعيل شبكات حماية مدنية على تماس مع الحياة اليومية.
- النخب الفكرية والدينية مدعوّة لإنتاج خطاب نقدي يزعزع البُنى الذهنية الطائفية، ويعترف بتعدّد السرديات دون نفي الآخر والتعالي عليه.
- الفصائل المسلّحة غير التابعة للدولة تتحمّل مسؤولية ترسيخ الطائفية بفرض الانتماء كشرط للحماية، في الشمال الشرقي والغربي والساحل والسويداء.
خاتمة مفتوحة
فرادة الحالة السورية لا تكمن في الحدث وحده، بل في كثافة التفاعل بين العوامل السياسية والاجتماعية والنفسية العميقة. فالطائفية لا تُفهم خارج هذا التشابك المركّب. ومواجهتها ليست معركة رمزية أو رقمية، بل تمسّ جوهر المشروع الوطني المقبل. لن تُهزم بالنوايا، بل بالمؤسسات؛ ولن تُلغى بالشجب، بل بتفكيك البنى التي تتيح إعادة إنتاجها. وفَهْمُ شروط تشكّلها هو الخطوة الأولى في مسار مقاومتها.
نزع تسييس الدين والطائفة ليس رد فعل ظرفي، بل مشروع استراتيجي طويل النفس، يُدار بخبرات متخصصة في السياسات العامة، والتعليم والإعلام، لا بقرارات فوقية أو بشعارات مرتجلة. أما المساواة الاجتماعية، فهي الشرط الجوهري لنزع فتيل الانقسام، فحين تغيب العدالة في التعليم والصحة والسكن، يُعاد إنتاج الطائفية.
المجتمع السوري لم ينهَر، بل تفكّك، ومع ذلك لا يزال يحمل في تربته بذور “نحن” جديدة: جماعة تتأسس على الاعتراف المتبادل، وتعيد طرح سؤال الوطن بوصفه تفاوضًا حيًّا على المعنى والمسؤولية.
يمكن لسورية أن تنتقل من الفراغ إلى التماسك، إذا جرى بناء المشروع الوطني على أسس تشاركية. عندها قد تتحوّل التجربة السورية إلى واحدةٍ من أعمق الدروس في مقاومة التفكك، وإعادة تشكيل الاجتماع السياسي على قواعد تتجاوز الطائفة والانتماءات ما دون وطنية، نحو بناء الإنسان-المواطن، والدولة-المواطنة.
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة