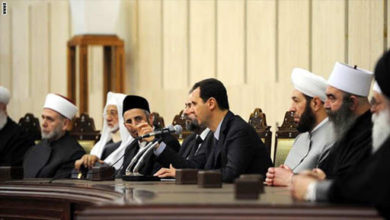حين يسألونك عن النقد، تيقّن أنه لحظة التحوّل بين حالَين أو زمنَين. هو القدرة على التقاط مفاصل التغيير وإضاءتها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون جزءاً من حال سابق أو بعده، بقدر تمايزه من الاثنين في آن. وحين تصبح مصطلحات الخيانة والكراهية وشيطنة الاختلاف عامة، مهيمنة في مرحلة ما، فالشكّ (من موقع النقد نفسه) بأنّ معايير الزمن والثقافة قد استحالت زمنَ جريمة، فإن كان شاهدَها الدمُ المراقُ للأبرياء من دون ذنب، فدلالتها الثقافية قُنوط وجُحود وسيرورة خيبات وتبدّل مسارات.
هكذا تمرّ على السوريات والسوريين مرحلة ما بعد الفرح والانفراج. مرحلة ما بعد الخلاص من هيمنة الاستبداد السياسي والفكري والثقافي. مرحلة اللون الواحد ونفي التمايز. مرحلة تتبدّل فيها المعايير كل لحظة، وتنقلب موازينها بدرجة حدّية ومتسارعة. فسيادة خطاب الكراهية والتخوين الحاصل في الشارع السوري اليوم لم يعد يكفيه الاحتكام إلى شروط سياسية في تفنيده أو تعليل أسبابه، بقدر ما هو دلالة على سلوك نفسي يحاول الهيمنة ثقافياً وذهنياً على مجتمع يعاني صعوبات التحوّل كلّها، من دفّة الموت إلى الحياة، ومن مركب الجريمة إلى النجاة، فتغزوه سهام القتل المادّي والمعنوي من دون رحمة. ويصبح النقد في ذاته كما الثقافة، جريمةً يُشترط انتماؤها إلى إحدى الحالتَين، وإلّا رُجمت من كليهما، لتبقى مقولة “كفى! شبعنا موتاً وجريمة” ثقافةً نقديةً تحاول التمايز.
تمرّ سورية اليوم في ممرّ إجباري من التحوّل، سيزداد تعقيداً إذا ما رُجم ناقدوه
تبدو مجريات الأحداث السورية اليوم سهلةً ويسيرةَ التفنيد سياسياً بإحدى الروايات المشاعة: بسط هيمنة الدولة وحصر السلاح بيدها، وهذا في المبدأ حقّ قانوني ودستوري، ولكن هل تبسط الدولة هيمنتها بالقوة العسكرية واستباحة دم الأبرياء، بما فيهم الأطفال والنساء ورواد ثورة الحرية والكرامة، كما جرى في السويداء مثلاً؟ أم تبسط الدولة حضورها بشرعية سيادة القانون، وأهم أدواتها تفعيل دور المؤسّسات وتغليب لغة الحوار والتوافق على شكل الحكم، وهذا مختلف عن مفعول القوة النافذة؟ فكيف وإن كنّا في مرحلة انتقالية تكاد تكون معالم الدولة فيها لم تتضح بعد جلياً!
في المقابل، ثمّة من يكرّر أنها سلطة فصائلية إرهابية، اغتصبت السلطة وحوّلت البلاد مستقنعاً من الدماء، ويطالب بالانفصال الكلّي عنها. ولكن هل شارك في معركة البناء وتجاوز معيقات الخلاف القيمية لأطر الخلاف الموضوعية من حيث البناء والنقد والمساهمة النسبية فيه، من دون تعميم رؤيته المطلقة على المختلف معه عقائدياً وأيديولوجياً؟
بين هاتَين الموضوعتَين يضيع النقد، وتصبح معاناة الثقافة أكثر وضوحاً. فنقد موضوعة الهيمنة السلطوية بالقوة لا يعني الانتماء لما بعدها بالحالة الانفصالية، ونقد موضوعة الانفصال السياسية العقائدية أو المصلحية لا يعني الانتماء لموضوعة سلطة القوة. هي تلك الثقافة التي لا تنتمي إلى زمن الحرب والعنف والتقسيم وإقامة الجدران الإسمنتية بين أطر الاختلاف المحلّية، دينيةً كانت أم سياسيةً أم فكريةً. هي تماماً في موقع يختلف عن المرحلتَين والثقافتَين كلاهما. هي تنتمي إلى لحظة التغيير القائم على الحوار، والحوار نقيض العنف والخصام. وعلى تحقيق العدالة، والعدالة نقيض الإجحاف وشريعة قتل المختلف. هي مع حقّ الأبرياء بالعيش في سلام وأمان، وهذه لا تنتمي إلى المتاجرة بقضاياهم لمكاسب سياسية شخصية أو أيديولوجية على حسابهم. هي مع سياق البناء التوافقي وتأصيل أسسه المتينة في التنوّع وحقّ الاختلاف، وهذه أبداً لا تنتمي إلى معايير التخوين والتكفير والرجم الجزافي.
المحنة السورية اليوم، وإن تبدو سياسيةً، مرّت فيها شعوب العالم في المراحل الانتقالية، حين سادت الفوضى ومغالبة الشرعيات في الأحقية المطلقة بالحكم، إلّا أنّها في الوقت نفسه امتدّت عميقاً لإطفاء مصابيح النور وأسئلة التنوير التي طرحتها أوروبا على نفسها قبل قرون. والتنوير إضاءة الحقائق من دون مواربة، والشجاعة على استخدام العقل من دون غرائزية، والقدرة على فعل الضرورة، ووعي أهمية الانتقال من زمن الظلم إلى زمن العدالة والقانون، والنقد الفعّال الكاشف عن تباين أطر الصراع على مكاسب السلطة الجارية في الساحة السورية اليوم بين متشدّدين من كل الجهات، وهذا التشدّد ينعكس سلباً على قيم التعايش السلمي وحقوق الاختلاف وطرق حلّه، والاستسهال في رمي التهم الجزاف بالتخوين والتكفير والتجريم.
“الثقافة والنقد في امتحان عسير اليوم تقتضي لحظة تعقّل والخروج من مولدات العنف والهدم السياسية ذاتها
سياسياً، تمرّ سورية اليوم في ممرّ إجباري من التحوّل، لكنّه سيزداد تعقيداً إذا ما رُجم ناقدوه، وكفّرت ثقافة الحرية والسلام والكرامة من الجهات المتصارعة على طريقة الحكم المنفردة، مركزية الطابع كانت أو طرَفيةً طائفية، تقوم على النهج الذي يقفون ضدّه. فمعاندة مسار التحوّل من عصر الاستبداد إلى عصر الاستقرار لا يعني أبداً إقامة مجزرة للثقافة والنقد، واشتراط انتمائها السياسي إلى هذه الحالة أو تلك. وهنا تتجلّى معاناة الثقافة وامتحانها في الوقت نفسه، وامتحانها المبدئي في الوقوف بجانب معاناة وآلام الناس وعذاباتهم، والجرائم المرتكبة بحقّهم. وفرق بين ثقافة تستمدّ حضورها من روائز مدنية وإنسانية حقوقية، وأخرى تستمدّ حضورها من بواعث سلطوية المكسب. وامتحانها الأشدّ هو قدرتها على التمييز الحادّ بين زمن الحكمة وزمن الحماقة، بين صيرورة الحقّ والحرية، وبين الظلم والوحشية والعنف، أيّاً كان من يمارسها، سلطة حاكمة أم معارضين لها. وكأنّ التاريخ يعيد نفسه، إذ عبّر تشارلز ديكنز في روايته الأشهر “قصّة مدينتَين” عن تناقضات عصره التي نكرّرها اليوم، وكأننا لم نقرأ التاريخ بعد: فقد “كان أحسن الأزمان وكان أسوأ الأزمان. كان عصر الحكمة وكان عصر الحماقة. كان عهد الإيمان، وكان عهد الجحود. كان زمن النور، وكان زمن الظلمة. كان ربيع الأمل، وكان شتاء القنوط”… لتصبح الرواية الأشهر التي تدرس، مفارقات وتناقضات التحوّل الأوروبي العام من عصر الظلمات إلى دولة الحقوق والدستور والحريات، بل تدلّل بوضوح على سوء العنف والظلم العام من أيّ طرف يمارسه، وهذا ما على الثقافة السورية اليوم أن تعيد صياغته بنكهتها ومظالمها الخاصة.
هل يمكن التوقّف عند ناصية المشهد، والإقرار بأنّ سلطة القوة ونقيضها ليستا إلّا وسيلتَين قابلتَين للانقلاب في أيّ لحظة أمام سلطة أقوى، وأن الديمومة والاستقرار يأتيان بالسياسة، إدارةً للحكم وموارد الدولة، لا بقوة الاستحواذ أو الانفلات منها، وأن الثقافة والنقد في امتحان عسير اليوم تقتضي لحظة تعقّل والخروج من مولدات العنف والهدم السياسية ذاتها؟
المصدر: العربي الجديد