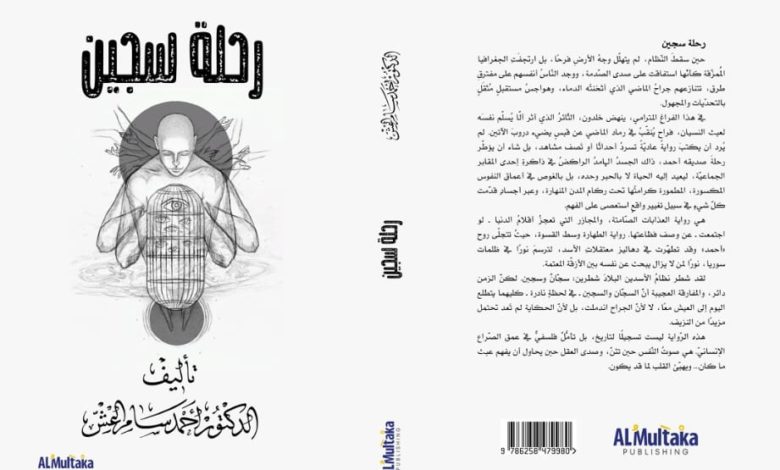
أثناء جلوس خلدون في المنزل يدون رحلته في البحث، رن هاتفه؛ إنه رقم أخو حسن، صديقُه خالد الذي انقطعت أخباره منذ خروجه بالباصات الخضراء إلى الشمال، بعد حصار بلدته ببيلا لأشهر عديدة، كان اتصالُ خالدٍ صدمةً لخلدون؛ فمنذ أيام وأحاديث أخيه حسن لا تفارق ذهنه المرهق.
بلهفة أجابه خلدون: والله إنك ابن حلال، فما زال طيف أخيك حسن لا يفارقني، منذ يومين وأنا أهدس به وبلقاءتنا التي لم تكن تتوقف معه في بيتكم القديم. طمني أين أنت الآن؟ قال له: أنا في بيتنا الآن، فقد عدت مع المحررين منذ شهر، لكننا لم نكن لنستريح ساعة بعد التحرير، وهذه ثاني ليلة لي في البيت، وأحببت أن اتصل بكم بعدما علمت بفقدان أمل العثور على صديقنا أحمد. عندها سارع خلدون بسؤاله: عن أسباب عدم تواصله معه طوال الفترة المنقضية، أخبره أنه من أخطر المطلوبين للنظام، ووجودك تحت رحمتهم منعني من تعريضك للمسألة والخطر من تبعات التواصل، فكما تعلم كان النظام وزبانيته ” أولاد حرام”، وليس عندهم محرمات في إنهاء حياة من يقف على النقيض منهم!
اتصلت بك؛ لأني أريد زيارة والد صديقنا أحمد لتقديم واجب العزاء، وأريد منك مرافقتي بعد إذنك، وبذلك أراك ونقوم بواجب العزاء، يعني نضرب عصفورين بحجر واحد؛ لأن إجازتي سوف تنتهي غداً، وقد تم استدعاؤنا سريعاً؛ لإطفاء التمرد في الساحل كما تسمع وتشاهد.
في منزل عائلة أحمد اجتمع خلدون وخالد، وكان يرافقه شخص لم يرَه خلدون من قبل يُدعى القاضي حبيب، أخلاق خلدون لم تسمح له بإزعاج صديق خالد بأسئلة استفسارية، بل اكتفى بتوزيع الابتسامات على صعوبتها، فقد خرج ليس من وقت بعيد من آلام مزمنة نتيجة رحلة بحثه المضنية.
بعد خروجهم من منزل والد أحمد طلب خالد من خلدون أن يرتشفوا القهوة في أي مقهى قريب؛ لأنه ربما لن يراه ثانية إلا بعد فترة مجهولة التوقيت، فمنذ التحرير وهم لا ينامون جيداً، فالأسد على ما يبدو لم يغادر قبل أن يدمر البلد حجراً فوق حجر، والأنكى من ذلك أنه دمَّر من يسكنون داخل هذه الكومة من الأحجار.
استجاب خلدون على الفور وخاصة أنه بالحقيقة مشتاق لخالد وكذلك الفضول دفعه للتعرف أكثر عن هذا المرافق الذي على ما يبدو أنه مقرب جداً من خالد، بل وحتى أمين سره!
في المقهى جلس خالد يُحدِّث خلدون برحلته الشاقة التي سارها منذ لحظة خروجه من بلدته ببيلا إلى أن عاد فاتحاً مع جحافل الثوار، كانت تلك الرحلة ممزوجة باليأس أحياناً وبالأمل أحياناً أخرى، كانت صور الأطفال الذين ماتوا جوعاً بالحصار الجائر الذي فرضه النظام لا تفارق أحلامه، وكذلك صورة والدِه وهو يودع الحياة ويلفظ أنفاسه الاخيرة، وهو يقول أشم رائحة خبز طازج ما زالت لا تفارق مخيلته.
في رحلة التهجير القسري، عاش لاجئاً في بلده، بعد أن عاش طوال حياته غريباً حتى في المنزل الذي وُلد فيه، التفت إلى خلدون، وقال له: هل تذكر كيف كنتُ أحدثك عن أخي السجين حسن؟ لقد حلمت عندما كنت صغيراً أنه سيخرج عندما تصل الكرمة في صحن دارنا إلى الطابق الثاني، وبالفعل تحقق الحلم عندما كنا في السنة الثالثة في الجامعة… استمر حديث خالد عن الذكريات ورحلة عذاباته، وخلدون بين الفينة والأخرى ينظر بطرف عينه إلى صديقه الذي يبدو كمظلي هبط من السماء، فيراه يبتسم ابتسامة ناعمة، ولكنه يعبس بشدة مع كلِّ لحظة حزينة تعبر في حديث خالد! وكأن هذا الشخص الذي يبدو في نهايات عقده السادس، قد كان ممثلاً بارعاً يبرع في عكس مشاعره على ملامح وجهه!
التفت خلدون إلى صديق خالد، لقد عَرَّفَ عنك صديقنا خالد أنك قاضٍ، ولكن أراك ذا وجه تلفزيوني يصلح لتكون نجماً سينمائياً. ابتسم القاضي، لكنه بقي صامتاً، وكأنه جُلْمود صخر يأبى أن يكشف داخله حتى يحافظ على هيبة هويته.
لكن كلُّ شيء انقلب عندما طلب منه خالد أن يحدث خلدون بقصته، ومنذ ذاك الطلب تحول القاضي حبيب إلى راوٍ بارع لقصة أغرب من الخيال.
كان القاضي حبيب نائباً عاماً، أُفرز مع بدايات الأزمة لصالح الإدارة العامة للاستخبارات نتيجة للضغط الهائل للقضايا وحالات الاعتقال، كان عمله يقتصر على تثبيت الأحكام القضائية لما يقترحه المحققون في ثلاثة أفرع استخباراتية، يقول القاضي: ربما كنت شاهد زور في تلك الفترة، فالتصديق على أحكام المحققين يتنافى مع مبدأ العدالة الذي درسناه أو مارسنا جزءاً ولو مشوهاً منه في أقسام التحقيق الجنائي. لكن لم يكن في الأمر حيلة، فكلُّ ما عليك فعله هو التأكد من هوية الشخص الماثل أمامك وتثبيت الحكم المذكور في إضبارته. أما إذا كان مذنباً أو بريئاً أو يستحق هذا الحكم أم لا، فهو أمر لا يمكن التحقق منه وخارج مسؤوليتي. أقنعت نفسي بدايةً، أن هذا الإجراء رغم خلوه من أي رائحة للمتعارف عليه من القانون، لكني أعلم أن الأوامر الصادرة من القيادة يُعتبر الاعتراض عليها بمثابة الخيانة العظمى، فما بالك في خضم هذه الأزمة التي تهدد النظام وأركانه وتحاول تخريب منظومة حياة درجنا عليها لفترة طويلة؟!! بل بالأحرى لم نعش خارجها ولو لثوان قليلة، فأي اعتراض ولو كان بالتلميح فإنه يدخلك في فئة المتآمرين الذين يستحقون الإفناء بعد أن كنت كما يقولون لحم كتافك من خيرات النظام ومَكرمات القائد!
إحدى أكثر اللحظات المؤثرة والمخيفة تحدث عندما يستقبل القاضي حبيب، الذي كان متواطئاً في تصرفات النظام القاسية، فتاةً لم تبلغ الخمسةَ عشرَ عاماً عمياء صغيرة تعرضت للتعذيب والاغتصاب على يد قوات النظام. تُركت الفتاة في حالة صدمة، محطمة جسدياً، ومشوهة عاطفياً. القاضي، الذي كان ينظر إلى المعارضين ذات يوم على أنهم مجرد أعداء يجب التعامل معهم، يبدأ في رؤية إنسانيتهم من خلال تلك الفتاة.
مثَّل هذا المشهد نقطة تحول في فهم القاضي للسلطة والظلم؛ حيث تعكس الإساءة الجسدية والعاطفية التي تحملتها الفتاة الوحشية الأكبر للأنظمة المستبدة، وتُظهر محاولة القاضي رعايتها ومحاولة فتح التحقيق بحقها من جديد صراعه الداخلي. يجبر المشهد القاضي حبيب على التفكير في التكلفة البشرية لإنعاش النظام وإزالة الإنسانية التي غالباً ما تصاحب الاستبداد.
يتأمل القاضي حبيب بعد هذه الحادثة، دوره في النظام ومعاملتهم لـ “للمعارضين”. تكشف أفكاره عن مزيج معقد من الشعور بالذنب والتبرير والشعور المتزايد بالقلق. يواجه نفاق منصبه ويبدأ في التساؤل عن الهياكل ذاتها التي تدعم القوة الجبروتية لنظام يدعمه العالم أجمع.
إنه الانحلال الأخلاقي الذي ينشأ عن التواطؤ في الأنظمة القمعية… إنه استكشاف عميق وغير مريح لكيفية تورط حتى الأفراد ذوي النوايا الحسنة في أنظمة القسوة والعنف. تسلط صورة الفتاة العمياء المغتصبة جسدياً ونفسياً الضوء على الإدراك التدريجي لدور القاضي في إدامة الأذى، مما يجعلها لحظة حاسمة في رحلته نحو الوعي الذاتي والتساؤل الأخلاقي.
عندما يذهب القاضي حبيب للقاء المحقق سلوم الذي أصدر الحكم بحق الفتاة، يشهد القاضي التعذيب المروع الذي تتحمله امرأة أمام طفلها الذي لا يتجاوز عمره الأربع سنوات، وهو يبكي بكاءً مراً بلا توقف في غرفة المحقق، والسجان يُمسكه من تحت إبطه بيد واحدة حتى كاد يخلع ذراعه. إن قسوة السجان والضابط سلوم مبررة باسم حماية النظام والقائد المفدى، لكن القاضي منزعج مما يراه، مما يخلق صدعاً في دعمه غير المشروط لأفعال النظام.
مشهد التعذيب وحشي وواضح ويصعب قراءته، لكنه يمثل تحولاً في منظور القاضي. إنه يجبره على مواجهة ذاته والتأثيرات اللاإنسانية للتعذيب، ليس فقط على الضحايا، ولكن أيضاً على من يقفون على الحياد والشهود الزور. يبدأ الصراع الداخلي للقاضي في التبلور هنا، وتعكس أفعاله اللاحقة مقاومته الأخلاقية المتزايدة.
عندما يبدأ القاضي حبيب في التعاطف مع “المعارضين” وإدانة سياسات النظام، يصبح معزولاً بشكل متزايد. يتدهور وضعه المحترم ذات يوم حيث يواجه اتهامات بالخيانة والتعاون مع الأعداء. يتم سجنه وتجريده من سلطته وتعرضه للإساءة الجسدية والنفسية، تماماً مثل الأشخاص الذين تجاهلهم أو ساهم في اضطهادهم ذات يوم.
سقوط القاضي حبيب من النعمة مأساوي للغاية؛ لأنه يسلط الضوء على تكلفة الصحوة الأخلاقية في نظام فاسد واستبدادي مثل نظام الأسدين. يوضح فقدانه للامتيازات والمكانة العواقب الشخصية للوقوف ضد السلطة القمعية. لا يتعلق هذا السقوط بفقدان المكانة أو الاحترام فحسب، بل يرمز إلى التفكك الأخلاقي الأكبر لكل من النظام ومن يطيعون أوامره العمياء.
يتأمل القاضي فكرة “المعارضة والموالاة”. ويدرك أن المجرمين الحقيقيين ليسوا الأشخاص الذين كان يوقِّع يومياً على مئات الأحكام بحقهم، بل أولئك الذين يضطهدون الآخرين ويحطون من قدرهم باسم القوة والتقدم ومحاربة الأعداء وتعزيز الشعور القومي. لقد أصبح مصطلح “المعارضة والعمالة” أداة للنظام لتبرير العنف والسيطرة.
تسلسل الأحداث؛ دفع القاضي حبيب لإعادة التفكير في مفاهيم القانون والصمود والمقاومة وما يعنيه أن تكون إنساناً. إنه تعليق قوي على كيفية قيام المجتمعات غالباً ببناء “الأوهام” لتبرير العنف والهيمنة.
العلاقة بين القاضي والسجان موسى الذي يعذب السجناء المعارضين هي دراسة في ديناميكيات القوة والفساد الأخلاقي. إن ولاء السجان غير المشروط للنظام وانزعاج القاضي المتزايد من دوره في النظام يخلقان توتراً قوياً. تجسد هذه العلاقة استكشاف القاضي حبيب لمفاهيم التواطؤ والطاعة والمقاومة. يمثل السجان موسى تفاهة الشر – شخص ينفذ الأوامر الوحشية دون سؤال. إن رفض القاضي قبول نظرة السجان للعالم يمثل لحظة رئيسة في صحوته الأخلاقية. هذه اللحظات كانت حاسمة؛ لأنها تتحدث عن الموضوعات الأوسع في النقاش الذي دار بينه وبين السجان: التوتر بين الحضارة والهمجية، وعواقب الظلم، والانحلال الأخلاقي للأفراد المتواطئين في أنظمة القمع، والنضال من أجل الوعي الذاتي في مواجهة الظلم. شهادة القاضي حبيب أضافتْ الكثير من التفكير العميق إلى خلدون في طبيعة القوة والعنف والأخلاق.
اكتشف القاضي أن تكلفة تجاهل إنسانية الآخرين، سواء من خلال التواطؤ في العنف أو الفشل في الاعتراف بمعاناة أولئك الذين يعتبرونهم “آخرين”. سيؤدي إلى انهيار الفرد وسقوط النظام لا محالة.
القاضي حبيب بعد جداله مع الضابط والسجان، رُفع به تقريرٌ وجُرد من وظيفته وجُرد من كل شيء، حتى إن الضابط الذي تشاجر معه كان يشرف على استجوابه وتعذيبه، ثم حبس لمدة شهر في السجن، وأشرف على تعذيبه السجان نفسُه الذي كان يُمسك بالطفل!! لقد سمحت له تلك التجربة المريرة برؤية ما خلف السجان، وصف القاضي حبيب السجان موسى بما يجول داخل كلِّ سجان عندما يعذب أبناء جلدته إرضاء لأسياده:
“كان السجان يقف وراء القضبان مثل جدار لا حراك فيه، قاسياً متماسكاً كالحجر، لا يعبأ بآلام السجناء وعذاباتهم. كانت عيناه فارغتين لا تومضان بأي شعور إنساني، لقد كان مجرد جهاز يتنفس ويؤدي واجبه، لكنه كان يعرف في داخله أنه مجرد أداة في يد قوى أكبر منه، لكنه لا يستطيع الهروب من دوره، ولا يملك القدرة على التمرد.”
“كان السجان موسى طويلاً وضخماً، عيناه غارقتان في الكآبة والسوداوية، وفي كل مرة كان يمر بجانبنا، كان جسده يبعث شعوراً بالقسوة، كأنما كلُّ خطوة له على الأرض تترك أثراً من الوحشية. كنت أراه وكأنما هو جزء من جدران السجن، قاسياً وصامتاً، لكن في تلك اللحظة، ربما كان يواجه صراعاً داخلياً لم أكن أراه.”
“كان السجان يراقبنا بعينين زائغتين، وكأن الجدران نفسها تأخذ شكل عينيه. كان صوته خافتاً، لكنه كان ينقل لنا رسالة واضحة من خلال تعابير وجهه المتجهمة. وفي كل مرة يدخل فيها السجن، كنت أشعر أن شيئاً ما يعتصر قلبه، وكأن الفظائع التي كان يمارسها تتسلل إلى نفسه، وهو لا يستطيع التخلص منها.”
“كان السجان يعاملنا كما لو كنا مجرد أشياء لا قيمة لها، جسمه كان يطفح بالقوة والسلطة، يقترب منا بخطوات ثابتة ولكن قلبه كان غارقاً في جمود رهيب. وفي كل مرة كان يمر بيننا، كان يختفي خلف جدران صماء من الحجارة، وكأنما هو نفسه لا يشعر بشيء سوى الانتصار الذي يحققه بإذلالنا.”
“كان السجان يبدو وكأنه من حديد، لا يهتم بالمشاعر الإنسانية، كلُّ حركة له كانت مدروسة بدقة شديدة. جسده كان كأنما هو آلة تتحرك بلا شفقة. لكن عندما كان يبتعد عنا، كنت أراه يتنهد بشدة، ويخفي وجهه عن أنظارنا؛ ربما كان يريد الهروب من نفسه، من الألم الذي يتسرب إليه في خلواته.”
“كان السجان يمر بيننا بخطوات حثيثة، وقد غطت قسوة وجهه كلَّ تفاصيله. يده مشدودة إلى جنبه مثل رصاصة جاهزة، لكنه كان أحياناً يتوقف ليشرب ماءً، وعينه تتأملنا. كان يعتقد أننا لا نرى ما خلف تلك الأَعْيُنِ المُتحجرة، لكنه كان يعكس لنا نظرة ضعف يعجز عن التخلص منها.”
“كان السجان يقف بلا حراك، جسده ضخم كالجبل، يحاول أن يتغلب على أي إحساس بالذنب. لكنَّ عينيه توحيان أن هناك شيئاً ما يختفي خلف هذه القسوة، وكأنه يواجه نفسه، أو ربما يواجه الذنب الذي لا يستطيع الفرار منه.”
أخيراً خرج القاضي حبيب؛ كونه مسيحياً وعائلته لها ثقلها في قريته مرمريتا، فأغلب عائلته كانوا ينتمون للحزب القومي السوري الذي كان داعماً صلباً للنظام، عندما خرج القاضي حبيب تبرأ من كل شيء يمت إلى ماضيه بصلة؛ فكَرِه ،أيديولوجيته، حتى عائلته التي أنقذته من القتل بقوة ولائها للسلطة، لقد كان وردة خرجت من حقل أشواك؛ فأدرك أنه لن ينجو إلا إذا عاش في محيط لا يمت إلى ماضيه وذكرياته بأية صلة، ساعده في ذلك أنه كان وحيداً لا يملك عائلة ولا أولاد، ودَّع أقاربه الذين ظنوه أنه أصيب بمس من الجنون نتيجة الصدمة التي تلقاها، لكنه هو من أدرك الحقيقة فغدا بصرُه حديداً، بينما بقوا هم في سكرتهم يعمهون!







