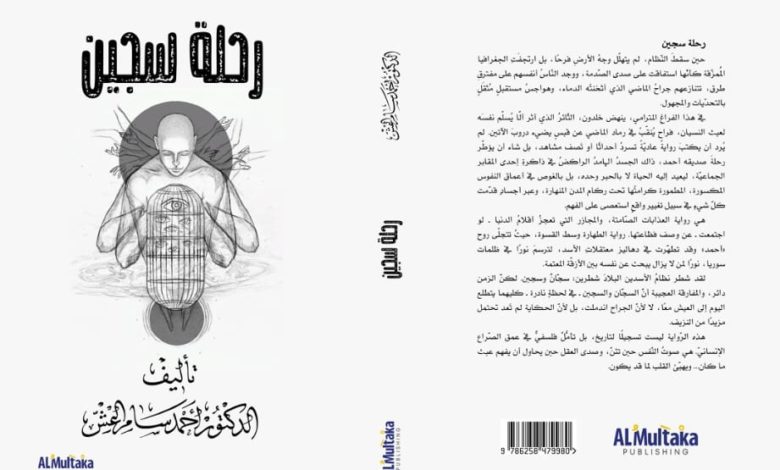
خرج الطبيب سعيد من منزل صديق خلدون، عاد الصديق الذي ودع الطبيب إلى الباب، ليجد خلدون جالساً في صمت مطبق، وكأنه في جلسة تأمل روحي، أو أنه يعيش في عالم آخر، أو أن روحه قد ودعت جسده تهيم في ملكوت الله تبحث عن أجوبة للأسئلة التي لا تنتهي، بينما عالم أسود ضبابي يقف سداً في طريق عودتها إلى الجسد المنهك، كان صديق خلدون الذي يدعى طاهر، يحاول إنعاش هذا الجسد -الذي عجزت روحه التائهة عن إيجاده- بطلب رأي خلدون عما سمع وما هي انطباعاته، دون أن ينطق خلدون بأي كلمة أو يُظهر أي ردة فعل، فقد كان ينظر في وجه صديقه دون أن يراه. بقي خلدون على تلك الحالة لدقائق فحواسه الخمسُ بوضيعة الاستقبال دون إمكانية الإرسال، إلى أن سمع كلمة أحمد ضمن سياق الكلمات المنبعثة من فم صديقه، عندها وجدت روح أحمد السابحة في فضاء المدينة مكان الجسد المتصلب في تلك الغرفة. أخذ جسد خلدون شهيقاً عميقاً عند عودة روحه إلى مسكنها، عندها أرسلت أول حواسه الرسالة التالية: عفواً طاهر، ماذا تقول؟ عندها شعر طاهر بالخجل من نفسه وسخافة حديثه مع شخص يبدو أنه خارج التغطية، التفت إليه بحدة، وقال له باللغة العامية: “شو وين عقلك؟ شكلك ما لك هون منوب”، اعتذر خلدون صاحب الخلق الرفيع، وقال له: والله حديث الطبيب سعيد، كأنه أصاب دماغي بفيروس مدمر.
هنا أحسَّ خلدون أن في فم طاهر كلاماً لم يعد يستطيع أن يكتمه. بعد أن انتقل الصمت وتوهان الروح من خلدون إلى طاهر، طرح خلدون السؤال التالي: ويكأن في فمك حديثاً حبيساً تريد أن تطلق سراحه. بعد هنيهات من التوقف قال طاهر: حديث الدكتور جعلني أفكر كيف أن النظام شرخ مجتمعنا بين سجين وسجان، وليس هناك حالة ثالثة بينهما كما كان يدعي في تقييماته، حين كان يصنفنا بين موالٍ ومعارض وحيادي إيجابي وحيادي سلبي! والعجيب الذي جلب انتباهي في حديث الدكتور سعيد، كيف يمكن للصدفة والعشوائية أن تلعب دوراً في وضعك في أيٍّ من الموقعين أو تجعلك تنتقل من ضفة لأخرى! عندما قلت لي: إن حديث الطبيب سعيد أصابك بفيروس ذكرني بقصةً حدثت معي قبل الثورة بقليل. كان عندنا في السوق رجل مقطوع اليدين من فوق المرفق، له وجه منير مشع مملوء بالرضا طوال الوقت والابتسامة لا تفارق محياه، كنا نحبُّه في السوق لأدبه وتعففه ونكرمه دائماً، كان يعمل في دكان جار لنا، لم يكن أحد يعلم قصته، وكيف قطعت يداه؟ وما سر رضاه وعدم تذمره وسر الابتسامة الناعمة التي لا تفارق وجهه؟ توطدت علاقتي به بعد عدة سنوات، كان الكلُّ يروي قصصاً مختلفة عن سبب بتر يديه الاثنتين، وتصله بعض من تلك القصص دون أن يعلق بالنفي أو الايجاب، فقد كان يبتسم دون أن تشعر أن شيئاً داخله تحرك أو أن سكينة نفسه تزعزعت ولو بمقدار شعرة!
ومع انطلاق أول مسيرة احتجاج في سوق الحريقة، ونزول وزير الداخلية وقتها لامتصاص غضب الناس عدت لدكاني وصادف ذلك عبوره أمامها، دعوته لشرب الشاي، كان قد انتابني شعورٌ غريب عندما تجمهرنا لأول مرة، وطالبنا بما لم نكن نجرؤ عليه منذ أن وعيت على هذه الحياة، فقد كان آباؤنا ينبهوننا دائماً –منذ نعومة أظفارنا- إياكم والحديث بالسياسة، ويطرقون على أدمغتنا مقولات مكررة ممجوجة كانت دستور حياتنا من أمثال: الجدران لها آذان، اللهم أبعد عنا الحكام والظلام… وكعادة تجار السوق، كان لدينا معادلة عجيبة تتمثل في خلط المال باللسان الناعم والكلمات المنمقة، مع رشة بهارات من التقية التي دأبنا على ممارستها قبل أن نعرفها ديناً لدى الشيعة الذين غزونا مع نظام الأسد. كلُّ ما سبق كان كتابنا المقدس الذي أقسمنا على الولاء له وتوارثناه جيلاً بعد جيل، حدَّثْتُ هذا العاجز الوديع بما اختلط في نفسي، وكيف أننا رغم خوفنا الشديد، لكنَّ شيئاً ما في داخلنا استيقظ من سبات عميق، لا أعرف ما هو، لكن كلُّ ما يمكن أن أقوله أنه شعور لم أجربه قبل الآن. عندها فقط فتح هذا الكائن المبتسم دائماً -رغم مصيبته- صندوقه الأسود، وقال لي: سأحدثك الآن بقصتي وسبب فقدي ليديَّ الاثنتين، لقد كنت مساعداً في فرقة الوحدات الخاصة التي اقتحمت حماة في بداية الثمانينات، كنت شاباً رياضياً مندفعاً، مغسول العقل بكل ما يروجه النظام، وكنت مدافعاً شرساً عنه، كنا نصفي الرجال بمشهد لا أذكر ما يشبهه إلا في فيلم مجزرة دير ياسين الذي كان يعرض علينا باستمرار على قناة التلفزيون الرسمي اليتيمة في ذاك الوقت، كنا ندخل الحي فلا نبقي فيه رجلاً إلا قتلناه، أما النساء والأطفال، فنجعلهم يمشون لكيلومترات خارج منازلهم وهم حفاة عراة إلا مما يخرجون به على أجسادهم، ومرة وفي تمشيطنا لأحد الطوابق في بناء قديم، دخلت شقة في الطابق الثالث، ووجدت في إحدى غرفها امرأة خائفة تحتضن صغيرها الرضيع، وتجلس في زاوية الغرفة على الأرض تضمه إلى صدرها حتى تكاد تعتصره من الخوف، كانت رائحة الموت تنبعث من كل زاوية في ذلك الحي، كان مستوى الأدرينالين في جسدي عالياً بشكل لا يوصف، كان دخولنا مع بعضنا كسرب قطيع ذئاب جائع يحرك في داخلنا شيئاً موحشاً ومخيفاً لا يمكن أن أصفه لك، وتشجيعناً لبعضنا بعضاً مع كلِّ قتيل نعدمه رمياً بالرصاص أو نجز عنقه بالسكين تعطيناً شعوراً غامضاً بالنشوة والانتماء. كانت المدائح والتعليقات بالإعجاب التي نلقيها على كل حركة قذرة أو عمل دنيء يقوم به أحد أفراد المجموعة سواء بالتفنن بالتعذيب أو الإبداع في الانتقام ممن يريدون أن يشوشوا علينا صفاء الصورة النمطية التي رسمناها في مخيلتنا، قد حولتنا دون أن نشعر من جيش نظامي مدرب لقتال العدو الإسرائيلي إلى مجموعة قتلة ومرتزقة مأجورين متفلتين من عقالهم، نظرتُ إلى تلك السيدة ورضيعها وقد تكورت في زاوية غرفتها قائلاً: أين خبأتم رجالكم؟ كنت أعلم أن رجالهم قد صفيناهم قبل دقائق معدودة عندما أدخلناهم بلا تمييز أو تحقيق أو فلترة إلى دكانة فارغة، وأطلقنا عليهم النار بلا رحمة أو شفقة. كنت بدافع غير معروف أريد أن أتفوق بالإجرام على زملائي، بل حتى على رؤسائي ومن ألقى وأصدر الأوامر لنا بالقتل، عندها أجابتني وصوتُها يرتعد من الخوف ووجهُها أشد صفرة من الليمون الطازج: والله ما في رجال بالبيت، شيء غريب دفعني لإمساك رضيعها من بين يديها وكأني أمسك بقطعة أثاث أو دمية بلاستيكية لا روح فيها، وأقول لها: أليس هذا برجل؟ وألقي به من النافذة، وكأني ألقي بكيس قمامة، كنت قد لمحتها بطرف عيني وأنا أهم بالخروج من الغرفة لأجدها وقد أغمي عليها. في الحقيقة، لا أدري أهي ماتت من القهر أو أغمي عليها؟ لم أهتمَّ لأمرها، كلُّ ما هنالك أني كنت أريد أن أخرج بسرعة؛ لكي أروي بطولاتي لزملائي؛ ولأثبت لهم ولائي للقطيع وسيده المُلهم للرواية المحفورة في ذاكرتنا المجمدة، لم أجد أحداً في البناء، ربما سبقوني إلى الخارج نزلت السلالم بسرعة سعيداً فرحاً بقصتي التي ترفع منسوب الانتماء إلى القطيع، وبمجرد خروجي من البناء، إذ بكابل التيار الكهربائي العالي ينفلت من العمود الخشبي ويهبط إلى الأرض والشرر يتطاير منه، بشكل لا إرادي أردت إمساكه بذارعيَّ فقُطعتا على الفور، أغمي علي ولم أعِ على نفسي إلا وأنا في المستشفى. عندها علمت أن الرسالة الإلهية وصلت، ومن وقتها وأنا أوقن أن الله أراد لي التطهر بالدنيا قبل أن أقابل وجهه الكريم في الآخرة، ومنذ تلك اللحظة فقدت ذراعيَّ، لكني وجدت نفسي، والأهمُّ أنني وجدت الله، كانت تلك الكهرباء ذات التوتر العالي قد أيقظت روحي من سباتها العميق، وأقسمت لربي من وقتها ألَّا أعود إلى الحال الذي كنت عليه، والآن أشعر أن السلك الذي سقط بقدرة الإله وأصابني في ذاك اليوم، الذي غيَّر مجرى حياتي بحق، قد سقط اليوم على مجتمعنا السوري، بعد أن كان وضعكم يذكرني بوضعي قبل أن يهوي ذاك السلك على يديَّ؛ لذلك أبوح لك بالحقيقة؛ لأنكم قبل هذا لم تكونوا لتدركوا شعوري قبل وبعد الحادثة!
هنا سأل خلدون طاهر: هل تظنُّ يا طاهر أننا كنا نحمل جزءاً من الجريمة التي ارتكبها هؤلاء؟ وأننا قد دفعنا لأكثر من أربعَ عشرةَ سنة الفاتورة المتأخرة علينا منذ أن سمحنا نحن والأجيال قبلنا أن ندمن الصمت! هل أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض. هنا أجابه طاهر لا أدري يا خلدون حقيقة لا أدري؟
يعترف خلدون وطاهر ضمنياً بأن الحرية الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا عندما يكون الناس على استعداد للقتال من أجلها، حتى بتكلفة شخصية كبيرة. القصص التي تمتلئ بها الآن الفضائيات والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي تُظهر ثمن الحرية، بما في ذلك فقدان وسائل الراحة الشخصية والأسرة وأحياناً حتى الحياة. أدرك خلدون أن سقوط النظام لم يأتِ نتيجة نصر عسكري، وإن كان يُمثل رأس جبل الجليد، لكن في الأعماق كان دعاء الأجساد المكدسة في الزنازين والمقابر الجماعية وصرخات الأطفال اليتامى، وأعراض النساء التي انتهكت بلا رحمة هي من حققت النصر وهي من ستكون الضامن لعدم تكرر المأساة، وإن كان بأشكال مختلفة !







