
دعونا نتفق الآن على ما أظهرته التجربة للثورة السورية من معضلة رئيسية تتمثل في أن من يمتلك الوعي السياسي في سورية لا يمتلك القدرة على التأثير في الجماهير والتفاعل معها وقيادة الحركة الشعبية، وأن من يمتلك القدرة على التأثير في الجماهير والتفاعل معها وتوجيهها لم يكن يمتلك الوعي السياسي العصري الملائم لقيادة الحركة الشعبية نحو تحقيق أهدافها المعلنة في الحرية والكرامة والديمقراطية.
وعندما نحدد المسألة التي بين أيدينا كما سبق يمكن لنا أن نخطو خطوة إلى الأمام نحو تحديد أية نخب سورية نعني، وأن يمتلك مصطلح ” النخب” معيارا يساهم في إزاحة الضبابية التي تتيح للبعض اللعب على المصطلح والتهرب من جوهر المشكلة التي نحن بصددها.
ويحيلنا مثل ذلك النقاش إلى الفرق بين من ينظر للتغيير باعتباره صناعة النخب ومن ينظر إليه باعتباره صناعة الشعب والحركة الجماهيرية في أطرها التنظيمية من أحزاب ونقابات وجمعيات تطوعية …الخ
فمن ينظر للتغيير السياسي باعتباره صناعة النخب لا يحتاج للاستناد لقاعدة اجتماعية ولا للتأثير في الجماهير والتفاعل معها، بل ينظر للشعب ككتلة جامدة صماء تتحرك وفق عقل جمعي موروث مغلق فما الفائدة من المراهنة عليه في التغيير السياسي الديمقراطي؟
حسنًا إذن كيف يمكن أن يحدث التغيير المطلوب؟ يجيب الفريق ” النخبوي”:
بالتبشير بوعي جديد، شيء يشبه صناعة دين جديد، فإن لم يكن ذلك واقعيًا فهناك حل آخر مضمر منطقيًا لدى ذلك الفريق وهو انتظار رافعة ما، تدخل خارجي، انقلاب عسكري، انشقاق داخل النظام …. وعند ذلك يمكن التمفصل مع مثل تلك الروافع والدخول للمجتمع من فوق لتغييره عن طريق سلطة الدولة.
لكن مهلًا قليلًا: ألا يعني ذلك أننا نضع الديمقراطية وراء ظهورنا؟ وماذا إذا كان الشعب له رأي آخر في غالبيته الساحقة؟
مما سبق يبدو كأن مصطلح النخب قد انشق على نفسه فأنتج لنا نخبتين متضادتين.
نخبة تتحدد بشرطين متلازمين امتلاك الوعي السياسي العقلاني الديمقراطي والانتماء للشعب والإيمان بقدرته على الفعل السياسي والاستناد إليه في عملية التغيير الثوري من خلال تفاعلها معه وقدرتها على التأثير به وقيادة الحركة الجماهيرية.
ونخبة أخرى مختلفة تمامًا تعتقد بأن السبيل الوحيد للتغيير في ظل مجتمع متأخر وعقل جمعي مغلق ومتخلف هو التغيير الذي تحمله ” نخبة ” وتفرضه على المجتمع عن طريق رافعة ما (….) مثل تدخل خارجي أو انقلاب عسكري …ومثال ذلك جمعية تركيا الفتاة وحزبها ” الاتحاد والترقي ” وزعيمها مصطفى كمال وما يمكن تسميته بالأتاتوركية.
ولماذا نبتعد؟ ألم يكن ذلك هو جوهر عقلية اللجنة العسكرية البعثية في نظرتها للتقدم والتقدمية وفي التعامل مع الشعب السوري قبل أن تتمخض تلك العقلية عن معاداة الشعب والإغراق في الديكتاتورية.
لا يمكن الجمع بين نقيضين الديمقراطية والحرية للشعب والاعتقاد بأن التقدم للمجتمع يمكن فقط أن يأتي من نخبة معزولة تنظر للشعب باعتباره غير مؤهل للديمقراطية والتقدم وبالتالي لابد من تأهيله من فوق كما يعطى الطفل الدواء رغما عنه.
مما لاشك فيه أن انعزال النخب السورية عن الشعب وفشلها في التفاعل معه كان من أهم الأسباب وراء مراهنتها على التدخل الخارجي في الثورة السورية، وبالمثل فالانفصال عن الشعب والنظر إليه باعتبار أن عقله الجمعي الموروث لا يسمح له بتقبل الحداثة وأفكار التقدم والبحث عن صانع ” نخبوي ” لتغيير يأتي من خارج الشعب ومن فوقه سوف يقود بالضرورة إلى ذات الخطأ الكبير الذي وقعت فيه النخب السورية في مراهنتها على التدخل الأمريكي لإسقاط النظام عشية الثورة السورية.
كما أن إضاعة الوقت في نبش التاريخ العربي الإسلامي لا من أجل أخذ العبر المفيدة للمستقبل ولكن من أجل التقاط السلبيات التي كان لابد أن ترافقه عبر مئات السنين وتسليط الضوء عليها وتعظيمها والخروج باستنتاجات تفتقر للموضوعية والدراسة المعمقة تتلخص في اعتبار ذلك التاريخ كله كتابًا أسود لابد من إدارة الظهر له أو إعادة تفسيره تفسيرًا لا يتسم بالروح الموضوعية والنزاهة والعمق كل ذلك لا يمكن اعتباره تنويرًا بل مجرد تهجم واتهام يفتقر للأسس البحثية العلمية موظف من أجل الانتهاء لفكرة مسبقة عن عقل جمعي عربي إسلامي يشكل عقبة تاريخية كأداء أمام الحداثة مما يستلزم حصر فكرة التغيير بالنخب وملء تلك الفكرة بمضامين لا تقيم أي وزن لدور الجماهير كصانعة للتغيير .
وفقًا لتلك الرؤية ” النخبوية ” شبه الأيديولوجية فالوعي السياسي المطلوب لا يتشكل بالتزامن مع النضال السياسي وبالمراهنة على الحركة الشعبية والعمل لإنهاضها والتمفصل مع الحراكات الوطنية الديمقراطية في أي منطقة، ولكن بصورة مستقلة، منعزلة، حتى تنضج وتخرج ” النخب ” من الشرنقة لتحلق عاليًا فوق الشعب.
ومن نافلة القول إن من الظلم الفادح النظر للشعب السوري على هذا النحو، وهو الشعب الذي بهر الغرب حين استطاع بفترة تعد بالأشهر وليس بالسنوات الانتقال من نظام الاستبداد العثماني إلى نظام ديمقراطي حداثي تمتعت سورية فيه بحياة سياسية غنية وحركة جماهيرية منظمة وصحافة حرة ومؤتمر عام أخذ باقتدار مهمة الجمعية التأسيسية والبرلمان وتمكن من وضع أفضل دستور عربي حداثي وعَلماني غير معاد للدين بمشاركة التيار الإسلامي الليبرالي، وأعني بذلك العهد الفيصلي الذي عاش فيما بين الأعوام 1918 -1920 تلك الديمقراطية التي وصفتها البروفسورة الأميركية اليزابيث طومسون بأنها أول تجربة ديمقراطية حقيقية للعرب أجهضها الغرب عبر الاحتلال الفرنسي عام 1920.




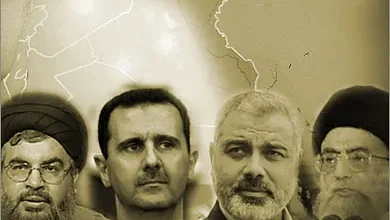



أثبتت الثورة السورية بإن النخبة التي تقود الثورة يجب أن تمتلك الوعي السياسي والتأثير بالجماهير والتفاعل معها، نحو تحقيق أهدافها المعلنة في الحرية والكرامة والديمقراطية، وإن شعبنا قادر لإنتاج تلك النخبة مثلما إستطاع الإنتقال من نظام الاستبداد العثماني لنظام ديمقراطي حداثي بفترة أشهر، وليس عن طريق نبش التاريخ بإسم التنوير والحداثة أو بالرافعة الخارجية، .