
أية وحدة عربية في المستقبل
إنّ مشروع الوحدة العربية هو جوهر الحركة القومية العربية، بمثل ما هو هدفها في الوقت نفسه. ولذا فقد لازم الهدف الحركة منذ نشوئها، وتطور معها نمواً وضموراً، وصعوداً وهبوطاً. ولكنّ أغلب المشاريع الوحدوية كانت من نمط الوحدات التي تفقد شعار الوحدة أهميته وجديته، حيث أنّ بعضها جاء تعبيراً عن محور سياسي عربي ضد محور عربي آخر، كما أنّ بعضها الآخر قد جاء على أمل حل بعض المشاكل السياسية أو الاقتصادية الطارئة. وبشكل عام يمكن أن نلاحظ أنّ هذه التجارب انطوت على جانبين: أولهما سلبي، حين أُفرغ الشعار من مضمونه التحرري، وحين أفقد جدية وثقة الجماهير العربية بالوحدة. وثانيهما إيجابي، يتمثل في بداية نضج فكرة التدرج في العمل الوحدوي، الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للدول العربية.
إنّ الشعار، رغم أهميته بالنسبة لقضايا النضال العربي في التاريخ المعاصر، أصبح أكثر صعوبة وتعقيداً. لأنه من جهة أولى، لم يدخل في إطار العمل والإنجاز المتواصل. ولأنه من جهة ثانية، لم ينمُ بشكل واضح ومتدرج. ولأنه من جهة ثالثة، اصطدم بتجارب فاشلة وبتراجعات متوالية. وفي ضوء هذا الواقع، لم يعد يجدي طرح شعار الوحدة بصيغته العامة، إلا بمقدار ما تكون الصيغ عملية وواقعية، يمكن من خلالها تجسيد الهدف. وبكلمة أخرى ” إنّ كل خطوة عملية، مهما كانت صغيرة، في اتجاه الوحدة، هي وحدها التي ستقود إلى الوحدة، إذا كانت هذه الخطوة جزءاً من عمل كبير مخطط، وكانت بتوقيتها وطريقة تنفيذها صحيحة ومُحكمة “.
لقد دلت التجارب الوحدوية العربية المعاصرة أنّ مطلب الديمقراطية لا يقل أهمية عن الوحدة ذاتها، إذ إضافة إلى كونه مطلباً حيوياً للشعوب، فإنه المحتوى الحقيقي الفعلي للوحدة، وهو أيضاً المناخ الذي يساعد على قيامها، ثم على استمرارها وحمايتها بعد أن تقوم. كما دلت على أنّ الوحدة لا تعني الدولة المركزية أو الاندماج الكامل والفوري لأجزاء الأمة العربية، لذلك فإنّ المفكرين القوميين حاولوا أن يجدوا، بين هذين الحدين، صيغاً مرنة لتحقيق هدف الوحدة. ومن أمثلة ذلك، يمكن أن نذكر ” أنّ عملية تحقيق الوحدة العربية لا يمكن أن تتم في فراغ بل لا بدَّ أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود، وهو واقع التجزئة، وتتحرك منه بقفزات متدرجة نحو الوحدة. ولعلَّ أهم ما يمكن استنتاجه – عملياً – من ذلك، هو أنّ الوحدة لا تتم دفعة واحدة، ولن تكون شاملة منذ البداية. والاستنتاج الآخر يتعلق بشكل نظام الحكم في الدولة العربية الموحدة، فهو كما يبدو سيكون أقرب إلى النظام اللامركزي الاتحادي منه إلى الدولة المركزية الموحدة “.
وهكذا فقد تبلورت نظرية التدرج في تشييد الوحدة العربية المستندة على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تستند هذه النظرية إلى أنّ الوحدة، بمنطق التاريخ المعاصر، تقوم على وحدات اقتصادية تمهد لها وتقود إليها، وهذه الوحدات الاقتصادية تتم بداية داخل كل دولة عربية، ومن ثم داخل كل مجموعة إقليمية عربية. ولا شك أنّ هذه النظرية قد أخذت في التبلور بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية، من أهمها:
(1) ـ الانتكاسات العربية، وخاصة هزيمة يونيو/حزيران1967، وكذلك تجيير حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 لصالح عقد معاهدات جزئية.
(2) ـ ضخامة المصالح الدولية، وخصوصاً مصالح الدول الرأسمالية الكبرى، التي حاصرت اقتصاديات الدول النامية ووظفتها لخدمتها. فبسبب فشل تجارب الحركة العربية في تشييد أنموذج وحدوي، وفشلها في خطط التنمية الخاصة بها، اضطرت إلى تركيز النظر على العامل الاقتصادي ليكون أساساً لبنية الوحدة.
(3) ـ تعالي لغة تجميع الموارد في عموم المجتمع الدولي، الذي اتجه صوب تشييد الكيانات الكبيرة ذات الاقتصاديات الواسعة.
ومن الممكن انتقاد هذه النظرية من عدة جوانب، بسبب حتميتها وإلغائها عامل الإرادة السياسية، وعدم اهتمامها بدور الأيديولوجيا الموحِّدة التي يمكن أن تبني حولها إجماعاً يتجه نحو العمل الاقتصادي والاجتماعي الذي يتجه بدوره نحو الوحدة. ولكنّ الأمر لم يقتصر على مراجعة واحدة لفكرة الوحدة العربية، وإنما تعددت وجهات النظر حول كيفية الوصول إلى دولة الوحدة، ويمكن أن نرصد الاتجاهات التالية في هذا المجال:
(1) ـ اتجاه يدعو إلى ضرورة التعرف على القوانين العامة في العمل الوحدوي، وغرسها في عقل المواطن العربي من خلال التنظيمات العربية، ونطلق عليه اتجاه ” الوضعية الوحدوية “، ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه الدكتور نديم البيطار، الذي قدم مجموعة من الدراسات العلمية حول ظاهرة الوحدة، وذلك من أجل تحديد القوانين الأساسية والثانوية التي تكشف عنها عملية الانتقال من حالة التجزئة إلى حالة الوحدة في تجارب التاريخ الوحدوية.
وفي مجمل ما كتبه نجد أنّ مفهوم ” الإقليم – القاعدة ” يشكل المحور الرئيسي لدراساته، وحسب اعتقاده أنّ الديمقراطية لا تتحقق إلا في دولة الوحدة، وفي هذا الصدد يقول ” إن نحن أردنا حقاً ديمقراطية صحيحة، نامية مستقرة، وجب قبل كل شيء معالجة الضعف العربي الذي لا يسمح بظهور هذه الديمقراطية، وهذه المعالجة تفرض قيام دولة الوحدة كأداة لتوحيد وتعبئة إمكانات الأرض والشعب المتوفرة لنا بضخامة. فالمجتمعات التي تعيش في خوف دائم على استقلالها، في قلق دائم على مصيرها وكرامتها، والتي تتعرض باستمرار إلى المخاطر الخارجية والأزمات التي تترتب عليها، هي مجتمعات لا تنفتح لأية ديمقراطية صحيحة “.
(2) ـ اتجاه يهتم بالأقليات القومية والطائفية، وضرورة إفساح المجال لها للمشاركة في العمل القومي، برز على الخصوص منذ سبعينيات القرن العشرين، وضم عدداً من الأكاديميين والمفكرين العرب. ولعلَّ اهتمام هؤلاء المفكرين بمسألة الأقليات يرجع إلى تفاقم بعض المشكلات السياسية التي واجهت العديد من الدول العربية بشأن مشكلة الأقليات.
(3) ـ اتجاه يؤكد أنّ إيجاد المناخ الديمقراطي وإفساح المجال أمام الشعوب، وكسر احتكار النخبة المثقفة للعمل القومي، هو الطريق لدولة الوحدة.
(4) ـ الاتجاه الذي يركز على المنهج الوظيفي في التعامل مع قضية الوحدة، حيث بدأ هذا الاتجاه بالتبلور خاصة بعد ظهور التكتلات الإقليمية العربية، حيث رأى أصحاب هذا الاتجاه أنّ ظهور هذه التكتلات يُعد تطبيقاً للمنهج الوظيفي في التعامل مع قضية الوحدة، كما أشار بعضهم إلى أنّ هذه التكتلات تستلهم نموذج ” السوق الأوروبية المشتركة “. والواقع أنّ هذا المنظور للاتجاه الوظيفي يعني أنّ لكل إقليم من الأقاليم العربية دوراً محدداً لا يمكن أن تستقيم الحياة العربية المشتركة إلا بقيامه به.
وبعد كل الأفكار والتجارب الوحدوية، التي عرفها العرب في تاريخهم المعاصر، تبلورت كتابات وحدوية جديدة، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي، تتميز بـ ” عقلنة الخطاب الوحدوي “. وهي تنطلق من أنّ الكتابات الرومانسية عن الوحدة العربية تساهم في إغناء الوجدان العربي، وتوسع دائرة الحلم العربي، لكنها لا تقيم الوحدة. إذ إنّ التأثير الحقيقي لا يتمُّ إلا بعد فهم معطيات المحيط العربي، بكل متغيراته وثوابته. وهو ما يعني محاولة إنجاز الحسابات السياسية التاريخية والعقلانية، ومحاولة تعميق الوعي بالمصالح والمنافع والخيرات المشتركة.
لقد ميزت الكتابات التقليدية في الفكر الوحدوي بين المدخل السياسي، والمدخل الاقتصادي، والمدخل العسكري. أما الفكر الوحدوي الناشئ فإنه ” يتجه، من جهة، نحو إعادة النظر في منطق التمايز بين المداخل المذكورة. مع محاولة إبراز التداخل الكبير بين الرأسمال الاقتصادي والرأسمال السياسي، والرأسمال الرمزي الثقافي “. لا ترتبط العقلنة هنا بالدفاع عن المدخل الاقتصادي بقدر ما تتجه نحو مواجهة الإشكال الوحدوي في شموليته، فالاقتصاد والسياسة والثقافة والتربية المواطنية، كلها عناصر متداخلة، حتى وإن صُنفت بشكل منفصل ومتقطع، وإنّ التفريط في أي جانب منها، باسم المطلب الكلي الشامل، يفرّط فيها أكثر مما يقرّب منها.
ويحتل مفهوم الدولة الوطنية مكانة هامة في الكتابات الوحدوية الجديدة، باعتبار أنّ تراكم خبرات بناء الدولة الوطنية الحديثة يساعد على إمكانية بلورة رؤية واقعية لكيفيات بناء الدولة القومية الواحدة. وعلى هذا الأساس، فإنّ البناء الوحدوي العربي، المستفيد من التجارب الوحدوية السابقة بما فيها بناء الدول الوطنية الحديثة، يُعتبر بمثابة تعاقد قومي جديد، أساسه الخيار الديمقراطي الحر ” لا يمكن أن تتم الوحدة أو تكون دون ديمقراطية، بدون تراضي الدول العربية المرشحة لأن تتحد إما كمجموعات إقليمية، أو كعالم عربي موحد. لا طريق آخر إلا طريق التراضي الديمقراطي بين هذه الدول، أي أنه يجب أن تعترف كل دولة عربية بالدولة العربية الأخرى، ولا يمكن أن تكون الديمقراطية بهذا الشكل إلا إذا كانت متوفرة في كل بلد على حدة “.
إنّ الوحدة العربية ليست عملية قيصرية إكراهية ضد كل الوقائع القائمة في العالم العربي، وإن كانت في جوهرها ثورة على جوانب كثيرة من تلك الوقائع، بل هي خيار طوعي حر وواعٍ يسلكه الأفراد والجماعات بفرادة مدركة لمصلحتها.
لقد غدا ثابتاً أنّ التجارب الوحدوية العربية لم تكن إلا محاولة استعادة بعضها لبعض، في طبعات تختلف في شكلها، بينما مضمونها لم يتبدل في أغلب الأحيان، وصعوباتها هي نفسها. فما هي الأوهام التي سقطت في امتحان التجربة والتاريخ؟
- – الوحدة ” الانعزالية “، حيث توهم أغلب القوميين أنّ الوحدة شأن عربي محض، طالما أنّ شروطها الذاتية، المتعلقة بإرادتنا، وشروطها الموضوعية، المتعلقة بمقوماتها، متوفرة وموجودة، وهي لذلك تعنينا وحدنا أو لا دور للآخرين فيها إلا بمقدار ضئيل. وإذا كانت الوحدة شأناً داخلياً، في المرتبة الأولى، إلا أنها أيضاً شأن دولي، تاريخي – سياسي مرتبط بمجموعة شروط وقواعد، أكثر تعقيداً واتساعاً من أن نملكها وحدنا.
إنّ كل زعم بإمكانية بناء وحدة، باعتبار ما نملك من قوة وحسب، بمعزل عن محيطها وواقعها وعالمها، هو وهم باطل. إذ لا قوة لمن لا يستطيع أو لا يعرف كيف يحول بين معوقات الخارج ورغبات الداخل.
(2) – الوحدة ” الفارغة “، أي الوحدة من دون مضمون، وهي وحدة لا تاريخية، أي خارج سياق الأشياء والوقائع والأفعال. فلقد ظن بعض القوميين أنّ المطلوب هو الوحدة وكفى، انطلاقاً من الاكتفاء بالمبدأ وإهمال التفاصيل والتطبيقات العملية.
(3) – الوحدة ” الزعاماتية “، وهي التي تنشأ بفعل إرادات أو رغبات ذاتية لـ ” الزعيم “، والرغبة التي ” تنشئ ” وحدة اليوم، في ظل مشاعر وأسباب وشروط محددة، سرعان ما تطيح بها رغبة أخرى في اليوم التالي، في ظل مشاعر وأسباب وشروط مختلفة، فتُلغى الوحدة بقرار مثلما قامت بقرار.
(4) – الوحدة ” اللاديمقراطية “، إذ إنّ بعض القيادات القومية ارتأت أنّ مطلب الوحدة هو أكثر شرفاً ونبلاً وتعميماً من أن تحده شروط الديمقراطية، وكأن الوحدة إضافة محايدة لا علاقة لها بالناس، بحياتهم وبمستقبلهم، وعليه فهي إما أن تصون حرياتهم وحقوقهم الأساسية، أو تسيء إلى تلك الحريات والحقوق فتسيء، بالتالي، إلى حياتهم ومستقبلهم. فإذا كان مطلب الوحدة قادراً أن يدفع ملايين الناس إلى الشوارع لتفرض الوحدة فرضاً، فإنّ اللاديمقراطية قادرة، بدورها، أن تعيد هذه الملايين إلى بيوتها مُحبَطة ويائسة وكافرة بالوحدة نفسها.
وهكذا، فإنّ الدرس الأهم من التجارب العربية الوحدوية المعاصرة هو أنّ التسرع في إظهار مطلب الوحدة، كيما يُذبح بعد ذلك، هو أكثر إيلاماً للمشروع العربي، من التأني في طلبها والتدقيق في شروطها، والتعقل في البحث عن أشكالها العملية، حتى وإن طال بها الزمن أو تأخر.
كما أنّ التجربة أثبتت أنّ الوحدة العربية ليست عقيدة أو إيديولوجية مغلقة على ذاتها بل هي مفهوم وهدف استراتيجي، يمكن أن تتلاقى على تحقيقه تيارات فكرية وسياسية متباينة. فوحدوية أي برنامج أو ممارسة، لم تعد تقاس بالشعار المرفوع، بل تقاس – أساساً – بمقدار نجاح هذا البرنامج أو الممارسة في إيجاد وقائع وحدوية فعلية على الأرض، تستقطب الشعوب إلى العمل الوحدوي.
وهكذا، فإنّ النقد الذاتي هو دافع ومحرك ورافع نحو التقدم، فلا يجوز أن نكتفي بنقد الإمبريالية والصهيونية وجعلهما مشجباً نعلق عليهما عوراتنا وهزائمنا. فقد سحقت فكرة ” الثورة ” فكرة ” التقدم ” في العالم العربي المعاصر، خاصة في قطريه الرئيسيين سورية والعراق. وليس المطلوب بناء أيديولوجية جديدة، وإنما المطلوب هو تغيير نوعية العلاقة القائمة بين الأفكار والتيارات القائمة في العالم العربي، وتحويلها من علاقة عداء وقطيعة واقتتال ذاتي إلى علاقة تعايش وتواصل وحوار وتبادل.
وعليه، فإننا لسنا بحاجة لشعارات من أجل مواجهة التحديات الكبيرة المطروحة علينا، بل الارتقاء إلى مستوى التحديات، بما يخدم مصالحنا ويضمن حقوقنا الأساسية في السيادة والحرية والاستقلال التام.
إنّ مشروع النهضة العربية، أي قضايا المسألة العربية، كان ولا يزال في حاجة إلى فكر الأنوار والحداثة، وكذلك استيعاب التحولات والتغيّرات التي تطرأ على الساحتين العربية والدولية. مما يستوجب الاعتراف بالخصوصيات القطرية، في إطار التنوع ضمن إطار الوحدة، مع إمكانية تحويل التنوع إلى عنصر غنى للثوابت العربية الضرورية لتطور كل حركة قومية. ومن أجل ذلك، تبدو الديمقراطية في رأس أولويات التجديد العربي، فالمسألة القومية تستدعي مقولات جديدة: المجتمع المدني، الديمقراطية، الدولة الحديثة، المواطنة. وتبدو أهمية ذلك إذا أدركنا أنّ العالم العربي المعاصر، بشكل عام، لا يملك لغة سياسية حديثة، منظمة وممأسسة، في بناه السياسية والثقافية، إذ بقي خارج تسلسل وتاريخ الأحداث، فالماضي مازال ملقى على هامش الحاضر، بل يهدد المستقبل.
لذلك، فإنّ العرب يجب أن يتجهوا نحو البحث عن حل تمديني – ديمقراطي، مما يعمق المحتوى الإنساني والمضمون الديمقراطي للحركة العربية، على مستوى الفكر كما على مستوى الممارسة. ففي مجتمع واسع متعدد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية كعالمنا العربي الكبير، لا يمكن لحركته الجامعة إلا أن تكون حركة ديمقراطية تعترف بالتنوع وتُثرى به، وتحترم تعدد الجماعات المكونة له وتسعى إلى تحقيق التكامل بينها، بل تحترم السيادات الوطنية لأقطارها وتسعى لأن تحقق تكاملها بعد أن ترسخ إحساس أبناء هذه الأقطار بهذه السيادة.
إنّ انخراط العرب في العالم المعاصر يتطلب منهم البحث عن مضمون جديد لحركتهم العربية، بما يؤهلهم لـ ” التكيّف الإيجابي ” مع معطيات هذا العالم، وبالتالي الانخراط في مقتضيات التوسع الرأسمالي، بما يقلل من الخسائر التي عليهم أنّ يدفعوها نتيجة فواتهم التاريخي، لريثما تتوفر شروط عامة للتحرر في المستقبل. فالعرب ليسوا المبدأ والمركز والغاية والنهاية، هم أمة من جملة أمم وحضارات وثقافات، لا يمكن أن ينعزلوا عن تأثيرات وتطورات العالم الذي يعيشون فيه. إنّ الأمم التي تدور حول نفسها لا يمكن أن تتقدم، خاصة عندما تكون خطابات نخبها الفكرية والسياسية متوازية لا تواصل بينها، في حين أنّ التقدم يتطلب تراكم خبرات كل قوى الأمة، التي تعانق تناقضاتها، وتبحث عن حلول ممكنة وواقعية لمشكلاتها.
ومن سياقات ما قدمته، يبدو أنه لا يجوز القفز عن واقع الدولة الوطنية تحت أي عنوان، بما فيه الطموح المشروع إلى دولة عربية واحدة. فالأمة العربية لن تكون أمة ” قبائل “، وإنما أمة دول حديثة تطمح إلى توحيد جهودها للبحث عن مصالحها المشتركة وتعظيمها. إنّ المشكلة الأهم المطروحة أمام الحركة العربية هي بناء الدولة الحديثة، وما يتفرع عنها من أدوات مفاهيمية تنتمي إلى المجال التداولي المعاصر: الأمة، المجتمع المدني، المواطنة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التعاقد الاجتماعي، الشرعية الدستورية والقانونية، التنوير، العقلانية، العلمانية.
إننا أحوج ما نكون إلى استنباط وسائل جديدة لاستنهاض العمل الديمقراطي العربي، وقد بدت أهمية بناء المجتمع المدني، بعيداً عن لعبة الصراع على السلطة، باعتبار ذلك هو السبيل إلى تعميق الاستقرار الاجتماعي وتطويره على أسس ديمقراطية وحدوية عقلانية هادئة. كما أنّ المشروع الحضاري العربي مازال، بأهدافه الكبرى، مطمح كثير من النخب الفكرية والسياسية العربية: الوحدة العربية في مواجهة التجزئة، والديمقراطية في مواجهة الاستبداد، والتنمية المستدامة في مواجهة التأخر، والعدالة الاجتماعية في مواجهة الظلم والاستغلال، والاستقلال الوطني والقومي في مواجهة الهيمنة الأجنبية، والتجدد الحضاري في مواجهة التجمد التراثي من الداخل والمسخ الثقافي من الخارج.






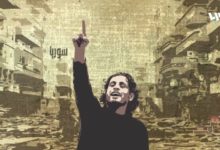

قراءة ورؤية وتحليل تحترم حول الوحدة العربية وتجاربها وما هو المطلوب، ضمن أزمة مشروع التقدم العربي وآفاقه المستقبلية، الوحدة العربية قامت بعض الأنظمة العربية برفع شعارها وتجربة فاشلة بإنجازها لغياب عوامل أساسية وهي الديبمقراطية ووحدة الموقف بالإقليم الذي سيكون اللبنة بهذه الوحدة، الوحدة بدون ديمقراطية فاشلة، والديمقراطية الإجتماعية والإقتصادية لبنات أساسية لنجاحها.