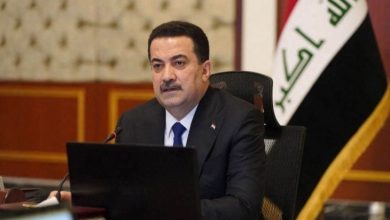لم تعد الأزمات في الشرق الأوسط مجرّد وقائع سياسية عابرة، بل تحوّلت إلى اختبارات لقدرة الدول على الحفاظ على توازنها في عالمٍ متحوّل. والمملكة العربية السعودية، التي أثبتت خلال العقدين الماضيين قدرتها على صياغة سياسة خارجية متماسكة تقوم على الواقعية والحذر الفعّال، تُعيد اليوم تعريف حضورها في واحدٍ من أعقد ملفات المنطقة: سوريا.
منذ اندلاع الأزمة السورية، تمسّكت الرياض بموقفٍ ثابت يرفض الفوضى ويصون مبدأ الدولة. لم تُغرِها العواطف الثورية ولا الحسابات الآنية، بل أدركت منذ البداية أن انهيار سوريا سيخلق فراغاً جيوسياسياً لا يملؤه إلا النفوذ الأجنبي. لذلك دعمت المملكة الحلّ السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، وأصرت على أن أي مستقبلٍ مستقر لا يمكن أن يُبنى على أنقاض المؤسسات الوطنية، مهما كان شكل السلطة أو موازين القوى.
تبنّت المملكة سياسة تقوم على إعادة ضبط التفاعل مع تركيا لا على عزلها؛ فهي تدرك أن الصراع مع أنقرة يطيل عمر الأزمة، أما الحوار معها فيفتح المجال لتفاهمات إقليمية توازن المصالح وتخفف من حدّة الاستقطاب الذي أنهك المنطقة طوال عقدٍ كامل.
لكن اللحظة السورية تغيّرت مع التحوّل السياسي في ديسمبر 2024، حين دخلت البلاد مرحلة جديدة أنهت حقبة الجمود وفتحت الباب أمام إعادة التموضع العربي والدولي. تعاملت الرياض مع هذا التحوّل بدقة الدولة لا بحماس اللحظة؛ لم تُبدّل ثوابتها، بل أعادت صياغة أدواتها، فانتقلت من موقع المتفرّج الحذر إلى موقع الفاعل المتزن الذي يسعى لترميم التوازن المفقود بين الداخل السوري وامتداداته الإقليمية.
إن جوهر المقاربة السعودية بعد 2024 يقوم على معادلة واضحة: الانفتاح المسؤول مقابل السيادة السورية الكاملة، وهي معادلة لا تقوم على المحاور بل على المصالح المشتركة. فالمملكة لا ترى في دمشق اليوم مجرد ملف سياسي، بل ركيزة للأمن العربي ومساراً ضرورياً لإعادة تعريف مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة. لذلك كان التحرك السعودي الأخير تجاه سوريا متعدّد المستويات، دبلوماسياً وإنسانياً وتنموياً، يهدف إلى دعم استقرار الدولة لا شخص الحاكم.
من الناحية الدبلوماسية، عززت المملكة حضورها عبر شبكة علاقاتها المتينة مع واشنطن وموسكو وبروكسل، ونسّقت في الوقت نفسه مع القاهرة وأبوظبي وعمّان لضمان مقاربة عربية موحّدة تعيد لسوريا مقعدها الطبيعي ضمن محيطها. غير أن الملف السوري لا يمكن فصله عن المعادلة التركية التي تبقى عنصراً فاعلاً في الميدان والسياسة.
لقد فهمت الرياض أن أنقرة – رغم تناقضاتها – لاعب لا يمكن تجاوزه في أي تسوية سورية. فوجودها العسكري في الشمال السوري، وتأثيرها على المعارضة، وعلاقتها المعقّدة مع موسكو وواشنطن تجعلها شريكاً لا غنى عنه في أي ترتيبات أمنية أو سياسية مقبلة.
لذلك تبنّت المملكة سياسة تقوم على إعادة ضبط التفاعل مع تركيا لا على عزلها؛ فهي تدرك أن الصراع مع أنقرة يطيل عمر الأزمة، أما الحوار معها فيفتح المجال لتفاهمات إقليمية توازن المصالح وتخفف من حدّة الاستقطاب الذي أنهك المنطقة طوال عقدٍ كامل.
وفي السياق ذاته، تراهن الرياض على أن التحوّل التركي الأخير نحو السياسة البراغماتية – بعد سنوات من التصعيد – يمكن أن يشكل مدخلاً لإعادة بناء تفاهمات إقليمية جديدة، يكون محورها استقرار سوريا وعودة مؤسساتها. فالتقاطع السعودي–التركي في ملفات الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي يمكن أن يُترجم إلى تفاهم عملي حول المستقبل السوري، بما يضمن وحدة الأراضي السورية وعودة تدريجية للسلطة المركزية عبر ترتيبات أمنية متفق عليها.
الجانب الإنساني لا يقلّ أهمية في الرؤية السعودية. فالمملكة التي تصدرت المساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب، انتقلت الآن من الإغاثة إلى مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما يزال من أبرز الجهات التي تعمل في المناطق السورية الأكثر تضرراً، والاتجاه الجديد يركّز على التعليم والصحة والبنية التحتية، تمهيداً لمرحلة عودة اللاجئين واندماجهم في دورة الحياة الوطنية. ذلك أن الرياض تنظر إلى استقرار سوريا باعتباره شرطاً لوقف تدفق اللاجئين نحو الجوار والعالم، وبوابةً لإعادة توازنٍ اجتماعي طال انتظاره.
في المشهد الدولي، يدرك صانع القرار السعودي أن إعادة بناء سوريا لا يمكن أن تنجح من دون توازن دقيق بين القوى الكبرى. فروسيا تملك مفاتيح التأثير الأمني والعسكري، في حين تمسك الولايات المتحدة والأوروبيون بأدوات الضغط المالي والسياسي. وهنا تلعب المملكة دور الوسيط المرجعي، مستفيدة من موقعها كحليفٍ تقليدي لواشنطن وشريكٍ منفتح على موسكو، لتقريب الرؤى وفتح مسارات تفاوض غير معلنة بين الفاعلين الدوليين حول مستقبل سوريا ما بعد الصراع. وفي هذا الدور، تبدو السعودية الطرف العربي الوحيد الذي يستطيع الحديث مع الجميع من دون أن يُتهم بالانحياز.
لا تُخفي الرياض قناعتها بأن إعادة بناء سوريا ليست مهمة سياسية فحسب، بل مسؤولية حضارية. فالدولة التي كانت ذات يوم قلب المشرق الثقافي والاقتصادي يجب أن تستعيد مكانتها ضمن منظومة عربية مستقرة.
تستند هذه السياسة إلى مبدأ سعودي أوسع يمكن تلخيصه بعبارة: منع الفوضى لا يكفي، بل يجب هندسة الاستقرار. فما بعد عقدٍ من الصراعات والفراغات الأمنية، لا بد من مقاربة عربية تتجاوز ردود الأفعال وتؤسس لبيئة دائمة من التوازن السياسي والاقتصادي. من هنا تبلورت الرؤية السعودية الجديدة التي تجمع بين الواقعية والقيادة، بين صلابة المبدأ ومرونة الوسيلة، لتضع سوريا في موقعها الطبيعي كدولة محورية في العالم العربي، لا كساحة تنازع مفتوح.
ومع كل ذلك، لا تُخفي الرياض قناعتها بأن إعادة بناء سوريا ليست مهمة سياسية فحسب، بل مسؤولية حضارية. فالدولة التي كانت ذات يوم قلب المشرق الثقافي والاقتصادي يجب أن تستعيد مكانتها ضمن منظومة عربية مستقرة. ولذلك تضع المملكة على جدول أولوياتها دعم العملية السياسية الشاملة، وتشجيع المصالحة الوطنية، والمساهمة في إعادة الإعمار على أساس العدالة والشراكة. هذه ليست شعارات، بل هي مشروع استراتيجي تراه السعودية ضرورةً للأمن القومي العربي لا ترفاً دبلوماسياً.
في نهاية المطاف، يمكن القول إن ما تفعله المملكة اليوم في الملف السوري ليس امتداداً لمرحلة سابقة، بقدر ما هو تعبير عن تحوّل عميق في التفكير العربي. فهي لا تسعى إلى نفوذٍ ولا إلى تسجيل نقاط، بل إلى تأسيس بيئة جديدة تُعيد للدولة العربية مركزها الطبيعي في معادلة الإقليم. منع الفوضى كان الهدف الأول، أما الآن فالمهمة الكبرى هي بناء منظومة استقرار قادرة على تحييد الصراع واحتواء الأطراف. بهذه المقاربة الهادئة التي توازن بين الدبلوماسية والعقلانية، وترسخ السعودية مكانتها كقوة عربية مسؤولة تُعيد رسم حدود السياسة لا على خرائط القوة فقط، بل على منطق التوازن والاحترام المتبادل.
المصدر: تلفزيون سوريا