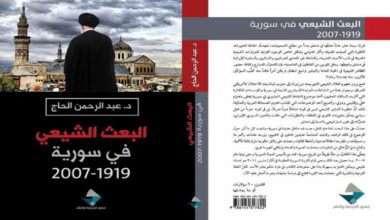«هل كان علينا أن نسقطَ من علوٍ شاهقٍ، ونرى دمَنا
على أيدينا، لندركَ أننا لسنا ملائكة… كما كنا نظن»
محمود درويش
-1-
حلمت، وكانت الأنثى هي الأخرى تشاركني ذاك الحلم، حلمنا ونحن في ظلال صفصافةٍ، تستريح على ضفاف نهرٍ يجري غير عابئٍ بنا.
في الحلم اختلطت أقدامنا في قاع النهر مع أقدام الشجرة، وببعض ضفائرها الذهبية؛ فتسربت إلى قلوبنا رعشةٌ باردةٌ من النهر تضج بالحنان وبالنشوة.
لكن أصواتًا ذئبيةً هشمت الحلم؛ فتوقفت أمواج النهر عن الجريان، وتكسرت أغصانٌ، وتساقطت علينا، تئنُّ حزنًا؛ لمفارقتها أحضان أمهاتها، فتسلل الحلم مبتعدًا، وغاص في أعماق النهر. لم أعد أتذكر مجريات ذاك الحلم، لكنني كنت فرحًا به، سعيدًا، وبجانبي تلك الأنثى التي أراحتْ صدرها المتعب على كتفي، وكانت تزداد التصاقًا بي، كلما عبثت أقدامنا بأطراف النهر.
-2-
في (مخيم النهر) تختلط عليكَ الرؤيا، كلما تعثر بكَ الحلم، وامتزجت ألوانه في أثناء المخيم، الذي تنتصب فيه أبنية مركبة بعضها فوق بعض، كأنها تخشى السقوط، تفصل بينها أزقة عريضة، لا تلبثُ أن تقتربَ؛ حتى تكادَ أن تتلاصق، فتوحي إليك بالأُلفة.
وبأناسٍ يأوون إليها، تقتلهم الغربة والحنين إلى بيوتهم، هناك خلف الجدار الطويل، ولا تستطيعُ أن تفرقَ بينهم، بين مَن رآها وبين من سمعَ عنها، كم كنا نرى من الشرفات سواعدَ مزينات بأساورَ، وأيدٍ تتبادل الأشياءَ والهدايا، وصحنًا من التبولة!.
تعبق أزقة المخيم برائحة الفلافل والباذنجان والبطاطا المقلية، تختلط بلهجات المدن التي وفد منها اللاجئون، ستون عامًا وسكان المخيم لا يملون الانتظار، ولا يغادرهم صوت فيروز «يا قدس، يا مدينة السلام، إليكِ أصلي»، ممزوجةً بأغانٍ ومواويلَ عراقيةٍ حزينة.
انداح المخيم، تسلَّق الجبلَ، رافق مجرى النهر، انحدر إلى البحر، لكن الحلم بالعودة إلى يافا، حيفا، القدس القديمة، إلى الأقصى وكنيسة القيامة، كبر هو أيضًا، ولم يملَّ الكبارُ التحدث عن بياراتهم في فلسطين، ولم يتخلَّ أحدٌ منهم عن مفاتيح بيته.
صمتَ سكان المخيم عما يجري خلف الجدران ليلًا، وبعضهم يتسلل نهارًا إذا لم يسعفْه الحظ ليلًا، عدوى تجتاحهم لممارسة الحب؛ حتى تحوّلَ المخيمُ إلى مفرخةٍ للإنجاب، ولو سألتَ أنثى أن تكف عن الإنجاب لابتسمت، ودارت بعضًا من حياء؛ قائلة:
– ماذا تريد أن نفعل؟ لم يبقَ لنا من سعادة في هذه الدنيا الظالمة إلا هذا، ثم تتحدث بجدية:
– ألا ترى كم يحصد الموت منا في كل يوم، فرحاهُ بدأت تطحن الأطفال، ثم تتابع بصوت باك، وبدمعة تكاد أن تقفز من عينيها:
– يا خوفي أن نعتاد قتل أبنائنا بأيدينا، لقد أدمنا العذاب، ونمضي نحو المجهول.
-4-
في ليلة غاب قمرُها، ظهرت الرؤوس المقنعة -تباعًا- في أزقةِ المخيّم، كانت تحمل البنادق، فتشابه ما يجري هنا بما يجري على ضفاف الفرات، وعلى جسر (المسيب)، وانخرط الرجال بلعبة الموت، وارتدوا الأقنعة، فتحولت البندقية في أياديهم إلى آلة تحصد أبناء المخيم.
عندما خيم دخان البارود في السماء هاجرت الطيور، وفرت العصافير فزعة، ونزحت الأحلام بعيدًا، فأمسى المخيم بلا أحلام، وأضاع الرجال مفاتيح بيوتهم وبياراتهم، وغدت البيوت خرائب متشحات بالسواد، لها أشداقٌ مخيفة.
-5-
في ذاك الحلم، وقبل أن يغوص في أعماق النهر، وبلا وعي مني، احتضنت صدر الأنثى، صرخت:
– يا الله، إننا تحولنا إلى هابيل وقابيل، فكيف سنواري جثثنا، فالغربة تسكننا وقد أدمنا الحزن، وهل تقبل صلاتنا وابتهالاتنا ونحن القاتل والمقتول؟
أذعنت أن تتسربل بالسواد الأنثى التي كانت تشاركني الحلم، قلت:
حسبي منها وجهها، يداها، في الكفين، في الأصابع، في الأنامل لغة إيمائية، يفهما العشاق، والغجر قراء الكف، وشيخ الزاوية، لكن تلك الأنثى دفنت وجهها ويديها، وأطلت عيناها من ثقبي البومة، وسيلةَ حوار بيننا.
عندما تقنّع الرجال، وانطلقوا بيننا، لم أعدْ أميز بين الحلم والكابوس، خرجتْ من ثقوب أقنعتهم عيونُ القتلة، فاختلط علي الأمر بين حَوَرٍ يُغزلُ بالحب، وعيونٍ تُغزلُ بالموت.
المصدر: الموقف الأدبي