
كان بناء سد الفرات، الذي مثّل الواجهة التحديثية لسوريا البعثية، بين العامين 1968 و1973 بمثابة لحظة رمزية مشحونة لخطاب تقدمي تضمن في جوهره افتراضات حول عدم التجانس الداخلي الزمني: فبينما روّج لصورة أمّة سورية تقدمية حديثة، قام في الوقت نفسه باقتلاع سكان هذا الجزء من البلاد إلى عالم الماضي والحاضر المتخلفين والمتقادمين، مما بخّس من قيمة أنماط حياتهم وتطلعاتهم الفعلية وشرعَن تهجيرهم بعد غمر قراهم وحقولهم تحت البحيرة الناشئة. كانت الهويات وأنماط الحياة “القبلية” مستهدفة بشكل رئيسي من خلال هذا التبخيس.
يستند هذا المقال المترجم أدناه، للأنثروبولوجية البريطانية كاثرينا لانغ، إلى البحوث الأدبية والعمل الميداني الإثنوغرافي المتقطع في سوريا بين العامين 2001 و2011…
حداثة بعثية أم تقديم أضاحٍ للمستقبل
استند كل من مؤيدي ومعارضي مثل هذه المشاريع إلى تزمينات متناقضة لدعم أجنداتهم السياسية. فقد عارض المنتقدون مشاريع السدود بتحذيراتهم الشديدة من فقدان العناصر القيمة التي تُسنِد الحاضر على الماضي: إذ ستُفصل المسارات الحالية والمستقبلية للمجتمعات المحيطة بمواقع بناء السدود عن طرق الحياة “التقليدية”، وسيُطاح بالتوازنات البيئية القديمة، ويُقضى على البقايا الثقافية والأثرية للحضارات القديمة إلى الأبد. وبرغم ذلك، سلط المدافعون الضوء على اعتبارات المستقبل، وغالبًا ما أخفوا الآثار الضارة لمثل هذه المشاريع ببلاغة سياسية تُسلط الضوء على قوتها التحويلية: الماء إلى كهرباء، والصحاري إلى حدائق، وما إلى ذلك. وتمتدّ القدرة التحويلية للسدود الكبيرة عادةً لتشمل البعد البشري من خلال تحويل السكان “المتخلفين” إلى مواطنين حديثين. وبالمقابل، فإن هذا يعني في كثير من الأحيان أن أساليب الحياة المحلية الفعلية، التي تقف في طريق بناء السد نفسه أو بحيرات الخزان التي أنشأتها مثل هذه المشاريع، يجب “محوها” من المسار الوطني التقدّمي رفقة المجتمعات التي تعيش هذه الحياة.
وُصف حرمان السكان المحليين من حقوقهم بسبب السدود الكبيرة وغيرها من مشاريع البنى التحتية واسعة النطاق في العديد من السياقات الإقليمية المختلفة. وبدلاً من اعتبار هذه العمليات مجرد “أضرار جانبية”، جادل البعض بأن إنتاج مجتمعات “غير متخيلة” يشكل جزءاً لا يتجزأ من جهود بناء الدولة أو التحديث التي تقام من أجلها السدود الكبيرة في أنحاء العالم. وفي حالة وادي الفرات أيضًا، ادعى الخطاب السياسي الذي صاحب بناء السد، وجود تباين رمزي قوي بين طبقات مختلفة من الماضي المحلي، الطبقات التي، على الرغم من اختلافاتها، تشترك في المساحة نفسها في وادي الفرات. فقد أُطرت الطبقة الأولى، المرتبطة بكون بلاد ما بين النهرين “مهد الحضارات” وكون سوريا مهدًا لبقايا بعض أقدم الحضارات الإنسانية، على أنها قديمة وبعيدة وقيّمة. وأُجري عدد كبير من الحفريات الطارئة في منطقة الخزان من قبل البعثات الأثرية السورية والدولية لكشف و”إنقاذ” بقايا ماضٍ قديم، بينما أُحيل النوع الآخر من الماضي المُتجاهل غالبًا باعتباره عديم القيمة أو حتى ضارًا بالصالح العام لسوريا، إلى نطاق زمني من التجربة الاجتماعية أقل بعدًا وأكثر ألفة. ولم يُشِر أي شيء في ردود الأفعال الوطنية أو الدولية على بناء السد إلى أن هذا الماضي المحلي البديهي والمُعاش كان يُعتبر جديرًا بالحفاظ عليه. وإذا ما ذكره المسؤولون على الإطلاق، فإنهم يرفضونه باعتباره “متخلفًا” وعديم القيمة.
وأعلى سد الفرات، لم يُطرد الأشخاص الذين وقفوا حرفيًا “لا مجازًا” في طريق التقدّم من المواقع التي شيّدت فيها الحداثة فحسب، وإنما أُبعدوا خطابيًا عن عالم الحاضر إلى عالم الماضي. ولم يُجبر المزارعون والرعاة المحليون على مغادرة منازلهم فحسب، بل كانوا “غير مُتخيلين” فقد نُبذت أنماط حياتهم باعتبارها مظاهر للتخلف واستُبدلت بالكهرباء والتوطين والتعليم والحداثة. وكرر العديد من المؤيدين، السياسيين والأكاديميين السوريين والأجانب، فكرة أن التخلف يسِمُ السكان في المنطقة التي شُيد فيها سد الفرات. ففي العام 1971، على سبيل المثال، افتتحت مجلة “العمران” التي تصدرها وزارة الإدارة المحلية السورية، عددها الخاص عن الرقة، بالإشادة بالسد باعتباره “جدار المجد الذي يبنيه شعبنا لمحو كل علامات التخلف”. أما منهاج التثقيف الحزبي البعثي بشأن السياسة الاقتصادية، المنشور في الثمانينيات، فقد احتوى على قسم أصيل من 21 صفحة حول سد الفرات وحده، وعزا استمرار تخلف المنطقة “الاقتصادي والاجتماعي” إلى الافتقار إلى الاهتمام السياسي من قبل الأنظمة السياسية السابقة للبعث بهذه المنطقة، وكان بين العوامل الأخرى للتخلف هيمنة نظام القرابة الذي رُبط بلاغيًا بوجود أسر كبيرة في ظروف سكنية غير وافية وبالعلاقات الاقتصادية الاستغلالية.
في العام 1990 قامت مجموعة من خبراء التنمية الألمان، بمراقبة لصيقة من قبل المؤسسات السورية، بإجراء مسح في 17 قرية محيطة بالبحيرة. وشهدوا في تقريرهم التلخيصي أن “حوض الفرات.. ما زال منطقة متخلفة في الوقت الحاضر”. التقرير ربط بي قرن تقريبًا بين التخلف الملموس للمنطقة وبين “البنى الاجتماعية للقرى”، أي “التأثير الذكوري للعلاقات القبلية”. ويعكس هذا التقييم التصورات المتشاركة، ليس فقط من قبل مؤسسات التنمية الغربية منذ الخمسينيات، لكن أيضًا من قبل البيروقراطيين والسياسيين في سوريا وعبر الشرق الأوسط.
فاتهام البُنى القبَلية باعتبارها “مشكلة” يتعين حلها، ردَّد صدى دعامة أساسية للسياسة الاجتماعية البعثية في المناطق الريفية في سوريا. فعلى سبيل المثال، نددت المادة 43 من النظام الداخلي لحزب البعث السوري بـ”البداوة”: “البداوة حالة اجتماعية ابتدائية تُضعِف الإنتاج القومي وتجعل من فريق كبير من الأمة عضواً فاشلا وعاملاً على عرقلة نموها وتقدمها، والحزب يناضل في سبيل تحضير البدو ومنحهم الأراضي وإلغاء النظم العشائرية وتطبيق قوانين الدولة عليهم”.
وفي العام 1966، بعد 3 سنوات من توليه السلطة، شجب الحزب، القبلية (العشائرية)، “الإقليمية” و”الطائفية”، باعتبارها “أمراضًا اجتماعية خطيرة” يجب محاربتها من أجل انتصار “العروبة”: “الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة، وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية”.
وقد وعد بناء سد الفرات بوضع حد لأنماط الحياة التي كان يعتقد أنها تعزز مثل هذه العلاقات الاجتماعية “البالية”: ينتمي جزء كبير من سكان تلك المنطقة إلى قبائل بدوية تنتقل من مكان إلى آخر بحثًا عن المراعي، ولن تحتاج هذه القبائل، بعد التنفيذ الكامل للمشروع، إلى الحركة المستمرة بسبب توفير المراعي الغنية بالعلف اللازم، وبذلك تُحل مشكلة البدو وتوطينهم وجعلهم جزءًا فعالًا من المجتمع.
كان من المتوقع أن تحل أشكال التعاون والجمعيات الأكثر “حداثة” محل الروابط الاجتماعية القائمة على النسب والقرابة: فقد امتُدح إنشاء التعاونيات، والآثار المترتبة على خطط الإصلاح الزراعي، وتنظيم وتدريب “العمال”، فضلاً عن إبعاد الفلاحين عن منطقة الخزان، باعتبارها إجراءات لإنهاء “استغلال الإنسان لأخيه الإنسان” في هذه المنطقة. وبعبارة أخرى، رُوّج لبناء السد على أنه يقدّم مجموعة من الحلول “للمشاكل” الاجتماعية المعينة التي يشكلها انتشار المجموعات الاجتماعية القائمة على النسب، أو “القبلية”، في منطقة الخزان. كما وسم الخطاب المصاحب لبناء السد، سكان تلك المنطقة بالتخلف، وبأنهم متشبثون بأسلوب حياة “قبلي” من مخلفات الماضي الذي كان لا بد من التغلب عليه. في الواقع، كان النازحون ينتمون بأغلبهم إلى واحدة من العشائر السورية. وأُعيد توطين العديد منهم في قرى جديدة شكلت ما يسمى بـ”الحزام العربي” في الجزيرة السورية التي يسكنها الأكراد إلى حد كبير – وبالتالي فقد ضحى القرويون النازحون من أجل مخططات التعريب الأكبر في شمال شرق سوريا الكردي واستفادوا منها في الوقت نفسه. وبقي كثيرون آخرون في وادي الفرات، وأقاموا قرى جديدة – من دون أي دعم من الدولة – على الضفاف المجاورة للبحيرة الناشئة. تقلصت مساحة الرعي المتنقل، المدعومة بالزراعة الموسمية، بينما تسارعت بشكل كبير هجرة العمالة إلى المدن الكبرى في سوريا، حلب ودمشق، وكذلك البلدان المجاورة (لا سيما لبنان والأردن). والأقارب الذين عاشوا في السابق متجاورين أصبحوا الآن بعيدين من بعضهم البعض مئات الكيلومترات ولم يكونوا ليلتقوا إلا في المناسبات الاجتماعية التي توفرها الجنازات أو الأعراس أو الأعياد الدينية.
مستقبل الماضي
وتكشف كذب وعود ومزاعم التقدّم المرتبطة بمخطط الفرات – بما في ذلك بناء السد نفسه بالإضافة إلى مشاريع التنمية مثل قنوات الري وضخ مياه الشرب ومزارع الدولة وما إلى ذلك – والتي كان على السكان المحليين أن يضحوا من أجلها بحاضرهم وماضيهم. فبعد مرور عشر سنوات من انتهاء أعمال السد، لم يكن امتداد المنطقة المروية المطورة حديثًا مساويًا للمساحات المزروعة المغمورة بالبحيرة. وبعد 30 عامًا، كانت مساحة 150 ألف هكتار فقط من الأرض تُروى من البحيرة، وعلاوة على ذلك، حتى الأرض المطورة حديثًا لم تتطور إلى حدائق مزهرة وخصبة كما توقع الخطاب البعثي، إذ أدّت الملوحة وارتفاع معدل الجبس في التربة المروية بسرعة إلى مشاكل خطيرة في مناطق السيئة الصرف والمروية حديثًا.
كان المؤرخ راينهارت كوسليك قد صك مصطلح “مستقبل الماضي” للإشارة إلى التصورات القديمة ورؤى المستقبل كما عُبّر عنهما في الماضي. وفي حالتنا هذه، استمر “مستقبل الماضي” المتجذر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في البقاء خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث واصلت الأمة فرض التضحيات على سكان العديد من القرى الواقعة عند أعلى مجرى السد. واستفادت المراكز الحضرية في شمال سوريا، في كثير من الأحيان، من التغييرات المادية التي أحدثها مخطط الفرات، لكن ليس جميع القرى القريبة من الخزان. وبحسب صحيفة “تشرين” الرسمية السورية، فإن أكثر من نصف النازحين على ضفاف بحيرة الأسد لم يتلقوا حتى الآن أي تعويضات، سواء عن منازلهم المدمرة أو عن سبل عيشهم التي غرقت تحت المياه.
علاوة على ذلك، حتى مشاريع التحديث الثانوية التي أعقبت بناء السد غالبًا ما نُفذت على حساب السكان المحليين. كما استمرت أوجه القصور الكبيرة في السياسات الحكومية تجاه الفلاحين في وادي الفرات خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ففي وقت عملي (الكاتبة) الميداني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن العديد من الطرق التي تربط مستوطنات المنطقة ببعضها البعض، والمدن الأكبر حيث تتوافر وسائل النقل المنتظمة إلى حلب أو الرقة أو منبج، لم تكن مُعبّدة، وكانت مليئة بالحفر. وفي الصيف، كانت القيادة على هذه الطرق تثير سحب غبار كبيرة، وكان هطول الأمطار وقلة الصرف يجعلها موحلة وزلقة في الشتاء. وبحلول منتصف التسعينيات، قيل إن 56% من العوائل في حوض الفرات تتمتع بالمياه الجارية. وحتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (وربما حتى اليوم)، كان عدد من القرى في هذه المنطقة، ممن ضحت بمراعيها وحقولها لتوفير مياه الشرب لحلب وأجزاء أخرى من البلاد، ما زالت هي نفسها غير مرتبطة بشبكة مياه الشرب.
ومع ذلك، كان أي انتقاد للسياسات العملية المحيطة بمخطط الفرات حساسًا للغاية سياسيًا، ويحتمل أن يكون خطيرًا، حيث يمكن قراءته على أنه انتقاد لمسار سوريا البعثية إلى الازدهار الوطني والأمن والتقدم. عندما أجريتُ عملاً ميدانيًا إثنوغرافيًا في هذه المنطقة بين العامين 2001 و2011، كان الخوف من مختلف أجهزة المخابرات القوية ومخبريها موجودًا في كل مكان، وغالبًا ما أدت الحساسية السياسية الدائمة للتشرد الناجم عن بحيرة الأسد إلى الصمت بشأن تفاصيل هذا الموضوع. لقد تطرق العديد من محادثاتي “العامة” حول تاريخ المنطقة وشعبها، في أحسن الأحوال، بشكل عابر فقط، إلى القضايا المرتبطة بإعادة التوطين وعواقبها، بينما ناقشنا الموضوعات “الأكثر أمانًا” مثل النسب والسياسة الاستعمارية ومقاومة الاستعمار بإسهاب.
التهميش المزدوج
إن مفاهيم الزمنية والتاريخية التي عبّر عنها فاعلون مختلفون خلال الحقبة البعثية، رشَحت بشكل قاطع ومتغلغل في تمثيلات الفاعلين المحليين لماضيهم، وظلت واضحة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ففي السياقات الرسمية، فضلاً عن السياقات اليومية، أدرج السكان المحليون أنفسهم خطابيًا –بشكل مُزرٍ أو إيجابي – في سرديات أكبر للتقدّم والحداثة والتخلف.
وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدم عدد متزايد من الكتب التاريخ القبَلي لسوريا المٌغيب منذ فترة طويلة، مُعيدين المطالبة بمكانة شرعية للقبائل والعشائر بوصفهم فاعلين تاريخيين. وقد استخدم المؤلفون علامات المعرفة “الحديثة” و”التاريخية” لإعادة إدراج المجتمعات القبلية السورية بمهارة في روايات أكبر حول التاريخ والزمنية.
رددت هذه الكتب جزئياً صدى الروايات الشفوية عن تاريخ القبائل التي كانت تُروى في “المَضافات” لوجهاء القبائل وشيوخها. فمن خلال تبني كلمات مفتاحية للخطاب القومي التاريخي مثل الوطنية، قام المتحدثون والكتّاب في الوقت نفسه بوسم هذه المفاهيم بمنظور محلي أو قبلي واضح. فقد ركزت الروايات التاريخية الشفوية، والنسخ المنشورة من التاريخ القبلي، بشدة، على أحداث عصر الانتداب، وسلطت الضوء على أعمال المقاومة ضد الفرنسيين، وجعلت من رجال الماضي مرئيين كرعايا يتصرفون ببطولة للحفاظ على شرفهم (وضمنيًا على شرف قبائلهم) كمضيفين كرماء ومقاتلين شجعان وفاعلين سياسيين بارعين.
وهكذا، أعادوا صياغة الهوية القبلية باعتبارها حاملًا للأصالة العربية القويمة، بدلاً من كونها حالة اجتماعية مخزية وبدائية. وبالنسبة للكثيرين، أتاحت القصص حول تجارب أسلافهم وأفعالهم خلال فترة الانتداب فرصة لمواجهة الازدراء الواسع الانتشار الذي نظر العديد من السوريين من خلاله إلى هذا الجزء من أبناء جلدتهم. لقد كتب مؤلفو تلك الكتب، إلى حد ما على الأقل، ضمنيًا ضد النبذ السابق للمجتمعات القبلية في سوريا باعتبارها هامشية في المسار التاريخي الوطني.
بيد أن النهضة المتفاخرة للاعبين التاريخيين المهمشين سابقًا ضمن المسار التاريخي الوطني قادت إلى تهميش مجموعة أخرى من التجارب التاريخية في هذه المنطقة. فالأصوات البارزة قدمت التاريخ القبلي بطريقة مدروسة بعناية للعالم الخارجي مُسلطة الضوء على أكثر الجوانب تساوقًا مع الروايات البطولية والغرّاء بينما استُبعد المزيد من الجوانب اليومية أو الخلافية. فقضايا مثل العيوب الشخصية المحتملة لوجهاء القبائل في الماضي، وعمليات الهيمنة والصراعات داخل القبيلة والتفاوت بين القبائل وغيرها من العلامات المُتصورة للضعف المجتمعي، قُلّل من شأنها أو حتى استُبعدت من مثل هذه الروايات “المهذبة بحزم” للتاريخ القبلي سواء كانت شفهية أو مكتوبة. كما أنّ المصاعب الاقتصادية وروتين العمل، والمنافسات والحسد بين القبليين، وجميع سمات الحياة اليومية التي شكلت بشكل حاسم التجارب اليومية، نُحيّت جانبًا إلى حد كبير من أجل السماح للجوانب الأكثر بطولية، وفي الوقت نفسه، ربما الأكثر نمطية وغير المثيرة للجدل في تاريخ القبائل لتحتل الصدارة. وجه آخر لهذا التهميش للتجارب التابعة “الأخرى”، تمثَّلَ في جَنسنة التمثيل التاريخي. ذلك أن إعادة إدراج وجهات النظر القبلية في روايات التاريخ السوري، مالت إلى جعل التاريخ القبلي يبدو كمسعى ذكوري بحت، مما حجب التجارب الأنثوية من خلال جعلها “غير مهمة” للتاريخ القبلي. وعلاوة على ذلك، مالت المنشورات المحلية حول التاريخ القبلي إلى تحرير أو “تعديل وحذف” العناصر الأدائية مثل الإيماءات والحركات، والمراجع المثيرة للذكريات الحسية، والتفكير في المرأة كفاعل في التاريخ وموضوع له، من تمثيلات تاريخ هذه المجتمعات، وبالتالي تحجيم وإسكات هذه الأشكال من التعبير عن التجربة التاريخية والارتباط بالماضي المحلي.
ذكريات كل يوم
جرى التعبير عن روايات التاريخ المركبّة هذه، المفهومة على أنها تأليف للأصول والأنساب وروايات الحرب والنزاع، بشكل حصري تقريبًا من قبل الرجال الذين استندوا إلى إلمامهم بالتقاليد الشفوية، لكن أيضًا لقدرتهم على الوصول إلى الوثائق والكتب والتعليم الرسمي، لتعزيز سلطتهم في مجال متنازع عليه بشدة. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد ممن حاورتهم- النساء بخاصة ولكن ليس بشكل حصري – في القرى المحيطة ببحيرة الأسد، والذين كانوا، في كثير من الحالات، بالكاد (أو لم يكونوا على الإطلاق) قادرين على القراءة والكتابة، أنكروا بشدة أن لديهم أي معرفة بالتاريخ. لم يزعموا أنهم جاهلون فحسب، بل ثبطوني عن استجوابهم، وأصروا على أنهم “لا يعرفون شيئًا” عن التاريخ وأنه لغرض بحثي، سيكون من غير المجدي التحدّث معهم. ومع ذلك، فإن العديد من أولئك الذين ادعوا في البداية أنهم يجهلون “التاريخ” كانوا على دراية وثيقة وقادرين ومستعدين لمشاركة ثروة من الذكريات الشخصية والحميمة عن حياتهم في الماضي. كما أظهروا نوعاً آخر من المعرفة، معرفة حميمة وملموسة بأنماط الحياة السابقة المفقودة والتي كانت مرتبطة بالماضي القبلي المُهّمش. لم يعبّروا بالضرورة عن كل ذكرياتهم لكنهم استخدموا العبارات الشفوية والروايات بالإضافة إلى تجسيد الممارسات والتفاعلات مع أشياء مادية محددة لنقل تجاربهم. كان كلا البعدين، المنطوق وغير المنطوق، متشابكين في أعمال التذكر التي تضمنت أيضًا اللمس والرسم والإشارة والإحجام عن التعبير، بالإضافة إلى التعامل مع الأشياء التي تضمنت الماضي والحاضر.
يشير التفاوت بين تنصل المتحدثين من معرفة أي شيء عن التاريخ، والمعرفة الملموسة بالماضي التي جسدوها ونقلوها، إلى شيئين. فأولاً، أظهر أن محاوريّ لم يساووا بالضرورة بين الإلمام الحميم بالماضي و”المعرفة التاريخية”. وثانيًا، يعبّر عن استجابة بُنى السلطة المحلية في مجال “المعرفة” لاعتبارات الجنس والعمر والجيل، لكن أيضًا للسياق والحالة. في مثل هذا السياق، يمكن للألفة العميقة والكفاءة في العمل، مع الأدوات المرتبطة بالماضي، أن تنقل موقفًا أكثر موثوقية وتطمينًا ذاتيًا إضافيًا للمتحدثين الذين قيّموا أنماط الحياة السابقة مقابل الأنماط الحالية. وفي مثل هذه الروايات العامية، عملت الأشياء المادية والممارسات الجسدية كجسور بطرق عديدة. فأولاً، أمكنها تجاوز الصمت من خلال التعبير عن علاقة بالماضي بطرق لا تستطيع الكلمات (وحدها) القيام بها. وثانيًا، كان لهذا النمط من التعامل مع الماضي القدرة بشكل كبير أيضًا على سد الفجوة المفترضة بين الماضي والحاضر، والتي يتذرع بها العديد من التمثيلات النصية التي تعتمد على الفهم الخطي للزمنية.
وتناولت هذه الروايات طائفة من المواضيع التي لا تشكل جزءاً من التاريخ المعروض في الروايات الأكثر اتساماً بالطابع الرسمي التي رويت في التجمعات أو نشرت في الأدبيات المذكورة أعلاه. كانت الأيام الماضية، بالنسبة للعديد من محاوريّ الأكبر سنًا، منظمة إلى حد كبير من خلال الرعي المتنقل موسمياً. “دُفنت” ذكريات هذا الوقت في أنواع خفيفة أو متنقلة من المساكن، في الأدوات المستخدمة في حَلب الحليب وتصنيعه، خصوصاً المهام والممارسات المرتبطة بالرعي. بيد أن الذكريات الثانوية في هذه الأشياء كانت أشباحًا مضطربة يمكن استدعاؤها من خلال اللمس والعمل مع شيء ما أو استحضارها من خلال رسوم تخطيطية لمثل هذه الأشياء أو إخراجها من التخزين. فمن خلال المناولة المادية، واللمس، وكذلك التحديق في أشياء معينة والتحدث عنها، تم تفعيل ممارسات وإجراءات الماضي واستحضارها: وفرت التجارب الحالية خلفية بديهية قورنت بإزائها تمثيلات الماضي (ضمناً وصراحة) وأُخضعت للمحاكمة. علاوة على ذلك، تطاولت إجراءات العمل وأدواته أحيانًا من الماضي إلى الحاضر، حيث كانت لها أهمية مختلفة عما كانت عليه في السابق: فبينما كانت حاضرة في الأيام السابقة بلا شك وبشكل غير مباشر في حياة معظم القرويين، أضحت، في وقت عملي الميداني، شواهد على أسلوب حياة غريب وقديم الطراز. وكان بوسعهم الآن، بحسب المتحدّث والجمهور والسياق، الدفاع عن أسلوب حياة “أنقى” (أكثر براءة وأصالة) أو “أقذر” (أكثر تخلفًا وبدائية).
ربما ليس من المستغرب بالنظر إلى التاريخ الحديث للمنطقة، وبالنظر، خاصة، إلى التشرّد الذي عانى منه العديد من الأشخاص من الجيل الأكبر سنًا، أن ذكريات المنازل السابقة جعلت التغييرات بمرور الوقت واضحة وملموسة. فكما هو الحال في العديد من الأجزاء الأخرى من الريف السوري، تغيّرت عمليات بناء المنازل في وادي الفرات بشكل كبير خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. وارتبطت أنواع مختلفة من المساكن بأساليب محددة من التواصل الاجتماعي والعمل. وكانت الخيَم، التي لم تعد تستخدم في وقت عملي الميداني، موضوعًا متكررًا لمثل هذه المحادثات.
كان البعض قد باعوا خيَمهم لأسر لا تزال تمارس أسلوب حياة الرحل (موسمياً)، واحتفظ آخرون بها مخزنة وملفوفة في زاوية من المنازل الدائمة الجديدة. لكن بالنسبة لمحاوريّ، لم تكن الخيمة رمزًا مريحًا للمنزل ونمط حياة سابق فحسب، بل كانت أيضًا مرتبطة بشكل ملموس جدًا بالعمل الجسدي الشاق. تتذكر أم سالم:
“كنا نخرج كل شتاء إلى السهوب ونعود للحصاد في الربيع. كان العمل في الخيمة من عمل النساء، لكن الرجال ساعدوا في العمل الشاق… تعلمتُ بناء الخيمة من زوجي ومن الجيران. تحتوي خيمتنا على ثلاثة أعمدة. كان بناء الخيمة مرهقًا للغاية… قبل ثلاثين عامًا، خرجنا مع خيَمنا للمرة الأخيرة. انتهت تلك الحياة الآن”.
شاركت نساء مُسنات أخريات ذكريات مماثلة. ففضلًا عن الخيَم، كانت ذكريات نمط الحياة الرعوية التي شكلت حياة العديد من كبار السن في الماضي لابثة أيضًا في عدد من الأدوات المُستخدمة لتحويل الحليب إلى لبن وزبدة وتخزين هذه المنتجات. كانت هذه الأنابيب أو الأكياس، المصنوعة من جلود الأغنام المدبوغة، تسمى الشيكوا أو المزباد وكان إنتاج “اللبن والزبد” وكذلك الاستخدام اليومي لتلك الأدوات عملاً نسائيًا، ولم تُشرح الإجراءات المعنية بشكل متكرر من قبل محاورين مختلفين فحسب، لكنها – في تلك الحالات القليلة التي كانت فيها هذه الأدوات لا تزال في متناول اليد – أُظهرت لي أيضًا.
ففي نيسان 2003، على سبيل المثال، زرت أم خلف في منزلها. ودعتني، باعتبارها من النساء القلائل في قريتها اللائي ما زلن يحتفظن بقطيع (وإن كان صغيرًا) من الأغنام، لأرى كيف تُحلب النعاج وكيف يُعالج الحليب. عندما وصلت إلى منزلها في الصباح الباكر، كانت أم خلف وزوجة ابنها في طور حلب 15 من الأغنام في منزلهما (وهو إجراء تكرر بعد الظهر). وواصلنا الحديث، طوال الصباح، عن كيف كانت الحياة وكيف تغيرت. وبينما كنا نتحدث، لم تتوقف أم خلف عن العمل. وعلاوة على ذلك، لم تعلق على العمل الذي كانت تقوم به فحسب، بل علقت أيضًا على محادثتنا نفسها (وبالتالي، على طبيعة “عملي” الخاص)، وتخللت محادثتها مرارًا وتكرارًا التمتمة المتذمرة على أن “الشغل يريد عذاب ما يريد حشي كلام”.
يمكن أن يكون التذكّر من خلال الكلمات والحركات والأشياء التي تستحضر روتين العمل السابق والممارسات الجسدية الأخرى أكثر أهمية، طريقة أعمق للتعامل مع الماضي، لخلق هالة عاطفية من مجرد السرد اللفظي للتجارب والأحداث السابقة. كما يمكن أن يُستخدم كأساس للمشاركة الأخلاقية مع مرور الوقت، من خلال التقييم النسبي لمزايا ومساوئ طرق معيشة معينة، متجذرة في نطاقات زمنية مختلفة. وعلاوة على ذلك، يتيح أحياناً طريقة (وإن كانت غير مباشرة) لمناقشة العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتهجير من دون الدخول المنطقة الحساسة لنقد التحديث البعثي صراحة.
فرواية أم سالم، على سبيل المثال، تستحضر الآثار الضارة للبنية التحتية الثانوية المستمدة من مخطط الفرات: في هذه الحالة “المحطة” التي تنقي مياه الفرات وتحولها إلى مياه شرب. كانت المحطة عبارة عن مجمع كبير محاط بجدار إسمنتي يشمل المرافق التقنية بالإضافة إلى المساكن والبنية التحتية لعدة مئات من الموظفين مع عائلاتهم. شُيّد هذا المبنى الكبير بجوار منزل أم سالم وعائلتها “كان كل واحد من أبنائي يزرع ما بين 13 و 14 هكتارًا” قالت أم سالم. “ثم جاءت المحطة وأخذت جزءًا من الأرض، والآن لديهم فقط 10 هكتارات” ومثل أم سالم، لم يتلق العديد من جيرانها وأقاربها أي تعويض من أي نوع عن خسارة أراضيهم، التي صُنفت، بأي حال من الأحوال، على أنها “أراضي دولة” (ميري) بدلاً من ملكية خاصة “طابو” حسبما قالت.
وكان العديد من المحادثات حول الماضي، إن لم يكن معظمها، مشوبًا بشدة بإيحاءات عاطفية ومعيارية. ولم تهدف “المحادثات” فقط إلى إعادة بناء كيف كانت الأمور وكيف تغيرت ولكن أيضًا إلى تقييم هذه التغييرات، والحكم على الطريقة التي كانت تسير بها الأمور، واستنتاج – ضمنيًا – التوجه للعيش في الحاضر والمستقبل. وتحدثت فكرة الزمنية التي استخدموها عن تراجع (أخلاقي واجتماعي) في مواجهة التقدم المادي والتعليمي. وأكدت مُسنات كثيرات الحاجة إلى العمل الجاد، وانتقدن عدم رغبة الجيل الحالي في المشاركة فيه. وبينما اختلفت التجارب الفردية وقصص الحياة عن بعضها البعض، حتى بين أفراد من الجيل نفسه تقريبًا، ومن القرى المجاورة أو حتى من الأسرة الممتدة ذاتها، ظهرت أنماط عامة. إن ثيمة العمل الجاد كخاصية من سمات الماضي، وتفعيله من قبل النساء الأكبر سناً في الوقت الحاضر من خلال إدامة أساليب عمل قديمة الطراز، ولّدت أبعادًا متجسدة ومادية ولكن أيضًا عاطفية وأخلاقية للتذكر. فقد أشار العديد من القرويين – وخاصة كبار السن – إلى الماضي الجماعي، وعلى وجه الخصوص، إلى الفترة التي سبقت غمر بحيرة الأسد، في إيحاءات من الحنين إلى الماضي.
ولدى إدانة العلاقات والظروف الحالية المعيبة، استدعى العديد منهم رؤى لماضٍ “أكثر نقاءً”. وقد بُني هذا النقاء بشكل استطرادي من خلال ادعاءات بوجود علاقات اجتماعية أكثر صحة غير ملوثة بالتنافس الوجودي الحالي على المال وعواقبه، مثل هجرة العمالة والندرة و”الجشع”. كانت المواقع الأخرى ذات النقاء المفقود على ما يبدو أكثر دنيوية مثل الطعام المصنوع منزليًا مقابل الطعام المشترى من المتجر ومستدعيات الصحة البدنية. فأم صالح، على سبيل المثال، وصفت الوقت “قبل الغمر” بأنه وقت النقاء والجمال والصحة بالنسبة لها، واثنتين من بناتها، وابنتي أخيها:
“كان موكب الزفاف (الزفة) من الجمال والخيول يأتي لجلب العروس من منزل والدها. الخيول الأصيلة! لم يستخدم أحد السيارات لزف العروس.. كان منظر تلك الخيول رائعًا.
والجميع ساعد الجميع، بلا مقابل بالطبع.
لأي نوع من الأعمال؟
لكل أنواع العمل
لكن ألا يزال الناس يساعدون بعضهم بعضًا؟
في الوقت الحاضر، فقط الأصدقاء والأقارب يساعدون بعضهم البعض، ولكن من قبل “أولي” اعتاد الجميع على المساعدة، كل الجيران”.
وفي ذلك الوقت، كان الجميع في القرية، وكان جميع الرجال هناك. في الوقت الحاضر، ذهب جميع الرجال للعمل في المدينة أو في الخارج.
ولم يكن هناك أطباء في ذلك الوقت. كان هناك أطباء فقط في حلب. لكن في ذلك الوقت، لم يمرض أحد، ولم نكن بحاجة إلى أي أطباء! كل ذلك تغير مع الغمر.
إن الإصرار على عدم معرفة الأمراض قبل الغمر، مما يجعل وجود الأطباء أو المرافق الطبية الأخرى غير ضروري، يجعل من الرطانة البعثية المتكررة عن تحسين الخدمات الطبية في الريف حول البحيرة الناشئة في أعقاب بناء سد الفرات مسألة مثيرة للاهتمام. تم التعبير عن مشاعر مماثلة من قبل أم صالح، وأم أحمد، التي كانت في السبعينيات من عمرها عندما التقيت بها للمرة الأولى في العام 2002. وصفت الحياة في الماضي (الحياة أولي) لي ولمجموعة من قريباتها في زيارة صباحية في منزل ابنها:
“يوجد اليوم كل شيء، لكن في ذلك الوقت، كانت حياتنا صعبة. [تشير إلى ابنتها الكبرى التي هي بدورها جدة]. أنجبتها في الليل، وفي الصباح، أجلسوني على حمار، وأنزلنا الخيمة ومضينا. […] ذهبنا إلى حد بعيد من هنا إلى المهدوم [مسافة حوالي 25 كلم]. اضطررت إلى ركوب هذا الحمار والطفل في ذراعي، والمضي قدمًا. لا طبيب ولا مستشفى! ليس مثل اليوم، يوجد اليوم كل شيء. هؤلاء [تشير إلى ابنتها وزوجة ابنها وابنة أختها الحاضرة أيضًا] لا يعرفون ما هو الكد. (يتمتم الزوار بالموافقة، على الرغم من أنهم أيضًا اشتكوا لي كثيرًا أثناء أو بعد مهنهم اليومية من أن “حياتهم لا تتكون إلا من العمل والكدح” (حياتي بس شغل وتعب”). نعم، كانت حياتنا صعبة، لكن لم يكن هناك مرض! كنا نأكل فقط الخاثر “اللبن” والعسل والسمن العربي (الزبدة المصفاة المصنوعة من حليب الأغنام). لم نمرض أبدًا، ولم نر طبيباً أبدًا. لم يعرف أطفالي حتى ما هو “الطبيب”. الآن فقط، منذ أن بدأنا نعيش في هذه المنازل ونأكل طعام تلك المدينة، التي لا أحد يعرف ماذا يضعون فيها [أصبحنا نمرض ونحتاج إلى الأطباء]”.
كانت هذه الذكريات مفيدة بطرق عديدة. فقد أعربت عن حنينهم إلى الماضي المُشّيد بصورة مناقضة للوضع الحالي المُنتقد ضمنًا. وفي حين انتقدت أم خلف وأم أحمد الكسل المفترض لشابات اليوم، مقارنة بالعمل والمصاعب التي عانتها أمهاتهن وجداتهن، تناول نقد أم صالح أبعادًا جمالية (جمال مواكب الزفاف المكونة من الخيول والجمال بدلاً من استخدام السيارات والدراجات النارية اليوم)، ولكن الأهم من ذلك أنه ركز على تحول العلاقات الاجتماعية. فقد كان إصرارها على أن المساعدة المتبادلة كانت تُمنح “بلا نقود” مؤشرًا على الأهمية المتغيرة (وتقييماتها المتنازعة) للأموال في هذا الإطار المحلي – وهو تحول قيمه المحاورون الآخرون أيضًا بشكل سلبي. وصورت أم صالح المجتمع القروي في وقت ما قبل الغمر على أنه سليم – على عكس الوضع المعاصر. وقد عبرت عن ذلك من خلال تركيزها على العلاقات الاجتماعية وعلاقات العمل التي تميزت بتضامن اجتماعي يومي منتشر يشمل القرية بأكملها.
وبينما اعترفت بأن المساعدة التضامنية المتبادلة لا تزال موجودة، تقلّص محيط الدائرة الاجتماعية التي يمكن للمرء الاعتماد عليها للحصول على المساعدة. ووفقًا لرأيها، بدلاً من تضمين القرية بأكملها، في أوائل العام 2000، كانت تضم فقط الأقارب والأصدقاء المقربين، مما يشير إلى التحولات في الروابط الاجتماعية التي ربطت القرويين في هذه المنطقة ببعضهم البعض وقت التحدث.
وقد عُبِّر عن الشعور بالماضي كعالم من “النقاء” والتوازن والبراءة المفقودة أيضًا من خلال تقييم العلاقات الاجتماعية، والتي غالبًا ما تم التعبير عنها من خلال المعايير المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين. ومن الأمثلة على ذلك، رواية أم عبود لهجرات المراعي الحولية لرعاة الأغنام في وادي الفرات. فقد امتلكت عائلتها عددًا كبيرًا من الأغنام. وفي كل شتاء أثناء الهجرة السنوية “في السهوب”، والانتقال من وادي الفرات نحو تدمر، أخبرتني أم عبود كيف كان والداها يبقيان في بعض الأحيان لرعاية الحقول على نهر الفرات أو يبقيان في مكان واحد معين في السهوب. بينما انتقلت هي – وكانت آنذاك لا تزال عزباء وتُنادى باسمها “فدا” إلى السهوب مع الأغنام، برفقة الراعي عبد الأحد، الذي كان يعمل للأسرة ولكن لم يكن له صلة قرابة بهم.
اهتم عبد الأحد بالرعي، في حين كانت فدا وأخواتها مسؤولات عن حلب الأغنام ومعالجة الحليب وصناعة اللبن والزبدة والجبن. وتقاسموا كلهم خيمة العائلة. في وقت عملي الميداني، كان من الممكن اعتبار ترتيبات النوم هذه غير مناسبة تمامًا للفتيات الصغيرات، اللواتي خضعت تحركاتهن وسلوكهن لمزيد من التحكم: فمخاوف وتوقعات “اللياقة” تضمنت الفصل الصارم بشكل متزايد بين الذكور والإناث. ومع ذلك، في ذلك الوقت، “لم يقل أحد شيئًا – كان طبيعيًا”، قالت أم عبود “لأنه كان هناك أمان في ذلك الوقت”.
تشير ذكريات أم عبود إلى فقدان حقيقي ومُجرّب ومحسوس لحرية الحركة، وتقييد التواصل الاجتماعي. وبعيدًا من كونها تجربة فردية، فقد استُدعيت ملاحظات مماثلة من قبل نساء أخريات في سنوات سابقة. وبمعنى ما، يبدو أن هذا يعكس الافتراضات القديمة، التي أوضحها العديد من المراقبين الخارجيين لسكان السهوب العربية، بأن الإناث في الريف، وخاصة في المجتمعات البدوية، يتمتعن “بحرية” أكبر في ما يتعلق بعلاقاتهن الاجتماعية مع الذكور من نظيراتهن في البيئات الحضرية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، وحتى في السياقات الحضرية، تغيرت قواعد اللباس الأنثوي والسلوك الجسدي نحو درجة أكبر من الفصل بين الجنسين في السنوات الأخيرة مقارنة بالعقود السابقة.
إن الاحتجاج بالماضي باعتباره موقعًا لطريقة حياة ضائعة وأكثر نقاء، يشير بالتالي إلى تصورات حول خسارة فعلية “للحقوق” بينما يعبّر في الوقت نفسه عن خطاب شوق إلى الماضي. بيد أن هذا الخطاب يتضمّن أيضًا – ويتجنب – التناقضات المتأصلة. ففي حين أن أسلوب الحياة المرتبط بتربية المواشي المنتقلة موسميًا، بما في ذلك الرعي والحلب ومعالجة الحليب، والانتقال في السهوب مع الخيام، وما إلى ذلك، تم تذكره بشغف وشوق كنشاط سابق، فقد كان الكثيرون يحتقرون مثل هذه الممارسات عند النظر إليها في الحاضر.
تناقضات مماثلة، على الرغم من أنها أقل وضوحًا، تتعلق بتقييمات الزراعة، ولكن أيضًا بالمجالات الاجتماعية والثقافية الأخرى، حيث تذبذبت تقييمات الماضي بين التعبير عن الحنين إليه والرفض المزدري له باعتباره تعبيرًا عن التخلف والجهل. ونظمت المواقف المتباينة تجاه المهن وأنماط الحياة السابقة مقابل “الحديثة” وتقييماتها جزئيًا من خلال الانتماء إلى الأجيال، فضلاً عن تغيير أدوار وعلاقات الجنسين.
خاتمة
يشير التاريخ الحديث للمنطقة المحيطة ببحيرة الأسد السورية إلى طبقات متعدّدة من التهميش في سوريا. وقد مُثلّت تجارب التهميش متعددة الطبقات هذه، كما تم تحديها من خلال الاحتجاج القوي بالزمنية والتاريخانية. وبرر ممثلو الدولة العنف البنيوي “التحتي”، أي التهجير واسع النطاق الناجم عن السدّ، فضلاً عن استمرار إهمال البنية التحتية في أجزاء من المنطقة، بالإشارة إلى ما يرون أنه الطابع الأمّي والمتخلف اجتماعياً للسكان المحليين. وقد قارن ممثلو الدول والحزب البعثيون والخبراء الأجانب المجد الماضي للحضارات القديمة بالماضي القريب، المنظور إليه على أنه عقبة أقل قيمة أمام التقدّم ومستقبل أكثر إشراقًاً. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدم المؤلفون المحليون النوع الناشئ حديثًا من المنشورات “البدوية” حول التاريخ القبلي لمواجهة عمليات الطرد هذه ضمنيًا من خلال تسليط الضوء على الفاعلية “الوكالة” التاريخية للسكان المحليين، وبالتالي إعادة كتابتها في سرديات تاريخية أكبر. بيد أن هذه الروايات بدورها، التي تركّز على الشخصيات البطولية والمعارك والأنساب والأصول، همشت، وتجاهلت المزيد من أشكال المعرفة اليومية حول الماضي.
في هذا السياق، لم تُغمر ذكريات الماضي، وروتين العمل، وأساليب العيش، فقط بسبب ارتفاع منسوب مياه بحيرة الأسد، فقد كان لها أن تغرق أيضًا بسبب الخلافات الصاخبة حول تاريخ هذا الجزء من سوريا ومستقبله. بيد أن هذه الذكريات المغمورة طفت إلى السطح مرة أخرى، لا سيما في التجمعات. فقد تشارك الإناث، الذكور، وقرويو حوض الفرات الذين ادعوا “الجهل” بالتاريخ تجاربهم الشخصية وتصوراتهم عن التغيير الاجتماعي والاقتصادي. وبالحديث عن تجاربهم الشخصية، عبروا عن إحساسهم بوجود قطيعة حاسمة، بدلاً من تغيير تدريجي، بين الماضي والحاضر. وربطوا هذا القطيعة ببناء سد الفرات وعمليات النقل التي أعقبت ذلك والتي كان يُنظر إليها على أنها وسعت المسافات الاجتماعية والاقتصادية بين الأقارب. فمن وجهة نظرهم، ميزت التغييرات الكبيرة بين الأجيال الانتقال من أسلوب رعوي قوي (ومتنقل موسميًا) إلى أسلوب حياة قروي مستقر، ونمط حياة حضري بشكل متزايد. والنساء الأكبر سناً، على وجه الخصوص، استجوبن هذه التغييرات واعترضن عليها أحيانًا، بناءً على تجاربهن في قدر أكبر من التنقل والسماع في الماضي.
(*) كاثرينا لانغ، عالمة أنثروبولوجيا متخصصة في الشرق الأوسط، وتدور منشوراتها حول توطين الأنثربولوجيا العربية، الأنثربولوجيا التاريخية للمجتمعات القبلية، وسياسة التاريخ والذاكرة في سوريا.
المقال الأصلي: Memory Studies 2019, Vol. 12(3) 322–335
المصدر: المدن




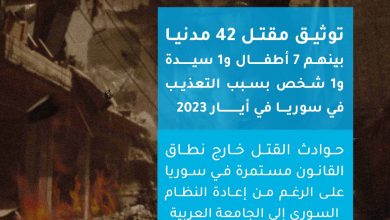



قراءة من خارج السياق لمنعكسات بناء سد الفرات ضمن مشاريع البنية التحتية للدول ، وما تؤديه الى فقدان الرابط الاجتماعي المكاني والزماني للمكونات الاجتماعية ، رؤية نقدية خاصة بمنطقة الفرات والتاريخ للمنطقة ، ولكن لكل حدث إيجابيات وسلبيات قد تختلف زاوية الرؤية بين المقارنين لتغلب إحداها الأخرى ، ولكن الحياة والتطور واجب مع الحفاظ على الأثر .