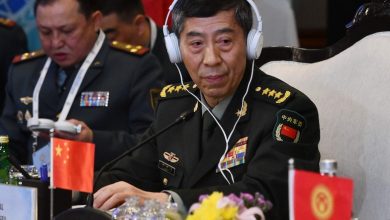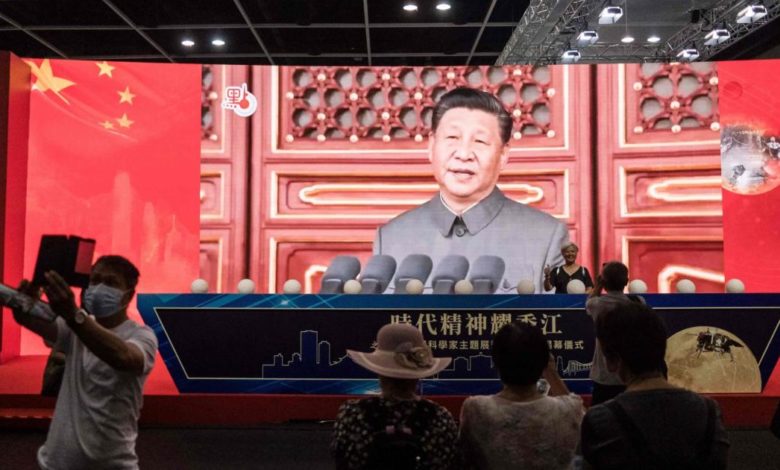
تبدو كأنها قصة نموذجية أخرى عن الفساد في الصين. إذ يملأ رجل الأعمال، بطل القصة، حقائبه بأسهم الشركة ويوزع الرشاوى يميناً ويساراً على المسؤولين المتنفذين كي يحصل على قروض رخيصة لتمويل مشاريعه الخاصة بالسكك الحديد. هكذا، أغدق بسخاء على المسؤولين عن البنى التحتية والموازنات العامة، ممن كانوا في الحقيقة من أصحابه وشركائه في العمل. أدار أقارب أولئك المسؤولين من أبناء العائلة نفسها شركات تعمل في صناعة الفولاذ، كان متوقعاً أن تستفيد من مد سكة حديد جديدة. وإذ ازدادت متانة العلاقات بين المسؤولين ورجل الأعمال مع مرور الزمن، فقد ضاعفوا الدعم المالي الذي كانوا يوفرونه لمشاريعه من دون أن يعترضوا على تكاليفه الكبيرة، على الرغم من ضخامتها المتعمدة، وخطر الخسائر المحتملة. وسرعان ما أخذت الأزمة المالية تختمر ببطء، لكن بشكل أكيد.
تُعتبر تلك القصة إحدى حالات مماثلة كثيرة باتت الآن متأصلة في الصين، حيث يتواطأ كبار رجال الأعمال مع كبار المسؤولين بغرض استغلال مشاريع تنموية لأغراض تتعلق بتكديس الأموال في جيوب بعض الأفراد، ويتفشى الكسب غير المشروع على المستويات الحكومية كافة، ويشجع السياسيون الرأسماليين كي يُقدموا على مجازفات كبيرة. إذن، لا عجب أن يقول بعض المراقبين منذ تسعينيات القرن الماضي، إن الاقتصاد الصيني سينهار تحت وطأة تجاوزاته بالذات، وحينما يتداعى سيُسقط معه النظام أيضاً. في المقابل، ثمة مفاجأة غير متوقعة تتمثل في أن رجل الأعمال الآنف الذكر، ليس صينياً، بل هو أميركي، وقد تكشفت فصول القصة في الولايات المتحدة وليس الصين. واستطراداً، تتناول القصة متمولاً كبيراً اسمه ليلاند ستانفورد، كان من أقطاب صناعة السكك الحديد في القرن العشرين، ساعد في دفع عملية تحديث الولايات المتحدة بقوة إلى الأمام لكن طريقه إلى تحقيق الثراء الفاحش كان معبداً بصفقات فاسدة.
وتذكيراً، لقد شكل “العصر المُذّهب” The Gilded Age الذي بدأ في سبعينيات القرن التاسع عشر، فترة تمدد “رأسمالية المحسوبيات”crony capitalism إضافة إلى كونه فترة من النمو والتحول الاستثنائيين في البلاد [تعتبر تلك الحقبة زمن انتقال أميركا إلى الرأسمالية والتصنيع]. وقد أُعيد بناء الولايات المتحدة وازدهرت، في أعقاب الخراب الذي حل بها إبان الحرب الأهلية. هكذا، انتقل في ذلك الوقت ملايين الفلاحين من الحقول إلى المعامل، وفتحت البنية التحتية الباب على تجارة المسافات الطويلة، وأفرزت التكنولوجيا الحديثة صناعات حديثة، إضافة إلى تدفق حر الرأسمال الذي لم يكن يخضع إلى تنظيم رقابي تشريعي. وفي سياق تلك العملية، اغتنم رجال أعمال متغطرسون على غرار ستانفورد وجي. بي مورغان وجون دي. روكفلر، الفرصة المناسبة في الوقت المناسب، كي يكدسوا ثروات بلغت مستويات هائلة، في الوقت الذي تقاضى أفراد الطبقة العاملة الجديدة أجوراً كانت بالكاد تسد رمقهم. وتواطأ السياسيون مع كبار رجال الأعمال وتلاعب المضاربون بالأسواق على هواهم. وبدلاً من التفكك الذي كان يمكن أن يفضي إليه، فتح فساد “العصر المُذّهب” الباب أمام “المرحلة التقدمية” Progressive era التي تمثلت في موجة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية [تُسمى أحياناً مرحلة “الإمبريالية التقدمية”]. ومهد ذلك، إلى جانب عمليات الاستحواذ الإمبريالية، الطريق أمام صعود الولايات المتحدة، فصارت القوة العظمى للقرن العشرين.
تعيش الصين حالياً في خضم “عصر مُذهب” خاص بها. يزداد رواد الأعمال من القطاع الخاص ثراء بشكل مذهل بفضل قدرتهم على الاستفادة من الامتيازات الحكومية. ويحذو حذو رواد الأعمال أولئك المسؤولون الذين يتيحون لهم الوصول بشكل غير مشروع إلى تلك الامتيازات، فيصبح المسؤولون بدورهم أكثر غنى بوتيرة مدهشة أيضاً. وبواسطة القوة الصرفة، يحاول الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يطبق “المرحلة التقدمية” الخاصة بالصين، أي الفترة الأقل فساداً والأكثر إنصافاً ومساواة، وذلك انطلاقاً من إدراكه لمخاطر “رأسمالية المحسوبيات”. في المقابل، ثمة مشكلة تكمن في أن تلك ليست الطريقة الكفيلة بترسيخ جذور الإصلاح الحقيقي. وبالتالي، يعمل الرئيس شي على قمع الطاقة التي تنطلق من القاعدة إلى القمة حاملة معها مفتاح حل مشاكل الصين الحالية. وفي نهاية المطاف، فقد يؤدي ذلك القمع الذي يمارسه الرئيس شي إلى جعلهم أقوى مما هم عليه الآن.
خطأ التصنيف
تمثل الصين بالنسبة إلى أولئك المهتمين بالفساد لغزاً محيراً. فقد درجت العادة أن تكون الدول التي يشيع فيها الفساد فقيرة، وتبقى كذلك. وقد أظهرت دراسة تلو أخرى وجود علاقة وثيقة بين الفساد والفقر. في المقابل، استطاعت الصين أن تواصل النمو أربعة عقود من الزمن على الرغم من المستويات التي بلغها الفساد فيها، حتى أن شي وصف تلك المستويات بأنها “خطيرة” و”صادمة”. لماذا يبدو أن الصين تخالف الاتجاه العام؟
يكمن الجواب على ذلك السؤال في نوع الفساد السائد في الصين. إذ تتجاهل معايير الفساد التقليدية أنواعه المختلفة. ويعتبر “مؤشر مدركات الفساد” Corruption Perceptions Index الصادر عن مؤسسة “الشفافية الدولية” سنوياً، أكثر معايير الفساد رواجاً، إذ يقيس الفساد كمشكلة ذات بعد أحادي يحدد قوتها على مقياس عالمي تبدأ تدريجاته في الصفر وتنتهي عند الـ100. وفي 2020، سجلت الصين 42 نقطة على ذلك المقياس، ما جعلها أكثر فساداً من كوبا وناميبيا وجنوب أفريقيا. وعلى العكس من ذلك، صُنِّفَتْ الدول ذات الأنظمة الديمقراطية على الدوام بين الأكثر نقاءً ونزاهة الفساد في العالم، الأمر الذي أسهم في تأكيد القناعة السائدة بأن الفساد داء لا تصاب به إلا الدول الفقيرة.
يتمتع ذلك المفهوم بجاذبية كبيرة بفضل بساطته، بيد أنه مضلل. في الواقع، يأخذ الفساد أشكالاً لكل منها طعم مميز، ويتمخض كل منها عن نوع مختلف من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية. يعرف العامة ثلاثة أنماط رئيسة للفساد، يتمثل أولها في السرقة الصغيرة، كما يحصل مثلاً حين يبتز عناصر الشرطة الناس في الطريق ويسلبونهم مالاً أو سواه. ويتجسد الثاني في السرقة الضخمة التي تجري حينما تنهب النخب الوطنية مبالغ هائلة من خزائن المؤسسات العامة، وتودعها في حسابات مصرفية خاصة في الخارج. ومن المستطاع تسمية النمط الثالث “المال التسريع” speed money ويتأتى من دفع رشاوى إلى مسؤولين عاديين بهدف تجاوز الروتين وتفادي التأخير وضمان الحفاظ على دوران عجلة البيروقراطية بسلاسة ويسر. وتُعد الأنماط الثلاثة غير قانونية، وتُدان بشدة، وتنتشر على نطاق واسع في الدول الفقيرة.
بيد أن الفساد يظهر بلبوس آخر أكثر مراوغة وخفاء، إذ يتجسد في “مال الوصول” access money. وفي ذلك النوع من التعاملات، يعرض الرأسماليون مكافآت عالية المخاطر على المسؤولين النافذين ليس لمجرد أن تكون ثمناً لتسريع الإجراءات، بل أيضاً الحصول على الميزات الحصرية المربحة، بما في ذلك قروض الائتمان الرخيصة، وقطع الأرض، وحقوق الاحتكار، وعقود الشراء، والإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك. يمكن أن يظهر “مال الوصول” في أشكال غير قانونية كالرشاوي والعمولات الهائلة، غير أنها تأخذ أيضاً أشكالاً قانونية مئة في المئة. لنأخذ مثلاً جماعات الضغط، وهي مجموعات مشروعة هدفها التمثيل السياسي في الولايات المتحدة وفي الديمقراطيات الأخرى. وتمول تلك المجموعات النافذة حملات سياسية، وتَعِد السياسيين بوظائف فخمة بعد ما يغادرون مناصبهم الرسمية، في مقابل نجاح مجموعات الضغط في التأثير على القوانين والسياسة.
تعيش الصين حاضراً زمن “العصر المُذهب” الخاص بها
واستكمالاً لتلك الصورة، تلحق أنواع مختلفة من الفساد الأذى بالدول في طرق مختلفة. تعتبر السرقة الصغيرة والضخمة نوعاً من أنواع العقاقير السامة، إذ تضر بالاقتصاد بوضوح وبشكل مباشر لا لبس فيه، من خلال استنزاف الثروات العامة والخاصة فيما لا تقدم أي فوائد مقابل ذلك. ويشبه “مال التسريع” المسكنات، فقد يخفف الصداع لكنه لا يفيد في تعزيز قوة المرء. ويشبه “مال الوصول” المنشطات. إنه يحفز نمو العضلات ويتيح للمرء أن ينجِزَ أعمالاً خارقة للعادة، لكنه يكلف ثمناً باهظاً على شكل أعراض جانبية خطيرة، بما في ذلك احتمال الانهيار التام.
هكذا حالما يفكّك المرء الفساد بتشابكاته المعقدة إلى عناصرها كلها، تغدو المفارقة الصينية واضحة لا تدعو إلى الحيرة. لقد مر الفساد في الصين على امتداد العقود الأربعة الأخيرة، بمرحلة التطور البنيوي، ثم المضي بعيداً عن البلطجة واللصوصية المباشرتين، كي يدخل مرحلة “مال الوصول”. وبات ذلك المال حالياً النمط المهيمن للفساد من خلال دفع المكافآت للمسؤولين ممن يخدمون المصالح الرأسمالية، مع زيادة إثراء الرأسماليين ممن يدفعون المال لقاء الامتيازات. وقد أدى ذلك النمط إلى تنشيط التجارة، والإنشاءات، والاستثمارات، التي تسهم كلها في نمو الناتج الإجمالي المحلي. إلا أنه أدى أيضاً إلى تفاقم عدم المساواة بين الناس كما تمخض عن مخاطر منهجية أيضاً. تفوز الشركات التي تحتفظ بعلاقات سياسية بقروض البنوك بصورة غير متناسبة، ما يجبر رواد الأعمال ممن يعانون من ضائقة مادية إلى الاستدانة من بنوك الظل بمعدلات فائدة ربوية. وتستطيع الشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية جيدة أن تتحمل إنفاق المزيد من المال بشكل لا مسؤول والمضاربة في سوق العقارات. إضافة إلى ذلك، باعتبار أن السياسيين يستفيدون شخصياً من الاستثمارات التي يستقطبونها إلى مناطق نفوذهم، فإنهم يغدون مدفوعين إلى الاقتراض والبناء بشكل محموم، بصرف النظر عما إذا كانت المشاريع مستدامة أم لا. ويؤدي ذلك كله إلى جعل الاقتصاد الصيني ليس مجرد اقتصاد عالي النمو، بل أيضاً اقتصاد عالي المخاطر وفاقداً للتوازن.
تطور الفساد
بدأ ذلك التطور الدراماتيكي للفساد والرأسمالية مع الزعيم دينغ كيسياو بينغ [الذي يرتبط اسمه بانطلاق الانفتاح الاقتصادي الصيني في سبعينيات القرن العشرين]، الذي مضى بالصين في اتجاه جديد، بعد ثلاثة عقود كارثية قضتها في ظل زعامة ما تسي تونغ. وأوجد دينغ ديناً جديداً متمثلاً في البراغماتية، من دون أن يفصح عن ذلك صراحة. وأدرك أن التحرر المتزامن على المستويين السياسي والاقتصادي من شأنه أن يزعزع استقرار الصين. وفي خطاب تاريخي ألقاه سنة 1978، ذكر أن “الاستقرار والوحدة لهما أهمية قصوى” بالنسبة إلى بلاد كالصين طالما عصفت بها الفوضى.
وبالتالي، اختار دينغ طريق التحرر الاقتصادي الجزئي بدلاً من التحول إلى الرأسمالية بقفزة واحدة مباشرة، فطبق إصلاحات السوق على الأطراف الجانبية للاقتصاد الموجه، إضافة إلى أنه خول الحكومات المحلية صلاحيات إدارة الاقتصاد في مناطقها. وبذا، أرسى بينغ القواعد الأساسية في تقاسم الربح ضمن البيروقراطية، بمعنى أنه صار بإمكان كوادر الحزب الشيوعي الصيني ممن يمسكون بالجهاز الإداري للدولة (ويسمى أفراد ذلك التقاطع بين الحزب ومؤسسة الدولة “آبارتشيك” apparatchiks، في إشارة إلى كونهم نخبة حزبية مميزة ضمن جهاز الدولة)، أن يستفيدوا شخصياً من الرأسمالية ما داموا مخلصين للحزب الشيوعي الصيني. إذن، فلا عجب أن المسؤولين على كل المستويات تبنوا بحماس إصلاحات السوق الجديدة. وفي الوقت الذي انطلقت فيه تلك الإصلاحات، تضاعف عدد المسؤولين ممن اتخذوا هيئة مزدوجة عبر تحولهم إلى رواد أعمال في الوقت نفسه، وشرعوا في إدارة المؤسسات التعاونية للدولة، واستقطاب المستثمرين من خلال شبكات علاقاتهم الشخصية، وإدارة الأعمال التجارية بشكل موازٍ مع أعمالهم الأساسية الرسمية.
في المقابل، تفشى الفساد وازدهر، فيما أخذت الأسواق تفتح أبوابها في ثمانينيات القرن الماضي. وقد أخذ الفساد أشكالاً تخص بلداً لا يزال متخلفاً ويملك اقتصاداً مختلطاً وحكومة لها قدرة محدودة على مراقبة ملايين البيروقراطيين. ومثلاً، تجلى أحد تلك الأشكال الخاصة للفساد في الصين، باحتفاظ كل حكومة محلية بما يمكن تسميته “خزينة صغيرة” ملأتها بأموال الرشى والنفقات غير المصرح عن تحصيلها، والغرامات، والرسوم التي انتُزعت عنوة من السكان والشركات. وباعتبار أن الجهات المركزية المسؤولة عن التنظيم الرقابي التشريعي، قد مارست إشرافاً محدوداً على الميزانيات المحلية، فقد استفحل الاحتيال. وكذلك انتشرت عمليات الرشوة الصغيرة. ففي محاولتها للتغلب على الروتين، اضطرت الطبقة الناشئة من رواد الأعمال إلى دفع الرشوة للبيروقراطية المحلية. ولم تسلم الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات كـ”ماكدونالدز” من ذلك، بل أُجبرت على الدفع أيضاً. إذ فرضت سلطات العاصمة في وقت من الأوقات 31 غرامة على مطاعم “ماكدونالدز” في بكين، علماً أن معظم تلك الغرامات لم يكن قانونياً. وأدى ذلك النوع من الفساد في الريف، إلى انتشار تذمر واسع بسبب الأعباء الناجمة عنه التي ألقت بثقلها على المزارعين، ما أطلق عنان احتجاجات عمت الأرياف في الصين.
يقمع شي الطاقة الصاعدة من القاعدة إلى القمة، وهي التي تحمل مفتاح حل مصاعب الصين الحالية
وبعد ذلك، جاء القمع الذي شهدته ساحة “تيانانمين” في 1989، ما وجه ضربة قاصمة إلى الحركة الإصلاحية. وفي تلك المرحلة، بدا مستطاعاً أن تعود الصين أدراجها إلى المرحلة السابقة كي تبدأ من جديد بالعمل وفق النظام الذي أوجده ما وتسي تونغ. لكن دينغ استطاع أن يعيد إذكاء الحماس للرأسمالية مرة أخرى عبر “الجولة الجنوبية” الشهيرة التي قام بها في 1992، وذلك قبل أن يُسلم القيادة إلى خليفته جيانغ زيمين. تابعت القيادة الجديدة في ظل جيانغ السير على خطى سلفه، فمضت بإصلاحات دينغ الجزئية للسوق في الثمانينيات إلى مرحلتها التالية. وآنذاك، تعهدت بكين تأسيس ما سمته “اقتصاد سوق اشتراكي”، وربما بدا ذلك الوعد فارغاً بالنسبة إلى عديد من الغربيين، بيد أن ذلك الشعار سرعان ما فتح الباب أمام ثورة مؤسساتية.
يمكن تشبيه فترة ما بعد دينغ، من بعض النواحي، بـ”المرحلة التقدمية” في الولايات المتحدة (جاءت رداً على تجاوزات رأسمالية “العصر المذّهب” الذي شهدته أميركا في أواخر القرن التاسع عشر. واتسمت المرحلة التقديمة بطابع إصلاحي سعت فيه الطبقة المتوسطة إلى تعزيز فعاليتها والقضاء على الفساد). ففي تلك الفترة، فككت بكين كثيراً من العناصر الرئيسة في التخطيط المركزي، على شاكلة ضوابط الأسعار وحصص الإنتاج، وخفضت بشكل كبير حجم الأملاك الاقتصادية التي تحتفظ الدولة بها. وعلى ذلك النحو، سُرح نحو 60 في المئة من العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة بين 1998 و2004. وفي الوقت نفسه، تابعت الحكومة المركزية إجراء إصلاحات جريئة في قطاع المصارف، والإدارة العامة، والمالية العامة، والتنظيم الرقابي التشريعي. وأرست تلك الجهود الأساس لمرحلة نمو متسارع، لكن ذلك حصل من دون تحرر سياسي رسمياً.
وقاد تلك الحملة التقدمية زهو رونغجي، رئيس وزراء الصين بين 1998 و2003. وطبق ذلك السياسي المعروف بإلقاء خطب نارية توبخ المسؤولين المحليين بسبب عدم كفاءتهم، مجموعة واسعة من الإصلاحات الإدارية. وعززت بكين الحسابات المصرفية العامة من أجل القضاء على الأموال غير الشرعية والإبقاء التعاملات المالية قيد المراقبة عن كثب. وكذلك جردت الوكالات الحكومية من أعمالها الجانبية بهدف منعها من الإساءة إلى صلاحياتها التنظيمية. واستبدلت بكين أيضاً طرق الدفع الإلكترونية بعمليات الدفع نقداً في الغرامات والرسوم، وذلك في محاولة منع البيروقراطيين من ابتزاز المواطنين أو سرقة المال العام.
وقد نجحت الإصلاحات. ونتيجة لذلك انخفض عدد حالات الفساد التي اشتملت على الاختلاس وإساءة استخدام المال العام بوتيرة ثابتة منذ عام 2000. كذلك تراجعت إشارات وسائل الإعلام إلى “الرسوم التعسفية” و”الابتزاز البيروقراطي”، مع العلم أن المساحة التي يفردها الإعلام للتقارير المتعلقة بتلك القضايا تعتبر مؤشراً عن مدى قلق الناس حيالها. ولذلك لم يكن من المفاجئ أن تسعة من المشاركين الصينيين ردوا بالإيجاب على سؤال مؤسسة “الشفافية الدولية” في عام 2011، بشأن دفعهم رشاوى بهدف الحصول على خدمات عامة خلال العام السابق، وذلك بالمقارنة مع 54 في المئة من المشاركين الهنود، و84 في المئة من نظرائهم الكمبوديين. ففي الصين، جرت السيطرة، أخيراً، على أشكال الفساد المعيقة للنمو، خصوصاً في المناطق الساحلية الأكثر تطوراً.
ادفع كي تلعب
في سياق موازٍ، تفشى “مال الوصول” بشكل مفاجئ وقوي على نطاق واسع. فقد حلق عدد حالات الرشوة بعد عام 2000، واشتملت على مبالغ أكبر بكثير تلقاها مسؤولون أرفع مما مضى. وتصدرت قصص فضائح الفساد المتخمة بتفاصيل فظيعة عن الجشع والانحطاط، الصفحات الأولى من صحف البلاد. مثلاً، حُكم على وزير سابق للسكك الحديد بقبض رشاوى بلغ مجموعها 140 مليون دولار (101.07 مليون جنيه إسترليني)، إضافة إلى 350 شقة سكنية نالها أيضاً في إطار صفقات فساد. وزُعم أن رئيس إحدى المؤسسات المصرفية المملوكة للدولة، قد احتفظ بحريم [أحياناً، يستخدم مصطلح حريم في الإعلام الغربي، للإشارة إلى وجود علاقات جنسية مع نساء كثيرات، أساسها الخضوع لذكر مهيمن] ضمت ما يزيد على 100 خليلة. وقد اعتقل وبحوزته 3 أطنان من العملات النقدية التي أخفاها في دارته. وفي سياق آخر، جمع قائد الشرطة في “تشونغكينغ” مقتنيات متحفية خاصة احتوت على أعمال فنية ثمينة وبيوض ديناصورات.
إذن، لماذا يتفشى “مال الوصول” بقوة مفاجئة على نطاق واسع؟ يعود سبب ذلك إلى أن الإصلاحات التي طبقتها الصين لم تخفف من السلطة التي تتمتع بها الحكومة على الاقتصاد إلى الحد الذي يتكفل بتغييرها.
وفي ثمانينيات القرن العشرين، تمثل الدور الأساسي للمسؤولين العامين في التخطيط والقيادة، لكنهم صاروا مخولين أداء وظائف أخرى في الاقتصاد الرأسمالي المعولم مع الوصول إلى تسعينيات القرن الماضي. وتضم تلك الوظائف الجديدة استقطاب المشاريع الاستثمارية العالية الخطورة، واقتراض رأس المال وإقراضه، وتأجير الأراضي، والانخراط في أعمال الهدم والبناء بوتيرة محمومة. ووفرت تلك النشاطات كلها للمسؤولين مصادر جديدة للسلطة لم يكن ممكناً تخيلها في الماضي إبان وجود نظام اشتراكي.
يمكن رد التغيير إلى مشكلة غامضة ظاهرياً، تتمثل في اختلال التوازن المالي بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. إذ أعاد الرئيس جيانغ ورئيس الوزراء زهو في 1994، وضع العائدات الضريبية في يد السلطة المركزية، وذلك في سياق حملتهما التحديثية، ما أدى إلى الحفاظ على حصة الأسد داخل بكين [مركز السلطة]، وخفض قيمة الفتات الذي نالته السلطات المحلية. وتُركت الحكومات المحلية كي تعاني من صعوبات مالية حتى في الوقت الذين تعرضت فيه إلى ضغوط بهدف تشجيع النمو وتوفير الخدمات العامة. ولذا جرى العثور على مصدر بديل بهدف الحصول على دخل، متمثلاً في الأراضي. إذ تملك الدولة كل الأراضي في الصين، الأمر الذي يعني عدم إمكانية بيعها، لكن يمكن تأجيرها إلى من يرغب في استخدامها. وفعلاً، أتاحت بكين للحكومات المحلية تأجير حقوق استخدام أراضيها إلى كيانات تجارية وشركات، وذلك كي تحصل تلك الحكومات على إيرادات.
هل تشكل حملة الرئيس شي القمعية مجرد ذريعة في التخلص من أعدائه، أم أنها محاولة حقيقية ترمي إلى الحد من الفساد؟
ومنذ تلك اللحظة فصاعداً، مضى جيش المسؤولين المحليين الصينيين قدماً في الانخراط بمزيد من الأعمال المتعلقة بالتطوير الحضري، متخلياً عن التصنيع. ولم تعد الحكومات المحلية تعتمد على التصنيع كمحرك أساسي للنمو، بل وجهت اهتمامها إلى تأجير الأرض الزراعية إلى مطوري العقارات ذات الاستخدام السكني والتجاري. هكذا تنامت عائدات تأجير الأراضي في العقدين اللذين أعقبا سنة 1999، بأكثر من 120 مرة. وقد جنى المطورون أرباحاً كبيرة من تلك الترتيبات، إذ حصلوا على إيجارات باهظة بعد استئجارهم أراضي زراعية بأسعار متهاودة وتحويلها إلى مشاريع سكنية رائعة. وفي إحدى الحالات التي حدثني عنها أحد البيروقراطيين، ارتفعت ببساطة قيمة قطعة أرض 35 مرة بمجرد تحويلها من زراعية إلى أرض للاستخدام الحضري.
واستطراداً، استفاد المسؤولون الذين يسيطرون على حقوق استخدام الأراضي بصورة شخصية. إذ قبضوا عمولات كبيرة مقابل مساعدة أصدقائهم ومعارفهم في تأمين العروض الثمينة. وكذلك ساعدوا المطورين على التلاعب بالمزادات والفوز بقطع أراض بأسعار زهيدة عن طريق الغش. ووظفوا أيضاً سلطات الدولة في تسريع عمليات التمدن. وعمل الموظفون المحليون على نقل الفلاحين إلى شقق سكنية في الضواحي وذلك بهدف إخلاء الأراضي الزراعية، إضافة إلى أنهم استثمروا بكثافة في البنى التحتية الحضرية كالشبكات الكهربائية، والمرافق العامة، والمتنزهات العامة، والنقل، من أجل زيادة قيمة المباني المنشأة حديثاً.
ولم يقتصر تمويل مشاريع البنى التحتية الجديدة على بيع حقوق تأجير الأراضي فحسب، بل تضمن ذلك أيضاً استعمال القروض. وإذ يحظر القانون على الحكومات المحلية أن تتعرض لعجز في الميزانية، فقد التف المسؤولون على ذلك القانون من خلال إقامة شركات فرعية تُعرف باسم “وسائل التمويل الحكومي”. وحصلت تلك الكيانات على قروض هدفها توفير مبالغ من المال استخدمها المسؤولون فيما بعد في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الأخرى الخاصة بهم.
وفي المقابل، تولى ذلك المصدر المزدوج للائتمان المتمثل في تأجير الأراضي والاقتراض، مسؤولية تمويل طفرة الصين الهائلة في مجال البنى التحتية. وبين عامي 2007 و2017، زادت البلاد طول طرقها السريعة بأكثر من الضعفين، إذ ارتفع طولها من 34 ألف ميل إلى 81 ألف ميل (من 54.71 ألف كيلومتر إلى 130.35 ألف كيلومتر)، أي “ما يكفي للتنقل حول العالم أكثر من ثلاث مرات”، وفق ما يتباهى به موقع إلكتروني حكومي. وكذلك جرى إنجاز مشاريع إنشاء مترو الأنفاق بسرعة محمومة لا تختلف من حيث الحدّة عن ذلك الاندفاع المسعور في شق الطرق. وتفاخر الصين حالياً بأن لديها 8 من بين أطول خطوط مترو الأنفاق الـ12 في العالم.
من زاوية مقابلة، أفرزت طفرة البنية التحتية مخاطر لم تكن موجودة من قبل، على الرغم من أنها دفعت التوسع الحضري في الصين إلى الأمام بقوة. إذ راكمت الحكومات المحلية وأدواتها التمويلية، ديوناً متكدسة. ولذا، لم يعرف المنظمون المركزيون حتى عام 2011 المستوى الذي وصلته تلك الالتزامات. في تلك السنة، أنجزوا أول تدقيق عن الحسابات، فوجدوا أن الحكومات المحلية اقترضت نحو 1.7 تريليون دولار(1.22 تريليون جنيه إسترليني). وواصل الدين المحلي صعوده حتى وصل إلى 4 تريليون دولار (2.88 تريليون جنيه إسترليني) في 2020، وذلك على الرغم من صدور مراسيم متكررة من جانب بكين ضد الاقتراض. في ذلك الصدد، يلفت أن حجم ذلك الدين يعادل تقريباً إجمالي الدخل الذي حققته الحكومات المحلية في تلك السنة نفسها. ويشكل ذلك الفقاعة التي يخشى كثيرون من إمكانية انفجارها.
وبهدف فهم معنى المزاوجة بين النمو والفساد، من المستطاع تأمل حالة مسؤول اسمه جي جياني كي. إذ صار جياني في 2004 سكرتير الحزب في “يانغتشو”. وهناك أطلق حملة واسعة النطاق من الهدم والبناء بهدف إبراز المدينة كموقع تاريخي سياحي، ما عاد عليه بلقب “جي البلدوزر”. وقد نجحت تلك الجهود في تحقيق الغاية المرجوة منها. فأشادت وسائل الإعلام بما فعله جي في إعادة إحياء المدينة التي منحتها الأمم المتحدة أيضاً جائزة اعترافاً منها بمكانتها. وازدهرت السياحة. وحلقت أسعار العقارات الفاخرة عالياً. وتمت ترقية “جي البلدوزر” في 2010 إذ أسندت إليه وظيفة أرفع، هي محافظ “نانجينغ” عاصمة المقاطعة.
لكن، اكتشف المحققون في وقت لاحق أن جي حصل مباشرة على حصة من أرباح مخططاته الطموحة في التطوير الحضري. كان راتبه الرسمي ضئيلاً للغاية، شأنه شأن البيروقراطيين الصينيين الآخرين، لكنه عوض عن ذلك من المساهمات التي أتته من الشركات. وفي مدينة تشهد عمليات إعادة إعمار هائلة، عمل جي على إعطاء كل العقود الحكومية تقريباً إلى شركة إنشاءات خاصة تدعى “غولد مانتيس” يملكها بعض أصدقائه القدامى. وفي مقابل ذلك، أعطته تلك الشركة عمولات كثيرة. وبالتالي، تنامت أرباح الشركة خلال عهد جي في “يانغتشو” بمقدار 15 ضعفاً في مجرد ست سنوات، وكذلك حصل جي على نسبة مئوية من الأسهم حين عُرضت الشركة في الاكتتاب العام.
توحي قصة جي ومثيلاتها بأن تصوير الدولة الصينية على أنها مفترسة أو جشعة، لا يعبر عن الطبيعة الحقيقية لـ”رأسمالية المحسوبيات”. صحيح أن ذلك المسؤول [جي] ملأ جيوبه من مال الدولة، بيد أنه قد نجح فعلاً في تغيير “يانغتشو” وجعلها مدينة مختلفة. وفي العقود الأخيرة، ثمة عديد من أمثاله من القياديين الفاسدين ممن استطاعوا مع ذلك تحقيق إنجازات في ميادين التجارة، والبنى التحتية، والخدمات العامة. وعلى عكس سياسيين في دول أخرى ممن سرقوا ببساطة من الشعب أو وضعوا العراقيل في وجه رواد الأعمال، إذ قبض المسؤولون الصينيون الرشاوى من خلال تسهيل عمل الرأسماليين وليس بتعقيده عليهم.
واستطراداً، لا يعني أي من ذلك أن “مال الوصول” جيد بالنسبة إلى الاقتصاد. وعلى العكس، فإنه يشبه المنشطات التي تسبب نمواً مصطنعاً غير متوازن. ونظراً إلى تمتع المسؤولين الصينيين بسلطات تخولهم السيطرة على حق استخدام الأرض، أدى التواطؤ بين الشركات والدولة إلى توجيه قدر مفرط من الاستثمارات إلى قطاع معين، هو العقارات التي توفر مكاسب لا مثيل لها إلى أولئك للأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات سياسية واسعة. ونتيجة لذلك، تواجه الشركات الصينية حوافز تخريبية بهدف تحويل جهودها بعيداً عن النشاطات الإنتاجية، خصوصاً التصنيع، والإقبال على العمل في مجال استثمارات المضاربة. وبالتالي، يجد الآن بعض شركات السكك الحديد المملوكة للدولة ومقاولي قطاع الدفاع، أن نشاطاتهم الاستثمارية في العقارات مربحة أكثر من أعمالهم الأساسية. وتلاحظ بكين التهديد الذي ينطوي عليه ذلك التحول. وقد أصدرت في 2017 تحذيراً من “التخلي عن النشاطات الإنتاجية لمصلحة نشاطات أخرى استثمارية”.
في السياق نفسه، يفاقم “مال الوصول” التفاوتات الموجودة. وفي عالم الأعمال، يستطيع الرأسماليون ممن تربطهم علاقات وثيقة بالسياسيين أن يحصلوا بسهولة على عقود حكومية، وقروض رخيصة، وأراض بأسعار مخفضة، ما يجعلهم يتقدمون على منافسيهم. وكذلك يتمكن فائقو الثراء في المجتمع ككل من اقتناص شقق سكنية فاخرة كي يتخذوها عقارات استثمارية يستفيدون منها. وفي غضون ذلك، يبقى الإسكان الحضري بعيد المنال بالنسبة إلى الصينيين العاديين ممن لا يستطيعون تحمل تكلفته العالية. وبالنتيجة، ينشأ وضع غير صحيح إذ تمتلك أقلية من الصينيين بيوتاً لا تسكنها في غالبية الأحيان، فيما تحتاج غالبية الصينيين إلى بيوت لا تستطيع تحمل تكلفتها.
شي يدخل الميدان
تسلم شي في عام 2012 زمام القيادة في ظل ظروف تنذر بالسوء. وآنذاك، واجه الحزب أسوأ فضيحة سياسية له منذ جيل كامل. فقد تقرر طرد بو شيلاي من مناصبه كلها على أن يجري اعتقاله قريباً بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة. ولم يكن بو سوى بطل تلك الفضيحة، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب، بل اعتُبر في وقت من الأوقات مرشحاً للمنافسة على أرفع منصب في البلاد. لذا، لم تكن تلك مجرد فضيحة فساد كأي واحدة أخرى، خصوصاً أن بو نجل زعيم بارز في الحزب الشيوعي الصيني، ومتورط في مقتل رجل أعمال بريطاني، وقد أشيع أيضاً أنه عمل على تدبير انقلاب ضد الرئيس شي.
ومن المؤكد أن ذلك الحدث الدراماتيكي قد أسهم في رسم معالم رؤية شي للعالم، وأضفى عليه إحساساً عميقاً بعدم الأمان لا يقتصر على مسألة مستقبل الحزب، بل يشمل أيضاً بقاءه هو بالذات. فقد كشفت وقاحة بو للرئيس شي أن “مال الوصول” في اقتصاد من الحجم الفائق الضخامة قد خلق مجموعات نخبوية أقوى بكثير من الفئات المماثلة التي اضطر أي زعيم سابق إلى التصدي لها. وكذلك شكل سقوط بو بالنسبة إلى عامة الصينيين، نافذة أطلوا منها على عالم التواطؤ بين الشركات الحكومية وأنماط الحياة الفارهة التي تتمتع بها النخب السياسية.
وحينذاك، بدا من الواضح أن الصين تغص بالفساد، واللامساواة، والانحلال الأخلاقي، والمخاطر المالية. من جهة أخرى، لقد انتشل الحزب بنجاح ما يقدر بـ850 مليون شخص من الفقر منذ بدأت إصلاحات دينغ، بفضل النمو الاقتصادي المستدام. في المقابل، استفادت أقلية صغيرة من التطورات بشكل غير متناسب، لا سيما أولئك الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية كي يتحكموا بقطاع العقارات. وفي 2012، “مُعامِل جيني” Gini coefficient الصيني، (عبارة عن معيار يقيس عدم المساواة في الدخل، يمثل فيه الصفر مساواة تامة والواحد تبايناً تاماً) إلى 0.55، متجاوزاً تلك الموجودة في الولايات المتحدة التي تبلغ 0.45. وبالتالي، شكل ذلك تميزاً صارخاً في دولة شيوعية نظرياً. وقد وصف لي رجل أعمال في شانغهاي الصدمة، “في صغري، حاولت الكتب المدرسية أن تقنعنا بأن الرأسمالية تعاني الانحطاط من خلال إبراز صور الحيوانات الأليفة التي يربيها الأميركيون وهي تتمتع بمكيفات الهواء، وتلك رفاهية لا تحلم بمثلها سوى قلة قليلة من الصينيين في تلك الأيام. أما حاضراً، فإن كلب جيراني لا يشرب سوى مياه “إيفيان” المعدنية”.
إذن، لا عجب في أن شي قد اختار أن يحدد معالم الإرث الذي سيتركه من خلال خوض معركتين رئيستين، إحداهما ضد الفساد، والأخرى في مواجهة الفقر. وبذا، لم يحاول شي التستر على التهديد الذي تمثله قصة بو الطويلة، بل أعلن في أول خطاب ألقاه أمام المكتب السياسي أن “الفساد سيجلب نهاية الحزب والدولة”. ومنذ ذلك الوقت، قد أطلق شي حملة تهدف إلى مكافحة الفساد تعتبر الأكبر والأوسع نطاقاً في تاريخ الحزب. وكذلك أُخضِعَ نحو 1.5 مليون مسؤول لإجراءات تأديبية بحلول 2018، ما يشكل رقماً مذهلاً. وعلى خلاف حملات مكافحة الفساد السابقة، لم تقتصر حملة شي على إماطة اللثام عن فساد مسؤولين من المستويات العادية أو المتدنية، بل تشمل فضح الفاسدين من مسؤولين رفيعي المستوى، أو الكشف عن “الذباب” و”النمور”، وفق تعبير شي نفسه.
يحيي شي نظام القيادة في إطار محاولته إنهاء “رأسمالية المحسوبيات”
هل تعتبر حملة الرئيس الحالي مجرد ذريعة للتخلص من أعدائه الحقيقيين أم أنها تأتي في سياق جهد حقيقي هدفه تقليص الفساد؟ الجواب، إن شي أراد تحقيق هذين الهدفين. ولن يكون من المستغرب أن يستغل شي تلك الحملة كي يستأصل أولئك الذين يشكلون تهديداً شخصياً بالنسبة له، بمن فيهم أولئك المسؤولون الذين قيل إن لهم علاقة بمؤامرة ترمي إلى إطاحة حكمه. في المقابل، لقد شرع أيضاً في تعزيز أخلاقيات العمل لدى الموظفين الإداريين، فنشر قائمة تضم ثماني قواعد تحظر
“الإسراف وممارسات العمل غير المرغوب فيها” على غرار تناول الكحول أثناء الدوام. وجاءت حملته تلك شاملة بشكل ملفت. إذ تجاوزت المكاتب العامة كي تطال الشركات المملوكة للدولة والجامعات وحتى وسائل الإعلام الرسمية. ويوحي الهبوط المفاجئ في بيع السلع الكمالية الفاخرة في أعقاب انطلاق تلك الحملة، بأن الرشوة والاستهلاك الصارخ قد تعرضا إلى الكبح بشكل مؤقت. من زاوية أخرى، جاءت طريقة تقبل الصينيين لما يجري، مختلطة. ففيما يشعر كثير من المواطنين بالإعجاب حيال حملة القمع الفاعلة، يحسّ آخرون بالإحباط بسبب هول التفاصيل البشعة عن مدى تغول الجشع، التي كشفت عنها تحقيقات الفساد تلك. علاوة على ذلك، لعل الحملة لم تفعل شيئاً كثيراً على صعيد معالجة اللامساواة. إذ انخفض معيار “معامل جيني” في البلاد بشكل مستمر منذ باشر شي مهامه الرسمية في نوفمبر(تشرين الثاني) 2012 وحتى 2015 ، لكنه عاود الارتفاع مجدداً، ووفق الإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية.
وفي سياق متصل، من السابق لأوانه القول، إن الحملة التي أطلقها شي قد خفضت بشكل كبير من انتشار “مال الوصول”. مع ذلك، هناك نقطتان واضحتان ينبغي ذكرهما، أولاهما أن تلك الحملة الصارمة قد وضعت المسؤولين في حالة تأهب قصوى. وفي سياق دراستي التحليلية عن مجموعة مؤلفة من 331 رئيساً حزبياً في المدن، خلصتُ إلى أن 16 في المئة منهم قد أُقيلوا بسبب الفساد بين عامي 2012 و2017، وتلك نسبة عالية من شأنها أن تشكل سبباً كافياً في حمل القادة المحليين على تجميد فسادهم. وتتمثل النقطة الثانية في أن المؤشر الوحيد على نجاة مسؤول ما من العقوبة في سياق حملة مكافحة الفساد، يتجسد في نجاة رعاته، من قياديين أرفع مستوى يعود إليهم الفضل في حصوله على منصبه، من المساءلة أيضاً. لم يلعب الأداء دوراً كبيراً في التقييم، ما يوحي أن النظام السياسي في ظل شي يميل إلى أن يعتمد على النواحي الشخصية أكثر من اعتماده على القواعد.
وباختصار، لقد حققت الحملة نتائج مختلطة. إذ نجحت في بث الرعب في قلوب المسؤولين الفاسدين، غير أنها لم تستأصل الجذور العميقة للكسب غير المشروع ، الكامنة تحديداً في السلطة الجبارة التي تستطيع الحكومة أن تمارسها على الاقتصاد، وأيضاً في نظام المحسوبيات السائد في البيروقراطية الصينية.
الطريق الذي لم يُتبع
لا توجد الصين في فراغ بالطبع. إذ يفصلها المحيط الهادي عن الولايات المتحدة، منافستها الرئيسة التي تعاني أيضاً “عصراً مُذّهباً” خاصاً بها. وكذلك فإن التكنولوجيا الحديثة التي تسعى الولايات المتحدة هذه المرة إلى السيطرة عليها، ليست قوة البخار [على غرار ما كانه الحال في أواخر القرن التاسع عشر، إبان بداية الرأسمالية الصناعية أميركياً]، بل الخوارزميات، والمنصات الرقمية، والابتكارات المالية. وتعاني الولايات المتحدة، شأنها شأن الصين، من عدم المساواة الحادة بين سكانها. وكذلك تخشى حكومتها رد الفعل الشعبوي المتأتي من أولئك الخاسرين في سياق نظام العولمة، إضافة إلى أنها تصارع مثل الصين، من أجل توفيق التوترات بين الرأسمالية ونظامها السياسي. وفي ذلك المعنى، يشهد العالم هذه الأيام منافسة بين القوتين الأعظم، لا تتجلى على شكل صراع حضارات، بل صراع بين عصرين مُذّهبين. وتكافح كل من الصين والولايات المتحدة لوضع حد لتجاوزات “رأسمالية المحسوبيات”.
بيد أن كلاً من البلدين يمضي في اتجاه تحقيق ذلك الهدف بطريقة مختلفة عن الآخر. لقد شكلت تفويضات الشفافية، والتلاعب بالصحافيين، والمحققين الذين لا يقف في طريق حماسهم أي شيء، شكلت جميعها العلامات الفارقة في مرحلة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة إبان “المرحلة التقدمية” ضد الكسب غير المشروع. أما اليوم، فتعتمد أجندة الرئيس بايدن التقدمية على استعادة نزاهة الديمقراطية. ومن زاوية موازية، اختار الرئيس شي القضاء المبرم على اللامساواة والفساد من خلال تشديد قبضة التحكم السياسي.
وأخذت الجهود الرامية إلى تنفيذ التعهد الذي قدمه شي باجتثاث الفقر في الريف شكل الحملة الوطنية. وفرض الممسكون بالتخطيط المركزي أهدافاً صارمة على المسؤولين المحليين، وجرى تحشيد البيروقراطية بأكملها، وأيضاً المجتمع ككل، بهدف تحقيق تلك الأهداف، مهما كلف الأمر. وعلى الرغم من نبل الأهداف، فإن الوسائل تشكو من التطرف. وتشكل المراسيم التي تصدر عن الجهات العليا ضغوطاً على كبار المسؤولين المحليين كي يحاولوا القضاء على الفقر بأمر من المراجع الرفيعة المستوى. ومثلاً، قد يكون ذلك عبر نقل ملايين السكان من مناطق نائية إلى الضواحي، بصرف النظر عما إذا كانوا هم يريدون الانتقال. ويعيش بعض أولئك المهجرين حالياً من دون أرض زراعية وبلا وظيفة أيضاً.
وبالمثل، تعمل الحملة التي لا تعرف التهاون ضد الفساد من القمة إلى القاعدة. وإضافة إلى اعتقال أعداد كبيرة من البيروقراطيين الفاسدين، حث شي المسؤولين على إثبات الولاء والالتزام بأيديولوجية الحزب. وتمخضت تلك الإجراءات عن تقاعس وشلل دب كلاهما في الجسد البيروقراطي، أو الحالة التي يسميها الصينيون “الحكم الكسول” التي تنشأ حين يختار المسؤولون الخائفون عدم فعل أي شيء كي يتفادوا اللوم والمسؤولية، بدلاً من طرح مبادرات يمكن أن تكون مثيرة للجدل. ويؤدي إصرار شي على الصواب السياسي إلى القضاء على ردود الفعل الصادقة من جانب البيروقراطية. ومثلاً، ربما أسهمت خشية المسؤولين من نقل الأنباء السيئة إلى عدم استجابة الصين باكراً لتفشي كوفيد- 19.
لم يكن محتماً أن تجري الحملة بذلك الشكل. وكان في استطاعة الصين أن تسلك طريقاً آخر في السيطرة على الفساد. وقبل وصول شي إلى سدة السلطة، أحرزت الصين تقدماً مضطرداً باتجاه الحكم المنفتح. وكذلك عملت بعض الحكومات المحلية على تعزيز الشفافية، وبدأت في التماس مساهمة الشعب لإغناء تلك السياسات. وعلى الرغم من قيود الرقابة، كشفت صحف استقصائية كـ”شايشين” و”ساوثرن وييك إند” بانتظام عن فضائح أدت إلى الإسراع بإجراء إصلاحات. وقد جربت مناطق شتى الإبلاغ عن ممتلكات مسؤولين حكوميين ومداخيلهم، وتلقت تلك الخطوات دعماً من قبل ناشطين قانونيين. وفي 2012، درس المسؤولون المركزيون عن التشريع تحويل تلك التجارب قانوناً وطنياً. من جهة أخرى، ما إن بدأت حملة الرئيس شي في مكافحة الفساد، حتى قُضي على تلك الجهود الصاعدة من القاعدة إلى القمة، وشددت الحكومة قبضتها على المجتمع المدني.
أدى نهج مركزية السلطة الشخصية الذي اتبعه شي إلى وضعه في موقع استثنائي من حيث القدرة على تحدي المصالح المكتسبة من قبل بعض الأفراد، ودفع عجلة الإصلاحات الصعبة إلى الأمام. وكذلك امتلك القدرة في تقليل احتكار المؤسسات المملوكة للدولة وتمكين الشركات الخاصة التي يعود إليها الفضل بدءاً من 2017، في توفير ما يزيد على 90 في المئة من الوظائف الجديدة. إذ يستطيع قطاع خاص قوي أن يسرع في تحقيق نمو من النوع الموسع على نطاق عريض، يحد من عدم المساواة. في نسق موازٍ، يستطيع شي أن يصحح الخلل في التوازن المالي بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بحيث لا تجد تلك الأخيرة نفسها مضطرة إلى تأجير الأراضي واقتراض المال كي توفر الإيرادات اللازمة لها. وكذلك يستطيع أن يجعل الطلبات المتضخمة التي يفرضها المخططون المركزيون على الحكومات المحلية أكثر بساطة. ومن شأن ذلك الإجراء أن يقلل من حاجة تلك الحكومات إلى ممارسة سلطات تنظيمية وتشريعية من جهة، ويخفف من الضغوط المالية التي تعاني منها من جهة ثانية.
مع ذلك، فقد أظهر شي قدراً ضئيلاً من الاهتمام بمثل تلك الإصلاحات. وبدلاً من ذلك، عمد إلى إحياء نظام القيادة ضمن محاولته وضع حد نهائي لـ”رأسمالية المحسوبيات”، علماً أن ذلك هو النهج نفسه الذي فشل فشلاً ذريعاً في ظل ماو تسي تونغ. يبدو الرئيس شي مقتنعاً الآن أكثر من أي وقت مضى، في أعقاب نجاحه في السيطرة على تفشي كوفيد- 19، بأن التعبئة الوطنية والأوامر التي تعطيها القمة للقاعدة في ظل قيادته القوية، تمثلان معاً السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام. إلا أن رفض شي للنهج التصاعدي من القاعدة إلى القمة، من شأنه أن يخنق قدرة الصين في التأقلم وريادة الأعمال، مع الإشارة إلى أن تلك كانت المواصفات نفسها التي ساعدت البلاد في شق طريقها وتجاوز عدد من العقبات، عبر سنوات مديدة. وذات مرة، نقل لي أحد المسؤولين، أن الأمر يشبه “قيادة دراجة هوائية. كلما شددت قبضتك على المقود، صار تحقيق التوازن أكثر صعوبة”.
المصدر: فورين أفيرز/ اندبندنت عربية