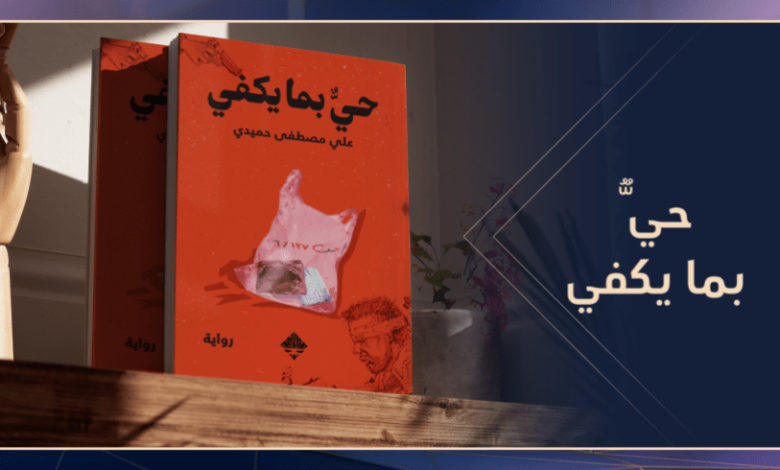
حيٌّ بما يكفي.. لعله العنوان الأكثر مباشرة للموجوعين، في واحدة من الأعمال اللافتة، التي ولدت من رحم الثورة، في إضاءة على أحد أهم فصول التجربة السورية نحو التحرر، قدمها الكاتب علي مصطفى حميدي، كوثيقة أدبية وإنسانية، ومرآة لأحداث عاشتها البلاد، في رواية ليست كسيرة شخصية وحسب، بل شهادة جماعية، تعبر عن أجيال عاشت داخل المعتقل الكبير، الذي مثله نظام الأسد لعقود، وإن كانت القصة تنطلق من مصير بطل واحد، هو عز الدين درويش، إلا أنها مرآة تتجاوز الفرد لتصف ملامح وطن كان يعاقب على الكلمة.
تكتسب الرواية أهميتها من كونها كُتبت في مرحلة لا تزال فيها الذاكرة مفتوحة، فالكاتب لا يستعيد الماضي ليتاجر به، بل ليعيد فهمه، بدأت مع كلماتها الأولى كزلزال يهز المشاعر، برحلة نجاة عز الدين من أقبية الموت، من معتقله ومعتقليه، ليواجه الحياة التي غيب عنه، والمجتمع الذي تبدل، وتغير في العمق، سطرها الكاتب كأحداث تدور في فضاء يربط بين الماضي والحاضر الجديد، بين زمن القمع والخوف والتعذيب، وزمن ما بعد النجاة، من خلال رحلة البطل في البحث عن أسرته المفقودة، وعن معنى الحياة بعد السجن، لتتحول الرواية إلى تأمل في طبيعة التغيير الاجتماعي والنفسي الذي أصاب السوريين، أي أن الرواية لا تقدّم بطلا بالمعنى التقليدي، بل إنسانا مثقلا بالذكريات والتردد، بما يمثل النموذج الواقعي للسوري الذي خرج من تجربة الاعتقال محملا بآثارها النفسية، يحاول فيها التكيف مع واقع مختلف، ولذلك فإن الرواية ليست عملا بكائيا ولا انتقاميا، بل بحث في كيفية تشكل الوعي بعد انكسار، في تداخل واضح بين السرد الشخصي والسياق العام، فحين يصف الكاتب تفاصيل الاعتقال، أو الخوف من العيون التي كانت تراقب، لا يهدف إلى التأثير العاطفي، بل إلى توثيق حالة اجتماعية عاشها ملايين السوريين، في أسلوب يمنح الرواية بعدا واقعيا، يجعلها أقرب إلى الذاكرة الجمعية منها إلى الخيال الفني، في لغة هادئة وواضحة، تخلو من الزخرفة، وتستمد جمالها من دقتها، في حوار ووصف مختصر، إلا أنه كاف لخلق المشهد، فيمكن القول إن الكاتب استخدم أسلوب الاقتصاد في التعبير، ليترك مساحة للأحداث أن تنطق بنفسها. وهذا ما يجعل الرواية مقروءة بسلاسة رغم مضمونها الثقيل.
لماذا من المهم قراءة الرواية مرة أخرى؟
من الملامح الفكرية البارزة في الحكاية أنها تنظر إلى التحرير ليس بوصفه لحظة سياسية، بل تجربة إنسانية معقدة، فخروج المعتقلين لا يعني بالضرورة انتهاء أثر الاعتقال، فالحرية هنا ليست حدثا يمكن تجاوزه بسهولة، بل حالة داخلية تحتاج إلى وقت كي تتحقق، فعز الدين بعد الإفراج عنه، وجد الخوف يرافقه في تفاصيله الصغيرة، في عيون الناس ونظراتهم، في صمت الشوارع، وفي الحلم، في ارتباك يصوره الكاتب بدقة، ليذكر القارئ بأن آثار الاستبداد لا تزول بسقوط الأنظمة، بل تحتاج إلى معالجة طويلة، وإلى وعي جماعي يعيد تعريف الأمان وبناء الثقة، لتقدّم الرواية تأملا مهما في مسار التحول السوري، من دولة الخوف إلى مجتمع يحاول ترميم ذاته، وهي بهذا تساهم في صياغة سردية جديدة، كُتبت في مرحلة لا تزال فيها الذاكرة مفتوحة، لكنها لا تعتمد على البطولة أو المظلومية، بل على الاعتراف، والتعلم من التجربة.
قراءة للماضي بعيون الحاضر
في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد، تبرز (حيّ بما يكفي) كأحد النصوص التي تساعد على قراءة الماضي بعيون الحاضر والمستقبل، فهي تنتمي إلى الأدب السوري الذي كتب في وسط الصراع، إلى شكل جديد من الكتابة التي تضع الإنسان في المركز، بهذا المعنى يمكن النظر إلى الرواية كجزء من التحول الثقافي في سوريا الجديدة، حيث لم تعد الحرية شعارا، بل موضوعا للتفكير، فهي تطرح السؤال الذي يواجه المجتمع بعد التحرير، كيف نتحول من ضحايا إلى مواطنين؟
ولعل أهمية الرواية تكمن في أنها لا تقدّم أجوبة جاهزة، بل تترك الباب مفتوحا أمام التأمل. إنها تذكر بأن إعادة بناء البلاد لا يقتصر على الحجر، بل تشمل إعادة بناء الذاكرة والشخصية، فهي متماسكة في بنيتها، صادقة في لغتها، واقعية في رؤيتها. لا تبحث عن الإثارة، بل عن الفهم، تقرؤها فتشعر أنك أمام تجربة صاغتها سنوات من المعاناة والتفكير، لا مجرد خيال أدبي، في عمل قد يتجاوز السلطة إلى الإنسان الذي عانى منها ويبحث عن تجاوزها، ليشكل الكاتب إضافة حقيقية إلى المشهد الثقافي السوري، ليخرج القارئ من الرواية إلى الحقيقة، وهو يدرك بأن عنوانها ليس مجرد استعارة، بل خلاصة لتجربة جيل كامل، ليقول: لقد بقينا أحياء بما يكفي لنروي ما حدث ولنبدأ من جديد.
كم يشبهني علي حميدي وكم نشبه عز الدين، فلا يعرف قيمة التحرير كقيمة إنسانية ووجدانية كالذين تذوقوا مرارة أربع عشرة سنة من الصبر والفقد، وعايشوا المرحلة بتفاصيلها، بجزئياتها، بأحلامها، بانتشائها وانكساراتها، نحن من عانى من عجز الآباء وخوفهم، ومن حنين الأمهات وانكسارهن، نحن من نفهم الفجوة بين من عاشوا السجن والقمع والتهجير، وبين من عرفوا التحرير بوصفه نتيجة لا تجربة، وهذه الرواية لأنها كتبت من داخل التجربة فهي تستحق أن تكون وثيقة، وخريطة لتشرح لنا من أين جئنا؟، ولماذا كنا نرتجف من أشياء تبدو تافهة اليوم، وكأداة تربط الذاكرة بالواقع الجديد، ولتقول أنا جزء من معركة الوعي لا من معركة السياسة، ومعركة الإنسان وكيف يصنع من نجاته فرصة لخلق عالم مختلف، وقدرته على إعادة تشكيل العلاقة بينه وبين تاريخه، بين الماضي ورحلة التعافي، إلى مستقبل يروي حكايته بجرأة، ويراكم وعيه ليبدأ من جديد على جناحي الذاكرة والحرية.
شكرا عز الدين درويش
شكرا علي حميدي
المصدر: موقع تلفزيون سوريا








دعوة موضوعية لإعادة قراءة رواية “حي بما يكفي” للكاتب “علي مصطفى حميدي” كإحدى روايات ولدت من رحم الثورة ، بما تضمنته من صور عن التحرير ومعناه النفسي والجسدي وخاصة معتقلات صدمايا وغيرها .