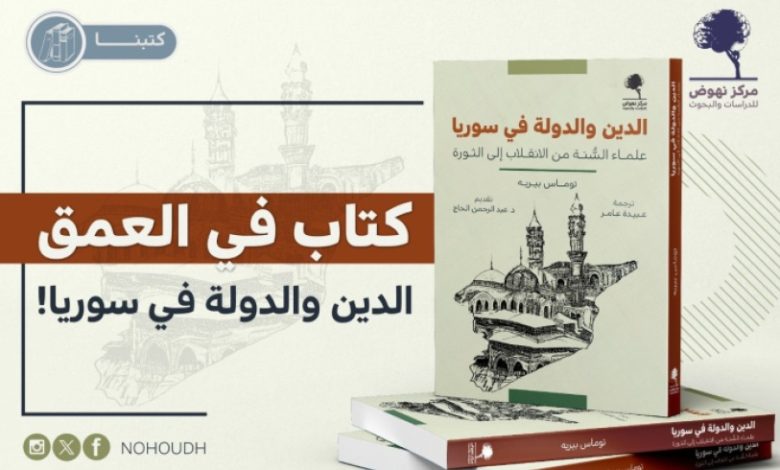
يستحق كتاب توماس بيريه «الدين والدولة في سوريا» أن يصبح بسرعة مرجعاً معتمداً في مجاله. وأن تصدر له ترجمة مدققة، بتوقيع عبيدة عامر، بعد أن ظهر، قبل ثلاث سنوات، بترجمة أولى بدت غير مرضية. خاصة بالنظر إلى أهمية موضوعه وغزارة معلوماته وبحثه المستفيض وملاحظاته الميدانية الحاذقة والذكاء الذي وسم تحليلاته. أصل الكتاب أطروحة لنيل الدكتوراه أنجزها الباحث بإشراف المستعرب الشهير جيل كيبل. وقد صدر بالفرنسية في عام 2011. ونشرت جامعة كامبريدج ترجمته إلى الإنكليزية في عام 2013، مما أتاح للمؤلف إضافة فصل يتابع تحولات موضوعه بعد الثورة السورية. أما الآن فقد صدر بالعربية مجدداً، في تشرين الثاني الفائت، عن «مركز نهوض للدراسات والبحوث» بالكويت، بعنوان فرعي هو «علماء السنّة من الانقلاب إلى الثورة».
يرصد الكتاب تطور أشكال جديدة من أنظمة التعليم رداً على التغريب الذي فرضته الحداثة، مما دفع الشيوخ إلى النظر إلى التعليم بوصفه السلاح الأهم في الصراع الثقافي. وبعد مرحلة من التراجع والظلام في أواخر العهد العثماني برزت، في دمشق على وجه الخصوص، معالم ما عُرف بالنهضة العلمية، على يد تلاميذ الشيخ بدر الدين الحسني. فتأسست «الجمعية الغرّاء» التي حاولت إنشاء شبكة من المدارس المسلمة على غرار مدارس الأبرشيات المسيحية. وفي سياق مواز ظهرت المعاهد الإسلامية الحديثة التي تولت تأهيل علماء البلاد وفق أنظمة تعليمية معتمدة حكومياً، وأبرز أمثلتها في الشمال «المدرسة الخسروية» التي سمّيت «أزهر حلب». وأنشأ بعض الشيوخ الأكثر تقليدية معاهد دينية خاصة لا تعتمد على الدولة في تمويلها ولا في مستقبل خرّيجيها، كالمدرسة «الشعبانية» ذات الصلة الوثيقة بالوسط التجاري المديني الحلبي، و«الكلتاوية» التي تعنى أكثر بريفها وبأبناء عشائره طلاباً وجمهوراً مستهدفاً. في حين سعت «جماعة زيد» الدمشقية إلى تحويل المسجد إلى جامعة باستقطاب دراسي العلوم الحديثة لتزويدهم بمقررات شرعية منظمة منهجياً.
أدت الانتفاضة الإسلامية المسلحة، التي وقعت بين أعوام 1979-1982، إلى تأثيرين متناقضين. فمن جهة نتج عنها استئصال بعض البيئات المشيخية التي تداخلت معها بشكل جذري، مثل «جماعة أبي ذر» المرتبطة بآل البيانوني في حلب. ومن جهة أخرى دفعت نظام حافظ الأسد إلى محاولة السيطرة على المشهد الديني عبر تعزيز الشبكات التي أبدت ولاءها المضمون له في أثناء أزمته. على رأس هؤلاء كان المفتي أحمد كفتارو وآل الفرفور مشايخ «معهد الفتح الإسلامي» الذي اتسع نشاطه وأهميته في دمشق. ثم نجح النظام في استقطاب محمد سعيد رمضان البوطي الذي اشتهر ككاتب جمع بين العلم الديني والفكر الحديث ولعب دوراً وسيطاً بين السلطة والمشيخة، قبل أن يحتل هذا المكان مفتٍ جديد ذو سيرة طموحة ومتعرجة هو أحمد حسون.
لم يكن مضمون هذه الإحيائية الإسلامية إصلاحياً بل تقليدياً تقريباً. ففي داخل المجال الديني كانت أقرب إلى تيار صوفي ينتمي إلى الطريقتين الشاذلية والنقشبندية أساساً، انسحب من العرفانية إلى الأخلاقية بتأثير صراعه مع السلفية التي كانت قوية رغم قلة عددها، وتلقت فرصة عرض أفكارها عبر التقنيات الجديدة كالإنترنت والأقراص المدمجة والفضائيات، متجاوزة المنع الرسمي الذي ساهم المشايخ في تعزيزه قبل أن يصبح توجهاً عالمياً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول. ومن طرف آخر بدت تقليدية هذا التيار الشرعي العريض في مواجهة دعوات تحديث، بدرجات متفاوتة، خرجت من داخله؛ سواء بالتجديد المثير للجدل الذي طرحه محمد حبش، أو اللاعنف الذي كان رسالة جودت سعيد المركزية، أو الإصلاح السياسي الذي دعا إليه معاذ الخطيب، سليل عائلة شيوخ الجامع الأموي.
كما لعب العلماء دوراً أساسياً في النمو غير المسبوق للرعاية الاجتماعية من خلال الجمعيات الخيرية التي أسست بالتوازي مع المدارس، واستندت إلى العلاقة الوثيقة بين المشايخ والتجار. وهو عامل لا تملك الدولة سيطرة كبيرة عليه، فقد كانت الفئتان متداخلتين وتتشاركان كثيرا من الخلفيات الاجتماعية والثقافية. وقد شهدت البلاد نهضة لدور الجمعيات الخيرية الأهلية بعد تبني «اقتصاد السوق الاجتماعي» وسياسات الانفتاح في العقد الأول من حكم بشار الأسد. وفي هذه المرحلة برزت «جماعة زيد» التي فرضت نفسها بفعل ما تملكه من علاقات في أجواء الطبقة الوسطى بدمشق. ولم يكن هذا التحول بعيداً عن تزايد القوائم التي تضم رجال الأعمال المرشحين لانتخابات «مجلس الشعب» الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على دعم المشايخ وجمهورهم. وفي الوقت نفسه أعطى النظام الضوء الأخضر لتأسيس المصارف وشركات التأمين الإسلامية بعد عقود من الاقتصاد الاشتراكي البعثي المضبوط مركزياً.
وفق عامل آخر يجب التمييز بين فئة المشايخ التي وجدت تمثيلها في «رابطة العلماء» وبين الناشطين الإسلاميين الذين أسسوا الفرع السوري لجماعة الإخوان المسلمين. يمكن وصف الأداء السياسي للمشايخ على أنه قطاعي لأنه يهدف إلى التأثير في سياسات الدولة في قضايا تعدّ مهمة من وجهة نظر نخبة فئوية بعينها دعماً لأجندة محافظة تتبدى في مطالب أخلاقية ودينية وتعليمية وعند اللزوم، في حين تُعنى الحركات الإسلامية بشؤون السياسة والاقتصاد والشؤون الخارجية بشكل دائم. وقد مرّت العلاقة بين الطرفين الإسلاميين ومواقفهما ببعض التباينات، قبل أن يوحّد بينهما الخطر الجذري الذي شكّله استيلاء حزب البعث على السلطة وحكمه بطريقة عسكرية تقوى تدريجياً. ومنذ 1964 تكررت حوادث الصدام بين التحالف الديني العريض من العلماء والإخوان وبين الحكم العلماني الذي يتحدر من الأرياف وربما من الأقليات.
لم تنفرج العلاقة بين المشيخة وبين السلطة بشكل ملحوظ بوضوح إلا في السنوات الأولى من حكم بشار الأسد. غير أن هذا المسار انتكس اعتباراً من عام 2008 بسلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى إخضاع النخبة الدينية والحد من تأثيرها في قطاعات اجتماعية متنوعة وفي مجال التعليم الديني والعام. سيُقطع ذلك بشكل مفاجئ مع اندلاع الاحتجاجات في البلد في آذار من عام 2011.
ففي المدن الثائرة، كدرعا وحمص وبانياس، انضم العلماء البارزون إلى المظاهرات وربما كانوا في صدارتها. لكن الأمور التبست في دمشق وحلب، حيث لم تتحمس البرجوازية السنّية للانتفاضة، فتوزعت استجابات العلماء على طيف واسع من المواقف من الولاء حتى التمرد. كان الأكثر غرابة هو تماهي البوطي مع الرواية الرسمية وإصراره عليها رغم تزايد القمع واستباحة الجوامع وقصف المآذن. في حين أيد مشايخ «جماعة زيد» من آل الرفاعي الحراك المعارض ودافعوا عن تلامذتهم الذين شاركوا فيه. وكذلك كانت حال عدد من العلماء الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد في النهاية، ليلتقوا مع نظرائهم المنفيين منذ عقود الذين شعروا أن فرصة عودتهم باتت قريبة فشاركوا في الدعم الخارجي للثورة في المجالات السياسية والإعلامية والإغاثية ثم العسكرية.
الكتاب زاخر بالتفاصيل الدالة والأوصاف الدقيقة لرسم خريطة شديدة الغنى للبيئة المشيخية كما تجلت في دمشق وحلب. وإن كان هناك من نقد يمكن توجيهه فهو عدم ربط سلوك المشيخة الدمشقية مع طبيعة حاضنتها السكانية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق، والأمر ذاته بشأن حلب. أما غياب المدن السنّية الأخرى عن التحليل، كحماة وحمص، فقد برره المؤلف بعدم تميز النخب الدينية فيهما عن العاصمتين، فضلاً عن عدم تعافيهما من آثار ضربة البيئة الدينية في الثمانينات. هذا التشابه صحيح إلى درجة كبيرة في حالة المنطقة الوسطى لكنه ربما كان أقل انطباقاً على مدن المنطقة الشرقية حيث حكمت السيرة الدينية والعلمائية سياقات مختلفة جزئياً. غير أن استكمال ذلك، رغم ضرورته للتعبير عن الإسلام السوري بكليّته دون الانجرار إلى المركزية، مهمة أوسع من قدرة باحث واحد قدّم كتاباً ممتازاً بالتأكيد.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا







