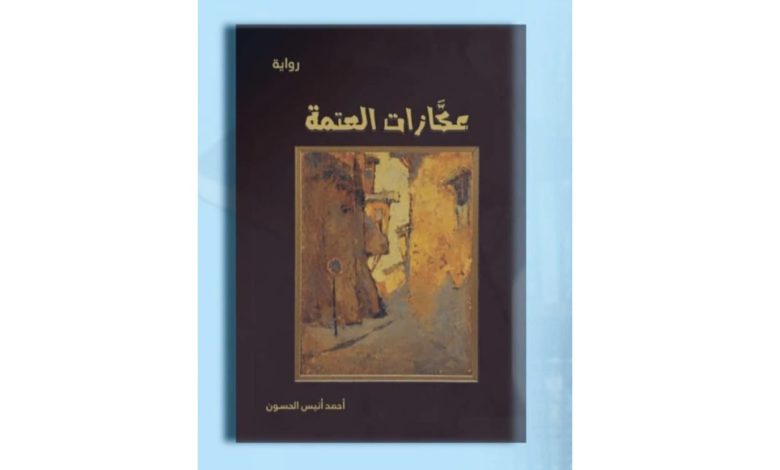
(عكازات العتمة)سرد يسند الضوء ماذا أريد من الروائي؟ أن يحكي لي الحكايا؟ أو يأتي بموضوع جديد غير مطروق ؟ أو أن يصف لي حالات متعددة تصدمني وتبكيني وتفرحني؟! إذا كان الأمر كذلك فإنّ عين الكاميرا لأكفأ منه والتقنيات الحديثة لأجدى وأقدر. نحن بحاجة إلى عقل محتج على كل النصوص المسطحة. أدّعي أن كل رواية إذا لم يكن مخزونها الفكري يسبق محتواها السردي بمئة سنة ضوئية فلن تكون قادرة على اختراق الزمن ولن تُعمّر طويلاً بل ستظهر كالفلاشة الضوئية التي تنتهي بعد أن تلتمع. وهنا طبعاً لا أقصد الإيديولوجيه إطلاقاً بل العمل الفني المتكامل بكل أبعاده، فكل جملة في الرواية إن لم تكن مُحمّلة بجدية الإبداع ومُنزّلة كحبة الماس في الحلية الثمينة فإنها ستسقط في المجانية والإفلاس . تبدأ رواية الدكتور احمد الحسون( عكازات العتمة) برجل النافذة الذي يغريك بكتابة قصيدة بعد ذلك يأتي السبك في تشابكات الرواية وتبدأ دمشق في الظهور بثوبها المهتريء وذلك من خلال وصف الشرطي وبيته ثم مقهى أم فواز وتغلغل الإيراني في مفاصل البلد. والحقيقة ان كل شخص من شخوص الرواية يجهز جيشا من البسطاء الضعفاء كي يعبث بملامح دمشق التي تنتظر الحزن والدم المؤجل على خشبة تعلن عنه بشكل ما . تتناول الرواية من خلال يوميات دمشق ، البحث عن أسرار ذاكرتها والخوف من هواجس تغيير معالمها. تتجمع الشخصيات في حي بسيط، جمعهم المصادفات في بيت واحد، تتعمق الصداقة ويتأثر الساكنون بالشخصية المحورية المشار إليها بكاتب مسرحي، أولاء كانوا مستأجرين في بيت الشاب الذي بقي طوال الرواية من دون اسم فمرة هو الابن البار ومرة الأحدب ومرة الأعرج.. وبقي حتى آخر فصل في الرواية دلالة عائمة لعدة احتمالات، شاب منعزل في بيته بعدما سوى أبوه معاشه التقاعدي ورحل مع الأم إلى شرق سورية على ضفاف الفرات، بقي وحيداً في البيت بعدما كان وحيد الأسرة، تجمعه الأيام بكاتب مسرحي هذا الأخير تربطه علاقة حب بفنانة مغربيةلأم سورية،وقد درست في دمشق الفنون الجميلة، فأنشأت علاقة فنية مابين نصوص الكاتب ولوحات الفنانة التي ترسمها بالألوان مصورة روح الشام وسحر حضورها. يموت الكاتب على طريق السفر، فيحمل صديقه الأحدب إرث النصوص التي كان يكتبها بعدما استطاع الكاتب تغييره من الداخل وتحويل مجرى تفكيره من التمسك بالماضي إلى مساحات واسعة من الحب والفن والتوغل بذاكرة دمشق. وهنا تطرح الرواية مأزق الخروج من سيناريوهات الماضي التي نشيدها في مكتبات ضخمة ونغفل عن سيناريوهات الحاضر وما تنتجه من تراجيديا محتملة بوصف الثقافة الماضوية محوراً أساسياً تلعب بأوتاره السلطة بكل أشكالها سياسية وثقافية واجتماعية عبر تكرار إنشائي بلغة ميتة سريرياً لا تنتمي للواقع المزمن بأمراضه. سنقرأ عن دمشق بلغة تمتزج فيها الرموز الأسطورية بالحضارية متشكلة بنهر بردى وجبل قاسيون، عن قهوة أُنجزت بماء أنهار سورية يقدمها بردى لقاسيون الذي يفقد هويته وهو المدجج بمنصات صواريخ مرعبة ومقامات تستقطب زوارها لممارسة طقوس الخوف. أمّا احداث الرواية فتدور في دمشق لكنها تنتهي في أوربا وتترك للقاريء فرصة التخييل والتأويل كما لو أنه يحضر عرضاً مسرحياً يشبه ما كان يقيمه البطل في صالون البيت عندما يجتمعون مساء للمسامرة وشرب الشاي، وكل شخص ينحدر من إحدى المحافظات السورية، يقيمون حواراً على لسان الأنهار التي تجري في شرايين مدنهم، فيجمعهم نهر بردى عند مصبّه عبر انسياب تلقائي للشعور واللاشعور بالتعبير عن وجع الجفاف وذاكرة الجريان، كما تتناول الرواية هموم البسطاء واضطلاع الموغلين بذاكرة دمشق بأن يقدموا رؤيتهم ونصوصهم تعبيراً عن وحي القلق والتوجّس، ليغيّروا بنية المفاهيم وتعميق الوعي بجهات الحب الأربع لدمشق، و يربتوا على ضفاف بردى المهدد بالجفاف وقمة قاسيون التي تتوق للاخضرار في ظل حاضر موحش وعواصف تطرد الغيمات عنه. تتداخل الموضوعات ومعادلاتها في تفاصيل الرواية وتحضر الأمكنة محملة بكل أبعادها كربوة دمشق ومسرح دمشق وقاسيونها ومقاهيها وشوارعها ومعتقلاتها وصخب الحياة وهدوئها في أحيائها، هناك مثلاً إشارة لجوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية و هواجس الشباب والتخوف من مستقبل مظلم من خلال التنويه لتنظيمات غامضة تتحرك ضمن العشوائيات لتكسب مريدين وتحاول إغراق البسطاء أيضا بوعود مختلفة وزعماء هذه الجماعات ينتمون الى كل الأطراف، فهناك عدنان الذي تربطه علاقات مشبوهة مع تنظيم ديني مشار إليه باسم الصحوة أو السرورية والإخوان وهناك حسن مدير المركز الإيراني في دمشق الذي يعقد الأمسيات ويغدق الزوار بالهدايا، تجمعهما الاثنان علاقة سرية في الطابق الثاني لأحد مقاهي الربوة مع صاحب شركة إنتاج تلفزيوني وبعض رجال الأعمال والشخصيات الرسمية، ولهذا الطابق حكاياته مع صاحبته أم فواز ورواده سلوى وفريد وقد أصبح مصيرهما غامضاً على ضفاف بردى في ربوة دمشق بينما بقي نهر البردى في كل التفاصيل المتعلقة هناك في الربوة الشاهد الوحيد على الليل والنهار وما بينهما، كما يتناول السرد قصة الأستاذ جلال المخرج المسرحي الذي ورد ذكره في ثنايا السرد وغاب حتى ورد ذكره في الفصول الأخيرة مجدداً وما آلت إليه الحال. وفي قصص الحي الذي يعيش فيه المسرحي حكايات مختلفة عن الشخصيات كقصة حب عناة ويوسف وزواجهما والتي انتهت بمقتل المحامية عناة على يد أخيها بسبب زواجها من شخص ينتمي لطائفة دينية مختلفة، وعمار وبثينة الذي انتهى بهما الحال برعاية الذكريات القديمة مع الأصدقاء وسقاية حوض الزريعة الذي تُرك عندهما أمانة من سومر ثم من الابن الأحدب، ونجد الثرثار أبا تيسير ومهمته بخلق الإشاعات والترويج لعدنان، وفي الحي هاني أستاذ الفلسفة المتقاعد الذي بقي صامتاً طوال الفصول التي أتت على ذكره وقبل رحيله إلى مسقط رأسه خارج دمشق. كل هذه الشخصيات مختلفة تركز من الصفحات الأولى على كاتب مسرحي أنهى دراسته الجامعية في قسم المكتبات لكنه توجه للمسرح والكتابة والإخراج ومذ كان طفلاً يصطحبه والده للمسرح فينبهر بملامح والده من خلال تعابيره وإيماءاته في عتمة الصالة وعلى الطرف الآخر طفل يزرع فيه أبوه كتباً ضخمة ومكتبة شاهقة فتبهره جودة صنعها ومتانتها كالرخام اللامع فتسقط عليه بأحجامها وتكسر مفاصل ظهره ليتحول لأحدب الحي، ثم تجمعهما الأيام صدفة في مرحلة الشباب وكل منهما يحمل على ظهره إرثاً ثقيلاً من الأسئلة. الرواية ليست الاولى للكاتب من حيث التوغل في اسرار دمشق حيث يتحول المكان لخشبة بلا ستائر، وتنبت الهواجس على الأصابع فيخرج القارىء في الفصول الأخيرة للرواية تتناوبه الاحتمالات والتكهنات بمفاصل السرد، كمن يخرج من عتمة المسرح يفرك اضمحلال عينيه بعدما فاجأتها الاضواء بعد عتم دام لوقت والكل يبحث عن ملامحه في وجه صديقه، سيشعر القارئ أنه في معرض فني كبير بلوحات تنطق بالصوت والصورة عن يوميات دمشق وبكائها على تجاعيد وجهها حزناً علينا أو العكس، سنراها تقاوم الجفاف وتعد للحاضرين قهوتها منقاة بماء أنهار سورية وهي تتلو نوتة أوغاريت الموسيقية التي تبتهل فيها الأمهات خوفاً على فلذات أكبادهن وإذ بالخوف والحزن ينعكس على وجه الشام المنعكس على وجوهنا بحيث نتوهم ملامحنا المحدبة على زجاج الشتات ولا نرى سوى وجه دمشق الموغل فينا مؤكدة لنا أن بردى مليء بقوارير معتقة تخزن فيها أسماءنا وملامحنا على ضفافه. الرواية تحتاج لقراءة معمّقة فليست سهلة إن صح التعبير، يبلغ عدد صفحاتها 346 مقسمة إلى فصول متفاوتة، فالقاريء سيعيش في دمشق وسيتوقف عند مفصل مهم يظن معه أن السرد توقف ها هنا لكن سرعان ما يضعنا الراوي على زورق لنبحر إلى شمال المغرب ومن ثم إلى الفصل الأخير نحو أوربا ومعنا اسرار الوردة الدمشقية الخضراء المجففة بين طيات الدفاتر. تختلف الآراء حول الرواية فهي إشكالية بالمعنى الحرفي سوى انها تنتصر للفن والإنسان والحب بوصفهما الهوية الأساسية للمجتمع البشري. ومن الآراء النقدية عن الرواية أن جماليةً تبدت في السرد الذي لم يمنح البطولة لأحد شخوص الرواية، فالرواية جاءت دون بطل ينفرد بالفصول، وهذا يؤكد نظرية الراوي على لسان الكاتب المسرحي الذي كان يعد نصاً الكل فيه بطل ورابح وخاسر ومنتصر ومنهزم..لقد أبدع الروائي في زج القارئ في الفصول وتركه عبر التشويق يخوض مثار التأمل والتفكّر في خلق البدايات أو النهايات وتعبئة الفراغات كلّ بما يراه ويوقن أنه الصواب، فلم يقدم الراوي الأجوبة النهائية لكل تساؤلات السرد ولم يكن سوى وجهاً من تلك الوجوه التي تبحث وسط العتمة عن ملامح حضورها، فقد تأسس السرد الروائي عند أحمد الحسون على فلسفة التوغل في الذات بحثاً عنا جميعاً.لذلك أتت النهاية المكثفة في الرواية خزّان عطر مفاجئ يجمع التاريخ والجغرافيا والحب والعشق والقلق والانبعاث… الفن الحقيقي هو مرآة الحضارات ،واذا تحوّل الى الرخص والمجانية فإننا نسقط معه ونُطرَد ُمن منظومة البقاء الأسمى للأدب.




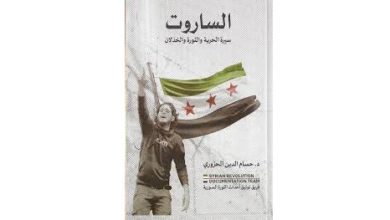



هذه الرواية تحفة فنية ولي ملاحظة بسيطة هو انها طويلة نوعا ما لكن بالمحصلة عن جدارة نحو تستاهل العالمية فالاسلوب ليس عادي وينم عن كاتب متمرس متميز باللغة وايضا تقديم الشاعرة ابتسام يبين فهمها الدقيق للرواية
الرواية رائعة بكل المقاييس اذا تم فهمها بشكل جميل وكلنا صرنا كما يقول الروائي احمد انيس الحسون ننظر الى وجوهنا على الزجاج ونبكي على تجاعيد وجه دمشق
قراءة مختلفة معمقة لقد اصابت دكتورة ابتسام بقراءة موفقة وافية فالروائي قرات له دراسة او اكثر نقدية ويالتاكيد هو كاتب متمرس ومن المفيد ان نقرا ادب النقاد وقريبا رواية عكازات العتمة تصلني، بالتوفيق للجميع