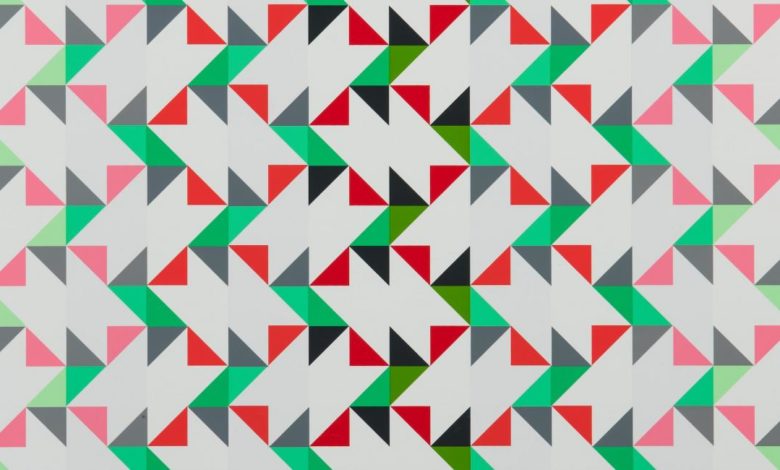
تتداخل السياسة والاقتصاد في رسم مصائر المجتمعات، ويبرز الاستبداد أحد أشكال السلطة التي ترتكز على المال لتثبيت نفسها، فهو ليس مجرد ممارسة سياسية أو سلطة لحظية، بل منظومة متكاملة تشكّل قيم المجتمع وأولوياته وفق مصالح اقتصادية محددة، محليّاً وعالميّاً. في هذا الإطار، يصبح المال معياراً للحياة والقوة والشرعية، بحيث يتحوّل الدين والمعرفة والعمل والتعليم من حقوق وقيم اجتماعية إلى أدوات تُستغل لتحقيق الربح وتثبيت الهيمنة.
لا يتشكل في فراغ، بل هو نتاج منظومة من الظلم والاحتكار، ويؤدّي إلى ترسيخ الفقر والبطالة وتوسيع دائرة التبعية الاجتماعية. تحتاج السلطة المستبدة إلى موارد مستمرّة لتثبيت أركانها، بدءاً من أجهزة الأمن والشبكات الولائية، ووصولاً إلى الإعلام الموجَّه والتشريعات المصمّمة لخدمة مصالح محدّدة. في هذا السياق، يتحوّل المال من وسيلة لتيسير الحياة إلى غاية بحد ذاته، بل إلى معيار للقيمة الإنسانية، فتصبح القوة والجاه والاعتبار الاجتماعي مرهوناً بما يمتلكه الفرد أو الجماعة من ثروة، فيما تتراجع العدالة والمساواة إلى مستوى الخيارات الثانوية أو غير المرئية.
في عديد من دول العالم الثالث، تتضح هذه العلاقة جلية، فالأنظمة التسلطية غالباً ما تتحالف مع الطبقات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك رجال الأعمال والاحتكارات والشبكات المرتبطة بالفساد، الذين يجدون في غياب الشفافية والديمقراطية بيئة مثالية لتراكم الثروة من دون مساءلة. الخصخصة غير الشفافة ونهب الموارد الطبيعية وتوجيه العقود العامة لتفضيل مصالح معينة كلها أدوات لإعادة توزيع الثروة من المجتمع إلى النخبة الحاكمة. في المقابل، يضمن النظام استمرار الدعم المالي والسياسي من هذه النخب، حتى لو كان الثمن توسيع دائرة الفقر وتدهور البنية الاقتصادية الوطنية، ما يعمّق الهوّة بين الطبقات ويضعف المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على المطالبة بحقوقهم الأساسية.
تتطلّب مواجهة التحالف بين الاستبداد ورأس المال أكثر من مجرد إصلاحات شكلية أو رمزية
ولكن تأثير المال على الاستبداد لا يقتصر على الحدود الوطنية. فالشركات العابرة للقوميات، والمؤسسات المالية الدولية، وبعض الدول الكبرى، تجد في النظم الاستبدادية شركاء “مستقرّين” يضمنون تدفق المواد الأولية وفتح الأسواق من دون أي عوائق تنظيمية أو أية استجابة لمطالب شعبية حقيقية. تُستخدم القروض المشروطة، والاستثمارات التي تتجاهل البعد الاجتماعي، وصفقات الأسلحة المبرّرة بالاستقرار، لترسيخ تبعية اقتصادية هيكلية، تجعل الاستبداد عنصراً أساسياً في الحفاظ على مصالح الطبقات الاقتصادية الدولية والمحلية. في هذا السياق، يصبح القمع وسيلة لضمان الانضباط الاقتصادي والسياسي، بينما يتحوّل الصمت الدولي إلى جزء من شبكة مصالح معقدة لا تتقيد بالقيم الإنسانية أو العدالة الاجتماعية.
ولا يقتصر الأمر على العالم الثالث، فحتى في الدول المتقدّمة تلعب رؤوس الأموال دوراً متزايداً في التأثير على صنع القرار السياسي. التمويل الانتخابي، ومجموعات الضغط الاقتصادية، وتدوير النخب بين السلطة والشركات الكبرى، كلها آليات تعمل على تفريغ السياسة من بعدها الاجتماعي، ما يجعل القرار السياسي تابعاً للمصالح الاقتصادية وليس لاحتياجات المجتمع. القمع هنا أقل عنفاً، لكنه يظهر في أشكال أخرى، مثل تقليص برامج الرفاه الاجتماعي، وتهميش النقاش حول العدالة الضريبية، وتقديم النمو الاقتصادي ذريعة لتجاهل الفوارق الطبقية المتنامية، ما يعكس نسخة أخفّ من الاستبداد، لكنها تحمل المبدأ نفسه القائم على قاعدة تغليب الربح على الإنسان.
في كل الحالات، يغلب منطق الربح على منطق العدالة. المساعدات الاجتماعية تُصوَّر عبئاً، وإعادة توزيع الدخل تُتهم بعرقلة السوق، بينما يُحتفى بتراكم الثروة دليلَ نجاح. لا تعزّز هذه المعادلة فقط سلطات الاستبداد، بل تغيّر القيم الاجتماعية نفسها، فتختزل الإنسان في إنتاجيته وربحيته، ويصبح التعليم استثماراً، والصحة خدمةً، والعمل امتيازاً لا حقّاً. وفي ظل هذه البيئة، لا يقتصر دور السلطة على القمع المادي، بل يشمل إعادة تشكيل منظومة القيم التي يعيش عليها المجتمع، لتصبح قيم المال والسلطة معياراً لكل شيء آخر.
يتحوّل الدين والمعرفة والعمل والتعليم من حقوق وقيم اجتماعية إلى أدوات تُستغل لتحقيق الربح وتثبيت الهيمنة
تتطلّب مواجهة هذا التحالف بين الاستبداد ورأس المال أكثر من مجرد إصلاحات شكلية أو رمزية. إنها معركة على تعريف التنمية نفسها. فهل التنمية تراكم الثروة لدى القلة، أم تحسين ظروف الحياة للجميع؟ هل الأولوية للاستثمارات التي تخدم الاقتصاد المحلي والعدالة الاجتماعية، أم للسوق العالمي وعائدات النخب؟ تتطلب المواجهة أيضاً تعزيز الضوابط على تراكم الثروة، والمساءلة الحقيقية للنخب السياسية والاقتصادية، وإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية بوصفها شرطاً للاستقرار الحقيقي لا نقيضاً له. فحيثما يُترك المال بلا ضوابط وحيثما تُهمَّش المساءلة، ينمو الاستبداد ويستمر، مهما اختلفت أشكاله أو لغته.
يكشف فهم العلاقة بين الاستبداد والمصالح الاقتصادية حقيقة قاسية: الظلم ليس مجرّد خلل عرضي في النظام، بل جزء من المنطق الذي يبني السلطة حين يُقدَّس المال وتُهمَّش حقوق الإنسان. ومن دون إعادة ترتيب القيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لصالح الإنسان قبل الربح، سيظل الفقر والبطالة والخراب وطناً مشتركاً، سواء في دول الجنوب أو في قلب الدول المتقدمة. تتطلب معالجة هذا الواقع مزيجاً من إرادة سياسية حقيقية، ووعي شعبي واسع، وضوابط اقتصادية واجتماعية، بحيث تصبح حقوق الإنسان والتنمية المستدامة معياراً للحكم والسياسة، لا تراكم الثروة والنفوذ فقط.
المصدر: العربي الجديد







