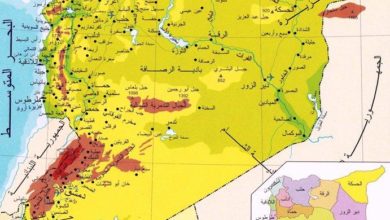شهدت سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011 تحولاً جذرياً في بنيتها الإعلامية والثقافية، إذ برز الفضاء الرقمي بوصفه ساحة مركزية لإنتاج السرديات وصياغة الوعي الجمعي. فقد أدّى الانتشار الواسع للإنترنت ووسائل الإعلام الجديد إلى خلق “مجال عمومي رقمي” تُعيد من خلاله القوى السياسية والاجتماعية السورية تنظيم حضورها، وإعادة تعريف الحقيقة والدلالة، بما جعل الحراك السوري في مستويين متوازيين: الحرب على الأرض وفي المنصات الرقمية.
وفي هذا المشهد المتشابك، أعادت شبكات الاتصال تشكيل أنماط التفاعل والمشاركة، على نحو ينسجم مع رؤية مانويل كاستيلز حول المجتمع الشبكي، بينما استخدم النظام السوري أدوات القوة الرمزية – وفق تصور الفيلسوف الفرنسي بورديو- لإعادة إنتاج خطابه في الفضاء الافتراضي. وكما برزت منصات إعلامية مستقلة خارج نطاق الدولة، أسهمت في توثيق الأحداث، وتوسيع دائرة النقاش، وصياغة سرديات مضادة.
– انتشار المعلومات وتشكّل الرأي العام في الفضاء الرقمي
أدى انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى انقلاب حقيقي في تدفق المعلومات داخل سوريا، وذلك بعد عقود من احتكار الدولة للإعلام التقليدي وإقصاء أي صوت مستقل. فمع اندلاع الثورة السورية عام 2011، تحوّل الفضاء الرقمي إلى مجال عمومي بديل – وفق تصور هابرماس – يتيح للسوريين تداول الأخبار والتعبير بحرية بعيداً عن الرقابة الرسمية. وقد دعّم هذا التحول رفعُ الحظر عن فيسبوك في بدايات عام 2011، ثم الازدياد المتسارع لاستخدام الهواتف الذكية، حتى بلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو تسعة ملايين بحلول 2025، أي ما يقارب 40% من السكان، مع انتشار رقمي واسع مكّن الأفراد من التحول إلى مرسلين ومتلقيـن للخبر في آن واحد.
غير أن هذا الانفتاح أفرز تحديات بنيوية في تشكيل الرأي العام؛ إذ أدى غياب المصادر الموثوقة وتضخم المبادرات الفردية إلى تفشي الشائعات والمعلومات المضلّلة، خاصة مع خوارزميات تفضّل المحتوى المثير على حساب التحليل المتزن. وكما دخلت أطراف محلية وخارجية في “حرب روايات” عابرة للحدود – وفق ما يوثّقه Atlantic Council- استهدفت المجتمع بخطابات طائفية ومناطقية زادت من الاستقطاب والضبابية.
ورغم ذلك، أسهم هذا الفضاء الرقمي في توليد وعي سياسي واجتماعي جديد لدى السوريين، خصوصاً الشباب، عبر الاطلاع المباشر على الأخبار العالمية والبدائل التحليلية المتنوعة. وتؤكد “نظرية الاعتماد على الإعلام” أن تأثير الوسيلة يتعاظم في أوقات الأزمات، وهو ما تجلّى في اعتماد السوريين على المنصات الرقمية لإعادة بناء صورتهم عن أنفسهم ودورهم. وقد شكّل التوثيق الشعبي للأحداث – عبر الهواتف ومنصات مثل فيسبوك ويوتيوب – أرشيفاً رقمياً مستقلاً مكّن السوريين من كسر احتكار السلطة للسردية، وأعاد تعريف القوة في المجتمع بما ينسجم مع رؤية مانويل كاستيلز حول مركزية الشبكات في إدارة الصراع والسيطرة الرمزية.
تشير الدلائل إلى تراجع واضح في الخطاب الوطني الجامع مقابل تصاعد الخطابات الفئوية التي تتحدث كل منها من منبرها الخاص، غير آبهة بتكوين قاسم مشترك على مستوى الوطن السوري.
– تغيّرات في الوعي الجمعي والخطاب العام
أدى الانفتاح الرقمي وما صاحبه من تدفق حر للمعلومات إلى تغييرات عميقة في الوعي الجمعي للسوريين، وإن كانت تغيّرات متباينة ومتضاربة في كثير من الأحيان. ومن منظور نظري، يعرّف الفيلسوف يورغن هابرماس المجالَ العمومي بأنه الفضاء الذي يتشكل فيه الرأي العام بحرية، خارج سيطرة الدولة والسوق والخصوصية، حيث يمكن للناس النقاش والتوصل إلى إرادة عامة. وغير أنّ الواقع السوري يطرح إشكالية: هل وُجد يوماً مجال عمومي حقيقي يجتمع فيه السوريون حول قضاياهم؟
ويقول الباحث مالك حافظ إن المجال العمومي في سوريا كان غائبًا بنيويًا حتى قبل الحرب؛ فالنقاش العام لم يتشكل يومًا كممارسة مواطنية مستقلة، بل وُلد في حضن السلطة وذاب في خطابها ليصبح امتدادًا للدولة. وهذا يعني أن النظام السوري – عبر عقود من الخطاب السلطوي – لم يمنع فقط حرية التعبير بالقمع المباشر، بل اِحتكر المعنى ذاته في المجال العام، وهو ما يسميه بورديو العنف الرمزي أو فرض هيمنة المعاني الرسمية على وعي الناس.
بعد سنوات الحرب الطويلة وما رافقها من انهيار اجتماعي، لم يؤدِ توقف الحرب وانهيار نظام الأسد إلى نشوء فضاء حواري صحي يعيد لحمة المجتمع، بل على العكس، يرى حافظ أننا نجد أنفسنا أمام شظايا مجتمعية وسياسية لا تلتقي. ولقد حلت الهويات الضيقة محل الهوية الوطنية الجامعة: انقسامات على أسس مناطقية وطائفية وإيديولوجية، وكل فئة تنتج مجالها الضيق الخاص بها في فضاء الإنترنت، دون وجود بنية فوقية تستوعب هذه التعددية. فعوضاً عن خطاب وطني شامل يسعى لرأب الصدع بعد الحرب، نرى خطاباً يتسم بالشعبوية والاستقطاب الحاد في النقاشات الدائرة على مواقع التواصل. وعلى سبيل المثال، تحولت صفحات فيسبوك وتويتر X إلى ما يشبه الساحات البديلة للصراع الطائفي والعرقي، حيث تُستخدم لغة التخوين والإهانات المتبادلة بين أطياف مختلفة من السوريين.
وفي كل الأحوال، تشير الدلائل إلى تراجع واضح في الخطاب الوطني الجامع مقابل تصاعد الخطابات الفئوية التي تتحدث كل منها من منبرها الخاص، غير آبهة بتكوين قاسم مشترك على مستوى الوطن السوري.
لقد غذّت وسائل التواصل الاجتماعي – في غياب رقابة إعلامية مهنية – ثقافة العنف والكراهية لدى البعض، وتراجعت قيمة النقاش العقلاني الهادئ، وتحولت كثير من الحوارات إلى سجالات صفرية. وهذه الأجواء سمّمت الوعي الجمعي ودفعت بكثيرين إلى الانكفاء داخل دوائرهم الضيقة، إما خوفاً من الهجوم أو تعصباً لهويتهم الفرعية. وبات التواصل بينهم أشبه بحوار طرشان، كل طرف يغني على ليلاه.
وعلى أن الصورة ليست قاتمة تماماً، فثمة مؤشرات على تشكّل وعي نقدي جديد لدى قطاعات من الشباب السوري نتيجة تعرضهم لتعددية الآراء عبر الإنترنت. وهؤلاء باتوا أكثر تشكيكاً في سرديات السلطة الوطنية الجديدة، وأقل قابلية لتصديق الدعاية دون تمحيص. وهذا خلق لدى البعض مناعة ضد الخطاب الأحادي، وربما حنكة في التحقق من الأخبار عبر المصادر المختلفة. وكما ظهرت مبادرات على مواقع التواصل تنادي بالتهدئة، واستعادة الخطاب الوطني الجامع، ونبذ خطاب الكراهية.
اعتمد النظام على دعم إعلامي روسي وإيراني واسع لتقويض تقارير دولية حول الانتهاكات، وخاصة الملف الكيميائي، ونشر روايات مضادة تمنحه شرعية سياسية ودبلوماسية.
استخدام النظام السوري للفضاء الرقمي لإعادة ترسيخ السلطة
مع بعد استعادة النظام السوري (البائد) السيطرة على كثير من أجزاء البلاد منذ 2018، اِتجه بقوة إلى إعادة فرض هيمنته على الفضاء الرقمي باعتباره امتداداً لمعركة تثبيت انتصاره السياسي. فبينما سمحت سنوات الحرب الأولى بهوامش نقاش أوسع بسبب انشغال الأجهزة العسكرية، عادت أجهزة الأمن لاحقاً لتشدد الرقابة على الإنترنت، وتلاحق أي صوت ينتقد السلطة. وقد شكّل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في نيسان 2022 نقطة مفصلية في تضييق حرية التعبير، إذ تضمن عبارات فضفاضة تتيح معاقبة أي منشور يُفسَّر بأنه “يمس هيبة الدولة” أو “الوحدة الوطنية”. ووفق تقارير المركز السوري للإعلام والشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتُقل منذ صدور القانون أكثر من 170 شخصاً بسبب نشاطهم الرقمي، بينهم صحفيون وموظفون حكوميون وحتى موالون تجاوزوا “الخطوط الحمراء”.
ولقد فعّلت السلطة أجهزتها الأمنية الأربعة لمراقبة المحتوى على المنصات، واستدعاء المؤثرين ومستخدمي الإنترنت للتحقيق، وإجبار بعضهم على توقيع تعهدات أو إحالتهم إلى محاكم استثنائية كـ “محكمة الإرهاب”. وهذا القمع القانوني ترافق مع أدوات دعائية نشطة، أبرزها “الجيش السوري الإلكتروني” الذي شن منذ 2011 هجمات واختراقات ضد مواقع معارضة وإعلام دولي، قبل أن تتولى “اللجان الإلكترونية” لاحقاً مهمة الترويج الكثيف للرواية الرسمية عبر حسابات وهمية ومنسّقة تهدف لإغراق النقاش العام وتوجيهه.
وعلى الصعيد الدولي، اعتمد النظام على دعم إعلامي روسي وإيراني واسع لتقويض تقارير دولية حول الانتهاكات، وخاصة الملف الكيميائي، ونشر روايات مضادة تمنحه شرعية سياسية ودبلوماسية. وفي ضوء مقاربة بورديو، تمثل هذه الاستراتيجيات ممارسة مكثفة للسلطة الرمزية عبر صناعة وعي زائف يرسّخ صورة “الدولة المنتصرة”، ويُغرق المجال العام بقضايا هامشية تصرف الانتباه عن الأزمات الحقيقية. ورغم نجاح النظام في إعادة ضبط جزء كبير من الفضاء الرقمي داخلياً عبر مزيج من الترهيب والدعاية، يبقى التحكم الكامل مستحيلًا بفعل الطبيعة اللامركزية للإنترنت واستمرار المنصات المعارضة في الخارج، ما يجعل معركة السرديات مفتوحة ولم تُحسم بعد.
دور المنصّات البديلة في تشكيل خطاب موازٍ
في سياق الهيمنة المحكمة التي مارسها النظام السوري البائد على الإعلام التقليدي والرقمي، برزت خلال سنوات الحرب وما تلاها منظومة إعلامية بديلة شكّلت أحد أهم التحولات في المجال العام السوري. فقد أتاح الانهيار المؤسسي الجزئي واتساع الفضاء الرقمي ظهور منصات مستقلة أسسها صحفيون وناشطون خارج قنوات الدولة الرسمية، لتقدّم سرديات مغايرة وتعيد الاعتبار للحقيقة في مواجهة الخطاب السلطوي. وقد أدّت هذه المنصات – مثل عنب بلدي والجمهورية وSyria Direct وشبكة آرام الإعلامية ومنصات تلفزيون سوريا وغيرها الكثير- دوراً تأسيسياً في كسر احتكار الدولة للمعلومة عبر شبكات مراسلين محليين، وصحافة استقصائية رصدت الانتهاكات الميدانية وجرائم الحرب بالصوت والصورة، لتغدو مرجعًا حيويًا للباحثين والمنظمات الحقوقية.
المصدر: تلفزيون سوريا