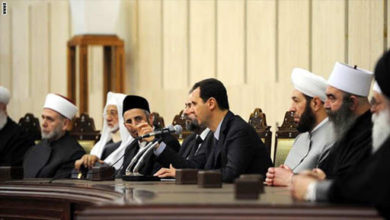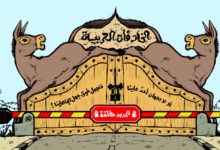بعد نحو شهر من سقوط النظام، كتب تسفي برئيل (צבי בראל)، الكاتب والمحلل البارز في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مقالًا بعنوان: «يتشكّل محور مناهض لإيران في سوريا قد يقوّض مكانة إسرائيل أمام واشنطن». ورغم أن هذه الفرضية بدت آنذاك بلا معنى أو بعيدة عن الواقع، إلا أن ما جرى لاحقًا وصولًا لليوم يشير إلى أنّها قد تكون سببًا غير مباشر يفسّر إصرار إسرائيل على فرض إرادتها بتقسيم سوريا وإبقائها محطّمة، أو، في أسوأ الأحوال، دفعها إلى تغيير مسار تموضعها الحالي باتجاه روسيا أكثر.
درس تسفي برئيل اللغة والأدب العربي وتاريخ المنطقة في الجامعة العبرية، وحصل على الدكتوراه من جامعة بن غوريون حول مفهوم «الغرب» في الخطاب الديني المعتدل بمصر. بدأ عمله في الحكم العسكري بالضفة الغربية، ثم انضم إلى صحيفة هآرتس مراسلاً للشؤون الفلسطينية، ولاحقًا في واشنطن (1984–1989). منذ التسعينيات برز كمحلل سياسي للشؤون الإقليمية والحركات الإسلامية، إلى جانب عمله الأكاديمي، وحصل عام 2009 على جائزة سوكولوف للصحافة.
ربما تضفي سيرته بعض الأهمية على ما يقول، وقد ينطق بلسان النخب الإسرائيلية أو يعكس تفكيرها على الأقل. ففي مقالته يرى أن تنامي الدورين السعودي والتركي في إعادة تشكيل الواقع السوري، بدعم أميركي ضمني، قد يضع إسرائيل أمام تراجع تدريجي في دورها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. فالدخول النشط لكل من الرياض وأنقرة على خط إعادة الإعمار وتثبيت النفوذ في سوريا ولبنان، يعيد رسم خريطة الشراكات الإقليمية أمام واشنطن، ويضع إسرائيل في موقع تنافسي جديد.
وإذا ما نظرنا إلى تاريخ إسرائيل بتمعّن أكبر، نجد أن ما يصفه الكاتب بـ الدور الاستراتيجي في المنطقة» ليس سوى امتداد لمفهوم «الدولة الوظيفية» الذي قامت عليه إسرائيل.
شكل اليهود في التاريخ الأوروبي حالة فريدة من التكوين الاجتماعي، إذ ارتبط وجودهم بما عُرف بـ «الجماعة الوظيفية» التي أُنيطت بها أدوار اقتصادية واجتماعية محددة لم يكن المجتمع الإقطاعي قادراً على أدائها ومنحهم ذلك ارتباطاً مباشراً بالملوك والأباطرة، وتمتعوا بحماية وامتيازات نسبية، شبيهة أحياناً بحقوق النبلاء ورجال الدين. لكنهم ظلوا خارج البنية الإقطاعية التقليدية، فلا هم فلاحون مرتبطون بالأرض، ولا فرسان، ولا أعضاء في الكنيسة. هذا الموقع المعزول جعلهم أشبه بعنصر يعيش على هامش المجتمع، من دون اندماج كامل فيه.
اقتصادياً، لعب اليهود دور الوسيط التجاري بين أوروبا المسيحية والعالم الإسلامي بعد انهيار روما، معتمدين على شبكات اتصالات واسعة قامت مقام نظام ائتماني عابر للحدود. تخصصوا في السلع الهامشية والكمالية، ثم في الإقراض بالربا والتجارة الداخلية، فصاروا أداة مثالية لاستخلاص القيمة من الشعوب لصالح النخبة الحاكمة. ورغم ما جنوه من أرباح، كانت الضرائب الباهظة تحول القسم الأكبر من الفوائض إلى خزائن السلطة، ما عزز تبعيتهم للحاكم.
ومع حلول القرن الثالث عشر، استقر وضعهم كجماعة وظيفية وسيطة، إلا أن التحولات الكبرى مع بزوغ الرأسمالية، وبخاصة نشوء اتحادات التجار المسيحيين (مثل العصبة الهانسية) والمصارف المحلية، أضعفت أدوارهم التقليدية وأنهت احتكارهم للتجارة والائتمان. وبهذا تحوّلوا إلى «جماعة وظيفية بلا وظيفة» بعدما فقدوا موقعهم البنيوي وباتوا معزولين. هذه الأزمة أصبحت تعبيراً عن تحول اجتماعي عميق أطلق عليه لاحقاً «المسألة اليهودية».
برزت الصهيونية مع صعود الفكر الاستعماري الغربي في القرن التاسع عشر كحل استراتيجي للمسألة. وقُدِّم اليهود باعتبارهم «فائضاً بشرياً غير نافع» يمكن تحويله إلى عنصر استيطاني يخدم الإمبريالية عبر تصديره إلى الشرق. هكذا تحوّل دور الجماعة الوظيفية من بعدٍ مالي-تجاري إلى «دولة وظيفية» تؤدي أدواراً عسكرية واقتصادية نيابة عن الغرب، ولم تُطرح كملجأ فقط، بل كقاعدة متقدمة لحماية المصالح الغربية.
منذ بدايات المشروع، شدّد القادة الصهاينة على أهميته الجيوسياسية وأشار ماكس نورداو إلى أن اليهود سيصبحون «حراساً على طول الطريق» من الشرق الأدنى حتى الهند، أما ثيودور هرتزل فتصوّرها «إمبراطورية بريطانية مصغّرة» أو «إنجلترا الصغرى». وشبّهها حاييم وايزمان بـ«بلجيكا آسيوية» تمثل خط الدفاع الأول عن إنكلترا وخاصة قناة السويس وناحوم جولدمان رأى أن إقامة الدولة لا تنطلق من دوافع دينية أو اقتصادية بل من موقعها بوصفها «المركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم». كما روّجت الحركة الصهيونية لدولتها باعتبارها «معقلاً للحضارة» و«جزءاً من جدار دفاعي يحمي أوروبا في آسيا» كما يذكر عبد الوهاب المسيري في كتابه «الصهيونية والحضارة الغربية».
في هذا السياق، جرى تسويق المشروع بوصفه خدمة منخفضة الكلفة بالنسبة للإمبراطورية الراعية، وعرض هرتزل على بريطانيا أن تكسب «وفي ضربة واحدة عشرة ملايين تابع سري مخلص ونشيط»، واعتبر أن هذه «سلعة ذات قيمة عالية».
ومع قيام دولة إسرائيل عام 1948، تطور الخطاب لتقديم المجتمع الجديد كـ«مجتمع نموذجي» يعكس قيم الحداثة الغربية في الشرق الأوسط وبذلك جسّدت إسرائيل الامتداد الحديث لفكرة «الجماعة الوظيفية».
رغم أن القادة الصهاينة قدّموا الدولة اليهودية منذ نشأتها بوصفها «دولة وظيفية» تخدم المصالح الاستراتيجية للقوى العظمى فإن التطورات الراهنة تكشف أن هذا الدور لم يعد مستقراً كما كان في الماضي.
نشرت الإيكونوميست مؤخرا مقالا بعنوان «كيف تخسر إسرائيل أميركا» يشير إلى أن تل أبيب مع اتساع عزلتها بسبب حرب الابادة في غزة، باتت «تعتمد بشكل أكبر على واشنطن»، إذ إن دولاً غربية مثل أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا اعترفت بالدولة الفلسطينية، ما يجعل الولايات المتحدة وحدها «تقف بين إسرائيل وبين تحولها إلى دولة منبوذة» ويؤكد الكاتب أن فقدان هذا السند سيحمل «عواقب وخيمة على أمنها الدبلوماسي والقانوني والعسكري».
التحليل الذي تقدمه المجلة يبيّن أن التحالف الذي كان يقوم على مزيج من «القيم والمصالح» خلال الحرب الباردة وما بعدها بدأ يتآكل. فقد تراجعت نسبة الأميركيين الذين يؤيدون إسرائيل إلى أدنى مستوى منذ خمسة وعشرين عاماً، حيث يرى 43% من المستطلَعين أنها ترتكب «إبادة جماعية في غزة»، في حين ارتفعت النظرة السلبية إليها بين الديمقراطيين والجمهوريين الشباب على حد سواء. ويذهب المقال إلى أن هذا التحول في الرأي العام «أكثر خطورة من الخلافات بين الحكومات»، لأنه يعكس تغيراً هيكلياً يصعب التراجع عنه.
في هذا السياق يصبح من الواضح أن الدور الوظيفي لإسرائيل، كحارس استراتيجي للغرب في الشرق الأوسط، بات مهددا. ففي حين كان يُنظر إليها في زمن الحرب الباردة باعتبارها «حصناً ضد التوسع السوفييتي»، ثم بعد 11 سبتمبر بوصفها شريكاً في «مكافحة الإرهاب الإسلامي»، فإنها اليوم توصف بعبء قد يجر الولايات المتحدة إلى حروب جديدة في المنطقة. وحذرت المجلة من أن رؤية نتنياهو لإسرائيل باعتبارها «سوبر-أسبرطة» قادرة على الوقوف وحدها قد تكون «سوء تقدير استراتيجي خطير».
منطق «الدولة الوظيفية» لم يتغير من حيث الأساس، لكنه يواجه اليوم إشكالية تتعلق بمدى قدرة هذا الكيان على الحفاظ على تحالفه المركزي مع الولايات المتحدة. فكما أن الجماعة الوظيفية اليهودية في أوروبا فقدت وظيفتها مع التغيرات البنيوية، يبدو أن «الدولة الوظيفية» تواجه بدورها خطر اهتزاز وظيفتها إذا لم تستطع الحفاظ على موقعها بوصفها أداة استراتيجية موثوقة للمصالح الغربية.
وفي هذا السياق يعد بروز أي منافسة إقليمية جديدة، حتى وإن كانت محدودة، دعوة للمراقبة والحذر، فالتغيرات الجوهرية التي شهدتها الساحة السورية لم تكن كلها في صالح إسرائيل، رغم أنها أسهمت ـ بشكل غير مباشر ـ في نشأتها. الدليل على ذلك يتمثل في موقفها المساند لبشار الأسد على مدى أربعة عشر عاماً من المأساة السورية، قبل أن تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع تداعيات التحول الراهن بقدر كبير من الارتياب. وكما يشير تسفي برئيل، فإن سقوط النظام فتح الباب أمام تشكّل تحالف إقليمي جديد، تكون سوريا في مركزه لأول مرة في تاريخ المنطقة الحديث، وهو تحالف يرتبط بوضوح بالمصالح الأميركية.
وأكد الشرع، في كلمته أمام الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك، على تموضع سوريا الجديد، قائلاً إن «العالم كان محرومًا منها، وهي محرومة منه» في إشارة إلى أن سوريا لم تعد على الحياد، بل باتت مصطفّة صراحة إلى جانب الغرب. هذا التموضع مثّل مصدر إزعاج لإسرائيل، التي سعت إلى إعادة توجيه المسار السوري، ونجحت جزئياً في دفع دمشق نحو موسكو، عبر الإيحاء بأن الاعتداءات الإسرائيلية يمكن أن تتوقف إذا وضعت سوريا أوراقها مجدداً في يد روسيا، التي قُدمت كضامن بديل، رغم أن الولايات المتحدة طرحت نفسها هي الأخرى وسيطاً وضامناً، إلا أن إسرائيل، على نحو لافت، فضّلت الدور الروسي.
قدمت هيئة تحرير الشام قبل وصولها إلى دمشق دورا وظيفيا كبيرا لواشنطن عندما ساعدت في القضاء على زعيم تنظيم الدولة البغدادي في إدلب ومن بعده قادة آخرين في التنظيم وتنظيمات جهادية أخرى في المنطقة، واستمر هذا التعاون بعد إسقاط النظام وظهر في أكثر من عملية استهدفت التنظيم، وتبدي الادارة السورية استعداد لتقديم أكثر من ذلك.
في مقابلة له مع «ذا ناشيونال» قال توم براك بأنه لا يثق بأحد في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل. «إذا كنا نتحدث عن الثقة، فأنا لا أثق بأحدٍ منهم. مصالحنا لا تتطابق. الحليف مفهومٌ مُضلِّل». وعندما سأله المُحاور إن كان يقصد المصالح الأميركية تجاه السوريين، أجاب بارك: «مع أيٍّ منهم، بما في ذلك إسرائيل». وعلى الرغم من أن كلامه لا يوضع في قراءة لفهم الموقف الأميركي إلا أنه يحمل تلميحا.
الشرق الأوسط يشهد إعادة تشكّلٍ لا تقوده إسرائيل وحدها، على عكس ما يحاول بنيامين نتنياهو تصويره. صحيح أن إسرائيل أسهمت في التحولات، لكنها ليست اللاعب الوحيد، إذ تشارك قوى إقليمية ودولية أخرى في صياغة هذا المشهد الجديد بطرائق متعددة، غير أن إسرائيل، وفق رؤية نتنياهو، ترى أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا عبر «سلام إسرائيلي» (Pax Israeliana) على غرار Pax Romana (السلام الروماني)، بما يعني أن الهيمنة الإسرائيلية هي الضامن الوحيد لإنهاء الصراعات. ومن هذا المنطلق، لا تقبل تل أبيب بأي منافس يمكن أن ينتزع جزءاً من «الوظيفية» التي رسّختها لنفسها في المنطقة، وعلى أي مفاوض سوري أن يعرف ذلك وهو يبحث عن أي اتفاق معها.
المصدر: تلفزيون سوريا