
لم يكن قرار مديرية التربية في حلب بتغيير اسم مدرسة نزار قباني للتعليم الأساسي، لتصبح “حذيفة بن اليمان”، مجرّد إجراء إداري عابر، فالاسم الذي لا يُختزل في لافتة فوق باب مدرسة في حيّ الزهراء، رمز متجذّر في المخيال السوري. وكان طبيعياً أن يثير القرار موجةً عارمةً من الجدل، قبل أن يتدخّل وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح لوقف تنفيذ القرار بحقّ الشاعر، ليؤكّد مسلَّمةَ أنّ “نزار لم يكن شاعر دمشق فقط، بل شاعر سورية والعرب جميعاً”. لكن ما يبدو هنا انتصاراً جزئياً للذاكرة الثقافية، يفتح الباب لسؤال أوسع: إذا كان إنقاذ نزار قباني قد تطلّب تدخّلاً وزارياً مباشراً، فماذا عن عشرات الأسماء الأخرى التي شُطبت؟ ومن يحمي الذاكرة الجمعية السورية من موجات المحو وإعادة الكتابة؟
قبل أيام، أصدرت مديرية التربية والتعليم في حلب قراراً إدارياً يقضي بتغيير أسماء 128 مدرسةً دفعةً واحدة. القرار شمل مدارس تحمل أسماء شخصيات أدبية وثقافية وسياسية بارزة: سامي كيّالي وميخائيل كشّور وإبراهيم حلمي الغوري وعائشة الدبّاغ ومحمد الفيتوري، وغيرها… كلّها أزيلت لتحلّ مكانها أسماء صحابة أو رموز دينية إسلامية مثل الإمام الغزالي وسميّة بنت خياط وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك… هذه ليست الحالة الوحيدة. ففي دمشق سبق أن دار جدل حول نيّة تغيير اسم مدرسة سعد الله ونوّس، تطلّب تدخلاً مماثلاً من وزير الثقافة ليؤكّد بقاء اسم المدرسة على حاله. وفي حماة أعلنت المحافظة (الخميس الماضي) خطةً لتغيير أسماء المدارس المرتبطة برموز النظام البائد أو حزب البعث، مؤكّدة أن الأمر “مكسب ثوري” و”واجب وطني”. على المستوى الرسمي، أكّد قرار الوزارة (الخميس) العمل على تنفيذ إجراءات تغيير أسماء بعض المدارس في جميع المحافظات، وفق آلية عمل موحّدة، وأن عملية تغيير الأسماء يجب أن تأتي “لتعزيز الهُويَّة الوطنية” و”ترسيخ الانتماء”، ضمن معايير تشمل أسماء المناطق، والرموز الوطنية والعلمية، والرموز الدينية، فضلاً عن “القيم المُلهِمة” مثل “الحرية” و”السلام”. غير أن الواقع يبيّن أن لا ضمانات لعدم إحلال الأسماء الدينية على حساب الأسماء الثقافية والفكرية، بحكم الأيديولوجيا السائدة لمَن عيّنوا قيّمين على العملية التربوية، الذين أثاروا جدلاً منذ بداية حقبة السلطة الجديدة في دمشق بتدخّلات لتغيير المناهج بحجج مماثلة، ما يُبقي الباب مفتوحاً على تأويلات متعدّدة حول الأهداف الفعلية لهذه السياسة.
ليست المدرسة مبنىً للتعليم فحسب، بل فضاء يحمل اسمه دلالات رمزية تشكّل جزءاً من الذاكرة الجمعية، ويصبح الاسم بوابة لتعريف التلميذ بهذا الرمز، ويفتح أمامه أفقاً معرفياً وثقافياً. نزار قباني، على سبيل المثال، لم يكن شاعر غزل حمل قضية المرأة العربية فقط، بل أحد أبرز الأصوات السورية التي واجهت القمع السياسي، فتحوّل رمزاً للحداثة الشعرية العربية. ليست إزالة اسمه عن مدرسة في حلب مسألةً شكليةً، إنها عملية محو لواحد من مفاتيح الذاكرة الثقافية. وبالمثل، فإن شخصيات مثل سعد الله ونّوس (المسرح)، أو محمد الفيتوري (الشاعر السوداني الليبي المصري)، أو سامي كيّالي (ناقد الأدب العربي)، تشكّل خيوطاً في نسيج الهُويّة السورية. استبدالها بأسماء دينية مشحونة بالقداسة يعني تلوين الذاكرة بلون واحد، وإفقارها إلى التنوّع الذي ميّز سورية تاريخياً. صحيح أن عقودَ حكم الأسدَين (الأب والابن) حوّلت تسمية المدارس والشوارع أداةً أيديولوجية، أسدية وبعثية، ووسيلة لتثبيت شرعية النظام، لكنها راعت التنوّع (ساحتا الأمويين والعباسيين مثلاً، فضلاً عن أسماء المدارس). والمفارقة أن مديريات التربية السورية لم تمحِ عبر قراراتها الأسماء الأسدية والبعثية وحسب، بل طاولت رموزاً لا علاقة لها بالنظام، بل هي جزء من الذاكرة الثقافية المشتركة. هنا يكمن الخطر: أن تتحوّل “إزالة رموز البعث” ذريعةً لمحو تاريخ كامل، وإحلال مرجعية جديدة بلون الواحد (دينية هذه المرّة) مكانها. بهذا المعنى، يُطرح السؤال: هل الهدف حقاً تصحيح الذاكرة من شوائب الاستبداد، أم إعادة كتابتها وفق أيديولوجيا جديدة؟
هناك صراع على الشرعية؛ انهار النظام البائد، لكن القوى الجديدة تبحث عن تثبيت حضورها عبر الرموز والأسماء
في وسائل التواصل الاجتماعي، مزيد من الانقسام بين السوريين. رأى بعضهم أن القرار خطوة صحيحة للتخلّص من أسماء ارتبطت بالاستبداد، فيما اعتبره آخرون (وصاحب المقال منهم) “عبثاً بالذاكرة” و”تغليباً لخطاب طائفي”. كتب ناشطون: “ابنوا مدارس جديدة باسم حذيفة بن اليمان إذا شئتم، لكن لا تشطبوا اسم نزار قباني”. وتساءل آخرون مُحِقّون: ما جدوى الانشغال بالأسماء بينما تعاني المدارس من نقص المعلّمين والكتب، ومن بنى تحتية مدمّرة لم تُرمَّم بعد (40% من المدارس السورية تعرّضت للتدمير الكلي أو الجزئي). الفصل بين الجنسَين في الصفوف، والملصقات الدعوية عند أبواب المدارس، وتغيير الأسماء… تصبّ جميعها في اتجاه واحد: تحويل التعليم أداةً أيديولوجية.
يظلّ تدخّل وزير الثقافة لإنقاذ اسم نزار قباني “انتصاراً” محدوداً وشكلياً، قد لا يوقف موجة التغيير الجارف التي طاولت (وقد تطاول) عشرات المدارس الأخرى، ولا يضع أساساً قانونياً أو مؤسّساتياً يحمي الرموز الثقافية من العبث. وكما في حالات تدخّل وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، لإطلاق صراح صحافيات وصحافيين اعتُقلوا تعسّفياً، يبقى الاعتماد على تدخّلات فردية كاشفاً غياب بنية قانونية ثقافية تربوية مستقرّة. لا تُحمى الذاكرة الجمعية بمبادرات استثنائية، بل عبر إطار وطني جامع يضمن التنوّع والتعدّدية، ويمنع أيَّ سلطة سياسية (أيديولوجية كانت أو دينية) من إعادة كتابة الذاكرة كلّما تغيّرت موازين القوة. في سورية هناك صراع على الشرعية؛ انهار النظام البائد، لكن القوى الجديدة تبحث عن تثبيت حضورها عبر الرموز والأسماء.
لا تصان الذاكرة الجمعية بقرارات استثنائية، بل بإطار وطني قانوني ثقافي يحمي التعليم من أن يكون أداة صراع سلطوي
المدارس مؤسّسات تلامس يوميات مئات آلاف الأطفال تصبح ساحةً مثاليةً لصراع الرموز، فتستبدل الاجتماعات المدرسية الصباحية (الطابور) بشعارات “البعث” شعارات دينية. في تلك الساحة تتقاطع الذاكرة الجمعية مع الشرعية السياسية، يريد كل طرف كتابة التاريخ بطريقته: فعلها “البعث” طوال أكثر من نصف قرن، والآن هناك من يريد كتابة ذاكرة جديدة محورها الرموز الدينية. لكن الخاسر الأكبر هنا هو المجتمع، الذي يُحرَم تنوّع رموزه، ويُختزَل في لون واحد. تجارب المجتمعات الخارجة من الاستبداد (في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا) أظهرت أن ثقافة المحو تؤدّي إلى انقسامات جديدة، بينما تتيح ثقافة التعدّد إمكانية تحويل الرموز موضوع نقاش وتعليم بدلاً من إزالتها. في الحالة السورية، يتفهّم الجميع إزالة أسماء مرتبطة مباشرةً بالاستبداد، لكن تعميم المنهج نفسه على رموز الثقافة والأدب والفكر يحوّل العملية من “تصحيح” إلى إقصاء، مهدّداً السلم الاجتماعي في بلد يحتاج اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى خطاب جامع يتجاوز الاصطفافات الأيديولوجية.
إنقاذ نزار قباني من قرار محو اسمه كان خطوةً ضروريةً، لكنّها غير كافية. فالشاعر رمز من بحر رموز تكوّن هُويَّة السوريين. ولا تصان الذاكرة الجمعية بقرارات استثنائية، بل بإرساء إطار وطني وقانوني وثقافي يضمن التوازن بين الإرث التاريخي والتنوّع المجتمعي، ويحمي التعليم من أن يكون أداة صراع سلطوي. يجب أن تكون المدرسة جسراً نحو المستقبل، لا ساحةً لتصفية الحسابات مع الماضي. والسؤال الذي يظلّ مفتوحاً: إذا كانت “حسنات” وزير الثقافة قد أنقذت نزار قباني، فمن ينقذ الذاكرة السورية بأسرها من أن تُمحى وتُعاد كتابتها مع كلّ صراع على السلطة؟
المصدر: العربي الجديد

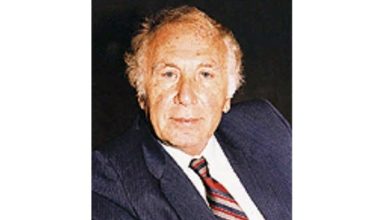






كان قرار مديرية التربية في حلب بتغيير اسم مدرسة “نزار قباني” للتعليم الأساسي، لتصبح “حذيفة بن اليمان”، ليس إجراء إداري عابر فقط لأن الاسم لا يُختزل في لافتة فوق باب مدرسة في حيّ الزهراء بحلب ، إنه رمز لشاعر خدم الوطن والعروبة ، هل صراع الشرعية هي من تغيير أسماء الرموز الوطنية؟ هل نحن بحاجة لإطار وطني قانوني ثقافي يحمي التعليم من أن يكون أداة صراع سلطوي ؟.