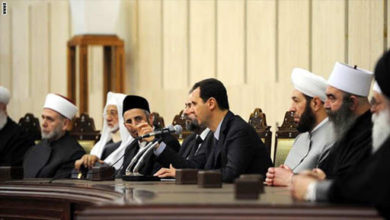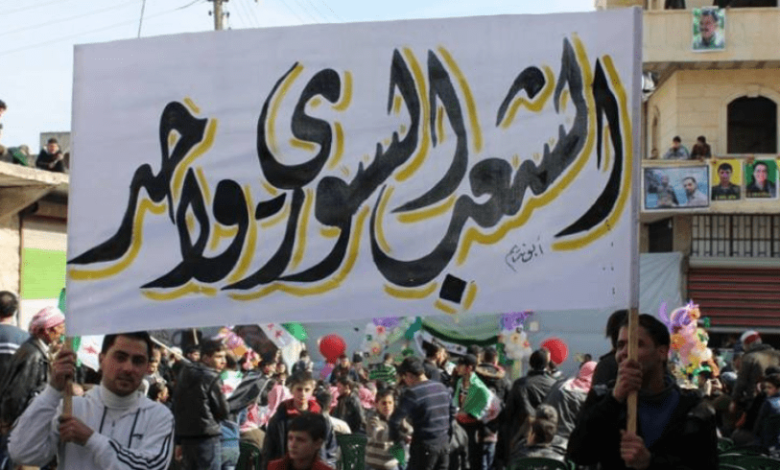
ربما يعرف كثير من السوريين قصة رواندا، ذلك البلد الذي شهد في عام 1994 واحدة من أفظع الإبادات الجماعية في العصر الحديث، حين قُتل نحو 800 ألف شخص في مئة يوم فقط، على خلفية تحريض متواصل بثّته إذاعة “راديو ميل كولين“.
الكلمات هناك لم تكن بريئة، “اقطعوا الأشجار الطويلة!” كانت هذه العبارة الأخطر، الشيفرة المباشرة للدعوة إلى قتل التوتسي، حيث تحوّلت اللغة إلى أداة قتل منهجي، مُجرِّدة الضحايا من إنسانيتهم وممهّدة الطريق لجرائم إبادة لا توصف.
هذه التجربة هي مرآة مخيفة تعكس كيف يمكن لخطاب الكراهية، إذا تُرك دون مواجهة، أن يشق طريقه من الشاشات إلى النفوس، فيحوّل الخلافات العادية إلى صراعات مدمّرة تمزق النسيج الاجتماعي قطعةً قطعة.
لعل ما يعمّق خطورة مشهدنا السوري اليوم هو أن المحرّضين لدينا يظهرون على هيئة صفحات وأسماء يدّعي أصحابها أنهم “مؤثرون” على وسائل التواصل الاجتماعي.
أغلبهم ليسوا إعلاميين محترفين ولا مفكرين، بل سطحيون فارغون فكرياً يمارسون التحريض بدم بارد، فيجعلون من صفحاتهم مزارع تعبئة غوغائية، ويدفعون جمهورهم إلى لعب أدوار الذباب الإلكتروني الذي يهدد النسيج السوري المتشظي أصلاً بمزيد من الانهيار.
حين نقدّس الأشخاص، فنحن نتحوّل عملياً إلى وكلاء كراهية ضد كل من لا يشاطرنا عبادة تلك الأصنام البشرية.
إن جوهر الانحدار في خطاب الكراهية يتمثل في مفعوله التراكمي بنزع الصفة الإنسانية عن الضحية، فحين يُسمّى البشر “صراصير” كما حصل مع التوتسي مثلاً، فإن المسألة قد تحوّلت إلى صناعة سرديات شيطنة تُحوّل الآخر إلى شيء، إلى مادة، إلى عدو خارجي يُلقى خارج حدود الإنسانية.
ما نراه اليوم من انحدار خطير في الخطاب الرقمي السوري لا يُعبّر عن قوة موقف أو شجاعة تعبيرية، إنما في جوهره، تعبير فجّ عن الضعف الأخلاقي والعجز الفكري. هؤلاء المؤثرين لا يتقنون سوى تكرار سرديات التخوين وتضخيم العصبيات المناطقية والطائفية، ويقودون من حيث لا يعلمون حملات ممنهجة لتدمير أي بذرة حوار وطني حقيقي. الأكثر مدعاة للقلق أن هؤلاء يتخفّون وراء شعارات الوطنية، في حين أن ممارساتهم قد لا تختلف كثيراً عن أدوات الحرب النفسية التي تخدم مصالح التقسيم والانقسام.
لا يمكن النظر إلى هذه الظاهرة كحالة سورية خاصة فقط، بل بوصفها جزءاً من نمط عالمي يتكرر في أزمنة الأزمات الكبرى، كما يوضح مانويل كاستلز، الفيلسوف وعالم الاجتماع الإسباني، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تنتج أيضاً شبكات تعبئة للغضب الجماعي، تتحول عبرها المشاعر الفردية إلى حركات جماهيرية رقمية قابلة للتوسع والتطرف. يرى كاستلز أن الطبيعة اللامركزية لهذه الشبكات تجعلها بيئة مثالية لتكريس الانقسام، لأنها تُضخّم الصدمات العاطفية وتُعيد إنتاجها بلا توقف.
إن من أخطر معوّقات مواجهة خطاب الكراهية في سوريا هو ما يمكن تسميته بثقافة تقديس الأشخاص، فحين يتحول الأفراد إلى تماثيل رمزية شبه مقدسة، يصبح المساس بهم، حتى نقداً بسيطاً أو تلميحاً عابراً، بمثابة ارتكاب “فجور فكري” أو “خيانة جماعية”.
هذه الظاهرة هي جزء من بنية عصبوية عميقة وصفها ابن خلدون قبل قرون بأنها “الروح الجامعة للجماعة”، لكنها في حالتنا المعاصرة تحولت إلى أداة تدمير داخلي. يقول ابن خلدون إن العصبية ضرورية لتماسك الدولة، لكنها إذا تجاوزت حدودها المعقولة تحولت إلى سبب سقوطها، لأن “التغلب والاستبداد مؤذن بالفساد”، أي أن العصبويات حين تعمى تفقد غايتها الأصلية في الحماية، وتتحول إلى دائرة مغلقة من الكراهية والصدام.
حين نقدّس الأشخاص، فنحن نتحوّل عملياً إلى وكلاء كراهية ضد كل من لا يشاطرنا عبادة تلك الأصنام البشرية. نغفر الأخطاء، ونتجاهل الكوارث، ونشيطن المختلفين، لأن نقد “الزعيم” أو “الشخصية الرمزية” يُفسَّر تلقائياً كاعتداء على الجماعة كلها. هذه آلية ذهنية خطيرة، لأنها تصنع مجتمعات عاجزة عن المراجعة الذاتية وتحوّلها إلى مصانع إنتاج متواصل لخطاب التحريض. من لا ينتبه لهذه الآلية يقع ضحية لها، إذ نجد مثلاً أن كثيرين من أنصار أي سلطة أو أي تيار سياسي يتحدثون بحدة تحريضية ضد منتقديهم، معتبرين أن الدفاع عن شخص أو مؤسسة أهم من الدفاع عن الحقيقة أو المصلحة العامة.
إن مواجهة خطاب الكراهية تتطلب أولاً تفكيك هذه الأوثان، لأن أي مشروع لمصالحة وطنية أو إعادة بناء مجتمعي لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار القداسة الكاذبة.
ليس تقديس الأشخاص وحده ما يغذي خطاب الكراهية، بل أيضاً موجات التطبيل الشديدة التي تحاصر الوعي السوري. نرى مشهداً سريالياً متكرراً حيث تتخذ السلطة قراراً فتنهال الإشادات من البعض بحكمتها الخارقة، ثم ما تلبث أن تتراجع عنه لتتسابق من جديد جوقة المصفقين لتبجل “عبقرية التراجع الاستثنائية”! هذا التناقض يغذي عقلية الانقياد الأعمى ويحوّل المجتمع إلى مسرح صراع بين من يصفقون، ومن يجرؤون على الاعتراض فيواجهون بسياط التخوين والتحريض.
من المفيد هنا التذكير بأن تقديس الأشخاص وموجات التطبيل ليسا ظواهر سورية فريدة، بل جزء من آليات المجتمعات التي تمر بأزمات هوية أو انتقالات سياسية حادة، لكنها في الحالة السورية تتفاقم لأنها تتداخل مع تراث عميق من الخوف الجماعي والتجارب المتراكمة في القمع والاستبداد. نقد السلطة، أو حتى نقد الزعيم المحلي أو شيخ العشيرة أو رجل الدين، يصبح نوعاً من “الخروج من الجماعة” وتهديداً مباشراً لهوية المجموع، وفي مثل هذا السياق، فإن مواجهة خطاب الكراهية تتطلب أولاً تفكيك هذه الأوثان، لأن أي مشروع لمصالحة وطنية أو إعادة بناء مجتمعي لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار القداسة الكاذبة، سواء لقداسة الأشخاص أو قداسة الخطابات العصبوية نفسها.
هربرت بلومر، عالم الاجتماع الأميركي ومؤسس النظرية التفاعلية الرمزية، قدّم مفهوم “تهديد الجماعة” لتفسير كيف يشعر الأفراد بأن مواردهم أو مكانتهم مهددة بوجود مجموعات أخرى، مما يزيد من احتمالات التحريض والعداء الاجتماعي. بحسب بلومر، فإن هذه الديناميكية لا تعتمد على التهديد الحقيقي بقدر ما تعتمد على تصورات جماعية متخيلة، تتحوّل بسرعة إلى مبررات لصنع أعداء وهميين وتعزيز الكراهية المتبادلة.
في بعض الأحيان، أصبحت قوالب التخوين جاهزة ومعلبة لكل من يتجرأ على التعبير، حتى الفنانين القديرين مثل سميح شقير لم يسلموا منها. هذا الفنان الذي لطالما غنى لسوريا الثائرة، وللكرامة والحرية، صار هدفاً لحملتين من خطاب الكراهية، آخرهما مع إطلاقه أغنية “مزنّر بخيطان”. وماذا كان ذنبه؟ أنه رفض الانجرار وراء غوغائيات اللحظة وأصرّ أن يكون صوته دائماً فوق جهل المتعصبين واستبداد الطغاة. ظاهرة التخويف الجماعي اليوم لا تستثني أحداً، فكل من يرفض الانخراط في جنون الشتائم والولاءات اللحظية يُتهم فوراً بأنه “فلول”، أو يباغته السؤال المعتاد “أين كنتَ من 14 سنة؟”. النساء، تحديداً، يدفعن الثمن الأغلى هنا، لأنهن في كثير من الحالات الأكثر عرضة للترهيب الرقمي، وهن أيضاً الأكثر صمتاً، إلا إذا كنا يتبنين الخطاب الأكثر شيوعاً ذاته فيمارس بعضهن نفس خطاب الكراهية وبقسوة حتى تجاه النساء الأخريات المعنفات ليشاركن في إسكات الأصوات المخالفة لهم/لهن.
الاستهداف لا يطول فقط آراء النساء السوريات السياسية أو الاجتماعية، وإنما التركيز المهين على أجسادهن، وتشويه صورهن وابتزازهن، بل وحتى تركيب صور مفبركة تسيء إليهن بهدف إذلالهن علناً وهذا ما يجب أن يكون مرفوضاً أياً كانت مواقفهن. ما نشهده هنا هو منظومة من العنف الرقمي المركب، تنشط فيها عصابات إلكترونية بلا رادع، لتدفع المرأة خارج المجال العام وتجعلها أسيرة الخوف، وتمنعها من التعبير والمشاركة.
علينا أن نقولها بوضوح وبلا مواربة؛ إن استهداف المرأة عبر جسدها هو مرآة لانهيار أخلاقي وسياسي يضرب أعماق المجتمع. هذا النوع من العنف الرقمي يفتح الباب أمام أخطر الأشكال والمتمثل بعنف سياسي موجه على أساس النوع، يُضاف إلى منظومات العنف الاجتماعي السائدة، ليكمل دائرة الإقصاء الممنهج ضد النساء وضد كل من يدافع عن قضاياهن ومواقفهن أو يتضامن معهن.
وفي خضم التحريض الذي اجتاح صفحات التواصل الاجتماعي السورية، وجد كثير من السوريين أنفسهم في موقع صعب، فهم ليسوا مع الخطاب التحريضي، ولا منخرطين في ماكينة الشتم والكراهية، لكنهم مع ذلك متعبون ومُنهَكون. هذه الفئة التي تحمل عبء المراقبة الصامتة وتشعر بثقل الانسحاب التدريجي من الساحة الرقمية، لأن المشهد بات خانقاً. ليس من الطبيعي ولا المقبول أن يصل الانقسام في الخطاب إلى درجة تجعل الأفراد يشعرون أن وجودهم في الفضاء العام ولو كمتابعين، بات خطراً على صحتهم النفسية وسلامتهم الاجتماعية. النتيجة هنا تفكك روحي وجماعي، وتهديد صريح للسلم الأهلي، لأن خطاب الكراهية والتحريض إذا استمر، فسيتحوّل إلى عدوى مجتمعية تنفجر في لحظة أزمات لاحقة بحدة وتأثير ربما أعظم من كل ما رأيناه سابقاً.
علينا أن نعترف بجرأة بأن خطاب الكراهية في سوريا ينمو على أرضية عدم احترامنا للاختلاف، وإنكارنا لحق الآخر في أن يحمل رأياً معارضاً.
ما نشهده اليوم في سوريا هو تهديد مباشر للسلم الأهلي، لأن الخطاب الرقمي عوض أن يصبح مساحة لإعادة بناء النسيج المجتمعي، صار أداة تفتيت إضافية. لدينا ثقافة ثأر عميقة تُترجم حتى في طريقة تعبيرنا على صفحات التواصل الاجتماعي، فأغلب النقاشات والخلافات تتحوّل إلى معركة وجودية، وكأن السوري لا يستطيع التعبير عن غضبه أو ألمه أو رفضه واستنكاره أو رأيه وموقفه إلا عبر تحويله إلى ساحة تصفية حسابات. نحن نندفع نحو الرغبة في الانتقام من الآخر، حتى لو على حساب كرامتنا وإنسانيتنا ووطننا نفسه. هذا الانفجار العاطفي يأتي من تاريخ طويل من القمع والتأزيم، لكنه في الوقت نفسه لا يعفي الأفراد من مسؤولياتهم؛ فنحن اليوم بأيدينا نعيد إنتاج أيديولوجيا الكراهية بدل الخروج منها.
من المهم الإشارة إلى أن حماية المجتمع من خطاب الكراهية لا تعني المساس بجوهر حرية التعبير، بل تستدعي تطبيق مبدأ “الحد المعقول” الذي تحدّث عنه الفقيه القانوني الأميركي رونالد دوركين، والذي يرى أن الحرية لا تصبح مطلقة إذا ما وصلت إلى نقطة تهدد فيها الحقوق الأساسية للآخرين بالسلامة والكرامة.
علينا أن نعترف بجرأة بأن خطاب الكراهية في سوريا ينمو على أرضية عدم احترامنا للاختلاف، وإنكارنا لحق الآخر في أن يحمل رأياً معارضاً، حتى لو كان ذلك الرأي يخالف السائد والمقبول شعبياً لأسباب ووقائع يطول شرحها. إن جرأة البعض على إطلاق الصفات الجاهزة، ووصم خصومهم بها بلا تروٍّ أو مساءلة ذاتية، هي طعنة في خاصرة أي مشروع وطني يسعى إلى بناء وطن متماسك لا يُقصي أبناءه ولا يشيطن المختلفين.
إذا واصلنا الانحدار في هذا المسار، فلن يكون بمقدور حتى أولئك الذين اختاروا الوقوف على الحياد، أو اتخاذ المواقف المتوازنة، أن يظلوا صامتين أمام موجات التحريض والوصم. وما لا ينبغي أن نستهين به أبداً هو الأثر العميق الذي يتركه خطاب الكراهية في نفوس جيل الشباب السوري، الجيل الذي ينمو اليوم وسط بيئة رقمية هشة، تنتقل فيها موجات الكراهية والتحريض بسرعة خاطفة ليشارك فيها، في ظل غياب قواعد واضحة لاستخدام مسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.
لقد علّمنا التاريخ، من رواندا إلى يوغوسلافيا، أن الصمت أمام خطاب التحريض هو مشاركة غير معلنة في الجريمة. من لا يرفع صوته اليوم ضد الشيطنة والتحريض والتخوين، سيجد نفسه غداً وحيداً أمام آلة الكراهية، تماماً كما وصف القس الألماني نيمولر زمن النازية: “عندما جاؤوا ليأخذوني، لم يكن هناك أحد يدافع عني”.
المصدر: تلفزيون سوريا