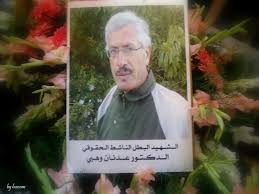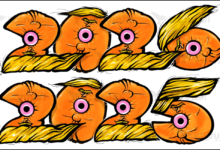تفيد التطورات العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، التي أصابت أوضاع البلدان المغاربية منذ العقود الثلاثة الأولى لبداية القرن العشرين، بأن مفهوم الزعامة السياسية نشأ وتطور في كنف العمل الوطني المعارض لوجود الحماية الاستعمارية، خصوصاً عندما استقرّت وترسخ وجودها في سياق المد الإمبريالي التوسّعي الذي بَرَّر مختلف الطرق والوسائل: السياسية العنصرية، والحربية من تهدئة وتقتيل، والدينية التبشيرية وسواها للغُنْمِ والاغتنام من الوجود الفعلي القائم على السيطرة والاستغلال.
ولم يتبلور ذلك المفهوم، في ما أرى، إلا في علاقة بظاهرتين مترابطتين: دور الفرد في تاريخ النضال وعلى مستوى الممارسة، وهو دور استبدل المفهوم القَبلي المعتمِد على “السيف” والإباء واللفيف والهَبَّة العامة في المواجهة (المخزون العاطفي والعَصَبِي)، بالدور الحضري (أو المديني) الذي اعتمد على التنظيم والاتفاق والتوعية، بما في ذلك القدرة الفعلية على التأطير والتواصل والاقتراح والمواجهة. والظاهرة الثانية أراها على صلة بالصراع السياسي الذي نشب في صفوف الوطنيات المختلفة بحكم طبيعة تكوينها والمنافسات المرتبطة بوجودها في ساحة العمل الوطني، في سبيل تحقيق الاستقلال أو الريادة، أو هما معا، في أفق بناء الدولة الوطنية الضامنة لمصالحها ومصالح من تدافع عنهم في الظاهر. مع العلم أن طبيعة الصراع السياسي المشار إليه كانت، في أحيانٍ كثيرة، (مثال المغرب الأقصى) بسبب التنافس العائلي المرتبط بالمجتمع التقليدي الحامي للأمجاد والأشجار الجينيالوجية التي يراد بمحمولها “العرقي” الأصولي المنافحة عن التَّلائد والرتب الاجتماعية والعلم الديني (المخزون الفكري والفقهي)… إلخ.
ويمكن القول أيضا إن نشوء مفهوم الزعامة السياسية بالمعنى الذي يفيد القيادة الرشيدة المؤهلة وطنياً للدفاع وقيادة العمل الوطني إلى مبتغاه الاستقلالي، أو التحرّر بعامة، كان أيضا من ابتداع السردية السياسية المتأثرة بنمط التفكير الأوروبي العصري حين التحمت تلك السردية، ولم يكن لالتحامها أي طابع ديني قد يفسده عقدياً، بقضايا الصراع الوطني ضد المحتل الأجنبي، فهو مفهوم حديث قوامه الفردية والأهلية، واعتُبِر سلاحاً مفيداً يمكن التسلح به لضمان الفعالية التي كان يتطلّبها العمل المنظم، إلا أنه كان في حاجةٍ إلى مقوّمات وخصائص تزكّيه في نظر الأتباع والمشايعين (أو الشعب) وتعلي به من شأن المَقَام والقِوَامَة (التكليف والمسؤولية) ضد الخصوم والمنافسين والمعارضين جميعاً، لأنه أسلوب قيادة يكون من المفروض أن يتمتع بقدر ضروري من (الشَّرَافَة، أو الجاه الأسري والمالي، العلم الديني، أو العصري، الانتساب إلى الأسرة المدينية أو السلالية، الوعي السياسي والتربوي واللغوي والديني، والقدرة على الاتصال بالناس ومخاطبتهم وتوجيههم) إلخ.
ومن هذه النواحي، أصبحنا في الحقيقة أمام نوع من “الزعامة السياسية” ذات الطبيعة الدينية تقريباً، ووجدنا، في المراحل الأولى لانطلاق الأعمال الوطنية في مختلف البلدان المغاربية تقريباً، أن بعض الفقهاء ذوي النزعات الإصلاحية، ومنهم من تخرّج من الجامعات التقليدية للعلم الديني (القرويين في المغرب، الزيتونة في تونس)، أو كانوا على ارتباط بالجمعيات الدينية الإسلامية (جمعية علماء المسلمين، 1931 في الجزائر، الجماعة الإسلامية الليبية 1949..)، هم الذين تصدّروا العمل الوطني، ولم ينافسهم في الشرعية المكتسبة غيرهم إلا جزئياً، رغم ارتكاز مواقف المنافسين وعملهم على التأويل الذي أولوا به تصوّرات الفكر الليبرالي الغربي، واستعدادهم من خلال الاحتكاك أو الاقتناع بأهمية الديمقراطية من الوجهة التطورية وفي إدارة الحكم.
يقال هذا مع الاعتبار أن العمل الوطني كان مرتبطاً، من جانب، بالعمل الإسلامي نفسه، وفي الجوهر منه، باستعادة أمجاد السلف الصالح، اعتماداً على تأويل ماضوي يتمنطق بالإصلاح والحفاظ على الدين ومحاربة الضلال والشعوذة وسوى ذلك (السلفية الجديدة والوهابية). كما أنه كان، من جانب آخر، في سبيل استعادة هوية وطنية مسلوبة تتعرض للمحو بالصفات والخصائص التي كانت عليها، ولخطر التبشير المسيحي الرامي إلى تحجيم الإسلام دين الجماعة، وفي علاقة بذلك الإجهاز على لغة القرآن التي هي أيضا لغة العبادات والأعمال والمعاملات.
عُدَّت الزعامة السياسية، من زاوية الممارسة العملية في ميدان العمل الوطني، مرتبطةً بالقدرة التي يملكها الشخص، بسبب تكوينه وملكاته لقيادة الآخرين
ولهذا، عُدَّت الزعامة السياسية، من زاوية الممارسة العملية في ميدان العمل الوطني، مرتبطةً بالقدرة التي يملكها الشخص، بسبب تكوينه وملكاته لقيادة الآخرين والتمكن من أنهم ينفذون ما هو مَذْكُورٌ في خطبه أو مُسَوَّدٌ في برامجه. ويتطابق هذا المفهوم إلى حد واضح مع ما كان قد حدّده ماكس فيبر لارتباط مفهومه الخاص بالقيادة السياسية للأفراد الخاضعين لـ”سِحْرِ” القائد السياسي، خصوصاً عندما يقودهم، بالضرورة، في الطريق السويِّ من أجل الوصول إلى أهدافٍ خاصة أو مشتركة مع غيره. وهذا النوع من القيادة السياسية ضروري، أو “لا محيد عنه” في المجتمع بتعبير فيبر، وخصوصا في “ظروف الأزمات” التي تبرز فيها الحاجة إلى “قائد جديد” عليه أن يكون قادراً على “الاتصال والتواصل مع المشايعين له موجها ومشعرا إياهم بأن لهم السلطة لبلوغ أهدافهم”.
وبناء على التقارب المفهومي، والالتقاء الضمني بين الزعيم السياسي الوطني الذي تجسّده العلاقة بين الراعي والرعية بالمعنى العام والقائد السياسي الذي يكون من بين أهدافه خوض الصراع من أجل السلطة عن طريق “السيطرة البدنية والرمزية”، مع تحليه بالـ”إيطوس” (المزايا العامة والصفات بالمعنى الإغريقي) التي تشخص ذلك، من السهل فرضياً أن نعثر على ترابطات مختلفة تقوم على فلسفة التفكير الغربي، الفرنسي تحديداً، الممجدة والرافعة من شأن الفرد في التصوّر، ودوره على مستوى ما، في حركة التطور التاريخي للمجتمع الناهض. ويبدو لي أنه بناء على ذلك، أو بالاستفادة البرغماتية من أثره، حيثما بدا في مجرى التطور التاريخي للدول المغاربية، اعتبارا للخصوصيات الوطنية النوعية التي طبعت ذلك بما في تكوينها من عناصر متميّزة، حيثما أصبح لمفهوم الزعامة السياسية الوطنية مبرّره الواقعي المنسجم إلى حد ما مع طبيعة الذهنية السائدة، الواعية بذاتها، في مجال العمل الوطني الناهض. أي الوقوع على المبرر الذاتي الذي يسهل للخصوصية الوطنية (المحلية) البحث عن السند الذي يزكي دورها في الممارسة السياسية.
المثال على هذا أن الزعامة السياسية في المغرب (علال الفاسي، مثلاً) استندت إلى السلالة الحاكمة (الأسرة العلوية) ولمفهوم “البيعة” التي كانت لها، وإلى “المخزن” التاريخي ككيان للدولة المنظّمة (وقعت عليها الحماية الفرنسية) وإلى السلفية الجديدة وما هو في تأويلها من مقومات: الماضي الصافي، اللغة العربية، الدين القويم الخالي من الشعوذة… إلخ. ولم يحدُث ما يماثل ذلك في ليبيا بصورة واضحة، رغم الشرعية التي استعادها السنوسيون، إلا في علاقة بثورة الفاتح من سبتمبر (معمّر القذافي مثلاً) التي استندت بالتبعية إلى الاختيار الناصري وإلى النزعة القومية عموماً التي كانت تلهب شعور العاملين في سبيل الوحدة العربية من خلال الانقلاب الذي أحدثوه في البيّنات وفي الذهنيات في أكثر من قُطر. ويمكن أن نجد في موريتانيا كيف أن الاحتماء بالوسط الاستعماري الفرنسي، والاستناد إلى الطبيعة القبلية التي نهضت عليها الدولة بعد الاستقلال مباشرة، ساهما في بروز الزعيم السياسي المختار ولد داداه محرّراً وطنياً لمقاومة التوسّع المغربي والدفاع المستميت، بإيعاز من النزعة القومية أيضاً، عن كيان مستقلٍّ عن المغرب، وليس بالضرورة عن الاستعمار الفرنسي. ويمكن أن نجد في تونس كيف اعتمدت الزعامة على فكرة التحرير الوطني (بإزاء الهيمنة التركية) وعلى “القومية المغاربية” (مكتب تحرير المغرب العربي في القاهرة، والتأثير الذي مارسه عبد الكريم الخطّابي في تلك الدائرة) النابعة من فكرة التحرير نفسها، ولم يبرز الحبيب بورقيبة، كزعيم سياسي متنفذ، إلا بعدما ربط النضال الوطني التونسي بالفكرة القومية وسعيه إلى القضاء على النظام الموروث (البايات) والانفراد بالسلطة.
لم تشذّ الثورة الجزائرية عن قاعدة السند لبناء الزعامة السياسية إلا في بعض التفاصيل المرتبطة بقصّة المقاومة والتحرير
ولم تشذّ الثورة الجزائرية عن قاعدة السند لبناء الزعامة السياسية إلا في بعض التفاصيل المرتبطة بقصّة المقاومة والتحرير. والمقصود بهذا أن الثورة الجزائرية، من الناحية التنظيمية، كانت ثورة مجموعات سياسية مقاتلة، تشكّلت حسب جهات وطنية ترابية، فأصبحت المجموعة، مع تمايزاتٍ مختلفة بين أفرادها، هي القائد الجماعي. وتَمَّ، بعد الحصول على الاستقلال، أن كانت الجزائر، في علاقة بقيام الدولة الوطنية الجديدة التي تنازل عنها المحتلون الفرنسيون بموجب اتفاقيات إيفيان (مارس/ آذار 1962)، في حاجة إلى قطب تنظيمي حديث وجديد لقيادة البلاد والشعب، يحظى بالمصداقية النضالية (مليون شهيد)، اعتماداً على الاختيارات التي صاغتها جبهة التحرير (العقل الجماعي) في مرحلة التحرير، ضدّاً على النخب العالِمة والليبرالية، ومن أجل أن تكون لها السيادة الشاملة على جميع المستويات. ويبدو أن أحمد بن بلة كان هو الزعيم الاستقلالي المرشّح بعدما احتمى بسند الاختيار القومي ذي البعد الاشتراكي المتسلح بالشرعية النضالية المُقَاوِمَة القادرة وحدها على “إقناع الشعب” وقيادة البلاد، غير أن هواري بومدين، مع آخرين، سارع إلى تحويل “مجموعة وجدة” إلى قيادة للجيش وللدولة في الاتجاه المرسوم نفسه وبالسند المُعَلَّل نفسه، وحوَّل نفسه أيضاً إلى زعيم عالم- ثالثي بالمواصفات نفسها التي كانت للزعيم الذي انقلب عليه. وما يمكن قوله في ذلك إن زعامته لم تُدِنْ له، بصورة حاسمة، إلا باغتيال، أو نفي، جميع القادة (الزعماء السياسيين المحتملين) مع احتمائه بالنظرية “الثورية” المعلنة في إطار “الاشتراكية العربية” المفترضة.
سؤال أبلوره في سياق هذا التحليل: ألا يمكن القول إن الزعامة السياسية التي ولدها العمل الوطني، سواء من خلال التنظيم والنضال والمساومة، أو من خلال الانقلاب ومناورة الظروف الاستثنائية وتصفية خصوم هي التي كرست في الثقافة السياسية وعلى صعيد النخب مظاهر الاستبداد (النابعة من سلطة الفرد والمؤسّسة التي يتحكم فيها)؟
المصدر: العربي الجديد