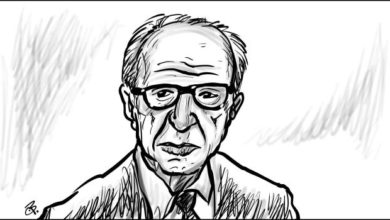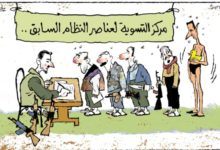تزدحم الساحة السياسية المصرية بعدة تناقضات، خاصة في ضوء تقييم التجربة الحزبية بوضعها الحالي، وأهمها المفارقة بين العدد الكبير لهذه الأحزاب ونشاطها العام، إذ تزيد عن مائة حزب، وقد تكاثرت عبر موجتين: الأولى عقب ثورة يناير في 2011، بتشكيل رموز محسوبين على الثورة ولديهم تاريخ من العمل السياسي أحزاباً، مثل محمد البرادعي الذي شكل حزب الدستور، وتلاه “مصر القوية” الذي أسسه عبد المنعم أبو الفتوح ومجموعات من الشباب، وشكلوا جناحاً من جماعة الإخوان المسلمين في السابق، بالإضافة إلى حزبي الوسط والكرامة لمؤسّسه حمدين صباحي، واللذيْن نالا الشرعية القانونية في أعقاب الثورة. بالإضافة إلى حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي الذي خرج جزء كبير من أعضائه من حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.
وتزامن نشوء هذه الأحزاب مع حيوية سياسية رافقت الاستحقاقات السياسية في هذا الوقت، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2012، والتي رسَّخت بنتائجها ظهوراً واضحاً لمعسكر المعارضة المدنية اليسارية والإسلامية والليبرالية .
بينما ظهرت الموجة الثانية عقب تظاهرات 30 يونيو وبيان 3 يوليو (2013)، والانقلاب على حكم جماعة الإخوان، إذ بدأ ظهور عشرات الأحزاب الأخرى، وكان أغلبها مقرّباً من السلطة، منها حزب المصريين الأحرار ومستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري.
وأسّست هذه الأحزاب مجموعات متنوعة من ضباط الجيش والنواب السابقين ورجال أعمال احتاجوا إلى نفوذ سياسي يدعم قوتهم الاقتصادية، وأغلب هؤلاء ممن مارسوا السياسة كانوا أعضاء بارزين في الحزب الوطني الديمقراطي والذي حلّه القضاء عقب ثورة يناير، وحاولت كل من هذه الأشكال تقديم نفسها ظهيراً سياسياً لنظام عبد الفتاح السيسي. ويبدو أننا بصدد الموجة الثالثة بنشوء حزب “الجبهة الوطنية” الذي يرعاه إبراهيم العرجاني، وضم رموزاً ناصرية وليبرالية سابقة، تميزت بتغيير المواقف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوزراء السابقين، وبعضهم يعمل في شركات العرجاني، الأمر الذي يمثل نوعاً من تضارب المصالح. إلى جانب ذلك، هناك حزب الوعي، ويضم عدداً من جيل الوسط المقرّب من أجهزة الدولة.
جدير بالذكر أن عدد الأحزاب السياسية في مصر الذي لم يتجاوز رقم الآحاد منذ نشأة التعدّدية الحزبية الثانية، حيث أحزاب التجمّع التقدمي والعمل والناصري والوفد والأحرار، والتي عكست نفوذ زعامات تقليدية، على غرار فؤاد سراج الدين وإبراهيم شكري، بالإضافة إلى مصطفى كمال مراد وخالد محيي الدين العضو السابق في مجلس قيادة ثورة 23 يوليو (1952). لحقت بها أحزاب أخرى في فترة الحراك السياسي الذي بدأ عام 2005، مثل حزب الغد والإصلاح والتنمية والمحافظين.
نجحت حركات اجتماعية وجبهوية، على غرار حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل، في تحقيق نجاحات كبيرة أدّت إلى مسار التغيير بثورة يناير
هناك عدة تناقضات واضحة في تقييم الظاهرة، أبرزها التناسب العكسي بين عدد الأحزاب وحالة الانفتاح السياسي، إذ يظهر هذا المشهد حيوية بالغة الحضور لهذه الأحزاب، في ظل نظام حسني مبارك، بالرغم من محدودية عددها، ظهر في حصول جماعة الإخوان المسلمين على ما يزيد على 88 عضواً من مقاعد مجلس النواب في 2005، ثم استجابة نظام مبارك بإجراء أول انتخابات سياسية تعددية في العام نفسه، بالإضافة إلى ظهور الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وتزايد دور النقابات المهنية والعمّالية والحركات الشبابية. كما أسهمت أحزاب ما بعد “25 يناير” إيجابياً في بلورة الحراك السياسي لأجيال من الشباب الذين خاضوا غمار ثورة يناير وانتخابات الرئاسة عام 2012. وعلى العكس، لم تشهد الظاهرة الحزبية التي تكاثرت بوضوح عقب 2013 بإنشاء عشرات الأحزاب المشار إليها سابقاً في أي حالة حراك سياسي واجتماعي، ولم تتضح لها اتجاهات أيديولوجية، يميناً أو يساراً، أو يبرز لها توجهات اقتصادية في نقد سياسات الدولة التي جنحت نحو الاقتراض وبيع الأصول والتخلّي عن الإنفاق والدعم الاجتماعي.
ويلاحظ أن أغلب أحزاب هذه الموجة كان محسوباً على أجهزة بعينها، ولم تعكس التعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، وليس لها جذور في العمل العام، ولم تأت قياداتها من حركات مجتمعية وجماهيرية سابقة، بل هبطت “بالباراشوت” على ساحة العمل السياسي، وعكست تكوينات وشبكات مصالح لأعضائها الذين جاؤوا من خلفيات عسكرية أو بيروقراطية سابقة، وحظيت بوجود برلماني ضمن سياق نظام انتخابي أعطاها هيمنة واسعة من خلال نظام القائمة المطلقة، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ توريث المقاعد العائلية من خلال تلك القوائم. وأضافت هذه التعدّدية الشكلية ملمحاً استبدادياً واضحاً من خلال تقييد الحياة السياسية والحزبية على كل المستويات، وهيمنة الدولة على أجهزة الإعلام، وتصاعد الهجمة على المخالفين في الرأي، وحبسهم احتياطياً بقراراتٍ من نيابة أمن الدولة، وهو ما يؤكد المشار إليه أعلاه.
وفي هذا السياق، يأتي إنشاء حزب الجبهة الوطنية الذي حظي بأسرع موافقة في التاريخ السياسي المصري، إذ نجح في استكمال توكيلاته، والتي جاء أغلبها بحشد المواطنين الذي قاموا بها مقابل مكافآت مالية. ولك أن تقارِن هذا بوضع أجهزة الدولة عشرات العراقيل أمام حزب تحالف “حزب الأمل” وقائده أحمد طنطاوي، باستكمال التوكيلات اللازمة لإنشاء الحزب وقبلها في الانتخابات الرئاسية، بل حبس عشرات من أعضائه المؤسّسين.
أضافت التعدّدية الشكلية ملمحاً استبدادياً واضحاً من خلال تقييد الحياة السياسية والحزبية على كل المستويات
في المجمل، تطرح هذه المفارقات ضرورة تقييم تجربة التعدّدية الحزبية الثانية في مصر، والتي أسّست في 1976 بتكوين نظام المنابر، ثم تحوّلت إلى أحزاب، مثلت اليمين والوسط واليسار، وهو ما تحوّل لاحقاً إلى غضب من الرئيس أنور السادات على الأحزاب التي عارضت سياساته، وهو ما حدث مع أحزاب التجمّع والوفد والعمل الاشتراكي. وفي المقابل نجحت حركات اجتماعية وجبهوية، على غرار حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل، في تحقيق نجاحات كبيرة أدّت إلى مسار التغيير بثورة يناير. ويطرح هذا ملمحاً آخر بغياب الأحزاب الجماهيرية القوية التي تعبر بشكل واضح عن فئات اجتماعية، وتضم آلاف الأعضاء. ويقابل ذلك عزوف المواطن المصري عن العملين، الحزبي والسياسي. واعتباره غير معني به، لمخاوفه من إغضاب أجهزة الدولة أو التعرّض لمضايقات أمنية.
وبغض النظر عن الأسباب القانونية والسياسية التي حاصرت العمل الحزبي في مصر، واعتبرته مجرّد شكل ديكوري، ولا يسمح لهذه الأحزاب بالنشاط الجماهيري الحقيقي. ساعد على ذلك ابتعاد الأحزاب نفسها عن العمل داخل القرى والمدن، وتكوين مجموعات ناشطة على المستوى القاعدي أفقياً، وهو ما يحتاج إلى اجتهاد حزبي، للخروج من هذا المأزق، وكسر هذه الدائرة المغلقة.
المصدر: العربي الجديد