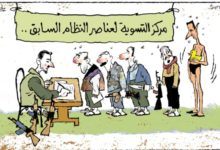إبّان احتلال لبنان عام 1976، احتل شبان فلسطينيون فندق سميراميس في دمشق. بعد قليل، وصل حافظ الأسد إلى المكان. عندما سأل اللواء ناجي جميل عن الوضع، أخبره أنهم طالبوا بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون السورية، وتعهدوا ألا يلحقوا أذى بمن احتجزوهم، فقال له بغضب: لو طلبوا عشر ليرات سورية مقابل إطلاق رهانئهم لما أعطيتها لهم، وأمره بالهجوم على الفندق. بعد انتهاء العملية بقتل الشبان الأربعة وعشرات السياح، ظل مدير الفندق يتساءل طوال أشهر، وهو يضرب كفّا بكفّ: أين ذهبت الملاحف والشراشف وأغطية الأسرّة وبرادي النوافذ وكراسي الغرف وطاولاتها، وموجودات نزلائه، إذا كان الإرهابيون قد غادروه جثثا هامدة؟
بنى الأسد الأب نظامه على مبدأ أمر ابنه بأن يتمسّك به في جميع الظروف، رفض كل ما طلبه خصوم النظام ونقّاده السوريون، والمحافظة على النظام ضد أي تغيير مهما كان تافها، وسحق المطالبين به، كائنا من كانوا، ورؤية أي أمر انطلاقا من كمال الأمر القائم، والحذر من التنازلات، وخصوصا الصغيرة والجزئية منها، التي يؤدّي قبولها إلى انهيار النظام، كما ينهار بناءٌ كبير انتزعت حصاة صغيرة من أحد جدرانه. وقد عبر “الولد” عن التزامه بـ”حكمة” أبيه، وأخذ يكرّر جملةً، في أحاديثه مع مستشارية المقرّبين، ملخصها: “هادا شعب حقير، إذا مسّكته إصبعتك الصغيرة بيصير بدو إيدك كلها، وما له شغله إلا ينق، وما بيستاهل ينرد عليه بغير الصرماية”.
وكان الأسد قد أخبر، أخيرا، أحدهم أنه سيُخرج الروس من سورية بالصرماية التي فهم محدّثه أنه يعني “جمهورية إيران الإسلامية” التي كشف أمين سر “مجلس الشعب”، خالد العبود، عن ضلوعها في خطة لإسقاط بوتين، وذكّر الكاتب الروسي، من أصل فلسطيني/ سوري، رامي الشاعر، الذي انتقد النظام الأسدي، بأن هذا استقدم إيران إلى سورية استباقا لمعركته مع روسيا، التي استقوى بها على الأميركيين، وستنتهي مهمتها بخروجهم من “القُطر المقاوم”، وأن من الأفضل لموسكو قبول نظامه في الصيغة التي ورثها الولد عن أبيه، والتسليم بأنه رئيسٌ لا بديل له لنظام هو أكمل النظم، وأن مطالبتهم بتغييره أو بإصلاحه يعادل انضمامهم إلى المؤامرة الكونية عليه، ومواجهتهم بالحرس الثوري الإيراني، “صرمايته” المتربصة بهم، والقادرة على ردعهم وإخراجهم من عرين الصمود والتصدّي.
وكان وزير الخارجية الروسي، لافروف قد تبنّى، لشدة ذكائه، نهجا أدّى إلى تلاشي خيارات موسكو السياسية، بقدر ما تعاظم انخراطها العسكري في سورية، فلا عجب أن يواجه اليوم أحد خيارين: إعادة النظر في علاقاته مع شريكيه، الإيراني والسوري، وفي موقفه من تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، أو فشل خطة بوتين للانفراد بسورية، وتحويلها إلى قاعدةٍ يستعيد ما كان للسوفيات من حضور ونفوذ في الدول العربية بواسطتها، وتبدّد أوهامه حول ما لمشروعه السوري من أولويةٍ، بالمقارنة مع المشروع الإيراني، بالنسبة للأسد أيضا، وحول دوره موزّع أنصبة الغنيمة السورية وحصصها بعد الحرب، والذي يتبيّن اليوم أنه لم يعد دورا يرى الآخرون أنفسهم بدلالته، وأن سيد موسكو لا يستطيع تحقيق أهدافه بوجود منافسه الإيراني في دمشق، وانحياز بشار الأسد إليه، بما أورثه أبوه له من وفاءٍ يجعل من المحتمل أن يردّ على رغبة موسكو في تطبيق القرارات الدولية، بمطالبتها بقصر دور جيشها على المجال الاستشاري وحده، وخفض عدده وسلاحه، ومرابطة قواتٍ أسدية في قواعده، تحاشيا للمشكلات التي قد تترتب على انتشاره في سورية مع العرب وواشنطن، واحتراما لسيادة سورية. لهذه الأسباب، قيل إن بوتين نقل المسألة السورية إلى وزير الدفاع، في إقرارٍ آخر بالفشل، فالدول تكل الحروب إلى الجنرالات والحلول السياسية إلى الدبلوماسيين، لا العكس.
دخل الكرملين سورية ليفوز بها ويقرر مصيرها. ما أعظم المسافة بين أوهامه والواقع.
المصدر: العربي الجديد