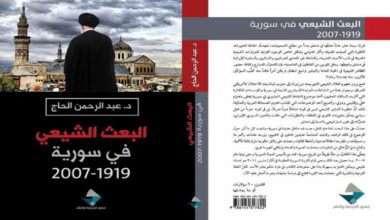كنا صغارًا نلقّب أغبياء المدرسة بالبراميل، ونطلقُ على الشخص الغبي عمومًا (البرميل). حدثني على الهاتف النقال؛ معرِّفًا بنفسه: – أنا البرميل الذكي، رمتني طائرة حوامة منذ ثوانٍ فوق حلب، فبدأت أهبط إلى الأرض. – كم أنا سعيد برؤية أقدم مدينة في التاريخ؛ مخترقًا قطعان الغيوم، تتداعى في رأسي أفكار خلال سقوطي إلى الهاوية! بحث عن مكان آمن ولائق بسقوطي، لكنني اكتشفت أنني الضحية والقاتل في آن معًا، وأدركت متأخرًا أنني برميل غبي فحسب، سأتفجّر بعد قليل رغم أنفي. صممت أن أختار مكان سقوطي، سأنزل فوق دورة مياه في الحديقة العامة، سأبتعد عن روضة الأطفال، ولن أسقط فوق شجرة الياسمين التي بجانب تمثال أبي فراس الحمداني، يحتمي في ظلها عاشقان، وتزقزق فوقهما بضعة عصافير. أرى معالم الأرض بوضوح، وأشهد السيارات تتسابق كالخيول في شوارع المدينة العريقة. سألتُ: – لمَ تتقاتل كائنات صغيرة على طرفي زقاق عند (باب الفرج)؟ – لن أختار الروضة مكانًا للسقوط. أنا حزين؛ لأنني لا أستطيع الوصول إلى الحديقة، أساق إلى حيّ سيف الدولة سوقًا، إلى أبنية لجأ إليها أطفال ونساء؛ هربًا من الأحياء القديمة، بعيدًا عن ساحة الحرب، إنهم نيام، أشاهد بعيني طفلًا رضيعًا يحتضن ثدي أمه بحنان. – أين أنتَ أيها الأمير الحمداني؟ وبلاطك كان يضم المتنبي وأبا فراس والفلاسفة والعلماء. بعد قليلٍ سأصل إلى الأرض وأنفجر، لتنتظر الروضة والحديقة برميلًا غبيًا آخر، عليّ أن أستيقظ من حلمي ومن هذا الكابوس، لقد ظننت أني برميل ذكي، أتحكّم بمصيري، ولي حق الاختيار. نهايتي ليست سعيدة ولا جميلة، وكيف يسعد من كان مدمِّرًا وقاتلًا ومقتولًا؟ أشحت بعينيّ عن الطفل الرضيع. أحسُّ باضطراباتٍ مزعجةٍ في جوفي، تسكن في بطني نفاياتٌ معدنيةٌ قذرةٌ، وثقيلةٌ، ومصابةٌ بداء الصدأ. سأُخرج ما في أحشائي، وأرمي بها بعيدًا عن هذه العائلة؛ شفقةً عليها، وإكرامًا لذاك الأمير. بحثتُ عن الفتحة الوحيدة، فوجدتها سُدَّتْ بفتيل مشبع برائحة النفط الأسود. أنا البرميل الغبي، لا أملك حرية السقوط، وسدوا فمي بإحكام. وداعًا، عذرًا عن إطالة المكالمة، الآن أتفجّر، وأتشظّى.