
يلخص كتاب “مصر الثقافة والهوية” للباحث خالد زيادة، شخصية مصر السياسية والثقافية في جانبها الفكري النهضوي. وفي جانب منه، يمكن اعتباره استكمالاً أو امتداداً لكتاب “كاتب السلطان/حرفة الفقهاء والمثقفين”، فهو محاولة لـ”رصد تطور السياسة في مصر، بالتوازي مع تطور دور المثقف منذ بداية القرن التاسع عشر، وحتى السنوات الأخيرة”(على الهامش يمكن رصد كتاب آخر عن دور الفنون والسينما في صناعة الهوية المصرية).
يقول زيادة إن الخوض في هذه المحاولة يحتاج إلى أمرين. الأول، “تعيين المثقف، ومتى ظهرت الشخصية والتسمية، والأمر الآخر هو وضع الاسئلة في إطار تجربة تاريخية محدّدة”. والمثقف بالمعنى الذي يقدّمه خالد زيادة يختلف عن المثقف بالمفهوم الفرنسي التقليدي أو المفهوم الذي سوّق له جان بول سارتر وإدوارد سعيد باعتبار أنّ وظيفته النقد ونقد السلطة تحديداً، “فظهور المثقف وبروزه سبقا التسمية” بحسب زيادة، وعادة ما تطلق التسمية على “أولئك الذين اكتسبوا شيئاً أو بعضاً من ثقافة الغرب، الذين احتلوا وظائف لم يكن العالم التقليدي الفقيه يقوم بها”. فقد ورث المثقف الحديث، طرفاً من وظائف العالم، واستحوذ على وظيفة كاتب الديوان، لكن هذا المثقف، على عكس العالِم التقليدي، يدين بوجوده إلى مشروع الدولة الحديثة، وتبني الدولة لأفكاره. ومنذ بداية الحملة الفرنسية على مصر وحتى نهاية عهد الخديوي اسماعيل، تغيرتْ مصر تغيراً كبيراً، لا في بناء المؤسسات فحسب، بل في إزاحة النظام التقليدي أيضاً الذي كان يوزّع النفوذ على ثلاث هيئات: رجال الدين أو العلماء، ويشار اليهم باسم “العلمية”، وكتّاب الإدارة الذين يعرفون بأهل القلم أو “القلمية”، والعسكر الذين تناط بهم حماية الدولة والحفاظ على أمنها، وهم “السيفية”. وباشر الفرنسيون في زعزعة هذا النظام، فيما انتزع محمد علي، من العلماء، امتيازاتهم وأبعد الزعامة الدينية، ولم يتوان عن إثارة البغضاء بين كبارهم، وألزمهم في نهاية الأمر بالاكتفاء بوظائفهم كمدرّسين في الأزهر. وفكك جهاز الكُتّاب الممثل في المحاسبين الأقباط، ارتكب مذبحة القلعة بحق المماليك واستأصل أي أثر لهم. وتقلّصت الهيئات التقليدية في الدولة، وحلّ مكان العالِم الأزهري، الخبير المتخصص الذي لا يرث العِلم عن أساتذته ومشايخه، بل يأخذه من عالِم آخر.
وكان افتتاح قناة السويس محطة أساسية في الكثير من التغيرات في مصر، فهو حرض على بناء قاهرة جديدة… وفي عهد الخديوي اسماعيل، توطدت الإدارة البيروقراطية واتخذت شكلها الحديث لجهة المهمّات التي تؤديها، وأدى انشاء مدرسة الحقوق إلى تخرّج نخبة ستكون لها أدوار بارزة في الحياة الثقافية والفكرية المصرية. ونشأت النهضة الأدبية والتربوية والصحافية، وكانت لها رموزها مثل الشيخ علي مبارك، وهو مصري الأصل وَرَد اسمه في البعثة التي تعرّف ببعثة الأجيال في العام 1844 والتي ضمّت اسماعيل (الخديوي لاحقاً)، وعدداً من الأمراء، وكانت وجهتها فرنسا.
تلقى مبارك خلال مسيرته العلمية، تدريباً عسكرياً وخبرة علمية خوّلته إنشاء دار العلوم (1872) التي كان لها دور في إعداد المعلمين وفي ارتقاء العربية الفصحى. وما يمكن استخلاصه من تجربة مبارك هو أنه يمثّل أولئك الأشخاص الذين نشأوا وتعلّموا في زمن محمد علي باشا، وظهرت آثار خبرتهم في ظل حكم الخديوي اسماعيل، وهو “مثال للمثقف النهضوي الذي يفهم دوره في المشاركة في بناء مؤسسات الدولة المصرية”، ويؤمن بـ”أن تقدّم مصر يأتي عن طريق التربية والتعليم”.. وعلى هذا يمكن مقارنته برفاعة الطهطاوي الذي هو نتاج مشروع الدولة ووظائفها، إلا أن السمة التي ميّزت الطهطاوي هي أنه “عمل في حقل الثقافة بالمعنى الواسع للكلمة”. وإذا كانت مقارنة الطهطاوي بمبارك تفيد في إطار المزايا التي تمتع كل منهما بها في إطار التجربة الواحدة، فإن مقارنة الطهطاوي بالجبرتي “تُظهر المقدار الذي أحرزته مصر في مجال الثقافة وانبثاق الفكرة الوطنية”.
وإذا كانت الحملة الفرنسية، وتعلّم بعض الشخصيات المصرية في باريس، شكّلا محطة بارزة في بناء الهوية المصرية، فثورة 1919 شكّلتْ فاصلاً في تاريخ مصر الحديث، وقد عبّرت عن التطور الذي أحرزته مصر خلال قرن من الزمن، في المجتمع والسياسة والثقافة. فالنخبة التي أخذت على عاتقها المطالبة بالاستقلال، تكونت من مجموعة كان معظم أعضائها من خريجي مدرسة الحقوق، وذوي باع في الحياة العامة وأعضاء في الجمعية التشريعية، وكوّنت فكرة الثورة في حد ذاتها إجماعاً سياسياً تلقائياً وفريداً، ومن هنا أهميتها التاريخية. وأفسحت المجال العريض للمثقف الذي اضطلع بأدوار سياسية مباشرة أو غير مباشرة، وكان صاحب الرأي في الأحداث، وأخذ على عاتقه مهمة إنجاز المواقف وصوغ البرامج والرؤى، في صوغ هوية مصر. وغيّرت الثورة تعريف المثقف، فما عاد الفقيه الأزهري كما في بداية القرن التاسع عشر، ولا الخبير من خريجي مدارس محمد على باشا. واعتُبرت العقود الثلاثة التي أعقبت ثورة 1919 بمنزلة المرحلة الليبرالية في تاريخ مصر الحديث. خلال هذه الفترة، أصبحت مصر مركز الثقافة العربية، وكانت قد اجتذبت من سبعينات القرن التاسع عشر، المثقفين الوافدين من بلاد الشام، خصوصاً من لبنان. وساهم بعض هؤلاء في نهضة الثقافة والصحافة والفنون، وكانوا في غالبيتهم من المسيحيين.
ومع الليبرالية المصرية ولدتْ أحزاب تعبّر عن اتجاهات متباينة تحت سقف المواطنة، وتؤمن بأن تقدّم المصريين يكون عبر التربية وعبر الممارسة الدستورية… إلا أن التجربة الليبرالية لم تمتد سوى سنوات قليلة، من العام 1922 إلى العام 1936، بحسب الباحثة عفاف السيد، إذ عصفت الانشقاقات بحزب “الوفد”، حزب الأكثرية، واستعرت الصراعات بين الأحزاب، ما أدى إلى اندحار الليبرالية، وظهور التيارات الأصولية الجماعية على حساب الفرد.
وبرز الكثير من الشخصيات الثقافية المصرية مع ثورة 1919، من محمد حسين هيكل إلى سلامة موسى وعبد الرحمن الرافعي، وأصبح عباس العقاد ناطقاً باسم الثورة، وتحوّل إلى كاتب للمقالات السياسية في الصحف، وكانت له مواقفه. فدافع عن علي عبد الرازق، صاحب كتاب “الاسلام وأصول الحكم”، واعتبر أن القضية تتعلق بحرية الرأي، بينما وقف الزعيم سعد زغلول مؤيداً قرار تجريد عبد الرازق من درجته العلمية وإخراجه من هيئة كبار العلماء. كما وقف العقاد إلى جانب طه حسين في قضية محاكمته بسبب كتابه “في الشعر الجاهلي”، بالرغم من أن حسين كان آنذاك من معارضي حزب “الوفد”. وتمثل تجربة العقاد نموذجاً للعلاقة الملتبسة بين المثقف والسياسي. فهو، بحسب زيادة، أراد أن يستخدم معرفته وقلمه في خدمة ما يعتبره معتقده ووطنيته،” لكن الفرق بين المثقف والسياسي هو نتيجة حتمية لافتراق منطق الثقافة عن منطق السياسة”. ومع أن العقاد كان نائباً، لكن شهرته ككاتب طغت على عمله في السياسة. واجتمعت عناصر كثيرة لتجعل طه حسين الأكثر وحضوراً وشهرة في زمانه، ولهذا أسبابه الكثيرة. وأدى المثقفون الليبراليون، من مؤرخين وكتّاب، في المرحلة الليبرالية، دوراً بارزاً في إعلاء الوطنية المصرية، وفي إضفاء أبعاد تاريخية بين الانتماء الى الحضارة الفرعونية والانتماء إلى الثقافة المتوسطية والثقافة العربية.
لكن، لم يبق القدر الكبير من آثار المرحلة الليبرالية، بعدما أصبحت جزءاً من التراث الثقافي وتاريخه. فلم يبق من أحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل، شيء يذكر، سوى سيرة الأول ورواية “زينب” للآخر، لسبب واحد فقط هو أنها أول، أو من أوائل الأمثلة على كتابة الرواية. أما العقاد فإن أعمالة دخلت في طي النسيان. وحده طه حسين بقي علامة على الثقافة الليبرالية، وقد نُسيت أعماله الإسلامية، التي لا يعود إليها الاسلاميون لأنها لا تخدم أغراضهم، فيعود الليبراليون إلى كتابه “مستقبل الثقافة في مصر” باعتباره يحمل مشروعاً، على الرغم من أن أجزاء من هذا المشروع تحقق في الدولة الناصرية.
وفي كتابه “المسألة المصرية”، يحلّل صبحي وحيد، بأن مصر عرفت موجات عبر تاريخها، وآخرها الموجة الغربية، ففرضت أوروبا ثقافتها لدى النخبة وفرضت قوانينها ومصالحها، إلا أن هذه الموجة التي بدأت مع حكم محمد علي باشا، بقيت آثارها سطحية، بالرغم من أخذ قوانينها وأفكارها. كان من آثارها، إهمال التراث لدى النّخب المغرّبة، من دون استيعاب تطور أفكار الغرب وتجربته. لقد عُوّل على دور التربية في صوغ المواطن وإعداده عبر التعليم وتمثل قيم التمدّن، لكن المشروع التربوي لم يحقق أغراضه المتوخاة، كما أخفق مشروع تمصير الاقتصاد الذي أصبح رهينة الاقتصاد الرأسمالي العالمي. فكان كتاب صبحي وحيد، الذي صدر قبل حركة الضباط الأحرار، بسنتين، أشبه برسالة نعي للحقبة الليبرالية بانتظار التغيرات العاصفة التي ستشهدها مصر لاحقاً.
_______________________
(*) يُتبع بحلقة ثانية وأخيرة.
(**) كتاب “مصر الثقافة والهوية” صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت.
المصدر: المدن




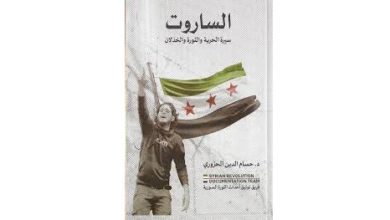



كتاب “مصر الثقافة والهوية” للباحث “خالد زيادة” قراءة جميلة للكاتب “محمد حجيري” بالقسم الأول من قراءة الكتاب “صعود الليبرالية وأفولها” ضمن محاولة لـ”رصد تطور السياسة في مصر، بالتوازي مع تطور دور المثقف منذ بداية القرن التاسع عشر، وحتى السنوات الأخيرة” وبروز نخبة ثقافية أمثال أحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل .