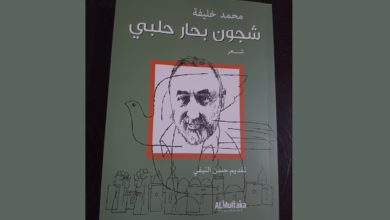لم تمر أوضاع السوريين طوال سنوات العقد الماضي بصعوبات تماثل ما هم فيه الآن، وهي صعوبات تتفاقم بشكل متسارع، لا أحد يستطيع أن يخمن أشكال تطورها، وإن كانت الأكثرية تتفق على الخطورة الشديدة لما سيكون. حيث يكرس الانقسام وجود أربع سلطات الأمر الواقع، التي إن تعارضت شكلياً، فإنها صارت متعايشة بعضها مع بعض، وثمة مصالح مشتركة لا تقتصر على النفط، وتتوافق على وجود ودور المعابر المتقابلة، التي تمرر بضائع وسلعاً، وقلة من أشخاص، يمكن أن تتزايد أعدادهم عند الحاجة، والهمّ الرئيس في إدارتها، محكوم بثنائية السلطة والثروة. ولا يختلف وضع المعارضة خارج سورية عن وضعها في الداخل إلا بصورة محدودة، رغم الفارق الملموس بينهما في مقدار الحريات والإمكانات، وإن كانت وما زالت بلا حاضنة شعبية فاعلة ونشطة.
وسط وضع معقد، تبدو خيارات السوريين صعبة في مواجهة الواقع، خاصة إذا جرى التركيز على الجوانب السياسية، حيث كانت آمالهم معلقة على تطبيق القرار “2254”، هذا القرار الذي يبدو أنه أصبح من الماضي وكل ما يجري حالياً يتذرع به لكنه خارج إطاره، إذ أن تحققه مرتبط بالتوافق السياسي الذي أنتجه في لحظة تاريخية مضت. وبالتالي فإن الأمر يتطلّب إما قراراً جديداً من مجلس الأمن، وهو مستبعد جداً، وإما خلق تغيرات في المشهد السياسي الداخلي والخارجي تؤدي إلى عملية سياسية بطرق جديدة. وبالتالي فإننا نحتاج حالة وطنية قادرة على التغيير، سواء تحت مظلة أممية، أو مظلة تسويات سياسية أوسع. ونظراً لكون المعارضة تعاني من ضعف هياكلها، كما أن كروت التأثير ليست بيدنا، كما أن اللاعبين الإقليميين أو الدوليين غير معنيين بإيجاد حلول في الوقت الراهن، فيبقى أمامنا المراقبة، وانتظار نتائج الحراك الشعبي في إيران، أو الحرب الروسية- الأوكرانية، وفي هذا الوقت على قوى الثورة ضخ دم جديد عسى أن نصبح جزءاً من الحل عوضاً عن كونها جزءاً من المشكلة.
وفي هذه الأثناء تزداد تعقيدات الكارثة السورية، فقد أضاف العام الأخير، وللأسف، معالم جديدة أكثر إيلاماً، ففي المناطق الخاضعة لعصابات الأسد، لم تعد تقتصر معالم الحياة على الفقر والعوز وانهيار الليرة السورية وتفشي غلاء فاحش، بل وصلت إلى الجوع، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وبات معظم أهلنا عاجزين عن فعل أي شيء سوى انتظار المزيد من الحرمان كي يفتك بهم، يحدوهم انحسار متواتر للمعونات الغذائية الأممية التي كانت تقدَّم للفقراء والمحتاجين، والمهددة بالتوقف نهائياً بشمال غربي سورية إن فشل مجلس الأمن، هذه الأيام، في تمديد آلية إيصال المساعدات عبر تركيا. أما في مناطق اللجوء على حدود الوطن فقد بدأ سيف الترحيل القسري لملايين اللاجئين مشرعاً، فلم يعد ثمة ترحيب بهم أو رحمة وتفهم لما يكابدونه، ويتعرضون لشتى أساليب الضغط، الصريحة والمضمرة، لمحاصرتهم ونبذهم، ووضعهم أمام خيار وحيد هو العودة لبلادهم، من دون الضمانات التي تقيهم الاضطهاد والاعتقال بعد الخراب الرهيب الذي طال منازلهم وممتلكاتهم.
ومع تزايد العقبات أمام العملية البرّية التي كانت تعتزم تركيا القيام بها لإنشاء منطقة آمنة، تتّجه أنقرة إلى بناء تفاهماتٍ جديدة أو تطوير قديمة، وإن كان ذلك يفسّر تزايد الاتصالات التركية الروسية وعلى مستويات رفيعة، إذ أنه كلما اشتدّت الضغوط الغربية على موسكو تزايدت فرص تقاربها مع تركيا التي تحاول بدورها الاستفادة من مأزق روسيا والغرب، لتحقيق أمنها الطاقوي أولاً، وبلوغ حلمها القديم في التحوّل إلى منطقة عبور للطاقة الواصلة إلى أوروبا من مناطق روسيا وآسيا الوسطى وبحر قزوين وإيران ومنطقة الخليج العربي.
في هذه الظروف خرجت تصريحات من القيادة السياسية التركية بدءاً من وزير الخارجية وصولاً إلى رئيس الجمهورية الذي دعا إلى قمة ثلاثية تجمعه مع بوتين والأسد، وبالرغم من التفسيرات التي استندت لكون هذا الأمر يعتمد على خريطة طريق تريدها أنقرة للحوار مع دمشق، تعبر فيها عن رؤيتها للحلّ في سورية، باعتبار أنّ تركيا أكبر المتضرّرين من ركود مسار المفاوضات، وغياب أي بوادر توحي بقرب الحلّ السوري، وأنّ وجود نحو أربع ملايين سوري على أراضيها، وستة آخرين في الداخل السوري، بشكلٍ ما، هم تحت رعايتها، يجعل منهم مشكلة وأزمة للقيادة والشعب التركيين، وإنّ هناك شروطاً على دمشق التزامها قبل حصول أي لقاء على مستوى الرؤساء، وأن هذه التصريحات غايتها فقط سحب أوراق سياسية ضاغطة من يد المعارضة التركية والاستثمار فيها داخلياً بما تبقى من وقت، ريثما يحين موعد فتح صناديق الانتخابات التركية منتصف العام المقبل، وبعدها يخلق الله ما يشاء.
إلا أننا نعتقد بأن الذي تريده القيادة التركية مرتبط بجذر مسائل أمن تركيا القومي، وأنّ التحرّك التركي بدأت ملامحه منذ عامين تقريباً، عبر أجواء مصالحات تركية مع الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وعبر تطبيق سياسة قديمة جديدة من خلال عودة الدبلوماسية التركية لسياسة “صفر مشاكل مع الجوار”، إذ أن السياسة التركية باتت إلى حد بعيد خاضعة لتقديرات المستوى الأمني ورؤاه، وسينعكس ذلك بدرجة كبيرة على الملف السوري، وعلى المعارضة واللاجئين السوريين، الذين يمرّون اليوم بأصعب مراحل علاقاتهم مع أنقرة.
وإن كنا خلال الأيام القليلة الماضية نشعر بمحاولات أميركية لإجراء تعديلات على القوى المتحالفة معها شرق الفرات، من خلال السعي لإعادة إحياء لواء “ثوار الرقة” لوضعهم لاحقاً على خطوط التماس مع فصائل المعارضة السورية في ريف الرقة الشمالي، لتبديد مخاوف أنقرة من وجود الوحدات الكردية في المنطقة. وخاصة كون هذه المحافظة تقع على مساحة أكثر من 20 ألف كم2 وهي من أهم المحافظات الزراعية في البلاد، فضلاً عن أنها تضم سدين على نهر الفرات ينتجان الطاقة الكهربائية ومعظم سكانها من العرب السوريين. إلا أننا نعتقد بأن هذه العملية لن تخرج عن إطار تكريس سيطرة قوى الأمر الواقع المرتهنة للقوى الإقليمية والدولية، ولن يعني بحال من الأحوال تقدم للثورة السورية لنصل لدولة حرة مستقلة ذات كيان واحد يسود فيه حكم القانون ويتمتع سكانه بحق المواطنة.
المصدر: إشراق