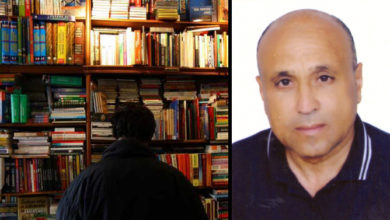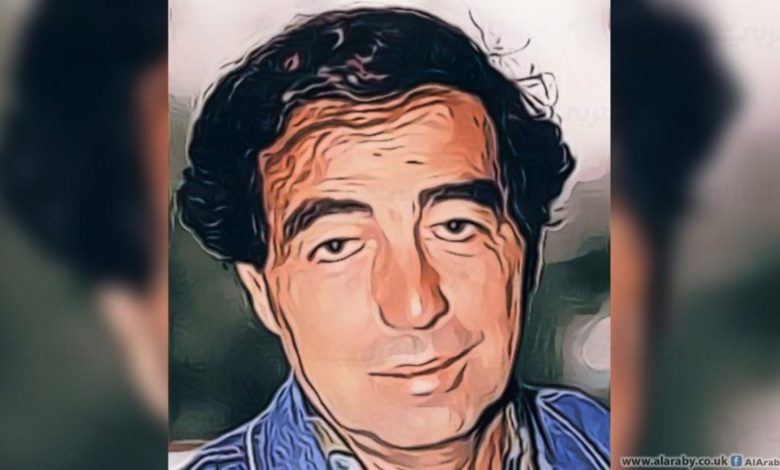
قبل حضور زمن حيطان الكتابة شبه الرسمية (فيسبوك وما شابهه)، كان يقال “الحيطان دفاتر المجانين”، وكانت الحيطان دفاتر للبوح أحياناً، وللفضائح والنمائم في أحيان أخرى. وكانت حيطان بعض “التواليتات”، على نحو خاص، مجالاً للتنفيس عن عقد متعدّدة. أما في عهد الاستبداد، فقد غدت مجالاً للتنفيس عن ظاهرة القمع السياسي. ولعلَّ المسرحي سعد الله ونوس قد استعار في مسرحيته “يوم من زماننا” حائطَ “تواليت” في مدرسة ثانوية للبنات ليرسم أو ليعلِّق عليه أحدهم صورة للزعيم، وليُحدِث بالتالي مشكلة خطيرة لمدير الثانوية الذي فقد صوابه خوفاً ورعباً، إذ ما الذي يمكن أن يحصل له إذا ما انتشر خبر تلك الرسمة أو الصورة؟ فهذا يعني أن وظيفته سوف تطير، إنْ لم يقدْه ذلك الأمر إلى ويلاتٍ لا أحد يدرك مداها ومحتواها. ولذلك لم يكترث بشكوى الأستاذ فاروق مدرس مادة الرياضيات الذي اكتشف بؤرة “دعارة” في الثانوية، تقودها “الموجّهة التربوية”، وقد جاء ليناقش أمرَها الخطير مع السيد المدير الذي وجده غارقاً بمصيبته التي يراها أشدّ خطراً من أيِّ أمر آخر.. حتى وإن كان تدنيساً للحرم المدرسي رمز الطهر والفضيلة. وهكذا تمضي المسرحية لتفضح الاستبداد والفساد معاً.
وقبل المجيء إلى وفاة الأديب السوري، وليد معماري، وما أحدثته من ردود أفعال متباينة، أودّ الإشارة إلى أننا شهدنا بعد موجة الربيع العربي أنَّ حيطان “النت” قد غدت مشروعة للجميع، وليقول كلٌّ منا ما يرغب به! والملاحظ في مثل هذا المجال غلبة الأقلام الشعبوية، فما إن تتوفى شخصية اعتبارية، سياسية أو ثقافية، حتى تنبري الأقلام مديحاً أو هجاء، ويجري التقييم بحسب الأمزجة، والرأي المكوَّن مسبقاً، ودونما تقيُّد بأية قاعدة للكتابة أو منطق للحديث.
كثيرون أشاروا إلى زاوية قوس قزح، وإلى زوايا أخرى لوليد معماري، وأقول إذا كانت تلك الزوايا تمرُّ محمولةً على سخريتها، فإنها تؤدّي، من جهةٍ أخرى، مهمة تفريغ الاحتقان الشعبي الذي يوجع الناس في قضاياهم المعيشية أو مما يرونه من فساد وتمييز وغير ذلك، فإن معماري دان الديكتاتورية في أوج عزّها، ففي قصته “عشية مات الزعيم” التي نشرت في ثمانينيات القرن الماضي، عن عيدٍ رسميٍّ في إمبراطورية الزعيم هو “عيد النمر” الذي يحتفل به سنوياً، ويُلقي فيه الزعيم خطاباً يصفق له الشعب تعبيراً عن حبه وولائه، لكن الأقدار لم تكن رحيمةً في إحدى السنوات، فقد جعلت موت الزعيم عشية هذا العيد، ما أوقع الحاشية والأعوان في موقفٍ حرج، فكيف يجعلون “عيد النمر” ينقلب إلى مأتم وأحزان؟! وبعد طول تفكير، لمع ذهن كبيرهم بفكرةٍ مجنونة، فماذا لو عمل على إحياء الميت؟! وهكذا يتذكّر مدير الكهرباء فهو القادر على تخليصهم من تلك المصيبة، وهو موظفٌ يحمل دكتوراه في الفيزياء من بلد أجنبي، لمَّا لم يجدوا مكاناً له في دولة الزعيم يناسب شهادته، عينوه في القصر مديراً مسؤولاً عن إنارة الكهرباء! وقد حان وقت عمله فهو لم يعمل شيئاً طوال سنيِّ خدمته، وهكذا تكتمت الحاشية على مسألة وفاة الزعيم، وطلبت من مدير الكهرباء أن يسخِّر خبرته في عملية تحريك أعضاء الزعيم، وخصوصاً يديه وفكّه، وتثبيت رجليه خلال إلقائه خطابه الجماهيري، المعتاد، وعلى مدير الكهرباء أن يرتب الخطاب من خطابات سابقة مسجّلة. وهكذا، ومن خلال أسلاك مخفية، استطاع مدير الكهرباء أن يجعل الزعيم يلقي خطابه، وأن يصفّق الشعب، ويمرّ العيد، وتسير الأمور كما تشتهي الحاشية.. رموز القصة واضحة من اسم العيد إلى شهادة مدير الكهرباء وتهميشه بالوظيفة التي تقلّدها إلى العمل الذي أنجزه. وقد غطى الكاتب قصته بأن أشار، في بدايتها، إلى أنها قصّة مترجمة عن اللغة الصينية، وذكر اسماً للمؤلف وآخر للمترجم.
ويبقى السؤال المهم: هل يكفي المثقف موقف عابر أو مواقف متعدّدة؟ وما المعيار الذي يمكِّن القارئ من الحكم الدائم على المثقف؟ أما في الحال السورية، فقد كان جوهر التناقض بين الحرية والاستبداد. تؤكد ذلك قصة وليد ذاتها، وهذا الذي كان مطلوباً من المثقف، أن يثْري ذلك الهدف، ويساند ملايين الناس الذين هتفوا للحرية، لا أن يوازن بين السيّئ والأسوأ مثلاً؟ وكيف له أن يفعل ذلك، وكل شيء كان واضحاً، منذ البداية، وقبل أن تبدأ أحداث درعا. أما المعارضة التي برزت خلال العقد الأول من القرن الجديد، فلم يبدُ منها أيّ تطرّف، ولم يكن فيها إسلام سياسي بالمطلق، بل كان معظم الذين وجدوا منشقّين عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ذاتها، أو يجرون مجراها في الإطار العام، ومنهم كان منسجماً فكرياً مع بعض أحزابها
موازنة المواقف المبنية على حسابات مصالح خاصة، أو على مصالح حزبية، أو فئوية معينة، ليست من سمة المثقف أبداً، قد تكون من سمة السياسي .. الموقف الخطأ الذي وقع فيه بعض المثقفين السوريين، وأحزابهم اليسارية، وجعلهم يتراجعون عن مواقف سابقة لهم، انطلاقهم من المقارنة بين الاستبداد ومظاهر التطرّف التي ظهرت بعد أن أخذ الجيش بفتح نيرانه على الحراك الشعبي، وقد كان لأركان دولة الاستبداد دور مباشر في وجود ذلك التطرّف، لا لسياسة القمع وما يستتبعها، بل لأنَّ أصابع الاستبداد نفسه كانت وراء صناعته، فمعظم الذين قادوا التطرّف خرّيجو سجن صيدنايا، وإن شئت “معهد صيدنايا” للتطرّف الذي وفّر للسجناء العائدين من العراق كل ما من شأنه أن يصنع منهم جهاديين بامتياز. فقد “كان هنالك حالة فريدة ليس لها مثيل في العالم ربما، وهي “تصنيع الجهاديين السلفيين وتصديرهم للعالم”. إذ “فتحت سجن صيدنايا للجهاديين السلفيين السوريين العائدين من العراق، ووضعتهم مع سجناء القاعدة القادمين من أفغانستان، وبدأت حملة اعتقالات واسعة لذوي الميول السلفية في أنحاء البلاد منذ عام 2004 لزجّهم في سجن صيدنايا، وإجبارهم على التواصل مع القاعديين القدماء، وتوفير بيئة فكرية لتوليد جهادية سلفية، وصل الأمر حتى إلى توفير مكتبة جهادية فريدة من نوعها تضم كل المراجع الجهادية المحرّمة أو الممنوعة من التداول في سورية، كانت عملية استثمار ضخمة وفريدة” (كتاب “الثورة والحرب: الإسلاميون في موقع المعارضة الداخلية في سورية”، عبد الرحمن الحاج، ص 112).
وبعد، أساس البلاء من الاستبداد، ولا حل للوضع السوري إلا بزواله، وبقيام نظام ديمقراطي يسمح بتشكيل أحزاب سياسية، وإعلام حرّ، وقضاء مستقل، وتداول للسلطة، وكل من وازن في الموقف منح الاستبداد فرصاً أطول للبقاء، وفضَّله على نزوع الشعب السوري في تطلّعه إلى الحرية. وهو مسؤول على نحو أو آخر عن معاناة السوريين اليوم.
المصدر: العربي الجديد