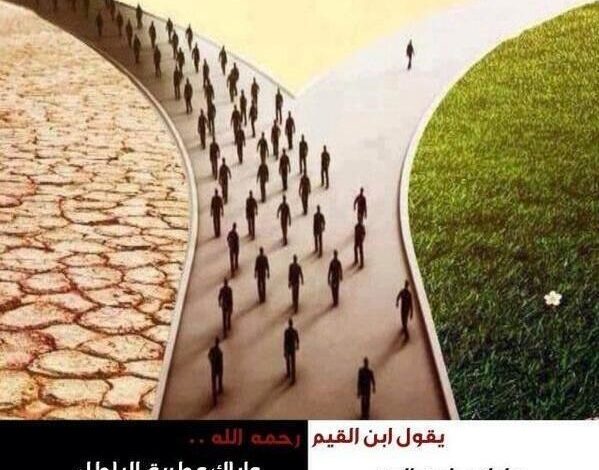
لا يخفى على كثيرين أن هنالك الألوفَ من المقالات والأبحاث التي تحدثت عن طريقِ الحق وطريق الباطل وتناولت هذا الموضوعَ من جوانب متعددةٍ سواء الدينيةَ منها أو السيكولوجية أو حتى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية أو حتى تدوينِها كوثيقة أنثروبولوجية …. لكننا في هذه المقالةِ لن نتطرقَ إلى كل ما ذكر أنفًا حتى لا نكررَ المكررَ، وحتى لا نصنعَ فيلماً هوليوديًا يُظهرُ انتصارَ الحقِّ في النهاية وغلبة الخير على الشر ولو كان بتعريف صناع السينما.
ما سنطرحه في هذه المقالةِ سؤالًا باتجاه آخرَ: ماذا لو انتصر الشرُّ وعلا أصحابُ الباطل؟ كيف سنتصرف وماهي حكمةُ الخالق من انتصار الشر ولو إلى حين؟! وماهي السنةُ الكونية من هذه المعادلةَ المقلوبة؟
بالتعريف: إنه من الأسلم والأدق والأليق أن نقولَ: انتصر أهلُ الباطل على أهل الحق، ولا نقول: انتصر الباطل على الحق؛ فالحقُّ لا ينتصر عليه الباطلُ مهما بلغت قوته وسيطرته، فهزيمة الحق انكسارُه وتبعيته للباطل ورضوخه له، وهذا ما لا يكون أبدًا.
بل يبقى الحق مهما بلغ ضَعفُ حَمَلتِهِ عزيزًا قويًا ثابتًا، ولو في القلوب والصدور، الحق هو كلمة الله، وهي الكلمة التي جعل الله لها العلو أبدًا، حتى لو انهزم أهلُها وجُندُها في ألف معركة، فهي كلمة مستقرة في القلوب والعقول، ولا تهتز هذه الكلمةُ ولا تبرح مكانَها ومكانتَها مهما كان، بل إن العجب العُجاب، أنها تزدادُ رسوخًا وثبوتًا في القلوب والعقول كلما ازداد ضغط أعدائها على أهلها ومعتنقيها.
يقول الله – عز وجل – في كتابه (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا) [التوبة: 40]، إذن، أهلُ الباطل هم الذين ينتصرون على أهل الحق في بعض الجولات والمعارك، ولا ينتصر الباطلُ على الحق أبدًا، فالحق هو كلمة الله، وهو باقٍ ببقاء الله، وعزيزٌ بعزة الله، مهما كانت الظواهر وتفصيلاتها.
يقول أحمد بن عطاء الله السكندري: “لا يكنُ تأخرُ العطاءِ مع الإلحاحِ في الدعاء موجبًا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابةَ فيما يختارُه لك لا فيما تختارُه لنفسك”.
ضمن اللهُ لأهل الحق المجاهدين في سبيله – إن هُمُ استقاموا وأخلصوا – الأجرَ والثواب التام، ولم يضمنْ لهم النصرَ اللازم في كل معاركهم وجولاتها، لكن لا بد أن تكون الصورةُ هكذا: أهلٌ للحق مستقيمون مخلصون ثابتون في كل المراحل، أمام أهلٍ للباطل ظالمين فاسدين.
يقول محمد الغزالي رحمه الله: ” إن خدمة الإسلام تحتاج إلى رجل يجمع بين عنصـرين لا يغني أحدُهما عن الآخر.. الأول: الإخلاصُ العميق لله، والثاني: الذكاءُ العميق والفـهم الناضج في رؤية الأشياء على طبيعتها.”
إذن هل يفتقد أصحاب الحق الإخلاصَ العميقَ لله أمِ الذكاء العميق والفهم الناضج أو يفتقد كليهما؟
الهزيمة في أرض المعركة ليست دليلا على حق الفريق المنتصر وباطل الفريق المنهزم، لكن، ماذا بعد المعركة؟! المعارك بكيفيتها ومآلاتُها ليست دليلا على شيء، وإن انتصر فيها من انتصر، وهُزم فيها من هزم.
الكتَّابُ والأدباءُ الروس والكاتب الإنكليزي شارلز ديكنز في القرن التاسع عشر انعكس في أدبِهم شعورُ الأديب مرهف الحس وسط الاضطرابات التي تعصف فيما حوله. وفي أجواء الظلم تلك تبدو الشفقة على المظلومين لا تكفي، وكذلك الغضب على الظالمين لا يجدي، لذلك اتخذ هؤلاء الأدباءُ من السخرية اللاذعة سلاحًا لتحقيق ما يهدفون اليه من التنبيه والتحذير والإصلاح.
توفيق الحكيم في رائعته “يوميات نائب في الأرياف” يبتدئ روايته بالمقدمة التالية: لماذا أدون حياتي في يوميات؟ ألأنها حياةٌ هنية؟ كلا! إنّ صاحبَ الحياة الهنيئة لا يدونها، إنما يحياها. إني أعيش مع الجريمة في أصفاد واحدة. إنها رفيقي وزوجي أطالع وجهها في كل يوم، ولا أستطيع أن أحادثَها على انفراد. هنا في هذه اليوميات أملك الكلام عنها، وعن نفسي، وعن الكائنات جميعًا. أيتها الصفحاتُ التي لن تنشر! ما أنتِ إلا نافذةٌ مفتوحةٌ أطلق منها حريتي في ساعات الضيق!..
“تُحفظُ القضية لعدم معرفة الفاعل “عبارة أنهى بها توفيقُ الحكيم رائعته تلك “يوميات نائب في الأرياف” وتصلح لأن تصفَ واقعنا الراهن حين يجتمع الضحية والمجرم في جسد واحد! حين نجد من يدعي خدمة الوطن والمواطن هو أكبر مجرم في حق الوطن والمواطن!
من الصفحة 129 في رائعة توفيق الحكيم نقتبس النص التالي: “شيكاجو وأبنوب (قرية صغيرة في بلاد الوجه القبلي بالقطر المصري) قطبا الغريزة السفلى على هذه الأرض. الأولى إجرامُ الحضارة! والثانية إجرام البداوة! كلٌّ له طابعُه ومميزاته: إجرام الحضارة قد ارتدى هو أيضًا ثوبَ الحضارةِ بأسلحتها وأغراضها وأسبابها! هنالك الجريمةُ المتحضرة تخرج في سيارتها المصفحة حاملة “المسدسات” و”المتراليوزات” و”المفرقعات” لتهجمَ على أضخم “البنوك “وبيوت المال ثم تعودَ إلى مكمنها بثروات طائلة من الجنيهات!… وهنا الجريمةُ الفطرية تخرج متدثرةً في عباءتها حاملةً هراوتِها أو فأسَها أو بندقيتها لتسفكَ دمَ رجل ضعيف انتقامًا لعِرض أُهِين في نظر التقاليد والعادات. هنالك الثروةُ والمال، وهنا التقاليدُ والعادات. هذا هو الفرق بين الحضارةِ والفطرة بين ما يشغل بالَ الرجلِ المتحضر وما يشغل بالَ الرجلِ المتأخر! نعم، إن الشرَّ هو دائماً الشرُّ. ولكن الشرَّ الناتجَ عن سبب كبير لأجدرُ بالتقدير من شر نشأ عن سبب تافهٍ حقير! إن الحضارةَ العظيمة لا تزيل الشر ولا تمحو الجريمة، ولكنها توجد الشر العظيم والجريمة العظيمة!
في خيام اللجوء وبين النازحين والمشردين في شمال سوريا ولبنان وفي اليمن وبين مشردي الروهينغا تكمن الجريمةُ العظيمة، لكن يرافقُها كذلك الجريمةُ الفطرية التي يرتكبها بالمشردين أبناءُ جلدتِهم الذين امتهنوا الاسترزاقَ من تلك الجريمةِ العظيمة!
في الصفحة 99 من رواية “يوميات نائب في الأرياف” اقتبس المقطع التالي الذي يجسد فيه توفيق الحكيم بألم فكرةً فلسفيةً عميقة تعكس مفاهيم نعيشها اليوم في ثورات الربيع العربي، تحلل وتشرح مفهوم الجريمة الفطرية لدينا على الرغم أن الرواية كُتِبت عام 1940:
“إن الفلاح المصري يلجأ كثيرًا إلى محترف يقتل له، كما كان ملوكُنا الأقدمون يلجئون إلى الجنود المرتزقة. أهو نقصٌ خلقي في الفلاح يضاف إلى أمراضه الجسمانية والفكرية والاجتماعية الكثيرة. أم أنها قلة مقدرة وضعف ثقة بالنفس منشؤها اشتغالُه بأعمال العبيد من قديم في الأرض والزراعة وترك الفروسية والجندية للمغيرين، وأقربُهم بنا عهدًا الأعراب والأتراك.. “يذكرني ذلك الفلاحُ المصري بالتاجر السوري وراعي الإبل السوداني والصومالي والحرفي الجزائري والليبي الذين تركوا الجندية والفروسية لمن يحكمونهم اليوم!
كثيراً ما يحدثنا أهلُ الباطل عن حقوق الإنسان والقانون الدولي والإجراءات المتبعة في كل ما حولنا سواءٌ في الاقتصاد والاجتماع بل وحتى العمل الإنساني! وهنا أعود لمبدعنا توفيق الحكيم لاقتبس من رائعته هذا المقطع:
“إن تلك الإجراءاتِ التي تُتبعُ في أعمالنا القضائيةِ طبقًا للقوانين الحديثة ينبغي أن يُراعى في تطبيقها عقليةُ هؤلاء الناسِ ومدى إدراكهِم وقدرتهم الذهنية. أو فلترفعْ تلك المدارك إلى مستوى تلك القوانين “. (صفحة 96)
الشاعر محمود درويش في قصيدته “أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسي” يقول:
“مَنْ سَيُنْزِلُ أَعْلامَنا/ وَمَنْ سَوْفَ يَتْلو عَلَيْنا مُعاهَدَةَ الصُّلْحِ/ مَنْ سَيَدْفِنُ أَيّامَنا بَعْدَنا/ وَمَنْ سَوْفَ يَرْفَعُ راياتِهِمْ فَوْقَ أَسْوارِنا”.
ويقول بأسى “سوف أسقط من نجمةٍ في السماءِ إلى خيمةٍ في الطريق.. إلى أَيْن؟ أَيْنَ الطَّريقُ؟”.
تنتمي قصيدة محمود درويش “أحد عشر كوكبا إلى آخر المشهد الأندلسي” إلى فئةٍ تراجيديةٍ خاصةٍ مليئةٍ بالتوتر والإسقاطات وثنائيات الحضور والغياب والماضي والحاضر، وكأن الأندلسَ كانت بالنسبة للشاعر حضورًا زمانيًا ومكانيًا آخرَ للشتات واللجوء الفلسطيني وفقدانِ الأرض، وتصلح كذلك لتكون وصفًا حيًّا على ما نعيشُه هذه الأيامَ، ونحن نسمع بالتسويات على حساب الأجساد المددة في العراء وتحت الخيام والأرواح التي تهيم بحثًا عن قبر تلوذ به يحوي شاهدةً تشير إلى اسم وعنوان جسد:
“إِنَّ هذا السَّلامَ سَيَتْرُكُنا حُفْنَةً مِنْ غُبار”، و”كُلُّ شَيّءٍ مُعَدٌّ لَنا، فَلِماذا تُطيلُ التَّفاوُضَ، يا مَلِكَ الاحْتِضارْ؟”.
“لا حُبَّ يَشْفَع لي
مُذْ قَبِلْتُ (مُعاهَدَةَ الصُّلْحِ) لَمْ يَبْقَ لي حاضِرٌ
كَيْ أَمُرَّ غَداً قُرْبَ أَمْسي. سَتَرْفَعُ قَشْتالَةُ
تاجَها فَوْقَ مِئْذَنَةِ اللهِ. أَسْمَعُ خَشْخَشَةً لِلْمَفاتيحِ في
بابِ تاريخنا الذَّهَبيِّ، وَداعًا لتِاريخنا، هَلْ أَنا
مَنْ سَيُغْلِقُ باب السَّماءِ الأخيرَ؟ أَنا زَفْرَةُ الْعَرَبيِّ الأَخيرَةْ”
لقد قسّم محمود درويش قصيدته إلى أحدَ عشرَ مقطعًا متمثلًا الكواكبَ الأحد عشر التي استوحاها من القرآن الكريم في رؤيا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال بكلمات حادة في ثنايا القصيدة يصف حال آخر ملوك الأندلس والذي يشبه حال شعوبنا المشردة هذه الأيام “لَمْ تُقاتِلْ لأَنَّكَ تَخْشى الشَّهادَةَ، لكِن عَرْشَكَ نَعْشُكْ فاحْمِلِ النَّعْشَ كَيْ تَحْفَظَ الْعَرْشَ، يا مَلِكَ الانتِظار”.
في حواره مع مجلة الآداب اللبنانية (يوليو/تموز 1974)، يعتبر محمود درويش أن علاقة الشعوب “بفردوسها المفقود” هي علاقةُ ارتباط بالماضي الذي يحدُّه القدر، إنه حنينٌ مجانيّ وبكاءٌ للذكرى والعزاء، ومع ذلك فهي أيضًا “فرح بقدرة ماضية على إنجاز جميل مضى”.
ربّما هذا ما يبحث عنه أصحاب الحق في وطننا العربي والإسلامي الكبير “الفردوس المفقود” المغلف بالفتنة. والفتنةُ هنا تُخشى أكثر ما تخشى على أهل الحق لا على أهل الباطل، لأن عمل الشياطين في إضلال أهل الحق وإفساد قلوبِهم هو أهم عمل لهم، ولمثل هؤلاء تتفرغ الشياطينُ وتجتهد، فيدخل الرجل المستقيم المخلص ساحة الجهاد والثورة، ثم لا يلبث أن يتغير فيها ويُفتن، فإذا دخل ساحة الجهاد والثورة وخرج منها مستقيمًا مخلصًا لا يلبث أن يتغيرَ ويُفتنَ بعدها، إن هو هُزم يتغير ويُفتن بهزيمته يأسًا وقنوطًا واستعجالًا للنصر، وإن هو انتصر يتغير ويُفتن بانتصاره التفاتًا للغنائم وطمعًا في المكانة وحبًا للسيادة والظهور.
واختم هذه المقالة بمقولة كتبها توفيقُ الحكيم في مقدمة الطبعة الأخيرة لروايته “يوميات نائب في الأرياف”:
“إن شيئًا لم يتغيرْ بعد لدرجة تذكر في ذلك العالمِ الغارقِ في الوحل ….حتى الاختناق.”





