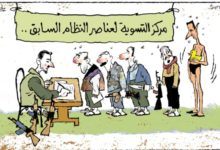هذا الشهر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو فيه إلى تحقيق العدالة لعشرات آلاف المفقودين في الحرب السورية، وغالبيتهم الساحقة مرت في معتقلات نظام الأسد، وما زالت مصائرهم مجهولة. القرار جاء بمبادرة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة (غالبية قوامها 26 صوتاً)، في مقابل الاعتراض المعتاد من موسكو وبكين (15 دولة أخرى امتنعت عن التصويت).
ذاك أن قضية المفقودين في سوريا، باتت تحظى باهتمام حقوقي متزايد، سيما بعد قرار مفاجئ للنظام قبل 3 سنوات، بإعلان وفاة آلاف المعتقلين دون تبيان أسباب ذلك أو فتح تحقيق في هذا الشأن، أو حتى التواصل مع أهالي الضحايا. بين هؤلاء الضحايا، كانت هناك مجموعة كبيرة من الشباب والشابات اعتُقلوا جميعاً نتيجة نشاطهم إما في التظاهر والاحتجاج أو إغاثة المتضررين من الحرب. كما أن عدد الضحايا (عشرات الآلاف على أقل تقدير) أكبر من أن يُهضم.
في الصورة الأولية، يبدو كأننا أمام انتقام للنظام من معارضيه أو تصفيتهم جسدياً بهدف التخلص منهم ومن احتمال تسبيبهم صداعاً مستقبلياً له في حال الافراج عنهم، أو إذا طالب بعض المجتمع الدولي بكشف مصيرهم. لكن هذا الوصف، مخالف للحقيقة. بيد أن الشهادات المتواترة عبر السنوات الماضية، تُؤشر الى اعدامات دورية وجماعية للمعتقلين واستقبال موجات جديدة منهم لتعذيبهم وإعدامهم. كيف بإمكان نظام بالكاد يقدر على تأمين لقمة عيش جنوده، أن يعتقل مئات آلاف المواطنين والمواطنات؟
عملياً، جمع المعلومات المتوافرة، ولو أنها غير وافية بشكل كامل، يُؤشر إلى مقتلة جماعية داخل السجون، وعلى مستوى “صناعي”. وهذا النهج يتكامل مع مقاربة النظام السوري في الحرب، لجهة استخدام القوة المفرطة والتدميرية بما لا يتناسب مع متطلبات الحرب، وبهدف طرد المدنيين وتدمير منازلهم ومبانيهم.
لهذا من الضروري هنا الاعتراض على اللغة المستخدمة في وصف الجرائم الواقعة في السجون، وقد وثّقت “منظمة هيومن رايتس ووتش” عملها في قضية المفقودين، ومنهم مئات الناشطات والناشطين السوريين المعروفين بالأسماء (راجع مقال مديرة قسم الازمات والنزاعات ومديرة مكتب بيروت في المنظمة، لما فقيه عام 2018).
الإشكالي هنا أن اثارة القضية وحلها يأتي من بوابة لا يصف الواقع. بيد أن السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية سايمون مانلي تحدث أثناء عرضه النص عن امتلاك النظام السوري “الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل … هذا عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف”.
هل اعلان النظام عن مصائر الضحايا كما فعل قبل سنوات، يكفي لانهاء مأساة المفقودين؟ التعاطي مع هذه القضية على هذا المستوى، يحيلها الى محض إدارية، فيما هي أكبر من ذلك بكثير.
الواقع أن مراكز الاعتقال هي جزء يسير من عملية تغيير ديموغرافي، وشهدت عمليات قتل جماعية على مستوى صناعي وفقاً لآليات تضمن فاعلية وانتاجية لدى السجون (تُشبه تلك السائدة في المصانع، مع كوتا إنتاجية محددة). الكوتا هنا هي عدد المساجين المقتولين دورياً. خلال الحرب، فظائع السجون باتت أكبر من مجرد تعذيب السجناء والتنكيل بهم على مدى شهور وسنوات. لعبت المعتقلات دوراً في جريمة تطهير سكانية، وكانت عاملاً مكملاً لعمليات القصف الوحشية للمدنيين، إذ أنها شملت تصفيات لمن لم ينزحوا أو يموتوا بالقصف، أو لمن عارض في مناطق لم تشهد حرباً. وفي الحالة الأخيرة، بالإمكان رصد بعض حالات النزوح المترافقة مع الإعتقالات، أي أن عائلات الضحايا غادرت أماكن إقامتها.
مقاربة قضية المفقودين على أساس أنها جزء من عملية تطهير أو إبادة لقسم من السوريين، يُساهم في الإحاطة بتفاصيلها وربما اجراء تحقيق دولي، إما رسمي من خلال الأمم المتحدة أو عبر منظمات حقوقية ذات صدقية، في عمليات القتل الجماعي داخل السجون. هي عملية إبادة، وتستدعي مقاربة مغايرة واهتماماً أكبر مما نراه اليوم.
المصدر: المدن