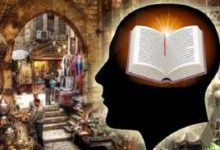عصر الظلام هو الوصف الذي يُطلق على أوروبا خلال ما يقرب من عشرة قرون، منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية وإلى بدايات زمن النهضة. يفسّر هذا الوصف أغلب، إن لم يكن كل، المظاهر التي سادت في القارّة الأوروبية: الأمية، الجهل، الفقر، سيطرة السحر، الاستغلال الإقطاعي، تغوّل الكنيسة على الحكم والناس، استرذال العلم، الحروب الأهلية والطائفية، وسواها كثير. عندما يسأل سائلٌ لماذا لم يقم الأوروبيون بكذا أو كذا، يكون الجواب المجمل والقاطع: كانوا في عصر الظلام. الصفة التي تُطلق على عصرٍ معيّن توجز الكثير مما حدث أو لم يحدُث في ذلك العصر. واجهت الصين قرناً مديداً سُمي عصر أو قرن الإذلال، امتدّ تقريباً منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين وقيام الصين الحديثة. في ذلك القرن، خضعت الصين، بطولها وعرضها وديموغرافيتها الهائلة، لسيطرة الإنكليز والفرنسيين واليابانيين والألمان والأميركيين وتحكّمهم. حالة الإذلال هي التي تجيب عن سؤال لماذا لم يقم الصينيون بما كان عليهم أن يقوموا به. … في المنطقة العربية، عندما يأتي وصف “عصر المغول” تتداعى إلى الأذهان صور الخراب الذي أحدثه هؤلاء في العراق وبلاد الشام، وتدمير بيت الحكمة، والهمجية التي تصرّف بها الغُزاة. وعندما يأتي وصف “العصر الذهبي الإسلامي” تنثال في المخيلة صور صعود بغداد ودمشق والأندلس، وما رافق ذلك من تقدم علمي وازدهار. الوصف الإجمالي لعصرٍ ما هو المفتاح الذي يشرع بوابة عريضة تتيح إطلالة إجمالية وسريعة على المشهد العام لذلك الزمن، ويكاد هذا الوصف يقدّم نموذجاً تفسيرياً أولياً، ليس نهائياً أو تفصيليّاً، paradigm يوفر الإجابة المُختصرة على أسئلة كثيرة.
ما نعيشه، نحن العرب، في هذه المرحلة هو “عصر النذالة”، وهو التفسير المختصر والإجابة الفورية لأسئلة لا تنتهي تُحاصرنا من كل جانب صباح مساء
ما نعيشه، نحن العرب، في هذه المرحلة هو “عصر النذالة”، وهو التفسير المختصر والإجابة الفورية لأسئلة لا تنتهي تُحاصرنا من كل جانب صباح مساء. لماذا لا تقوم الدول والحكومات العربية بفعل كذا وكذا من أجل غزّة وأهلها أسوة بدول وحكومات غير عربية؟ لماذا لم تلتحق ولا دولة عربية مع جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية؟ لماذا لا تتحرّك الشعوب دفاعاً عن ذاتها وكرامتها أولاً، وعن أشقائها المطحونين بحرب الإبادة، كما تفعل شعوب العالم من أستراليا إلى كولومبيا واليابان؟ لماذا لا يتجرّأ إعلاميون وكتاب ومشاهير على الاقتراب من جوهر الحقائق الواضحة كالشمس، بينما يضحي فنانون ومشاهير غربيون وغيرهم بمستقبلهم المهني مناصرة لفلسطين؟ لماذا يجبُن علماء دين عن الصدْع بالحق، ويتحوّلون إلى أحذيةٍ باليةٍ يلبسها الحكام، وعوض أن يكونوا قادة كرامة يغرقون في مستنقع الانحطاط؟ لماذا يختبئ رجال أعمال وراء عجزهم ويبخلون عن التبرّع لمن يموتون جوعاً هناك؟ ثم تأتي أسئلة أكثر صعوبة ومرارة: لماذا وسط هذه المقتلة المذهلة تُعقد صفقات بعشرات مليارات الدولارات مع الدولة المجرمة، في وقتٍ يطالب فيه أحرار العالم بمقاطعتها اقتصاديا وسياسيا؟ ولماذا ازدادت معدّلات التبادل التجاري بين إسرائيل وعدة دول عربية خلال سنتي حرب الإبادة المجرمة؟ ولماذا تتحوّل دول عربية عديدة إلى مجرد وسيط بين المجرم النازي والشعب المطحون، عوض أن تصطفّ معه؟ ولماذا تقدّم تريليونات مُذهلة لأميركا وهي الراعية الأكبر للدولة المجرمة، والشريكة معها في كل المقتلة؟ لماذا تتهافت حكومات عربية على التطبيع فور توقف حرب الإبادة، وكأنها تمنح الدولة المجرمة عطايا شكر وامتنان على إجرامها؟ الجواب السريع لكل هذه الأسئلة هو “عصر النذالة” وتمثلاته.
وصف الواقع النذل كما هو والأنذال كما هم بداية التخلص من عصر النذالة وتخطّيه. لا أحد يقبل أو يريد أو يستمرئ العيش في حالة موصوفة بالنذالة
ليس القصد من نحت هذا الوصف الإمعان في الجلد الذاتي او فشّ الغل والغرق في سوداويةٍ لا معنى لها. القصد هو إزاحة كل المساحيق التجميلية والمسوّغات والتبريرات “الواقعية” والفلسفات التي يتنطّع بها المُدافعون عن “الوضع القائم”، والوقوف أمام المرآة ورؤية الواقع كما هو. وصف الواقع النذل كما هو والأنذال كما هم بداية التخلص من عصر النذالة وتخطّيه. لا أحد يقبل أو يريد أو يستمرئ العيش في حالة موصوفة بالنذالة، وهنا بالضبط قد تتموضع الطاقة التحرّرية لهذا الوصف: الانعتاق منه عبر الالتزام بالفعل المضادّ. كتب الفيلسوف الكندي آلان دونو عن “عصر التفاهة” المُعولم الذي يسيطر على كل مناحي الحياة الجمعية اليوم، ودعا إلى القطيعة مع هذا العصر عبر فعل اجتماعي منظم. لا أحد يريد أن يكون “تافهاً” أو جزءاً من عصر التفاهة، ولا أحد يريد أن يوصف بالنذالة أو أن يكون جزءاً من عصرها. في تحليله لعصر التفاهة، تقوم أطروحة دونو على تفكيك مُعمق للمجتمعات الغربية الرأسمالية تحديدا، والتي حولت الأفراد إلى لاهثين خلف المال والاستهلاكوية السطحية والمظهرية الرثة. العالم غير الغربي غارقٌ في مآسٍ أكثر توحّشاً من التي تواجه الغرب، وهي مآسٍ لا تترك مساحة لترف التفاهة أو لخيار أن يكون الفرد تافهاً. في الغرب المُترف، ربما هناك مساحات للأفراد والجماعات تتيح لهم اختيار التفاهة سبيل حياة، أما في الشرق المُتعب وبقية مناطق العالم فينتفي هذا الخيار أصلاً.
ثمّة تفريق ضروري بين مفهومي النذالة والإذلال. في الأول تخلٍّ عن القدرة الذاتية للفعل والذهاب طواعية للخضوع، أما الثاني، فهو مفروضٌ على الذات من طرف قوي أو أطراف، وليس ثمّة قدرة ذاتية على المقاومة والرفض. قد تستسلم الدول والجيوش في المعارك وتتعرّض للإذلال الظرفي، وهذا جزء من سيرورات التاريخ. بيد أن النذالة فعل ذاتي وواع، وهي كما يقول لسان العرب “الخسّة والوضاعة، والنذل هو من لا يؤتمن ولا يعتَمد عليه”.
النذالة فعل ذاتي وواع، وهي كما يقول لسان العرب “الخسّة والوضاعة، والنذل هو من لا يؤتمن ولا يعتَمد عليه“
في قلب منظومات الأخلاق العربية، كما يقول محمد عابد الجابري في كتابه المهم “العقل الأخلاقي العربي”، تتموضع المروءة مكوّناً تأسيسياً لهذا العقل، وجماعها الكرم والنجدة وحسن الخلق والابتعاد عن الدنايا (كما في “المعجم الوسيط”). في الفهم والتطبيق الجمعي للمروءة تمثل النجدة والكرم عماد النظام الاجتماعي، ومن أسمى تجسّداتها في التاريخ العربي قبل الإسلام “حلف الفضول” وهو ما تواضعت عليه قبائل الجزيرة العربية آنذاك وأساسه نصرة المظلوم والضعيف. يمثل هذا الحلف الذي مدحه الرسول الكريم نموذجاً في “العلاقات الدولية” والدفاع عن الضعيف قبل أن تصل الأمم المتحدة سنة 2005 إلى إطلاق مبدأ شبيه، وهو مسؤولية الحماية Responsibility to Protect، والذي يفترض موقفاً أخلاقياً من الدول الكبرى لحماية المجتمعات والدول التي تتعرّض لحرب تطهير عرقي أو إبادة من طرف قوي، وبقيت حبراً على ورق. قبل حلف الفضول الذي قام على مبدأ المروءة والنجدة ونصرة المظلوم كانت حرب ذي قار التي اتّحدت فيها القبائل العربية ضد كسرى الفرس نجدة لملك الحيرة الذي استجار بها.
قد يقول كثيرون إن لا مكان لهذا الكلام الأخلاقي الخاص بقيم الأفراد في السياسة بين الدول، والتي تقوم على الواقعية ومصلحة الدولة. وهذا كلامٌ مردود، ورغم ترداده كثيراً، لأن صنّاع السياسة الواقعية في الغرب تأسّست سياستهم، ولا تزال، على “قيم” مشتركة معلنة مع المشروع الصهيوني، ولم تقم على المصلحة السياسية حصراً وتحديداً. يُضاف إلى ذلك أن المنظّر الأكبر لمدرسة الواقعية السياسية، الأميركي هانز مورغنثاو (1904 – 1980)، أشار في كتابه Politics Among Nations الذي أسّس فيه ونظّر لهذه المدرسة، أن مكانة الدولة وهيبتها (State Prestige) تعدّ أحد دوافع تحرّكها السياسي مع الدول الأخرى، وهذه “الهيبة” مسألة أقرب إلى القيم منها للمصلحة السياسية. لو طبقنا هذا المبدأ في عصر النذالة (عربيا) لجاز السؤال: كيف تقبل دول عربية كبيرة ومتوسّطة وصغيرة أن تُحتقر مكانتها وهيبتها من دولة صغيرة لقيطة، بعيداً عن فلسطين ومناصرة الفلسطينيين، وتقبل أن تصبح ذيلاً لها في عصر تتنافس فيه النذالة مع الصهينة؟
المصدر: العربي الجديد