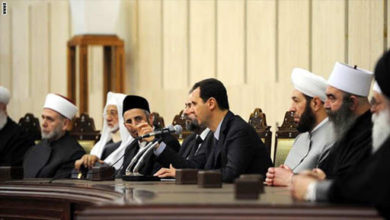تشهد محافظة السويداء في الجنوب السوري واحدةً من أكثر حلقات العنف الأهلي تعقيدًا في المشهد السوري، بعد تراجع سلطة الدولة المركزية. ولا يمكن فهم ما يجري بوصفه صراعًا على السلطة بالمعنى الكلاسيكي لماكس فيبر حول “السلطة العقلانية القانونية”، ولا كصدام أيديولوجي بين مشاريع سياسية متعارضة، بل كتجلٍّ لانهيار البنى الحداثية للدولة، وانكشاف المجتمع السوري أمام خطر التفكك الوطني.
ما يحدث، وفق “نظرية الانحراف البنيوي” لعالم الاجتماع روبرت ميرتون، يمكن تفسيره بوصفه نتاجًا للتوتر بين الأهداف الثقافية العامة للمجتمع والوسائل المشروعة المتاحة لتحقيقها، ما يدفع الأفراد نحو أنماط انحرافية من التكيّف، من بينها الانكفاء الطائفي والانخراط في العنف الأهلي، كردّ فعل على فقدان الأمان والضمانات المؤسسية.
الهوية الوطنية في مواجهة التفكك
السويداء، التي شكّلت نموذجًا خاصًا في الحراك السوري، مالت إلى السلمية والاستقلالية، ورفضت الاصطفافات المسلحة للنظام البائد والمعارضة على حد سواء. لكن، ووفقًا لنظرية التفكك الاجتماعي واللامعيارية لدى عالم الاجتماع إميل دوركهايم، فإن المجتمعات التي تفقد تماسكها الأخلاقي والمؤسسي سرعان ما تُنتج حالات من التفكك والانحراف الجماعي. ما نشهده اليوم هو لحظة “أنومي” Durkheimian بامتياز، حيث ينهار النظام القيمي، وتُستبدل التراتبية الاجتماعية التعاقدية بأنماط ما قبل حداثية من الانتماء. وهو ما يتقاطع مع ما يسميه إدوارد شيلز “عودة الهويات الأولية”، حين تنهار الهويات الحداثية المرتبطة بالدولة القومية المركزية، وتطفو على السطح انتماءات طائفية وعشائرية تتغذى على الخوف وغياب الأمان.
لا يمكن تفسير تراجع المثقف إلى داخل طائفته أو جماعته المغلقة بوصفه موقفًا واعيًا دائمًا، بل هو غالبًا انعكاس لما يسميه زغمونت باومان “تفكك الإطار الأخلاقي” في المجتمعات السائلة.
من الهوية الحداثية إلى “الهوية الحامية“
في ظل غياب الدولة كضامن قانوني وأخلاقي، يلجأ الأفراد إلى الجماعة الأولية، لا انطلاقًا من وعي طائفي مؤدلج، بل كردّ فعل دفاعي يحاكي ما وصفه بيير بورديو بـ”رأس المال الرمزي”، الذي يمنح حامله مكانة أو حماية ضمن جماعة محددة.
وتتحول الانتماءات الطائفية أو العشائرية إلى أشكال بديلة من رأس المال الرمزي، توفر شعورًا بالانتماء والأمان في زمن تتهاوى فيه الشرعيات الوطنية. وهذا لا يكشف فقط عن فشل الدولة، بل عن إخفاق مشروع “الأمة” ذاته، الذي لم يتحول إلى عقد اجتماعي جامع في السياق السوري ما بعد الاستعمار.
أزمة المثقف بين الخوف والانكفاء
من أبرز مؤشرات الأزمة الراهنة في السويداء موقف النخب السياسية والثقافية، التي فشلت في بلورة خطاب نقدي يُفكّك البنى العصبوية، واكتفت بمواقف تبريرية تعزز الانغلاق الهوياتي، تحت ذرائع الخصوصية أو الواقعية السياسية.
هذا التراجع الفكري يعكس ما أسماه أنطونيو غرامشي “أزمة الهيمنة”، حيث تعجز النخب عن إنتاج مشروع تفسيري جامع، وتفقد بالتالي قدرتها على القيادة الثقافية، لتتحول من منتجة للمعنى إلى أدوات تبرير للانقسام. فالهيمنة، في تصور غرامشي، ليست قسرًا فقط، بل قدرة على تشكيل وعي الجمهور عبر الرضا الطوعي. وعندما تفشل النخب في ذلك، ينهار التماسك المجتمعي وتُفتح الأبواب أمام الفوضى والعنف.
الطائفة كملاذ وجودي في مواجهة الخوف
لا يمكن تفسير تراجع المثقف إلى داخل طائفته أو جماعته المغلقة بوصفه موقفًا واعيًا دائمًا، بل هو غالبًا انعكاس لما يسميه زغمونت باومان “تفكك الإطار الأخلاقي” في المجتمعات السائلة. ففي هذه المجتمعات، تنهار الهياكل الاجتماعية المستقرة، وتُستبدل القيم الفردية بقيم الجماعات الأولية التي توفر الحماية في ظل الاضطراب.
وبذلك يصبح الحفاظ على الوجود الشخصي، وليس فقط المعيشي، أولوية تتقدم على الالتزام القيمي، ما يفسّر الانجذاب نحو الانتماءات الأولية في ظل تهديد الوجود والهوية.
في الحالة السورية، يمكن فهم كثير من خطابات الحكومة أو بعض الجماعات الطائفية بوصفها تمارس عنفًا رمزيًا، حين تفرض تعريفًا أحاديًا للوطن، أو تُقصي الآخر المختلف ثقافيًا أو دينيًا.
صعود الهويات الطائفية في ظل الفراغ السيادي
لفهم صعود الهويات الطائفية، لا بد من العودة إلى مفهومي “العنف الرمزي” و”رأسمال الهوية” عند بورديو. فعندما تُسحب الشرعية من الدولة وتُترك المجتمعات في فراغ سيادي، تسعى الجماعات إلى إعادة إنتاج هوية قادرة على خلق حد أدنى من الأمان والانتماء.
وتتحول الهويات الأيديولوجية الكبرى (القومية، اليسارية، الدينية) إلى مجرد شعارات، ما لم تتجسد في مؤسسات حقيقية، كما أشار ميشيل فوكو مرارًا إلى تلازم الخطاب والسلطة.
وفي الحالة السورية، يمكن فهم كثير من خطابات الحكومة أو بعض الجماعات الطائفية بوصفها تمارس عنفًا رمزيًا، حين تفرض تعريفًا أحاديًا للوطن، أو تُقصي الآخر المختلف ثقافيًا أو دينيًا.
في هذا السياق، تصبح الطائفة فاعلًا سياسيًا، ليس لأنها تمتلك مشروعًا سلطويًا واضحًا، بل لأنها تمثل ملاذًا أخلاقيًا للفرد في زمن انهيار العقد الاجتماعي. وهو ما عبّر عنه توماس هوبز في مؤلفه الشهير اللفياثان (Leviathan, 1651)، حين ربط بين الخوف والأمن، مؤكدًا أن غياب الضامن (الدولة) يؤدي حتمًا إلى تفكك المجتمع وصعود ولاءات أولية بديلة.
من الدولة إلى اللا-دولة
ما يجري في السويداء لا يمكن عزله عن السياق السوري الأشمل، فهو يعكس ما أسماه شارل تيلي “الحرب الأهلية منخفضة الكثافة”، الناتجة عن تآكل مؤسسات الدولة وفقدانها لاحتكار العنف المشروع. فقد أسهم النظام السوري السابق، عبر تفكيكه المتعمد للمجال العام وتحويل الوطنية إلى أداة تطويع، في إعادة إدخال “القبيلة والطائفة إلى المجال السياسي”، وظهور سلطات أمر واقع.
ويصف المفكر الفرنسي أوليفييه روا هذا التحول بأنه انحسار للهويات السياسية الكبرى (القومية، الأممية، الإسلام السياسي)، مقابل صعود “الهويات الصغرى” كالطائفة والقبيلة والعرق، بوصفها هويات اضطرارية يلجأ إليها الأفراد كدرع حماية وجودي في ظل غياب الأفق السياسي الجامع.
هذه “اللا-دولة” ليست فراغًا سياسيًا فحسب، بل حالة اجتماعية ممتدة من التذرر والانقسام، تتطلب مساءلة شاملة لمفهوم الوطنية ذاته، وعلاقته بالمواطنة والانتماء والعقد الاجتماعي.
من النقد إلى التأسيس
هذه الحالة لا تمثل فقط فراغًا سياسيًا، بل تذررًا اجتماعيًا ممتدًا، يُحتم مساءلة المفاهيم التقليدية للوطنية والمواطنة والعقد الاجتماعي. إذ لا يكفي تفكيك اللحظة الطائفية، بل لا بد من تقديم بدائل حقيقية قادرة على إعادة إنتاج المجال العام، كما نظّر يورغن هابرماس في مفهومه لـ”الفضاء التداولي”، الذي يُبنى على الحوار العقلاني والاعتراف المتبادل، لا على القسر أو فرض الهويات من الأعلى.
غياب هذا الفضاء في سوريا، نتيجة الاستبداد ومن ثم الحرب، أدى إلى تهميش المواطن كفاعل حر، وأعاد إنتاجه بوصفه تابعًا لجماعته. وبالتالي، فإن قيام ديمقراطية حقيقية مرهون بإحياء هذا المجال العمومي.
إمكانية بناء مشروع وطني جامع؟
إن ما يجري في السويداء ليس حدثًا محليًا معزولًا، بل مؤشرًا بنيويًا لانفجار اجتماعي متكرر في عموم الجغرافيا السورية كلما غابت الدولة، وانكمشت النخب، وتراجعت الفكرة أمام العصبية.
السؤال المحوري لم يعد: من سينتصر في صراع جزئي؟ بل: هل لا يزال ممكنًا، سوسيولوجيًا، إعادة بناء مشروع وطني جامع؟ وهل يمكن تجاوز “اللحظة الطائفية” لصالح عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة الفاعلة؟
إن الجواب لا يكمن فقط في الحقل السياسي، بل يتطلب إعادة صياغة سوسيولوجية شاملة للعلاقات الاجتماعية والهويات والانتماءات، تعيد تعريف السياسة بوصفها ممارسة مدنية تشاركية، لا مجرد انعكاس لصراع الهويات المغلقة.
المصدر: تلفزيون سوريا