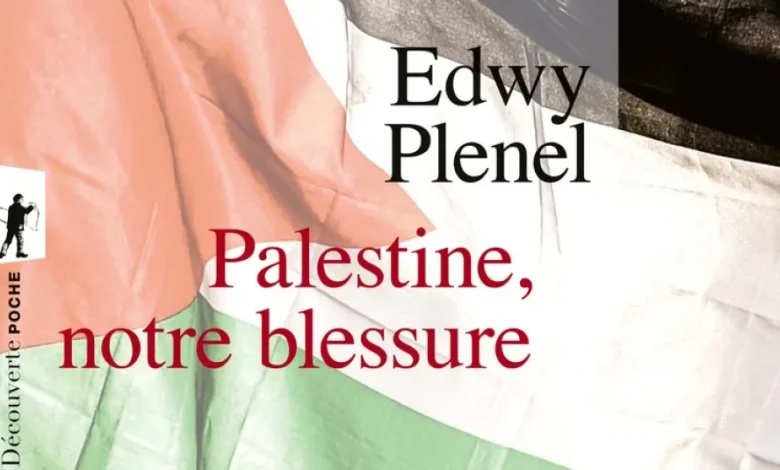
في كتابه فلسطين، جرحنا المفتوح، يقدّم الصحافي الفرنسي المعروف إدوي بلينيل، رئيس وأحد مؤسسي “ميديا بارت”، مرافعة سياسية حماسية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يوجّه انتقادات حادة للسياسة الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية، خصوصًا في العقود الأخيرة. يُكتب هذا العمل بلهجة احتجاجية لا تخلو من الصدق الإنساني، ويحاول كسر جدار الصمت الأخلاقي الذي يحيط بمعاناة الفلسطينيين. إلا أن الكتاب، رغم حماسته وشجاعته السياسية، لا يخلو من مواطن ضعف منهجية وتحليلية، تقلل من قوة حجته وتحد من أثره الفكري.
منذ الصفحات الأولى، يعلن بلينيل رفضه لما يسميه “الحاضرانية”؛ أي الميل إلى تحليل الأحداث المعاصرة بمعزل عن جذورها التاريخية العميقة. وهذا المبدأ يمثل عمودًا فقريًا للطرح الذي يقدمه في الكتاب، حيث يدعو إلى قراءة الواقع الفلسطيني من خلال عدسة التاريخ الاستعماري، وليس فقط من خلال الوقائع الجارية أو التغطيات الإعلامية الظرفية. إلا أن هذه الدعوة، رغم مشروعيتها، لا تُطبق بدقة في كل فصول العمل.
من أبرز إشكالات الكتاب، والتي تثير جدلًا واسعًا، هي اعتماده على مقارنات مبسّطة وربما مضلّلة بين اجتياح العراق عام 2003 والاعتداءات المتكررة على غزة. يرى بلينيل أن الموقف الغربي، الذي دان بشدة التدخل الأميركي في العراق، يفتقر إلى التناسق حين يغضّ الطرف عما يصفه بـ”الحرب على غزة”. يكتب: “لا يمكننا من جهة إدانة حرب العراق، ومن جهة أخرى قبول، ولو بصمت، ما يحدث في غزة”.
لا شك أن هذه المقارنة تنطلق من وعي أخلاقي يستحق التقدير، لكن من الناحية التحليلية، يبدو الأمر أكثر تعقيدًا. الحرب على العراق كانت غزوًا مباشرًا من دولة كبرى ضد كيان سيادي على أساس معلومات مفبركة، بينما الصراع في فلسطين أكثر تركيبًا، وينطوي على تاريخ استعماري طويل، ونزاع على الأرض والهوية، وصراع غير متوازن بين قوة محتلة وشعب يخضع لحصار دائم. الإصرار على هذه المقارنة في أكثر من موضع من الكتاب، يُفقدها قيمتها التحليلية، ويحوّلها إلى شعار سياسي أكثر منها أداة لفهم الواقع.
يتابع بلينيل في السياق نفسه، بالإشارة إلى نتائج الاجتياح الأميركي، التي أسفرت عن صعود تنظيمات متطرفة مثل “داعش”، ويرى أن غزة قد تشهد مآلات مشابهة إذا استمر القمع والخذلان الدولي. هذا الربط، وإن كان ينطلق من نية تحذيرية، يغفل الفوارق الجوهرية بين السياقين، ويقع في فخ الاستنتاجات المتعجلة.
جانب آخر مثير للجدل في الكتاب هو تركيزه الشديد على الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. يخصص بلينيل فصلًا كاملاً على شكل “رسالة مفتوحة” إلى هولاند، يتهمه فيه بتحويل الجمهورية الفرنسية إلى شريك غير مباشر في الظلم الواقع على الفلسطينيين، متهمًا إياه بتجريم كل نقد لإسرائيل، عبر الخلط المتعمد بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية. رغم أن بعض هذه الانتقادات في محلها، خصوصاً فيما يخص تقييد حرية التعبير بشأن فلسطين في فرنسا، فإن تحميل هولاند كل هذا الثقل يبدو مبالغًا فيه. فالسياسة الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية لم تبدأ بهولاند، كما أن خلفه إيمانويل ماكرون -الذي لم ينل سوى ذكر عابر- يتبنّى توجهًا أكثر دعمًا لإسرائيل. هذا التخصيص المفرط لشخصية واحدة يُضعف البعد البنيوي للتحليل، ويحوّل القضية من نقد مؤسسة إلى إدانة فرد.
بلينيل، المعروف بخلفيته التروتسكية وبنشاطه في الدفاع عن الحريات، يتبنّى موقفًا معقدًا إزاء إسرائيل. فهو من جهة يدين ما يسميه “الظلم الأصلي” المرتبط بتأسيس الدولة العبرية، ومن جهة أخرى لا ينكر شرعية وجودها وحقها في الاستمرار. هذه الازدواجية -أو هذه المحاولة للتوفيق بين الإدانة والاعتراف- تجعل خطابه في بعض المواضع مترددًا أو غامضًا. ومع ذلك، فإن تأكيده المتكرر على ضرورة رفض “الدعم غير المشروط” لأي طرف، سواء إسرائيل أو حماس، يعكس موقفًا ناضجًا يسعى لتأسيس عدالة نقدية لا تُحتجز في فخّ الاستقطاب.
رغم ما سبق، لا يمكن إنكار أهمية الكتاب في إثارة الأسئلة الضرورية حول موقف فرنسا، والإعلام الغربي عمومًا، من النكبة الفلسطينية المستمرة. بلينيل يذكّر القارئ الفرنسي -والغربي عمومًا- بأن جرح فلسطين ليس مجرد مأساة “بعيدة”، بل هو مرآة تعكس فشل القيم التي تدّعيها أوروبا، من حرية وكرامة وحقوق إنسان. من هنا، فإن العنوان نفسه، “فلسطين، جرحنا المفتوح”، ليس فقط وصفًا لحالة عربية، بل اعترافًا بجُرحٍ أخلاقي غربي لم يلتئم بعد.
في المحصلة، يمكن القول إن بلينيل يقدم كتابًا صادقًا في مشاعره، ومخلصًا في منطلقاته، لكنه محدود في أدواته التحليلية. إن حماسته السياسية، رغم جاذبيتها، تأتي أحيانًا على حساب العمق التاريخي والتعدد المفاهيمي. كان بالإمكان تعميق التحليل عبر إشراك المزيد من الأصوات الفلسطينية أو استحضار دراسات ميدانية معمّقة. كما كان يمكن تجاوز المقارنات السطحية، والتخلص من التركيز المفرط على أسماء بعينها، لصالح نظرة أكثر بنيوية وشمولًا.
ومع ذلك، فإن أهمية هذا العمل لا تكمن فقط فيما يقوله، بل في كونه ينضم إلى عدد قليل من الأصوات الفرنسية الجريئة، التي ما زالت تملك الشجاعة لتسمّي الأشياء بأسمائها، وتطالب بمساءلة أخلاقية حقيقية تجاه الظلم المستمر في فلسطين. قد لا يكون هذا الكتاب هو التحليل الأعمق أو الأكثر توازنًا، لكنه بالتأكيد واحد من أكثرها صدقًا ووضوحًا في زمن كثرت فيه الأصوات الصامتة.
المصدر: المدن







