
تمثل السياسة والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزّة والضفة الغربية عناصر لاستراتيجية واحدة، لها الأهداف والمقاصد نفسها، فما الذي يجمع بين الإبادة والعقوبات الجماعية الجارية منذ 21 شهراً في القطاع وبين الهجمات الاستيطانية والعقوبات الاقتصادية وعمليات القمع في الضفة الغربية والقدس؟
على عكس ما تروّجه الدعاية الإسرائيلية، وبعض المتورّطين في ضلالها، ليست الهجمات الوحشية على القطاع موجّهة ضد حركة حماس وقوى المقاومة وحدها، بل ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته، من رجال ونساء وأطفال، إذ للقصف الإسرائيلي على قطاع غزّة، وتهجير محافظاتٍ بكاملها تحت نيران الطائرات والمدافع، والمناورات الإسرائيلية في المفاوضات الجارية، هدف واحد، معلن وصريح لا يخفيه القادة الإسرائيليون، وهو محاولة دفع معظم، إن لم يكن جميع، سكّان القطاع نحو ما يسميها وزير الجيش الإسرائيلي، كاتس، “منطقة إنسانية” بين محوري موراغ وفيلادلفي، بغرض حشرهم في معسكر الاعتقال الأكبر في تاريخ البشرية، وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ثم التضييق عليهم بالتجويع، والفتن، والأمراض، لدفعهم نحو الترحيل أو التطهير العرقي إلى خارج قطاع غزّة. وما يسميها كاتس “منطقة إنسانية” ليست في الواقع سوى معسكر وحشي للتطهير العرقي.
يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، هذا المخطط الخبيث بأنه “فكرة رائعة”، ويتخابث أكثر، حين يصفها بأنها “رؤية ترامب”. ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، لم تخف حكومة نتنياهو مقاصدها من الجمع بين ثلاث جرائم حرب: الإبادة والعقوبات الجماعية والتجويع، فالهدف كان وما زال تكرار ما جرى في نكبة 1948، باستكمال التطهير العرقي لما تبقى من الشعب الفلسطيني على أرضه.
يعرف حكّام إسرائيل أن ما يعيق مخطّطاتهم هو الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، رغم قسوة الظروف الإنسانية بشكلٍ لم تعرف له البشرية مثيلاً
وفي الضفة الغربية التي لم تكن ساحة لـ “7 أكتوبر”، ولا تديرها “حماس”، بل السلطة الفلسطينية، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الهدف نفسه، بوسائل أخرى تشمل: أولاً، هجمات المستعمرين المستوطنين الإرهابية ضد القرى والمدن الفلسطينية في ما يكرّر إرهاب عصابات شتيرن والهاغانا وإيتسيل عام 1948، وترحيل ما لا يقل عن 40 تجمّعاً سكانياً. وثانياً، مصادرة الأراضي وتخصيصها لتوسع لا سابق له للمستوطنات. وثالثاً، هجمات لا تتوقف للجيش الإسرائيلي على مختلف التجمعات السكانية، وحملة اعتقالات غير مسبوقة من حيث الحجم منذ الانتفاضة الثانية. ورابعاً، حصار مادي واقتصادي يشمل أكثر من ألف حاجز عسكري تقطع أوصال الضفة الغربية، وقرصنة مكشوفة لأموال الضرائب الفلسطينية لتحطيم قدرات السلطة الفلسطينية، وحصار للبنوك لتحطيم العمود الفقري للعمليات التجارية والاقتصادية، واستيلاء متواصل على كل ما تبقى من صلاحيات للسلطة الفلسطينية. وخامساً، وكما تعمل إسرائيل على إنشاء عصابات مسلحة عميلة للاحتلال في قطاع غزّة لسرقة المساعدات الإنسانية، وترسيخ الاحتلال، فإنها تحاول إحياء الفكرة التي فشلت سابقاً بإنشاء روابط قرى متعاونة مع الاحتلال في الضفة الغربية.
الخيط الجامع بين كل هذه العمليات في القطاع والضفة بعد ضم القدس ترسيخ السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المنطقتين ومحاولة تهجير أكبر عدد من سكّانها إلى خارج فلسطين. وعندما يعلن وزراء فاشيون في الحكومة الإسرائيلية نية ضم المناطق المهجّرة في قطاع غزّة وإعادة بناء مستوطنات فيها، فإنهم يكملون دعوة 14 وزيراً من حزب الليكود الحاكم ومعهم رئيس الكنيست الإسرائيلي نفسه، لضم فوري للضفة الغربية، مستغلين صمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذه المخطّطات وتجاهله المطالب الدولية والسياسة الأميركية السابقة بتبنّي ما سمّاه المجتمع الدولي “حل الدولتين”.
إنها حرب تطهير عرقي وإبادة شعب في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزّة، وهل هناك ما يوضحها أكثر من التدمير الجاري لمخيمات طولكرم وجنين ونور شمس، تهجير أكثر من 65 ألف فلسطيني في الضفة الغربية من مخيّماتهم وقراهم وتجمّعاتهم البدوية. ولن ينجو الفلسطينيون المقيمون في أراضي 1948، من مخطّطات شبيهة، بعد أن جُردوا من معظم أراضهيم، إن نجحت المخطّطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
تعلّم الشعب الفلسطيني من تجربة 1948 أنه إذا ترك وطنه فلن يعود أبداً
ويعرف حكّام إسرائيل أن ما يعيق مخطّطاتهم الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، رغم قسوة الظروف الإنسانية بشكلٍ لم تعرف له البشرية مثيلاً، وإصراره على البقاء في وطنه، سواء في قطاع غزّة أو القدس أو الضفة الغربية. ورغم التقاعس المريع للمجتمع الدولي، والمحيطين العربي والإسلامي، لأن الشعب الفلسطيني نفسه تعلم من تجربة 1948 أنه إذا ترك وطنه فلن يعود أبداً، ولن يحافظ على كرامته ومستقبل أبنائه، ولأنه تعلم، عبر التجارب المؤلمة والمتكرّرة، أن “ما حكّ جلدك مثل ظفرك”، وما من بديل للاعتماد على النفس. ويؤدّي هذا الصمود البطولي إلى تحطيم كامل للرواية الإسرائيلية وإلى استنهاض حملة تضامن عالمية لا سابق لها مع الشعب الفلسطيني على امتداد المعمورة، وإلى تكريس القضية الفلسطينية باعتبارها “قضية العدالة الإنسانية الأولى في عصرنا”، كما تنبأ الزعيم والمناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.
فهل بقي، بعد ذلك، مجال أو مكان لتحريض الفلسطيني ضد الفلسطيني، أو لاستمرار الانقسامات والخلافات السياسية والفصائلية والفئوية؟ وإذا كان الشعب الفلسطيني بغض النظر عن أماكن وجوده، يواجه عدوّاً واحداً، ومؤامرة واحدة، وعمليات عدائية واحدة، فما الذي يبرّر استمرار غياب “قيادة وطنية موحّدة” لنضاله، واستراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة الخطر الوجودي الذي يتعرّض له، ولحماية مستقبله الوطني وحياة أبنائه وبناته؟
المصدر: العربي الجديد



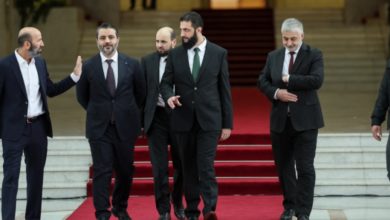




الحرب المتوحشة القذرة التي تشنها القوات الصhيونية لدرجة الإبادة والعقوبات الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني بالقطاع والهجمات الاستيطانية والقمع في الضفة الغربية والقدس، ليس غايتها حركة حماS وقوى المقاوmة وحدها، بل ضد كل الشعب الفلسطيني، ولمواجهتها يتطلب “قيادة فلسطينية وطنية موحّدة” لنضاله، واستراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة خطر وجوده.