
بمناسبة الحديث المتواتر من جهات مختلفة عن إمكانية عقد اتفاق سلام بين سورية وإسرائيل، وبالنظر إلى الظروف التي سبقت ورافقت عملية إسقاط نظام الأسد، وتشير إلى وجود تفاهمات دولية وإقليمية ما بهذا الخصوص، وبأخذ التطوّرات الهائلة والجذرية التي تلت هذا الأمر، خصوصاً موضوع الاعتراف بالنظام السياسي الجديد في البلاد، ورفع العقوبات الأميركية والغربية، والدعم السياسي الخارجي الواضح للرئيس أحمد الشرع وطاقمه الذي اختاره لقيادة المرحلة، فإنّ سؤال السلام يجد ما يبرّره، وبقوة.
لقد كان الصراع العربي الإسرائيلي محوراً أساسياً في حياة أهل المنطقة منذ وعد بلفور المشؤوم (1917)، ولسنا بحاجة إلى تعداد المحطّات التي مرّ بها هذا الصراع، فهي معروفة، بل محفورة في الضمير بنقشٍ لا يُمحي من غضبٍ وألمٍ وخذلانٍ وعارٍ وتعب. هذا الصراع كان سبباً في تأخّر النهضة العربية، فقد كان جرحاً غائراً يأبى الشفاء، ليس في عقول النُّخب التي ما فتئت تدرس أسبابه ونتائجه وانعكاساته فحسب، بل أيضاً في قلوب ملايين العرب والمسلمين، الذين يجدون في الأمر أكثر من صراعٍ على قطعة أرض، بل صراعَ وجودٍ وهويّةٍ وحقوقٍ تأبى النسيان.
تحطيم الإنسان وتهشيم روحه ووصم ضميره أهداف منشودة للأنظمة الاستبدادية التي سادت بلادنا
أُضيفت مع تمادي الزمن إلى قضية فلسطين قضايا تخصّ بلدان الطوق، مصر والأردن وسورية ولبنان، فكان على أنظمة الحكم المتعاقبة أن تعالج قضاياها الداخلية والخارجية بتأثير هذا العامل الضاغط بثقله كلّه. لجأ أنور السادات إلى الحلّ المنفرد، واختار الأردن اتفاقه الخاص لاحقاً، بعد أن بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تخوض تجربة التسوية وبناء السلطة في الضفة وقطاع غزّة. بقيت سورية “صخرةً للصمود والتصدّي”، حسب أدبيات حافظ الأسد وابنه (بشّار)، وبقي لبنان رهينةً لمزايدات نظام الأسد على العرب جميعاً. ولّد هذا الوضع في المنطقة موتاً بطيئاً للقضيّة الفلسطينية، وقضماً مستمرّاً ومتلاحقاً للأراضي والحقوق، ليس في الضفة والقطاع فحسب، بل في جنوب سورية، وفي جنوب لبنان أيضاً، كما حصل في الأشهر الماضية. فهل كان ذهاب السادات إلى السلام بتلك الطريقة، وفي ذاك الزمن، استشرافاً مستبصراً لما ستؤول إليه حالنا من ضعف، فآثر الخلاص الفردي، واستعادة ما يمكنه من أرض مقابل سلامٍ محدودٍ من دون تطبيعٍ نهائي؟… التاريخ من سيحكم على خطوته هذه، وما إذا كانت نحو الأمام أو إلى الوراء، في حقل الصراع الشامل هذا.
ليس كشفاً، ولا هو بالجديد القول إنّ أنظمتنا العربية في أغلب دولها وأدت أحلام مواطنيها بالعيش الكريم، وبالديمقراطية، تحت شعار تحرير فلسطين، وكانت هذه المسألة سبباً في دمار بنى المجتمعات وخراب أسس هذه الدول، لا لأنّ القضية الفلسطينية ليست شأن العرب والمسلمين، بل لأنّ الأنظمة هذه سلكت طريق الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها عبر ممّر القضية، ولم يكن لضيق أفق من استولوا على هذه البلاد أن يسمح بإدراك هزالة الفكرة، وضعف الأدوات، في تحقيق الشعارات المرفوعة. إنّ تحرير الأرض لا يكون إلا بعد تحرير الإنسان الذي سيقوم بهذه المهمّة، وهذا ما فعلت أنظمتنا الجمهورية (بالأخص) عكسه تماماً. لقد كان تحطيم الإنسان وتهشيم روحه ووصم ضميره أهدافاً منشودة لهذه الأنظمة الاستبدادية كلّها التي سادت بلادنا.
لا تكون استعادة الأرض إلا باستعادة الإنسان، والأوطان لا تُبنى إلا لمصلحة الإنسان المواطن
ما الذي تحصّل عليه السوريون أو العراقيون مثلاً من السلاح الكيماوي الذي صنّعه نظام البعث في البلدَين؟… ليس إلا “حلبجة” و”الغوطة”، وما فاض عنهما من قتلٍ مستشرٍ بهذا السلاح ضمن حدود هذين البلدَين. هل تجرّأ أيٌّ من نظامي الحكم على استخدامه ضدّ إسرائيل، التي لطالما حدّثانا عن أهمية التوازن الاستراتيجي معها؟ وهل يكون التوازن بالسلاح فقط، وهل الحرب الوسيلة الوحيدة لاستعادة الحقوق؟ ما الذي تحصّل عليه اللبنانيون من بقاء السلاح بيد حزب الله بعد اتفاق الطائف، وهل أثمرت المقاومة إعادة بناء الهُويَّة الوطنية بعد حربٍ أهليّة أكلت الأخضر واليابس، أم أودت بلبنان إلى التهلكة لارتباطها بأجنداتٍ خارجيةٍ، ولاستعمالها وسيلةً للمساوماتِ تحقيقاً لمصالحَ بعيدةٍ وبرامجَ نوويةٍ في أقصى الشرق؟ في المقابل أيضاً، يمكن السؤال عمّا إذا كان إبرام اتفاقيات بين مصر والأردن ومنظمة التحرير من جهة، وإسرائيل من جهة مقابلة، قد جلب سلاماً لهذه البلدان العربية، وتنميةً حقيقيةً لمجتمعاتها، وكرامةً لمواطنيها، وعيشاً رغيداً؟… والجواب واضح في الواقع لا حاجة لشرحه، ولا للحديث عنه أكثر ممّا كُتب وأكثر ممّا قيل.
بالعودة إلى سؤال المقالة الرئيس، هل من جواب واحد ومباشر يمكن تقديمه الآن، وهل ظروف سورية تسمح أساساً بالخوض فيه، وما عناصر القوة التي يملكها السوريون، شعباً ودولةً، للارتكاز عليها في المطالبة باستعادة الجولان وما تبعه من أراضٍ قضمتها إسرائيل بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024؟… الإجابة الأولية بسيطة: لا شيء. وطنٌ ممزّق بين مجموعات لا تزال تناهض نظام الحكم الجديد، دولةٌ منخورةُ المؤسّسات منهوبةُ الثروات من طول عهد الاستبداد والفساد، شعبٌ منهكٌ متعبٌ من طولِ المعاناة، ومن حربٍ عليه دامت 14 عاماً، وهُويَّة وطنية ممزّقة، وشعورٌ عارمٌ بالضياع والتذرّر والتشتّت. فهل سيشيح السوريون الآن وجوههم عن معالجة هذا الخراب (والدمار) كلّه، ليذهبوا في اتجاه مقارعة إسرائيل على الجولان؟ وهل بمقدورهم ذلك، حتى لو أرادوا وعبّروا عن إرادتهم هذه باستفتاء شعبي حقيقي؟
يمكن تأجيل الإجابة عن سؤال استعادة الجولان إلى حين استعادة الإنسان السوري، شرط عدم التفريط بحجّة عدم القدرة راهناً
لا تكون استعادة الأرض إلا باستعادة الإنسان، والأوطان لا تُبنى إلا لمصلحة الإنسان المواطن، ولا وجود لهذا الأخير إلا بقيام مؤسّسات الحكم على أسس صحيحة وسليمة تراعي قيم الحقّ والعدل والتشاركية، وتُعلي مبادئ حقوق الإنسان وتثمّن كرامته. هذه المهام كلّها ليست سوى خطوات أولية لازمة وغير كافية في طريق استعادة الأرض، لأنّ تحدّي القوّة الغاشمة الإسرائيلية المدعومة من أميركا وأوروبا ليس بالمتاح لأيّ دولة عربية منفردة. فعلى صغر حجمها، استطاعت إسرائيل فرض معادلاتٍ جديدة في الشرق الأوسط كلّه، وتمكّنت من استثمار ما قُدّم لها من دعمٍ لبناء منظومةٍ عنصريةٍ متكاملةٍ، سخّرتها لهزيمتنا جميعاً.
استعادةُ الأرض تكون بعد استعادة الذات، فما قيمة الأرض من دون أهلها؟ وهل تغيّرت الأرض يوماً أو انزاحت من مكانها أم ساكنوها الذين انزاحوا وهاجروا وهُجّروا؟ ولا تعود الذات قبل طرح الأسئلة الصعبة، ليس أسئلة الماضي والتراث فقط، بل أسئلة الحاضر بكلّ راهنيتها. ولا تُشترط الآن الإجابة عن سؤال كيفيّة استعادة الجولان، فيمكن تأجيله إلى حين اكتمال شروط استعادة الإنسان السوري داخلياً، لكن مع اشتراط عدم التفريط بحجّة عدم القدرة راهناً، فيجب ألا نكرّر مأساتنا في لواء إسكندرون مجدّداً، ويجب أن نعرف متى نقول نعم، ومتى نقول لا، وهذا أضعف الإيمان.
المصدر: العربي الجديد


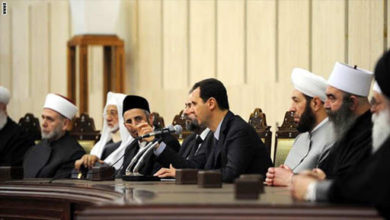





النظام البائد حطم الإنسان وهشم روحه ووصم ضميره بأهداف الأنظمة الاستبدادية التي سادت بلدنا، لذلك لا يمكن استعادة الأرض إلا باستعادة الإنسان، لأن الأوطان لا تُبنى إلا لمصلحة الإنسان، لذلك يكون تأجيل استعادة الجولان لحين استعادة الإنسان السوري، شرط عدم التفريط بحجّة عدم القدرة راهناً باستعادةُ الأرض، فما قيمة الأرض من دون أهلها؟