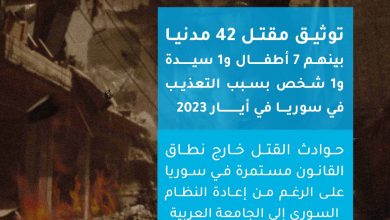الحلقة السابعة: الإخوان المسلمون ـ محاولة تفسير 3/6
محطات رئيسية في تاريخ التنظيم ـ خلاصات عامة
تلك هي المحطات الرئيسية التي رأينا أن نقف عليها، وهي تتمحور حول ثلاثة نماذج مستقلة في ظروفها وطبيعتها، وفي القوى المشكلة لأطرافها:
** في مواجهة القوى الرجعية المرتبطة كاملا بالغرب الاستعماري، والتي يحاصرها إجماع وطني مناهض ورافض (صدقي، النقراشي، السادات، النميري) يتشكل الأنموذج الأول. وقد كان التحالف مع هذه القوى هو الطابع المميز لسياسة الإخوان، وفي الغالب فإن المواجهة جاءت بمبادرة من هذه القوى ذاتها.
** وفي مواجهة قوة ثورية تحمل مشروعا حضاريا مستقلا، وتصطدم دون هوادة مع الغرب الاستعماري، وتلقى أوسع تأييد جماهيري يشهده تاريخنا المعاصر، يتشكل النموذج الثاني، وكان الصدام سمة العلاقة بين الاخوان وهذه القوة، وقد أخذ الإخوان المبادرة في تسعير هذه العلاقة.
** وأخيرا في مواجهة حكم ذي طبيعة ديكتاتورية، وسمة طائفية، ويواجه رفضا شعبيا متصاعدا، تشكل النموذج الثالث، وجاء الصدام ليطبع هذه العلاقة بطابعه، وقد حدث هذا الصدام دون أن يضع في حسبانه الرفض الشعبي، وتم تحوير المعركة من إطارها “الوطني ـ الاجتماعي”، إلى إطار طائفي مذهبي، وعجز بديلهم المطروح عن تمثل أي بعد اجتماعي، وقد خلف هذا الأنموذج من الصدام أسوأ الآثار السلبية، وهي تتطلب الكثير من الجهد الوطني لتجاوزها.
إن مراجعة هذه المحطات، ومراجعة تاريخ الإخوان المسلمين عموما يضع أيدينا على بعض المؤشرات التي تسمح لنا بفهم ما يبدو تناقضا غير مفهوم في مسلك الإخوان.
إن أهم المسائل التي دفعت حركة الإخوان المسلمين إلى الوقوع في المأزق الذي يشير إليه تاريخهم أنهم رفعوا شعار” الإسلام”، وجعلوا من هذا الشعار إيديولوجيا لهم، وتماما كما يقول مفكرو الإخوان، فإن الإسلام في جانبه الأول ـ إن صح هذا التقسيم ـ أي الجانب المتعلق بعلاقة الفرد بربه من حيث: العبادات، الأوامر والنواهي، لا يثير إشكالية كبيرة، ولا يحمل الأخذ به ثقلا مميزا، خصوصا حينما تنبسط النظرة الى هذا الجزء، وينزع أثرها من المجتمع، أو يوضع هذا الأثر كناتج طبيعي يتحصل بطريقة آلية.
أما الاسلام في جانبه الآخر، أي الجانب الاجتماعي، فإن الحمل يختلف، والإشكالية تظهر كأشد ما تكون، وهي تظهر على جانبين: الجانب الاجتماعي، والجانب الفكري.
** في الجانب الاجتماعي: فإن مادة الإسلام وقواه هي مادة وقوى الأغلبية الشعبية التي يتكون منها كل مجتمع إسلامي، وهذه الأغلبية إذ يختزن ضميرها الإسلام كوازع لا حدود له، ويملك عليها سلطانا عظيما، وهي تعيش واقعا اجتماعيا واقتصاديا مزريا، وتنتظر ممن يتقدم للتحدث باسم الدين أن يقدم إجابات شافية على أسئلة هذا الواقع، وأن يحمل بين يديه مشروعا ينقذها مما هي فيه.
**وفي الجانب الفكري: فقد توقفت النهضة الفكرية التي قامت في ظل الإسلام منذ أمد بعيد، وبتجاوز معتبر، يمكن القول إنها توقفت منذ إغلاق باب الاجتهاد، لكن الحياة بمختلف أبعادها لم تتوقف، فأصبح البون شاسعا بين ذلك الإنتاج الفكري الإسلامي، وبين هذا الواقع الاجتماعي الإسلامي، ولا بد من قطع هذه المسافة، وردم هذه الهوة، وهذه مهمة من الطبيعي أن يحملها ـ أو يجب أن يحملها ـ من يرفع شعار الإسلام.
وفي الجانبين الاجتماعي والفكري فإن حركة الاخوان المسلمين كانت أعجز من أن تحمل هذا العبء، ولا يأتي عجزها من عجز القائمين عليها ذاتيا، وإنما يأتي العجز من جذر موضوعي لا بد من كشفه.
إن كل الآراء والدراسات التي طرحها قادة الإخوان ما هي إلا تخريجات تستند إلى ذلك العصر من الاجتهاد الفقهي، وبالتالي فإن حقيقتها لم تتكون لتجيب على ما يطرحه واقع اليوم من إشكالات، وحين تقسر على القيام بهذا الدور، تبدو قاصرة، وذات صبغة لا تتوافق مع هذا الواقع، ثم إن هذا القسر يلقي بظلال قاتمة على ذلك الاجتهاد الإسلامي العظيم، الذي اكتسب صفته ومكانته بمقدار ما جاء استجابة لتحدي الحياة في ذلك العصر.
إن الربا حرام في الإسلام، وحرمته من الوضوح بحيث من يجادل فيها فإنما يجادل في باطل بيٍن. وحينما يصار إلى مناقشة الربا في هذا العصر فإن من الخلل الكبير البحث عن مؤسسات مالية لا ربوية معاصرة مثل ” البنوك الإسلامية”، والدعوة إلى حل مسألة الربا عن طريق “القرض الحسن”. ذلك أن تعقد الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتشابك النظام الاقتصادي العالمي يجعل القول ب “إسلامية البنوك” خديعة لله، ولرسوله، وللمؤمنين، وطريقة الغرض منها، أو المآل لها، تجميع أموال المسلمين ليستفيد منها قلة، وضخ هذه الأموال في آلة النظام النقدي الربوي العالمي، أكثر مما هي محاولة للخروج من أسر ربوية المصارف.
المصرف لم يعد مقرضا، كذلك لم يعد المقرض الذي كان يمارس الربا في العصر الذي واجهته الدعوة. المصرف اليوم جزء من نظام اقتصادي شامل يقوم على أسس وقوانين اقتصادية، واجتماعية، ومن رضي بأن يبقى في إطار هذا النظام فإن من الجهالة الادعاء بقدرته على جعل أهم أسس هذا النظام “المصارف” ذا صبغة إسلامية.
وعملية مقاومة الربا، ومحاربته، لا تتكون، ولا تصاغ من خلال مثل هذه “الحيل”، وإنما تصاغ بطريقة أخرى لا علاقة لها البتة بهذا الطريق.
إن المسلمين مدعوون حتى يحاربوا الربا أن يقطعوا الشرايين التي تصلهم وتربطهم بهذا النظام العالمي، والمدعو بالنظام الرأسمالي، وأن يغلقوا هذا الباب نهائيا، وبدون ذلك فإن كل كلام آخر عبث لا قيمة له.
ومعالجة الفقر في المجتمع الإسلامي، لا تتأتى من خلال الزكاة، ذلك أن الزكاة فريضة فرضها الله تعالى على الأغنياء للفقراء، وما يتصل بهم، وهي حقهم، في كل زمان ومكان، بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي، وآلياته، ومعالجة الفقر تتأتى من خلال نظام اجتماعي لا يسمح بهذا الذي نراه سائدا في مجتمعاتنا أن يستمر، أو أن يتشكل مجددا.
ومعالجة الاستبداد لا يتحقق من خلال رفع الحاكم لمبدأ الشورى، أو لشعار تطبيق “تطبيق الشريعة الإسلامية”، فإن الإسلام الذي جاء بهذا قبل خمسة عشر قرنا، فكان ثورة بكل معنى الكلمة، ترك تطبيق هذا المبدأ ـ كما غيره ـ لطبيعة كل عصر، بما يحقق جوهره. ومن الخلل الفادح أن نرى الظلم يحيط بنا من كل جانب ثم نقول: إن نتائج الشورى غير ملزمة للحاكم، أو أن الشورى تدور في نوع محدد من الناس، فيتحول هذا المبدأ من أداة لضبط الحاكم والحكم، إلى أداة لتغطيته.
الشورى الإسلامية في واقع اليوم تتطلب تحديد معنى السلطة، ومشروعيتها، ومشروعية أساليبها، ودور ” الناس” في الحكم، وواجبات السلطة في تمكين ” الناس” من القيام بهذا الدور ….. الخ.
إننا نضرب الأمثلة حتى نبين بعض جوانب المهمة الفكرية لكل من يحمل الإسلام شعارا له، وحتى نضع كل ذلك في الإطار الصحيح له.
في مواجهة النماذج ” الاقتصادية ـ الاجتماعية” المطروحة في الغرب، والملخصة بالأيديولوجيا الرأسمالية والشيوعية، فإن مهمة المسلمين أن يبنوا أنفسهم، ومجتمعاتهم، في إطار “مشروع حضاري مستقل”، لا هو المشروع الرأسمالي، ولا هو المشروع الشيوعي، وليس وسطا بين الاثنين، وإنما هو مشروعهم الخاص، مشروعهم الذي يستمد أصوله وجذوره من روح الإسلام العظيم، ومن الدلالات التي أشارت إليها حضارته الباهرة، وبناء هذا المشروع لا يتحقق من خلال الجهد الفكري النظري، وإنما من خلال الاستخلاص النظري في معركة الحياة ذاتها، وهذا يتطلب أول ما يتطلب تحديدا صحيحا لقوى هذا المشروع اجتماعيا، ولتوجهاتها اقتصاديا، ولإطارها حضاريا وثقافيا.
وإذ خسر الإخوان المسلمون معركتهم مع عبد الناصر، فإنهم ـ كما قلنا ـ لم يخسروها بواقع العنف الذي صاحب العلاقة بينهم وبين نظام الثورة، وإنما بواقع أن الثورة كانت تحمل مشروعا حضاريا مستقلا، استطاع أن يسحب من حركة الاخوان القاعدة الاجتماعية العريضة التي تحركوا من خلالها.
وإذ تصاعد الصدام والعداء بينهم وبين الثورة، فإن أول ما يجب ملاحظته أن تصاعد هذا العداء والصدام ترافق مع درجة نمو وتكامل رؤية الثورة لهذا المشروع، وحركتها في اتجاهه.
إننا لا ندعي هنا أن ثورة عبد الناصر امتلكت كل مستلزمات هذا المشروع، وأجرت كل التغييرات الاجتماعية التي يفرضها، وصاغت كل الرؤى الفكرية التي تعبر عنه، فإن مثل هذا الادعاء وهم يكذبه الواقع، وإنما نستطيع أن نقول بكل ثقة: إن هذا المشروع كان يتكامل في معركة البناء نفسها، ولقد انتكست الثورة قبل أن تستكمل جانبين مهمين لهذا المشروع:
أولهما: الجانب القانوني في بنية المجتمع.
وثانيهما: جانب بنية النظام التعليمي.
وهما جانبان تفرضهما مسيرة هذا المشروع ذاته، أي مسيرة تحقيق الاستقلال الحضاري والثقافي للأمة.
إن المنطق الشكلي للإخوان المسلمين، وهو منطق لا يمت بأي صلة إلى الإسلام، هو الذي يفسر وقوفهم إلى جانب أسوأ نماذج الحكام الذين مروا على هذا الوطن، وهو منطق يعكس رؤية متخلفة، والتزاما اجتماعيا رجعيا، ولو عدنا إلى المحطات التي وقفنا عليها، لتبين لنا بوضوح حقيقة هذا التوصيف.
فقد وعد ” إسماعيل صدقي” الإخوان المسلمين بأن يلتزم قضايا الوطن، وبالمثل فعل النقراشي، والسادات رجل مؤمن، وكذلك أبوه، أما جعفر نميري فقد أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال بنفسه إماما للمسلمين ؟!… هذه المبررات تجعل مناط الحكم على الفرد والسلطة هي الكلمة، وليس الفعل، هو القول وليس الموقع الاجتماعي والاقتصادي، هو ” اطمئنان قلب الإخوان” وليس اطمئنان موقف الناس. هو الرياء والخديعة، وليس الإيمان الذي يصدقه العمل. وقد يبدو فيما نقول بعض التحامل على هذا المنطق الشكلي، لكن الاستماع إلى أقوال قادة الاخوان يظهر صدق وأمانة هذا التوصيف، لنستمع إلى رواية ” محمود عبد الحليم” في مذكراته” الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ”، حينما يتعرض إلى اتصال إسماعيل صدقي رئيس الوزراء المكلف بالمرشد العام، يستطلع رأيه فيما أسند إليه، فبعد أن يقدم لهذا الاتصال بالحديث عن فساد الأحزاب، وعن واقعية الرجل “صدقي”، وعن المهمة الخطيرة التي وضعها نصب عينيه، يقول:” اتصل صدقي بالأستاذ المرشد، ـ بموافقة القصر، وتسليمه ـ ، وكاشفه باتجاه النية إلى اختياره لرياسة وزارة غير حزبية لمفاوضة الإنكليز، وأنه أرجأ رده بالقبول أو الرفض حتى يعرض الأمر على الإخوان المسلمين، وينتهي معهم على وضع معين، فصارحه الأستاذ المرشد بقوله: إن ما شاع بين الناس عن تاريخك السياسي قد يبعث على النفور منك، ولكننا نحن الإخوان مقيدون بقول الله تعالى: “ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا”. فنستمع إليك، ونزن ما تقوله بميزان دعوتنا، فقال الرجل: إنني أعلم ما أشاعه أعدائي عني، وإن كان كل إجراء اتخذته ضدهم كان له ما يبرره من وجهة نظر الحزبية المصرية، التي لا تتقيد بآداب ولا بمثل، ولا بخلق، وإنما هي كيد شخصي يكيده فرد لفرد، وحزب لحزب. أما وقد تطورت هذه الحياة السياسية، ونشأت هذه الهيئة التي تقوم على الدين والخلق، فلا يسعني حين أتقدم إليها إلا أن أخلع الثوب الذي لبسته طوال حياتي، وأعلن توبتي، وافتتاح صفحة جديدة.
وبعد هذا ناقشت الهيئة التأسيسية للإخوان أمر التعاون مع صدقي، وانتهى القرار من الهيئة بقبولها مبدأ التفاهم مع الرجل، ما دام قد جاء يريد فتح صفحة جديدة على أسس يرتضيها الإخوان”.
هذا نموذج، وفي كل ما أتينا عليه من نماذج، فإن موقف “الناس” الذين يشكلون مادة الإسلام، ومستودعه، لم يكن في البال، ولم يؤخذ بأي حسبان، وإذ يعكس هذا الموقف صميم الفكر الديكتاتوري، فإنه يفسر عمليا معنى “الجاهلية”، وبعيدا عن كل الطروحات النظرية التي قال بها مفكروهم.
لقد وقف الناس، كل الناس، ضد صدقي، والنقراشي، والسادات، والنميري،
ووقف الناس، كل الناس، مع الثورة، ومعاركها، ومع جمال عبد الناصر.
وفي الموقفين فإن سياسة الإخوان لم تأخذ مواقف ” الناس” في حسابهم، وسياستهم وتفكيرهم. إنهم رفعوا شعارا ” الإسلام” يحتم عليهم السير في طريق محددة، ويحملهم مسؤوليات جسيمة، وجليلة، وساروا في طريق آخر أملاه عليهم فهمهم الاجتماعي المتخلف.
وفي الموقعين أيضا، فإن معيار الصحة والخطأ، كان يختصر بالموقف منهم، ومن منطقهم، أي أنهم في الوقت نفسه أخذوا دوري: جهاز الارشاد، وجهاز النفيذ والحكم، وضاع في خضم حركتهم نداء المرشد العام “نحن دعاة لا قضاة”، ولهذا السبب أيضا فإنهم اصطدموا بالناس، واختلفوا عنهم بالموقف، ثم عادوا واصطدموا بحلفائهم من الحاكمين، ودخلوا المحن التي دخلوها، ولو كان في وسعهم إدراك قوانين الحكم وطبائعه لعرفوا جيدا أنه حتى بافتراض النيات الحسنة التي قد يتمتع بها حاكم ما! فإنها غير كافية، وغير ذات وزن في توجه السلطة، وفي قراراتها، وإن ما يحكم هذه وتلك ليست النيات وإنما ” الطبيعة الاجتماعية ـ السياسية” التي وضعت الحاكم في موضعه هذا ليعبر عنها وليحميها.