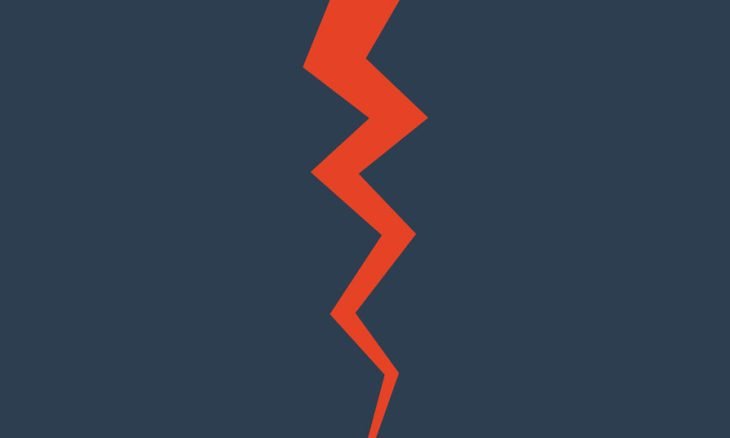
يندر أن لا تُذكَر سوريا في التصريحات المتعلقة بالحرب الأوكرانية، كمثال عمّا فعلته روسيا بها وتُكرّر بعضاً منه الآن في بوتشا وإربين وماريوبول. ويدفع هذا بالسوريين إلى مراوحة بين الأمل وفقدانه. الأمل بأن يتحرّك المجتمع الدولي لإيجاد حلٍّ للقضية السورية بعد أن يستوعب بوتين وحكومته الدرس، والخوف من أن يؤدي الصراع «الأوروبي» إلى الانشغال وتكثيف الطاقات، لتدارك آثار ما حدث وسيحدث هناك. فلن تخرج روسيا إلّا خاسرة بغض النظر عن كسبها الحرب عسكرياً أم هزيمتها، وقد تتمسّك بقاعدتها السورية بأظافرها بعد ذلك؛ أو أنها سوف تخرج مهيضة الجناح وتلتزم الواقعية السياسية لتخفيف خسائرها، فينفتح باب جديد للعملية السياسية في سوريا.
من ناحية أخرى، يرى البعض في استنقاع المسألة السورية الراهن، ضرورة للانتقال إلى الحلّ السياسي عند نضوج ظروفه وتوافق حملة الأسهم الأساسيين في القضية، أو أنه سوف يكون إذا امتدّ وطال مدخلاً لنهاية سوريا، وتكريس تفتّتها وتحوّلها إلى بؤرة توليد للعنف وتصديره إلى أكثر من مكان، بعد أن تمّ استيراد بعض أهمّ عوامله من أكثر من مكان إقليمياً ودولياً.
تنقسم البلاد حالياً إلى ثلاث مناطق، تحكمها قوى أمر واقع، وتحميها أطراف خارجية: سوريا الأساسية التي حكمها الأسد الأب ثم الأسد الابن حتى تحوّلت إلى خرقة يعشّش فيها الفساد وأمراء وتجّار الحرب والميليشيات العابرة للحدود؛ والشمال الغربي الذي يتمتّع بحماية تركية وتسود فيه قوى من بقايا بـ»الجيش الحر» بعد أن أصبح فصائل يغلب عليها التشدّدُ أو التطرّف، فالإرهاب، في انقسام ما بين منطقة في إدلب تهيمن فيها هيئة تحرير الشام، وأخرى في شمالها تحكم فيها الفصائل الأكثر التصاقاً والتزاماً بالسيطرة التركية؛ والشمال الشرقي الذي يتمتّع بالحماية الأمريكية، في تداخلٍ مع وجود روسي وأسدي، وتسيطر فيه عسكرياً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسياسياً مجلسها السياسي (مسد) وتحكمها إدارة ذاتية من نمط خاص، من صناعة حزب الاتحاد الديمقراطي أساساً، المتّهم بقربه أو بنوّته تنظيمياً أو أيديولوجياً لحزب العمال الكردستاني- التركي. وهناك مناطق مختلفة جزئياً، كمنطقة التنف، حيث القاعدة الاستراتيجية الأمريكية، وجنوب سوريا في درعا والسويداء والقنيطرة، وحتى في غيرها، مع اختلاف المسيطر الفعلي على الأرض، وعلى الحواجز. تختلف المناطق الأساسية من حيث شكل الحوكمة والسيطرة، ومن حيث الاجتماع والاقتصاد والتعليم والقضاء واحتكار العنف، وما بين تلك الميادين من اتّصال أو انفصال:
في منطقة النظام، يسيطر الأسد مركزياً ونظرياً، ويحيا على دعم روسيا وإيران؛ ويمسك رسمياً بخيوط الحكم والحوكمة وعواملها بين إدارات مركزية وبنية تشريعية متداعية الشرعية، مع بنية اجتماع متدهور اللحمة عصبويٍّ وفئوي؛ وتقسيم على الأرض يرتبط بالمسيطر على الحواجز من عصابات الشريحة السائدة. ويضاف إلى ذلك ما قام به النظام من تهجير قسري واسع إلى الشمال وخارج البلاد، بما يُدخِله في خانة الهندسة الديموغرافية، التي تهدف في أعرافه إلى» التجانس» البشري. وعلى طريقه لتحقيق» انتصاراته» قام النظام أيضاً بدكّ التجمعات السكنية وألغى صلاحية نسبة كبيرة من المساكن والأحياء والمناطق… بعد» تعفيشها» أو تعريتها من كل محتوياتها. وصل اقتصاده إلى الحضيض مع سعر متدهور للعملة، وحالة إملاق على حافة المجاعة، في بنية ريعية زبائنية فاسدة، تتغيّر عناصرها القائدة بوتائر سريعة؛ تعتمد على النهب وتصنيع وتجارة الكبتاغون وغيرها؛ وبنية تحتية هشّة و»لا مركزية» من كهرباء وماء ونقل ومواصلات وغير ذلك، لا يمكن استصلاحها بسلطات غير مسؤولة وعقوبات كاسحة خارجية. تدهور التعليم أيضاً وتراجع مستواه وتعاظمت أعداد المتسربين منه بشكل مخيف. كذلك تهتّكت وفسدت السلطة القضائية، التي يكفي آخر أخبار النظام لتخيّل حالتها، بإصدار الأسد قانوناً يجرّم التعذيب بعقوبات كبيرة، هو الذي قتلت أجهزته بالوثائق التي كشفت حتى الآن فقط (مجموعة صور قيصر) عن وفاة جزء ممّن ماتوا تحت التعذيب: أحد عشر ألفاً، مع وجود قانون قديم يعفُي أجهزة الأمن من أي ملاحقة قانونية أو عواقب لجرائمها، لاكتمال المهزلة والمسخرة.
وفي منطقة إدلب وشمال حلب ثم عفرين هنالك سيطرة واستقلال كبيران نسبياً لهيئة تحرير الشام (المُصنفَّة إرهابية) و»حكومة الإنقاذ» التابعة لها في إدلب مع عين تركية قريبة، وسيطرة لفصائل «الجيش الوطني» مع وجود الجيش التركي والإدارة التركية من الولايات المجاورة، ذلك الجيش الذي أصبح بعضه مصدراً للمرتزقة الذين يُرسلون هنا وهناك. وتعمل في تلك المنطقة أيضاً «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف الوطني لقوى المعارضة؛ الذي تراجعت منزلته بشكل كبير؛ وهيئات متنوعة في مدن وبلدات إعزاز وعفرين والباب وغيرها.
تعرَضت البنية التحتية لأذى شديد هنا، ويعتمد الناس على الكهرباء من الشبكة الرسمية بشكل محدود، مع أن أجزاء منها وأبراجاً قد فقدت، ومن مجموعات توليد خاصة انتشرت بشكل واسع. كذلك تعرّض الكثير من المصانع والمؤسسات إلى «التعفيش» وإخلاء مكوناتها الرئيسة للبيع بعيداً. كما تراجعت أحوال الزراعة والصناعة والتجارة وتراجع مستواها بوجود بعض السلطات الأكثر تخلّفاً والأقل قدرة على التنظيم والإدارة. وتدهور أيضاً مستوى التعليم وتعاظمت أعداد المتسربين منه إلى سوق العمل أو الانتساب إلى المجموعات العسكرية لكسب لقمة العيش. ويتراوح تنفيذ القانون هنا ما بين محاكم شرعية وقضاء تركي قريب العيون وتحكّم بعض الأعراف. وليست إدارة تلك المناطق بالأمر اليسير مع تركيز توجّه أعمال التهجير القسري من مناطق النظام، الأمر الذي أدّى كذلك إلى انتقال مجموعات عسكرية إسلامية إلى هناك، وجعل البنية الاجتماعية ممزقة ما بين الحياة في الخيام، وظروف المعيشة البائسة. أمّا في الشمال الشرقي، ورغم وجود إدارات النظام وأجهزة أمنه في مربّعات، وجيشه في بعض المعسكرات، مع وجود عسكري روسي، إلّا أن الهيمنة واليد العليا هي للوجود الأمريكي و»قسد» المعتمدة على نواتها القوية من» قوات حماية الشعب» وحزب الاتّحاد الديمقراطي. ولتلك المنطقة حوكمة محلية «إدارة ذاتية» ذات خصائص شمولية لا تخفى على أي عين، خصوصاً في ضعف الحريات الأساسية وانتهاكات لحقوق الإنسان متنوعة. ومؤخّراً تحاول تلك السلطات الخروج من تمركزها حول ذاتها لتؤكّد انتماءها السوري، ونفي كونها انفصاليّة العقلية والهوى، الانطباع الذي يشكّل انتشاره في الأوساط السورية عبئاً عليها وضغطاً كبيراً. كذلك أخذ التعليم شكل الفئة السائدة هناك وبعض أفكارها، وتنوّع القضاء وآليات تنفيذ القانون والنظام. ولتلك السلطات إشكالات غير محلولة وتزداد صعوبة على الحلّ مع الزمن، ليس مع العرب والقوى السياسية السورية عموماً، بل مع القوى الكردية الوازنة الأخرى.
إنّ الحوكمة الذاتية التي تغرق في التميّز والفرادة والغرائبية الأيديولوجية في الشمال الشرقي والشمال الغربي، مع حوكمة عصبوية في مناطق النظام، لن تساعد أبداً على استعادة وحدة سوريا في مستقبل قريب، بل على العكس تماماً، ستزيدها صعوبة، وقد تفتح الطريق إلى المزيد من التمزق والتفتّت والفوضى… وستصبح استعادة الجولان آنذاك – مثلاً- مجرّد طرفة. من تلك المناطق الثلاث هاجرت ملايين، ونزحت ملايين، وجاع وتعرى ملايين، وأصبحت هناك» سوريا الشتات» الكبيرة، بحمولة من مكوّنات النخب السورية، ما يجعل المناطق الثلاث ناقصة ومشوّهة، وتكتسب ميزاتها الخاصة شيئاً فشيئاً، مبتعدة عن غيرها، وعن سوريا التي عرفناها… ولن تعود كما كانت.
في هذه الأحوال، لا بدّ من أن تهزّ النخبة السياسية السورية أكتافها وترمي عنها الحمولات الزائدة، وتواجه المسألة بعقلية مختلفة ـ بشكل ثوري – عن السابق. وهي سوف تتحمّل مسؤولية تاريخية عن ضياع البلاد وتسرّبها من بين أيدينا ما لم تغيّر من كلّ طرائق تفكيرها وعملها القديمة، ومن كسلها أيضاً، الأمر الذي ساعد الآخرين – والنظام أولاً- على تدمير تلك البلاد الجميلة، وعلى أن يتعرض الشعب السوري لكلّ هذا العقاب، لمجرّد وجوده في المكان الجغرافي الخطأ، والزمن التاريخي الخطأ؛ كما قال باحث في أقصى الأرض! وربّما- ربّما صغيرة- تفتح حرب أوكرانيا نافذة سورية، سوف يكون كارثة ألّا نكون جاهزين لها!
المصدر: القدس العربي







