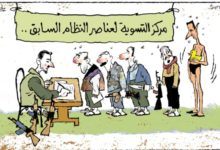في مخيم الرمل في اللاذقية، أو “الرمل الفلسطيني”، أوائل السبعينيات، وُلِدتُ. وبعد سنتين من استنشاق هواء الأبيض المتوسط الرطب، انتقلتُ مع أسرتي إلى دمشق لأعتاد هواء غوطتها الشرقية العليل، حيث عيّن والدي مديرا لمدرسة المجيدل المتوسطة للذكور، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي جوبر الدمشقي. كانت جوبر، في حينه، قرية ريفية، أُلحقت حديثا بدمشق، بموجب مخطط إيكوشار عام 1968. كان الحي من أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في دمشق خارج مخيم اليرموك. قدّمت “أونروا” خدماتها هناك، وافتتحت الفصائل الفلسطينية مكاتبها السياسية بالقرب من معسكراتها التدريبية في الغوطة الشرقية. قرّر والدي عام 1980 الاغتراب في دولة خليجية، بعد أن نال تعويضا بسيطا من “أونروا”، على خلاف زملائه موظفي “الوكالة” الذين بدأوا بالاستقالة أو التقاعد بتعويضاتٍ سخية، منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، بعد تحسّن في رواتب “الوكالة”، ونظام التعويضات الخاص بها، والذي جاء نتيجة نضال مستمر لموظفيها، ولعب فيه عامل فرق سعر الصرف، بعد تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، دورا مهما. الحي اليوم مدمّر بنسبة 80%، معظم المنازل باتت أثرا بعد عين، وتحت الركام دُفِنَتْ سنوات طفولتي الأجمل، ولا يزال أهالي الحي (حوالي 300 ألف نسمة وفق إحصاء 2008)، وعشرة آلاف فلسطيني، ينتظرون إذنا بالعودة إلى منازلهم.
مع انطلاق حركة التوسّع العمراني التي ابتلعت الأراضي الزراعية حول مخيم اليرموك، في ثمانينيات القرن الماضي، بدأ كثيرون من فلسطينيي جوبر ينتقلون إلى تلك المناطق، طمعا في امتلاك منازل، لأول مرة منذ لجوئهم. تمكّن والدي العام 1984 من شراء منزل في المخيم. وبوصفي “مغتربا” كانت علاقتي بالمخيم صيفية، لكنها لم تخلُ من الزخم والأصدقاء والنشاطات المختلفة لمراهقٍ في مثل سني؛ مباريات الشطرنج في الحارات، أفلام “الآكشن” والإثارة في سينما النجوم، كرة القدم، الأنشطة التي تنظّمها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وحتى، الوقوف ساعات على طوابير الزيت والسكر والرز والشاي وغيرها على أبواب “المؤسسة”، والمخابز، إبّان الحصار الاقتصادي معظم الثمانينيات على سورية. كان المخيم بيئة استثنائية للتفاعل والتأثر بكل ما يحدث في المنطقة العربية والعالم. بعد الاجتياح العراقي للكويت في 2 أغسطس/ آب 1990 بأسبوع، غادرت حائل، شمالي السعودية، برّا عائدا إلى دمشق، لأستقرّ في مخيم اليرموك طالبا جامعيا. على الطريق، شاهدت أرتال شاحنات عسكرية سعودية تنقل الدبابات والمدافع وعربات الجند المصفحة، وغيرها من أسلحةٍ ثقيلةٍ تتجه شرقا، في وقت كان فيه الإعلام السعودي، يؤكد أن لا نية للرياض في مواجهة مع العراق، وأنها متمسّكة بالحل الديبلوماسي بين الأشقاء. لدى وصولي، كان التوتر يسود المخيم؛ احتقان شعبي ورجال الأمن في كل مكان، كانت إذاعة مونت كارلو مصدرا رئيسيا لأخبار الحرب القادمة، قلّة منّا تمكّنوا من التقاط بث التلفزيون الأردني بوضوح صوتا وصورة. أعلنت سورية مشاركتها في الحلف الدولي ضد النظام العراقي، واستطاع صدّام حسين كسب تعاطف فلسطينيين كثيرين لمجرّد أن أميركا كانت هي العدو، مع بعض صواريخ سكود الاستعراضية التي أطلقها على الأراضي المحتلة.
تحسّنت الأوضاع الاقتصادية في سورية بعد ضيق الثمانينيات، بفضل الأموال الخليجية، لكن حالة الإحباط من “الهزيمة” استمرّت مسيطرة على المخيم. إعلاميا، حجبت بروتوكولات مؤتمر مدريد للسلام 1991 بريق الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وركّزت البروباغندا السياسية على فن صنع السلام، وعن أبطال السلام بعد أبطال الحرب، لم يحتف فلسطينيو المخيم بالسلام، بل اقتنعوا مع محمود درويش أن” كُلُّ شَيْءٍ مُعَدٌّ لَنا سَلَفًا”، وأن “هذا السَّلام سَيَتْرُكُنا حُفْنَةً مِنْ غُبار”. بعد “أوسلو” عام 1993 شعر فلسطينيو المخيم أن حلم العودة بات أبعد من أي وقت مضى، وأنهم يخسرون وزنهم النوعي فلسطينيا. لم تقدّم لهم فصائل “الرفض” الفلسطينية بديلا اجتماعيا سياسيا، حتى هي نفسها قرّرت الانتقال إلى الداخل الفلسطيني تحت عباءة “أوسلو”، وتلاشت سريعا لجان حق العودة التي شكّلها ناشطون فلسطينيون. منذ ذلك الحين، عانى فلسطينيو المخيم من أزمة تمثيل، وسيطر عليهم الشعور بالتخلي والخذلان إلى حد بعيد. تصدّع المجال السوسيولوجي في المخيم، وساءت أحواله الاقتصادية والاجتماعية، وبدأ خرّيجو الجامعات، وكنت واحدهم، بالانتقال إلى ضواحٍ في دمشق بدأ التوسع السكاني إليها حديثا، بحثا عن فضاء أرحب، من دون التخلي عن الهمّ العام أو قطع الصلة بالمخيم. بدا أن الروح تعود إلى الأخير بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومن ثم مع الغزو الأميركي للعراق عام 2003؛ قلّة من الأمهات استطعن استعادة أبنائهن المتطوعين للقتال، قبل أن تنطلق بهم الحافلات المتوجهة إلى بغداد، من عاد منهم، بعد سقوط بغداد، أخبرنا أن معظمهم لم يُسمح له بالقتال، وأن رصاصات من الخلف قتلت من قتلت منهم.
مع انطلاق الانتفاضة الشعبية السورية، كان حياد المخيم مجرّد خرافة، فالنسيجان الاجتماعيان، الفلسطيني والسوري، كانا متداخلين إلى حد كبير، تورّط المخيم، بدءا بالأعمال الإنسانية الإغاثية، ليجد نفسه جبهة قتال رئيسية في الحرب الأهلية السورية. المخيم اليوم سابع أكثر المناطق دمارا في سورية بنسبة تبلغ 65%، وعُفّش 93% من منازله وممتلكاته. فوجئ سكان المخيم، من سوريين وفلسطينيين، بصدور قرار تنظيمي يقضم مساحاتٍ واسعة منه، ويسمح بعودة 40% فقط من سكانه. لاحقا، أعلنت محافظة دمشق التريّث في تنفيذه، مؤكدة أنه لم يُلغ، وبدأت باستقبال طلبات الأهالي للعودة إلى المخيم، اعتبارًا من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفقًا لشروط السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على موافقات الجهات المختصة. بموجب هذه الشروط، عاد إلى مخيم اليرموك نحو 400 عائلة فقط. وانتظر الباقون “الفَرَجَ”، بعد أن سُمح لهم بالدخول لتأمل شواهد على دمارهم الاقتصادي والنفسي. والدي، الذي يزيد عمره عن عمر النكبة ببضع سنوات، كان أحد الواقفين على الأطلال، جلطات دماغية صامتة جعلته يغادر الحياة بعد شهرين من تلك الزيارة.
أُعلن مطلع الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) عن عودةٍ غير مشروطة إلى المخيم، مع مهلة شهر لترحيل الأنقاض من المنازل، استكمالا لإعادة تأهيل البنية التحتية فيه. سماسرة العقار نشطوا في المخيم مبكّرا هذا العام، وبدأوا بشراء البيوت أو التوسط لشرائها داخل المخيم بكل الوسائل، القانونية والالتفافية. تردّي الوضع الاقتصادي والتكلفة الكبيرة لإعادة الترميم لن يُمكّن معظم أهالي المخيم من القيام بأكثر من ترحيل الأنقاض، والحصول على بابٍ مستعمل ينامون محتضنين مفاتيحه. وقد بين استبيان لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، في يونيو/ حزيران الماضي، أن 72% لا يمتلكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، مقابل 4.9% قالوا إنهم قادرون على ذلك. معظم سكان المخيم مضطرّون للبيع، سيما من هم في الخارج، ولعلهم جميعا سوف يدركون أن هذه العودة “غير المشروطة” لم تكن إلا طُعما تجعلهم ضحايا للسماسرة من كل نوع. إنها الـ “لاعودة” بطريقة أخرى.
الذاكرة الفلسطينية لا تنسى، كان ذلك أحد مقومات الهوية الوطنية، لكنها اليوم إيقاع مأساةٍ مستمرّة، وبات الفلسطيني السوري مقتنعا أن “الكَمَنجاتُ تَتْبعُني ههُنا وهناكَ لتثأر مَنِّي/ الكَمَنجاتُ تَبْحَثُ عنِّى لتقتلني، أَيْنما وَجَدتْني”.
المصدر: العربي الجديد