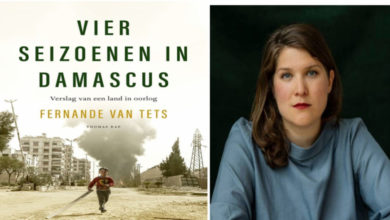تواترت أخيرا أنباءٌ كثيرةٌ عن أعمال عسكرية نُسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، أكبرها الهجوم على حافلة للمبيت تُقلّ عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، والذي قُتل نتيجته 37 عسكرياً، حسب مصادر إعلامية موالية وصفحات إخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكن التأكد من العدد بدقة، بسبب التكتم المفروض من القيادة الأمنية العسكرية للنظام على مثل هذه الأخبار.
يجب ألا يخفى عن البال أنّ ورقة “داعش” الأمنية ليست محصورة بجهة واحدة دون غيرها، فالقسم الأكبر من أسرى التنظيم موجود في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهذه خاضعة بشكل مباشر للحماية الأميركية، وقد هددت عدّة مرات، في السابق، بإطلاق سراح أسرى التنظيم، عندما وقعت تحت ضغوط غربية بشأن تعاملها في ملف حقوق الإنسان. من هنا، يمكن التكهّن بإمكانية ربط الهجوم الذي وقع في الأول من الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني) واستهدف قاعدة روسية شمال شرق مدينة الرقة، مع الموقف الروسي الضاغط على “قسد” لتسليم منطقة عين عيسى للنظام السوري، في مقابل منع الأتراك والجيش الوطني من اقتحام المنطقة. وإنّ المراقب ليشكّ بإعلان تنظيم حرّاس الدين مسؤوليته عن هذا الهجوم، فالمنطقة بعيدة جداً عن مناطق تمركز هذا التنظيم في محافظة إدلب من جهة، كما تفصلها مناطق حلب وريفها من جهة ثانية، وهي تقع تحت سيطرة “قسد” بالكامل، ما يعطي الانطباع بأنّ الأخيرة سهّلت لبعض خلايا “داعش” القيام بهذه المهمة نيابة عنها.
يُضاف إلى ذلك أنّ ورقة مكافحة الإرهاب والقضاء على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية كانت إحدى الركائز الثلاث التي حدّدتها الإدارة الأميركية لسياستها في سورية. ومن المعلوم أنّ الوجود الأميركي في منطقة شمال شرق سورية هو السند الوحيد لبقاء المنطقة تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية التي ستنهار حتماً تحت وقع ضربات الأتراك وحلفائهم من الجيش الوطني، وضربات النظام وحلفائه الروس بمجرّد رفع الحماية الأميركية عنهم. إذن، لا بدّ من بقاء المبرر الرئيس لهذا الوجود الأميركي في المنطقة.
يلعب تضارب مصالح الجهات المعادية للتنظيم دوراً مهماً في بقائه على قيد الحياة، فتحاول كل جهة توجيه بنادقها إلى صدور الخصوم والمنافسين، فمثلاً يغضّ الأميركيون النظر عن تحركات الدواعش، ما دامت موجهة صوب قوات النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين. وفي المقابل، يفعل الروس الشيء نفسه، عندما تكون أسلحة “داعش” موجهة إلى صدور خصومهم على الضفة المقابلة. لا يغيب عن البال هنا المثال الأبرز لاستثمار “داعش” من أجل تطويع الخصوم، فمقاتلو التنظيم الذين نقلوا من القلمون إلى شرق محافظة السويداء، لم يبخلوا على النظام السوري بالخدمات، لتطويع أهل المحافظة، الخارجين جزئياً عن السيطرة، وكلّنا يعرف المأساة التي وقعت هناك في 25 يوليو/ تموز عام 2018.
كذلك للإيرانيين والنظام السوري مصلحة في بقاء التنظيم، فالمليشيات الإيرانية المنتشرة بكثافة في المنطقة الحدودية مع العراق والأردن تعتبر وجودها شرعياً بحجّة مواجهة “داعش”. كذلك يستفيد النظام من هذه الفزّاعة، لإرهاب الأقليات المتاخمة مناطقهم لأماكن نشاط “داعش”، والمثال الأبرز هنا أيضاً هجوم الدواعش على قرية الفاسدة التابعة لمنطقة السلمية، ذات الأغلبية الإسماعيلية، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي عام 2020.
علينا أيضاً أن نأخذ ظروف “داعش” الخاصة بعين الاعتبار، وأن نحلل بنيتها الداخلية أيضاً، فلا بد من التفريق بين القادة الكبار للتنظيم وعملاء أجهزة الاستخبارات الذين تم زرعهم فيه بدقّة، خلال فترة نشوئه وتكوّنه من جهة أولى، والمقاتلين البسطاء ممن استولت على عقولهم فكرة الخلافة وإعادة إحياء أمجادها العسكرية من جهة ثانية، فالفئة الأولى تمزّقت بين قتيل ومعتقل، وبين عائد إلى حضن الجهاز الذي زرعه في صفوف التنظيم. والفئة الثانية، وهي الأكبر والأوسع، تشرّدت في البادية السورية باعتبارها حصناً طبيعياً بعد خسارتها المدن والقرى التي كان يسيطر عليها التنظيم. وهؤلاء لا مجال لديهم للعودة إلى الحياة الطبيعية، فلن تقبل بهم حكومات بلدانهم أبداً، وأغلبهم مرصود ومعروف لأجهزة المخابرات في دولهم. إذن، لم يبق أمامهم سوى القتال حتى الفناء، أو إيجاد مخرج مع الزمن، كما حصل بين حركة طالبان وأعدائها المحليين والأجانب.
من الناحية العسكرية، تعتبر بادية الشام من جهة الشرق مغلقة أمام الدواعش، لوجود قاعدة أميركية في منطقة التنف على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، فهذا الوجود هناك، مع الميزات التكنولوجية المتطورة جداً للقوات الأميركية، يجعل من الصعب على “داعش” التحرّك في ذلك الاتجاه. يُضاف إلى ذلك أنّ منطقة البادية السورية تعتبر خاصرة رخوة من الناحيتين، الأمنية والعسكرية، فهي حصن طبيعي طالما استخدمه العصاة والمهرّبون.
يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها بأنّ التنظيم الأكثر شراسة بين التنظيمات الإسلامية ليس موحداً، إن لم يكن على صعيد التنظيم، فعلى الأقل على صعيد ساحات العمل. ما ميّز “داعش” عن غيره من التنظيمات الإرهابية، الانتماء الفكري العجيب له، على الرغم من عدم ارتباط المنتمين به تنظيمياً بالمعنى المتعارف عليه، فالفكرة كانت جاذبة لكثيرين من الشباب الضائع، وخصوصا المنتمين إلى فئات المهاجرين المسلمين من شمال أفريقيا، ولم يتمكّنوا من الاندماج الكامل في المجتمعات الغربية، أو الذين لم تستطع هذه المجتمعات هضمهم، على الرغم من أنهم أبناء الجيل الثالث للمهاجرين الأوائل. وجد هؤلاء في التنظيم فرصةً لتحقيق الذات من خلال السلطة المطلقة التي مُنحت لهم، فكان مردّ كثير من حالات القتل الهمجية والاستعراض على طريقة هوليود لإشباع غرائز مقهورة ودفينة، ما كان لها أن تظهر بهذا الشكل الكبير في الدول التي كانوا يعيشون فيها.
إذن، هناك عوامل داخلية تتمثل في بنية التنظيم وحاجات أفراده النفسية، للبقاء في ساحات الفعل، وعوامل خارجية تتمثل في استثمار القوى الفاعلة في المنطقة لهذا الوحش خدمة لمصالحها. سيبقى شبح “داعش” مخيماً على المجتمعين، السوري والعراقي، ما دام البلدان محكومين بإرهاب الدولة والمليشيات. ولن نستطيع الحديث عن زوال هذا الخطر ما دام الانتقال السياسي لم يحصل فيهما. سيبقى التنظيم أداة للاستثمار السياسي بيد أصحاب المصالح، إلى أن تنتهي أساب وجوده.
المصدر: العربي الجديد